الصورة
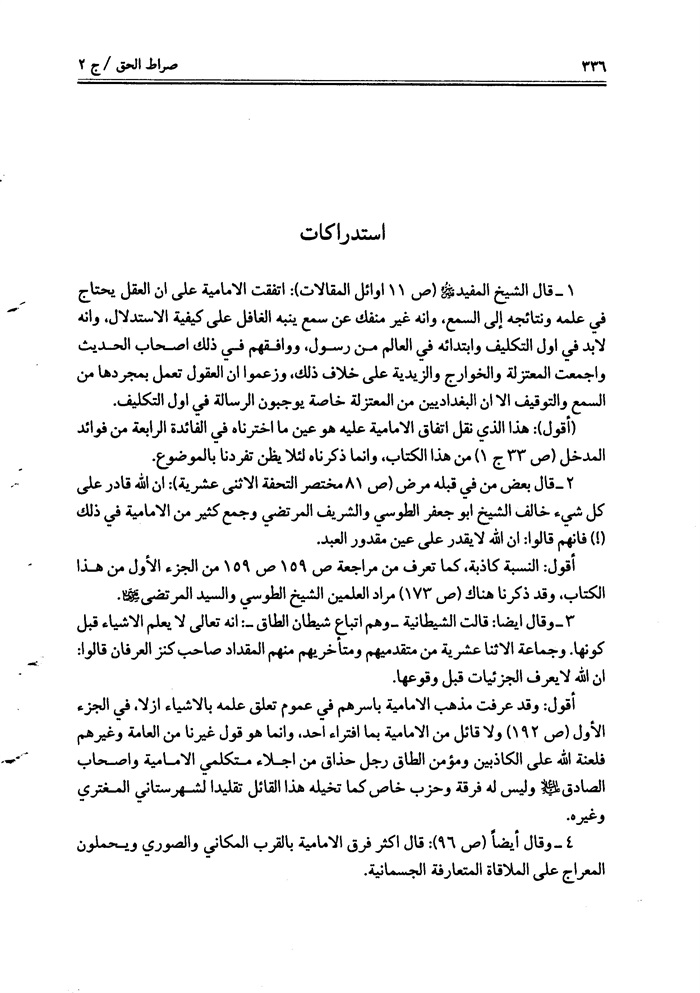
ص: 336
صراط الحق في المعارف الإسلامیة و الأصول الإعتقادیة
سایر عناوین:علم الکلام / المعارف الاسلامیه و الاصول الاعتقادیه
نویسنده: محسنی، محمد آصف
تعداد جلد: 4
زبان:عربی
ناشر: ذوی القربی - قم - ایران
سال نشر: 1385 هجری شمسی|1428 هجری قمری
محرر رقمي:میثم حیدری
ص: 1
ص: 2
بسم الله الرحمن الرحيم
ص: 3
ص: 4
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، و لا يحصي نعماءه العادون، و لا يؤدي حقه المجتهدون، و الذي لا يدركه بعد الهمم، و لا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود، و لا نعت موجود، و لا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته، و نشر الرياح برحمته، أو الدين معرفته، و كمال معرفته التصديق به، و كمال التصديق به توحيده، و كمال توحيده الإخلاص له، و كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. و من قال: فيم؟ فقد ضمنه، و من قال: على م؟ فقد أخلى منه، كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، و غير كل شيء لا بمزائلة.
و الصلاة و السلام على أفضل سفرائه و أشرف مخلوقاته محمد خاتم النبيين، و على آله الأئمه الهداة المعصومين الذين فرض الله طاعتهم على الناس أجمعين.
هذا هو الجزء الثاني من كتابنا «صراط الحق» في تحرير الأصول الاعتقادية و المعارف الإسلامية بصريحٍ العقل و صحيح النقل، و نرجو من الله سبحانه أن يجعله مفيداً للطالبين، و دليلاً للسالكين، و هادياً للضالّين، و حجةً على المعاندين، إنّه أكرم من اهتدى إليه السائلون.
ص: 5
ص: 6
المقصد الثالث
في تجليله تعالى عمّا لا يليق به
المطلب الأول: في أنّه تعالى لا يمكن أن يرى
المطلب الثاني: في أنّه تعالى ليس بمكاني
المطلب الثالث: في أنّه تعالى ليس بزماني
المطلب الرابع: في نفي الحركة و السكون عنه
المطلب الخامس: في أنّه تعالى ليس بجسم
المطلب السادس: في نفي الحلول و الاتحاد
المطلب السابع: في ابطال وحدته تعالى مع مخلوقه
المطلب الثامن: في نفي الحاجة عنه تعالى
المطلب التاسع: في نفي اللذة و الألم عنه تعالى
المطلب العاشر: في أنّه ليس محلّاً للحوادث
المطلب الحادي عشر: في نفي النقص عنه تعالى
المطلب الثاني عشر: في امتناع الاكتناه بحقيقته تعالى
الخاتمة
ص: 7
ص: 8
المقصد الثالث: في تجليله تعالى عمّا لا يليق به(1)
قد أسمعناك في الجزء الأول أنّ صفاته تعالى: إمّا ثبوتية كمالية، و إمّا سلبية تقديسية، أي أمور يمتنع ثبوتها لذاته المقدسة الواجبة، و لا يمكن اتصافها بها أبداً. و الثانية هي المقصود بالبحث عنها في هذا المجال، و حاصل المرام هو تنزيهه تعالى عن النواقص و لواحق الإمكان، و تجليله عن موانع الوجوب و مواقع الحدثان، فما أوهن رأي من اعتقد(2) أنّه سبحانه منزّه عن التنزيه كما ينزّه عن التشبيه؛ لأنّ التنزيه معناه السلب، و هو فرع إمكان الإثبات و لو ذاتاً و إن امتنع خارجاً لمانع.
و كلامه بطوله خبط فلاحظ. و قد قلنا: إنّ المراد من التنزيه هو نفي إمكان الإثبات لا مجرد سلب الوقوع، كيف و لو تمّ قوله لقلبناه على تنزيهه من التنزيه فيبطل من حيث ما صح! و قال أيضا في آخر كلامه (رحمه الله): إنّ ما في القرآن المجيد و كلمات المعصومين (عليهم السلام) من توصيفه بالتنزيه فهو على التوسع من باب التعريف على حسب كينونة العباد... و هو كما ترى. إذا تقرر ذلك فنبحث عن هذا المقصد في ضمن مطالب:
ص: 9
فاعلم أنّ الرؤية مشروطة بأمور:
1 - المقابلة بين الرائي و المرئي أو ما في حكمها، كما في رؤية الأعراض فإنّها في حكم محالّها القائمة بالذات المحاذية للرائي و كما في رؤية الإنسان صورته في المرآة مثلاً.
2 - عدم البعد المفرط، و هذا الشرط مما يتفاوت بحسب قوة البصر و ضعفه و من حيث كبر المرئي و صغره، ومن جهة إشراق لون المرئي و كدورته، فإنّ قويّ البصر قد يرى شيئاً على بعدٍ مخصوص و لا يراه ضعيف البصر على نفس البعد، و المرئي العظيم المقدار قديرى من بعدٍ و لا يرى الصغير المقدار من ذلك البعد، و ما لونه أكثر إشراقاً و ضوءاً يرى من بعد أكثر.
3 - عدم القرب المفرط، فإنّ المرئي إذا التصق بسطح البصر بطل إدراكه تماماً.
4 - سلامة الحاسّة، و هي واضحة الاعتبار، فحال العين الفاسدة حال سائر الأعضاء في عدم الرؤية.
5 - عدم الحجاب بين الرائي و المرئي، و فسره بعضهم بالجسم الكثيف المانع للشعاع من النفوذ فيه. و قيل هو الجسم الملوّن أو المضيء. و فيه: أنّ جملةً من الأجسام الملونة الرقيقة غير مانعة من الرؤية.
6 - عدم صغر المرئي المفرط؛ و لذا لا ترى المكروبات.
7 - قصد الرائي للرؤية؛ و لذا يرى في حال النوم و الغفلة و عدم الالتفات، و هذا شرط لزوم الرؤية، لا شرط جوازها.
8 - كثافة المرئي بحيث يمتنع نفوذ الشعاع فيه، كما قيل. و لازمه أن لا يرى الماء و بعض أقسام الزجاج فإنّهما لا يمنعان من نفوذ الشعاع فيهما. و يظهر من العلاّمة (قدس سره)(1) تفسير الشفّاف بما لا لون له، فإنّه قال: فإنّ الجسم الشفّاف الذي لا لون له كالهواء لا يمكن رؤيته. أقول: و في الحقيقة ان المرئي أولاً و بالذات هو الألوان فقط.
ص: 10
9 - أن يكون المرئي مضيئاً أو مستضيئاً، أي كونه ذا ضياء بنفسه أو من غيره؛ و ذلك لأنّ الجسم الملون لا يشاهد في الظلمة، بل إنّ اللون - و هو مبصر بالذات - لا يري إلاّ بالضوء فكيف حال غيره؟ بل ذهب ابن سينا و غيره من مشاهير الحكماء(1) إلى أنّ الضوء شرط لوجود اللون، لا لظهوره فقط، فالمرئي لا بد أن يكون ذا ضوء.
لا يقال: إنّه قد يكون مانعاً من الرؤية كما في رؤية جرم الشمس فإنّها لا ترى لأجل ضوئها.
فإنّه يقال: الذي جعلناه شرطاً هو حدّ مخصوص منه، و المانع هو المرتبة الشديدة منه.
10 - توسّط الشفّاف بين الرائي و المرئي كما قيل، و قيل: إنّه غير عدم الحجاب، و أسقطه بعضهم مع الرابع و السابع. و قيل برجوع الأخير إلى عدم الحجاب. لكنّ إسقاط الرابع و السابع لا وجه له.
و عند تحقق هذه الشرائط تقع الرؤية بالضرورة البتية، فهو علّة تامة لها قطعاً، و ما تخيّله الأشعري من أنّ توقفها على الأمور المذكورة إنّما هو بحسب العادة دون العلّية الواقعية فيمكن تحققها مع فرض عدم الرؤية، سفسطه واضحة لا يجوز صرف الوقت في ردّها أبداً، فمهما وجدت هذه الأمور فقد امتنع عدم الرؤية بالضرورة، و الضروريات مما لا يمكن أن تتعلق بها القدرة و لو كانت أزلية.
نعم، للقادر القديم أن يمنع من تحقيق العلّة بتمامها أو بعض أجزائها فيمتنع المعلول(2)، و أمّا منع المعلول مع وجود علّته التامة فهو ممّا لا يمكن القول به من العاقل، فإنّه بمنزلة منع أنّ ضرب الخمسة بنفسها ينتج خمسةً و عشرين!
و لعلّك تقول: فكيف نرى الشيء الكبير من البعيد صغيراً؟ و ما ذلك إلا لعدم رؤيتنا جميع أجزائه مع تساويها في حصول الشرائط المذكورة، فقد ثبت جواز تخلف الرؤية عن تلك الشرائط.
لكن يمكن أن نجيبك بأنّ التفاوت من جهة القرب و البعد، فنرى القريب منها دون البعيد، و يتحقق هذا التفاوت بخروج خطوط ثلاثة من الحدقة إلى المرئي، أحدها عمود و الباقيان ضلعا مثلث قاعدته المرئي، فالعمود أقصر لأنّه يوتر الحادّة، و الضلعان أطول لأنّهما يوتران القائمة.
ص: 11
لكنّ هذا الجواب ضعيف جداً(1). وحكى عن المحقّق الطوسي(2) و غيره: أنّه لا يلزم من رؤيتنا جميع أجزائه أن نراه كبيراً، و إنّما يلزم ذلك لو كان صغر المرئي و كبره بحسب رؤية الأجزاء و عدمها، و ليس كذلك، بل صغر المرئي و كبره بحسب صغر الزاوية الجليدية و كبرها على ما بيّن في علم المناظرة، يعني أنّ هذه الزواية كانت أو سع إذا كان المرئي أقرب من الحدقة و أضيق إذا كان المرئي أبعد منها.
أقول: و أورد عليه صاحب المواقف باعتراض مبنيّ على تركب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزّأ، و حيث إنّها باطلة بالضرورة كما أشرنا إليها في المقصد الأول أهملنا بيانه، مع ضعفه من غير هذه الجهة أيضاً.(3)
فتحصّل: أنّ اجتماع هذه الأمور بأسرها علة تامة للرؤية، و لا يعقل التخلّف أبداً. كما أن انتفاءها بأسرها يوجب انتفاء الرؤية بعين الملاك، و أمّا انتفاء بعضها فلا يستلزم انتفاءها مطلقا، بل فيه تفصيل، فإنّ ارتقاع الشرط الأول والخامس و التاسع مثلاً يوجب امتناع الرؤية، و انتفاء الثاني و السادس و السابع لا يوجب إلا نفيها عادةً.
و بالجملة: الشرط إن كان عقلياً فعدمه يوجب استحالة الرؤية عقلاً، و إن عادياً فبنفيه تمتنع الرؤية عادةً، و هذا واضح للعقلاء.
إذا تقرر ذلك فاعلم: أنّ الواجب القديم المنزّه عن الجسم و لوازمه لا يمكن أن يرى، كما عليه الإمامية و المعتزلة و الحكماء، و الدليل عليه من وجوه:
1 - أنّ كل مرئي لا بدّ أن يكون مقابلاً بالضرورة البتّية العقلية، و كلّ مقابل فهو في جهة بالضرورة، فلو كان الله مرئياً لكان متحيزاً في جهة، و سيأتي أنّ تحيّزه في الجهة محال عقلاً، و متفق عليه بيننا و بين من نريد إرشاده أيضاً، فتكون رؤيته أيضاً محالاً.
لا يقال: الكلّية القائلة بأنّ كلّ مرئي لا بد أن يكون مقابلاً، لا تزيد وضوحاً على الكلّية القائلة بأن كلّ موجود يجب أن يكون في جهة، فكما أنّ الثانية وهمية لا يعتنى بها، فكذلك الأولى فلتكن عاديةً لا عقلية.
قلت: بينهما بون بعيد و اختلاف شديد، فإنّ الثانية وهمية كاذبة يفنّدها العقل في حلقه، بخلاف الأولى فإنّها ثابتة قطعية عنده.
ص: 12
و بالجملة: لو تمّ هذا الشكّ لارتفع الأمان عن الأحكام العقلية رأساً.
و أما ما يقال من أنّ هذا الأمر لو كان ضرورياً لم يقع فيه اختلاف من العقلاء، ففيه ما مرّ في أول هذا الكتاب، من أنّ الضروري لا ينافي اختلاف الناس فيه، و إلا لم يبق ضروري لنا.
2 - أنّه تعالى ليس بجسم فضلاً عن جسم كثيفٍ فلا يرى، و إلا للزم رؤية العلم و الشجاعة و الحياء و طعوم الأطعمة، بل و الأمور الواقعية: كاستحالة المستحيلات، و إمكان الممكنات و الاستعدادات، و ملازمة الزوجية للأربعة و نحو ذلك، و لا يظن بعاقل أن يلتزم بها، فيكون بطلان التالي دليلاً على فساد المقدّم.
3 - لو كان الواجب مرئياً لكان له ضياء، و لكنّه لا ضياء له؛ لاستحالة كونه محلّاً للحوادث، فلا يمكن رؤيته. و أمّا بناءً على أنّ الرؤية بخروج الشعاع من المرئي الى الرائي فالاستحالة أظهر؛ إذ لا يتولّد منه تعالى شيء.
4 - لو يرى فإمّا أن يرى كلّه، و إمّا أن يرى بعضه بالضرورة، لكنّ الأول يوجب تحديده و تناهيه، و هذا محال عقلاً و نقلاً و اتقاقاً، و يلزم أيضاً منه خلو سائر الأمكنة عنه. و الثاني فاسد، ضرورة، للزوم التركّب من التبعّض فينقلب من الوجوب الى الإمكان.
5 - كلّ مرئي مشار إليه بالضرورة، و الواجب القديم ليس بمشار إليه عقلاً، و الا لزم تحيزه و اتفاقاً ممن نبحث معه في المقام.
6 - لو كان مرئياً لأحد لكان معلوماً له، لكنه ممتنع المعلومية لغيره عقلاً و نقلاً و اتفاقاً، بيان الملازمة: أنّ المرئي أولاً و بالذات - في الأجسام - هو الأعراض، و حيث إنّه لا عوارض للواجب القديم باتفاق الطرفين فيكون المرئي ذاته، و هذا معنى أنّ رؤيته مستلزمة لإدراك ذاته فتكون ممتنعة.
و علي الجملة: الرؤية المربوطة بالواجب بمعنى العلم، سواء كانت منه أم عليه، فإذا قيل: إنّ الله يرى يعنى به أنّه يعلم. و إذا قيل: إنّه يرى - بضم الياء و كذا في ما بعده - يعنى به أنّه يعلم، فافهم.
فهذه أدلة قويمة قوية قطعية على استحالة رؤيته تعالى.
و أما الدلائل النقلية و الآيات القرآنية على ذلك، فإليك بيانها:
7 - قوله تعالى: وَ لاٰ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً(1) كذا كلّ ما دلّ على أنّه لا يعلم بالتقريب المتقدم.
8 - قوله تعالى: بَدِيعُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ أَنّٰى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صٰاحِبَةٌ
ص: 13
وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ ءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (1) ... لاٰ تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصٰارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ اَلْأَبْصٰارَ(2)
وجه الدلالة: أن الإدراك متى قرن بالبصر لا يفهم منه إلا الرؤية بالعين، فإذا قيل: أدركته ببصري و ما رأيته، أو قيل: رأيته و ما أدركته ببصري، كان الكلام متناقضاً عند كلّ عاقل عارف باللسان العربي. فمعنى الآية: أنّ الله لا يراه أحد و لكنه يرى الأبصار، و هذه الصفة مختصة به تعالى بناءً على إنكار المجردات و صحة رؤية الملك و الجن. نعم، الآية تدلّ على نفي الوقوع دون الإمكان.
و قيل: إنّ الله سبحانه تمدّح بذلك؛ و لذا ذكره في أثناء المدائح فهو كمال و الصفة إذا كان أحد طرفيها من الوجود أو العدم، كمالاً كان الآخر نقصاً فيمتنع عليه تعالى، و أمّا الفعل فهو ليس كذلك؛ إذ يمكن كون عمل مدحاً و كمالاً و عدمه ليس بقبيح و نقصاً، كما في العفو و الانتقام، فإنّ الأول تفضّل، و الثاني عدل، و كلاهما كمال.
أقول: و فيه: أنّ عدم كونه مرئياً ليس من الصفات الذاتية، بل هو من الأوصاف المدحية كما مرت، و هي مثل الأفعال، و لذا كونه تعالى مشكوراً و معبوداً كمال و حسن، مع أنّ عدمهما ليس بنقص له، فإذا لم يشكره شاكر و لم يعبده عابد لا يكون ذلك نقصاً له، فافهم جيداً.
نعم، إطلاق الآية و ذكر نفي الرؤية المذكورة في مقام التمدحٍ دليلان على أنه لا يرى مطلقاً، لا في الدنيا و لا في الآخرة، فرضنا الرائي رسولاً كريماً أو زنديقاً لئيماً.
ناقش في هذا الاستدلال جماعة من أتباع الاشعري بوجوه عدّها الرازي في تفسيره - ذيل الآية الشريفة - إلى ستّة أوجه، لكنّها ممّا لا يستحق الجواب؛ لوضوح فسادها، و مع ذلك فنحن نذكر ما هو أهمها لتعرف الحال في غيره.
قال: لا نسلّم أنّ إدراك البصر عبارة عن الرؤية. و الدليل عليه: أنّ لفظ «الإدراك» في أصل اللغة عبارة عن اللحقوق و الوصول... فالحاصل: أنّ الرؤية جنس تحتها نوعان: رؤية مع الإحاطة، و رؤية لا مع الإحاطة، و الرؤية مع الإحاطة هي المسمّاة بالإدراك. فنفي الإدراك يفيد نفي نوع واحد من نوعي الرؤية، و نفي النوع لا يوجب نفي الجنس، فلم يلزم من نفي الإدراك عنه تعالى نفي الرؤية عنه، فهذا وجه حسن مقبول.
أقول: و هذا وجه قبيح مردود عليه:
ص: 14
أولاً: بما في مختار الصحاح: أدركه ببصره، أي رآه، فقد تمّ ما قررناه أولاً.
ثانياً: أنّ رؤيته مساوقة لإدراكه، فنفي إدراكه بعينه نفي لرؤيته بتقريب مرّ في الدلائل العقلية.
و ثالثاً: لو كان المراد نفي الرؤية مع الإحاطة لا مطلقها، لما كان لتخصيصه به سبحانه وجه أصلاً، إذا أكثر المبصرات لا يحاط بها، فضلاً عن أن يتمدح به.
ثم إنّه لم يكتف بهذا المقدار، حتى ادّعى أنّ الآية تدلّ على صحة رؤيته، بل على وقوعها! و إليك بعض وساوسه و أوهامه, قال: إنّ الله تمدّح بقوله: لاٰ تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصٰارُ(1) كما قلتم, فلابد أن تكون رؤيته جائزة, فإنّ الشيء إذا كان في نفسه جائز الرؤية, ثم إنّه قدر على حجب الأبصار عن رؤيته و عن إداركه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على المدح.
أقول: وقد خفي عليه أنّ هذا التلفيق لو تمّ لدلّ على إمكان الولد و الصاحبة له تعالى, و إمكان زوال علمه بكل شيء عنه, فإنّ الله تمدّح بنفي الأولين و ثبوت الثالث في نفس هذه الآية, و المدح في قاموس الأشعرييّن يلازم إمكان الممدوح به!!
و لعلّه يلتزم به حتى يتمّ قول مشايخه في مسألة الرؤية. و حلّ الإشكال: أنّ المدح كما يصح بالأفعال الاختيارية كذلك يجوز بالكمالات الذاتية, قال الله تعالى: قُلِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي اَلْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ اَلذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً(2). و أما بقية أوهامه فتر كناها لعدم الفائدة في إيرادها و إبطالها سوى إطالة المقام.
9 - قوله تعالى: وَ إِذْ قٰالَ مُوسىٰ لِقَوْمِهِ يٰا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخٰاذِكُمُ اَلْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلىٰ بٰارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بٰارِئِكُمْ فَتٰابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ اَلتَّوّٰابُ اَلرَّحِيمُ * وَ إِذْ قُلْتُمْ يٰا مُوسىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اَللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ اَلصّٰاعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (3).
قال بعض السادة الأمجاد(4) ما هذا ملخّصه: هاتان آيتان متصلتان, و الاُولى نصّت على عقوبة متخذي العجل بقتل أنفسهم, و نصّت الثانية على عقوبة الطالبين رؤية الله جهرة بالصاعقة تأخذهم و هم ينظرون, و هذا بمجرده يوجب القطع بتساوي الجرمين في الكفر؛ لتساويهما في
ص: 15
العقوبة من الله تعالى, و ليس شيء أدل من هذا على امتناعي الرؤية و وجوب الإنكار على القائلين بها..
10 - قوله تعالى: أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَمٰا سُئِلَ مُوسىٰ مِنْ قَبْلُ * وَ مَنْ يَتَبَدَّلِ اَلْكُفْرَ بِالْإِيمٰانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوٰاءَ اَلسَّبِيلِ (1).
وجه الدلالة: أنّ السئوال عن الرؤية كفر, و لا وجه له إلّا استلزامها تجسّم الباري و حدوثه فهي ممتنعه في حقه.
لا يقال: و لعله من جهة العناد دون امتناع المسؤول.
فإنّه يقال: قوله تعالى: يَسْئَلُكَ أَهْلُ اَلْكِتٰابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰاباً مِنَ اَلسَّمٰاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقٰالُوا أَرِنَا اَللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ اَلصّٰاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ (2) يدل على ما ذكرنا, و لا معنى للأكبرية إلّا اختصاص الثاني بالاستحالة المزبورة, ضرورة تحقق العناد في كلا السؤالين, فاستقم و تأمل.
11 - قوله تعالى: وَ لَمّٰا جٰاءَ مُوسىٰ لِمِيقٰاتِنٰا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قٰالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قٰالَ لَنْ تَرٰانِي وَ لٰكِنِ اُنْظُرْ إِلَى اَلْجَبَلِ فَإِنِ اِسْتَقَرَّ مَكٰانَهُ فَسَوْفَ تَرٰانِي فَلَمّٰا تَجَلّٰى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَّ مُوسىٰ صَعِقاً فَلَمّٰا أَفٰاقَ قٰالَ سُبْحٰانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ اَلْمُؤْمِنِينَ (3).
قالوا: كلمة «لن» للتأبيد, فإذا لا يراه موسى لا يراه غيره بطريق أولى.
أقول: فالروايات الواردة في وقوع رؤية الله سبحانه كلها تطرح لمخالفتها القرآن الكريم, بل الآية تدل على امتناع الرؤية أيضاً, فإنّ الرؤية معلقة على استقرار الجبل حال اندكاكه, و من الظاهر امتناع استقراره حين اندكاكه؛ لأنّه من الجمع بين الضدين أو النقيضين, و ليس الشرط هو مجرد الاستقرار, و إلّا للزم و قوع رؤية الله تعالى لموسى (ع), ضرورة تحقق المعلق بتحقق المعلق عليه, مع أنّ قوله تعالى: لَنْ تَرٰانِي(4) و قوله: فَلَمّٰا أَفٰاقَ قٰالَ سُبْحٰانَكَ تُبْتُ (5) صريح في أنّ موسى (ع) لم يره. و مع هذا فقد ادّعى قوم دلالة الآية على صحة رؤيته, تعالى و إليك بيان تلفيقهم ملخّصاً(6):
ص: 16
1 - لو كانت الرؤية ممتنعة لما سألها موسى (ع), فإنّ العاقل لا يطلب المحال, و أمّا احتمال أنّ موسى (ع) لم يعلم به - كما عن بعض المعتزله - فهو لا يتحقق من المؤمن.
2 - الرؤية علقت على استقرار الجبل الممكن، فهي ممكنة، لكن قد عرفت بطلانه بوضوح.
3 - التجلّي للجبل، معناه: أنّ الجبل قد رءاه فيستكشف عن إمكان الرؤية.
4 - لو كانت الرؤية ممتنعة لكان الجواب: لا أرى، دون «لن تراني» فإنّه يدلّ على أنّ رؤيته ممكنة، لكن موسى لا يراه.
أقول: أمّا الوجه الأول، فجوابه: أنّ القرآن ينزّه ساحة هذا النبي العظيم من هذه التهمة! و يصرح بأنّ هذا السؤال من قبل قومه، و أنّ بني اسرائيل هم الذين أصروا على ذلك و أجبروا نبيهم على السؤال عن ذلك: فاستنطق القرآن حتى ينطق لك: وَ إِذْ قُلْتُمْ يٰا مُوسىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اَللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ اَلصّٰاعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (1)وَ اِخْتٰارَ مُوسىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقٰاتِنٰا فَلَمّٰا أَخَذَتْهُمُ اَلرَّجْفَةُ قٰالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيّٰايَ أَ تُهْلِكُنٰا بِمٰا فَعَلَ اَلسُّفَهٰاءُ مِنّٰا(2).
أقول: و كيف يصح للمسلم أن يدّعي أنّ موسى (ع) أراد أن ينظر إلى الله، و النظر إلى الله، و النظر يستلزم جهة المنظور إليه؟!
و أما الوجه الثالث فهو أقوى دليل على أن المستدل يستهزئ بالقرآن المجيد و يطبّقه على طريقه آبائه الأولين و إن كان بينهما بون بعيد و تباين جلي! و لا أدري كيف رضي بهذا التلفيق و إثبات الرؤية للجبل و تفضيله على أحد أنبياء أولي العزم(3)؟!
و أمّا الوجه الأخير فمنقوض بقوله تعالى: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً(4) فإنّه - على مذهب هؤلاء الناس - يدل على إمكان الولد، و إلا لتعيّن التعبير ب - «الحمد لله الذي لا و لد له» أو «لا يمكن أن يكون له ولد» و جوابه هو جوابه.
و للصدوق (رحمه الله) رواية نقلها بإسناده عن الرضا (ع)، و هي بطولها موضحة لهذه الآية و تدفع
ص: 17
عنها كل شبهة تخطر بالبال، فلا حظها(1).
و الأرجح عندي - عدم دلالة الآية على هذه المسألة أصلاً، فإنّ غاية ما استفدناه منها هو امتناع الرؤية بالنسبة إلى موسى (ع) و أنّه لا يرى الله، و في الوجود من هو أفضل و أشرف من موسى - على نبينا و آله و عليه السلام - فلا يصح أن ينفى الرؤية عن غيره بالأولوية كما قالوه، و لا بالاجماع لأنه غير تام عندنا.
و بالجملة: الآية الكريمة لا تدل على امتناع الرؤية في نفسها، و لا على عدم وقوعها مطلقا، إلا بالنسبة إلى من و هو أدنى من موسى (ع).
قال شيخنا الأجل الأقدم، أبو عبد الله المفيد نوّر الله مضجعه: أقول: إنّه لا يصح رؤية الباري بالأبصار، و بذلك شهد العقل، و نطق القرآن، و تواتر الخبر عن أئمة الهدى من آل محمد (ص)، و عليه جمهور أهل الإمامة و عامة متكلّميهم، إلا من شذّ منهم لشبهةٍ عرضت له في تأويل الأخبار، و المعتزلة بأسرها توافق أهل الإمامة في ذلك، و جمهور المرجئة و كثير من الخوارج و الزيدية، و طوائف من أصحاب الحديث. فيه المشبّهة و إخوانهم من أصحاب الصفات(2). انتهى.
أقول: لعلّ مراده من هذا الشاذّ هو أحمد بن محمد بن نوح السيرافي، كما ذكره الشيخ الطوسي (قدس سره) في فهرسته، و قال إنّه ثقة في روايته، غير أنّه حكي عنه مذاهب فاسدة في الأصول مثل القول بالرؤية و غيرها. انتهى.
لكن التعبير بالحكاية يدل على عدم ثبوت هذه النسبة إليه(3).
و كيفما كان فقد قال العلامة المجلسى(4): إنّ استحالة ذلك (اي الرؤية) مطلقاً هو المعلوم من مذهب أهل البيت (ع)، و عليه إجماع الشيعة باتفاق المخالف و المؤالف... إلى آخره.
أقول: و من الجدير أن نتبرك بنقل بعض الروايات الواردة عن أهل العصمة و أرباب الحكمة:
1 - صحيحة صفوان عن الرضا (ع)(5) فقد قال في آخر كلامه لأبي قرة: «و قد قال الله وَ لاٰ
ص: 18
يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً(1) فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم و وقعت المعرفة، فقال أبو قرة: فتكذب بالروايات؟ فقال أبو الحسن (ع): «إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها، و ما أجمع المسلمون عليه أنّه لا يحاط به علماً، و لا تدركه الأبصار، و ليس كمثله شيء».
2 - صحيحة أحمد بن إسحاق(2) قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) أسأله عن الرؤية و ما اختلف فيه الناس؟ فكتب: «لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي و المرئي هواء ينفذه البصر(3)، فإذا انقطع الهواء عنالرائي و المرئي لم تصح الرؤية، و كان في ذلك الاشتباه، لأنّ الرائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما وجب الاشتباه و كان ذلك التشبيه، لأن الأسباب لا بد من اتصالها بالمسببات».
3 - رواية إسماعيل بن الفضل(4) قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) عن الله تعالى هل يرى في المعاد؟ فقال: «سبحان الله و تعالى عن ذلك علواً كبيراً. يابن الفضل، إنّ الأبصار لا تدرك إلا ما له لون و كيفية، والله خالق الألوان و الكيفية».
4 - صحيحة البزنطي، عن أبي الحسن الموصلي(5)، عن أبي عبد الله (ع) قال: «جاء حبر إلى أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك حين عبدته؟ فقال: ويلك ما كنت أعبد رباً لم أره. قال: و كيف رأيته؟ قال: ويلك: لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار، و لكن رأته القلوب بحقايق الإيمان أقول: و بمعناها روايات أخر. و لنكتف بذلك، و قد مرّ عن المفيد (رحمه الله) أنّ الأخبار في ذلك متواترة.
من هو القائل بالرؤية؟ القائل بها طائفتان:
الأولى: الكرامية و المجسّمة الذين يقولون بأن ربهم جسم. و لسنا نلتفت إليهم في هذا المقام، فإنّ الجسم ممكن الرؤية بلا إشكال.
الثانية: أتباع الأشعري و من كان قبله ممن هم بمنزلتهم فهماً و تعقّلاً، قال بعض(6): إنّ رؤية الله تعالى جائزة في الدنيا عقلاً، و اختلف في وقوعها و في أنه هل رآه النبي (ص) ليلة الإسراء أو
ص: 19
لا؟ فأنكر عائشة و جماعة من الصحابة و التابعين و المتكلمين، و أثبت ذلك ابن عباس(1).... و أخذه به جماعة من السلف، و الأشعري في جماعة من أصحابه، و ابن حنبل، و كان الحسن يقسم لقد رآه!! و توقف فيه جماعة، هذا حال رؤيته في الدنيا، و أمّا رؤيته في الآخرة فجائز عقلاً. و أجمع على وقوعها أهل السنّة!
ماذا يقولون؟ قال قائلهم(2): لا نزاع للمنافين «هكذا» في جواز الانكشاف التام العلمي، و لا للمثبتين في امتناع ارتسام الصورة من المرئي في العين أو اتصال الشعاع الخارج من العين بالمرئي، و إنّما محل النزاع: أنّا إذا عرفنا الشمس مثلاً بحدّ أو رسم كان نوعاً من المعرفة، ثم إذا بصرناها و غمضنا العين كان نوعاً آخر فوق الأول، إذا فتحنا العين حصل نوع آخر من الإدراك فوق الأوّلين نسمّيها الرؤية، و لا يتعلق في الدنيا إلا بما هو في جهة و مكان. و مثل هذه الحالة الإدراكية هل يصح أن يقع بدون المقابلة و الجهة و أن يتعلق بذات الله منزّهاً عن الجهة و المكان أم لا؟ انتهى. و لعل هذا غاية تهذيب دعواهم برفض منكرات عقلية دان بها سلفهم. و مع ذلك فهو مصادم للعقل في أولياته، فإنّ مثل هذه الرؤية لا يعقل تحققها من غير مقابلة المرئي و تحيزه في جهة ف كما عرفته مفصلاً.
و من هنا عدل بعض أفاضلهم(3) عن هذه العقيدة الزائفة، فقال في كتابه الكبير المسمّى ب - «دائرة معارف القرن العشرين»(4): قد نص القرآن بصريح العبارة أنّ الله تعالى لا تدركه الأبصار، و ذكر لموسى أنّه لن يراه، و علل عدم إمكان رؤيته بعدم احتمال الطبيعة البشرية لذلك الأمر الجلل.
و أمّا تخيل إمكان النظر إلى الله تعالى بالعين فمحال عقلاً و شرعاً.. إلى آخر كلامه الطويل النافع الصادر عن الإنصاف، فلاحظ.
ثم إنّ للمثبتين تلفيقات من العقل و النقل(5). أمّا الوجه العقلي فلا يستحق البحث و العناية؛ إذ هو مبني على تركب الجسم من الجواهر الفردة، و مفاده بعد فرض صحة المبني المذكور أنّ مفهوم الوجود المشترك بين الواجب و الممكن مرئي!! مع أنّه ينتقض بالخلق و لزوم كونه تعالى
ص: 20
مخلوقاً، تعالى الله عمّا يصفه الجاهلون.
و أمّا النقلي فاليك ملخّص بيانه.
1 - قوله تعالى: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نٰاضِرَةٌ إِلىٰ رَبِّهٰا نٰاظِرَةٌ (1) و جوابه: أنّ النظر لا يستلزم الرؤية(2)، بل هو بمعنى مدّ الطرف نحو شيء و تقليب الحدقة، و يدل عليه قوله تعالى: وَ تَرٰاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَ هُمْ لاٰ يُبْصِرُونَ (3). و أيضاً يقال: ما زلت أنظر إليه حتى رأيته، و الشيء لا يجعل غاية لنفسه. و أيضاً نعلم أنّ كل ناظر ناظر بالضرورة و لكن ليس كل ناظر براء بالضرورة. و أيضاً يوصف النظر بما لا توصف به الرؤية، فيقال: نظر إليه نظر غصبان، أو نظر عطوف، كل ذلك ظاهر. و في بعض رواياتنا(4) عن الرضا (ع) قال: «يعني مشرقة تنتظر ثواب ربها»، و به قال جماعة من الصحابة و التابعين وغيرهم، كما قيل. و في مرسلة الاحتجاج عن أمير المؤمنين (ع)... فعند ذلك أثيبوا بدخول الجنة و النظر إلى ما وعدهم الله عزّ و جلّ، فذلك قوله: إِلىٰ رَبِّهٰا نٰاظِرَةٌ (5). في بعض اللغة: هي المنتظرة، ألم تسمع إلى قوله تعالى: فَنٰاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ اَلْمُرْسَلُونَ (6)، أي منتظرة، و نقل ذلك عن مجاهد و الحسن و سعيد بن جبير و الضحاك.
2 - قوله تعالى: كَلاّٰ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (7) قالوا: لو لم ير المؤمنين الله لم يكن لتخصيص الحجاب بالكفار فائدة. و أيضاً أنّ الله ذكر هذا الحجاب في معرض الوعيد و التهديد للكفار، و ما يكون وعيداً و تهديداً للكفار لا يجوز حصوله في حق المؤمن.
أقول: صريح الآية: أن المحجوبون هم الكفار عن ربهم، لا ربهم عنهم، فهذا التوجيه على عكس الآية. و معنى الآية: أنّ الكفار محجوبون عن رحمة الله دون المؤمنين، فإنّهم ليسوا كذلك، فالحجاب بالنسبة إلى المخلوق لا إلى الله. و في توحيد الصدوق عن الرضا (ع):... إنّ الله تبارك و تعالى لا يوصف بمكان يحلّ فيه فيحجب عنه فيه عباده، و لكنه يعنى أنّهم عن ثواب ربهم لمحجوبون(8).
ص: 21
3 - قوله تعالى: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا اَلْحُسْنىٰ وَ زِيٰادَةٌ (1) قالوا: المراد بالحسنى هي الجنة و دار السلام المذكورتين قبل هذا، و حينئذٍ وجب أن يكون المراد من الزيادة أمراً مغايراً لكل ما في الجنة من المنافع و التعظيم، و هوالرؤية.
أقول: التفسير المذكور ممنوع، لم لا يكون المراد بالحسنى هو المثبوبة الحسنى التي يستحق و يستأهل العبد؟ ثم الله يزيد تفضلاً وكرماً(2) كما يدل عليه قوله تعالى: لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ (3)، و القرآن يفسّر بعضه بعضاً. و في تفسير الصافي عن مولانا أمير المؤمنين (ع) «الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب» و يدل عليه ايضاً قوله تعالى: لَهُمْ مٰا يَشٰاؤُنَ فِيهٰا وَ لَدَيْنٰا مَزِيدٌ(4).
4 - قوله تعالى: اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاٰقُوا رَبِّهِمْ (5) فإن الملاقاة تستلزم الرؤية بحكم العقل، لكنّه باطل، و يدلك عليه قوله تعالى: إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاٰقٍ حِسٰابِيَهْ (6)، و قوله تعالى: مَرَجَ اَلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰانِ (7)، و قوله تعالى: فَأَعْقَبَهُمْ نِفٰاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ (8)، إذ لو كانت الملاقاة مستلزمة للرؤية لكان الكفار - بنص هذه الآية - يرون الله، مع أنّهم مصرون على اختصاصها بالمؤمنين.
5 - الإجماع. قال في المواقف بعد نقل الآيتين الاوليين(9) بأنّ هذه الظواهر مفيدة للظن، و العمدة في إثبات المرام هو الإجماع قبل ظهور المخالف(10).
أقول: الإنسان قادر على أن يتكلم بكل شيء، و إن كان بيّن الفساد أليس يشعر هذا المدّعي أنّ الإجماع غير متحقق، و أنّه لا يفيد اليقين، و أنّ هذه الدعوى مختلقة؟ و الذي دعا هؤلاء الناس إلى هذه التعسفات والتكلفات هو وضع الغوغائيين أخباراً مكذوبة على النبي الأكرم (ص) في
ص: 22
رؤية الله تعالى، فاتّبعوهم بغير دليل و التفاف إلى العقل و القرآن.
و لله درّ السيد السند المجاهد العلامة عبد الحسين شرف الدين حيث كشف النقاب عن وجه هذه الروايات المدلّسة، و بيّن ضعف أسنادها و فساد طرقها، و أثبت سقوطها عن الحجية من كتبهم الرجالية. فإن شئت تفصيل الكلام فلا بدّ لك أن تراجع كتابه القيّم الذي وضعه في هذه المسألة و سمّاه «كلمة حول الرؤية».
و نختم المقال بنقل رواية من صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب عندهم، فقد أخرج بسنده عن أبي هريرة(1) قال: قال أناس: يا رسول الله، هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارّون في الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله، قال: «هل تضارّون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟»، قالوا: لا يارسول الله، قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك! يجمع الله الناس... و تبقى هذه الأمّة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم! فيقولون: نعوذ بالله منك! هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا... حتى يضحك «أي الله»، فإذا ضحك منه أذن للعبد في الدخول إليها...» إلى آخره.
أقول: قرّاء هذا الكتاب يستفيدون من هذه الرواية المعتبرة المحكمة أموراً في عقائدهم.
1 - إثبات الجهة لله تعالى كما للشمس و القمر.
2 - إنّ المنافقين أيضاً يرونه و تناقضه مع ما مرّ عنهم غير ضائر فلا تسأل عنه!
3 - إثبات المجيء له تعالى، و أنّ له حضوراً و غيبة و ذهاباً و إياباً كالأجسام المتحركة.
4 - أنّ عباده - مؤمنين كانوا أو منافقين - يعرفون صورته قبل هذا الموقف.
5 - إثبات الصورة المستدعية للمادة أو الجسم.
6 - حلول الحوادث فيه تعالى، بذهاب الصورة الاولى و طريان الصورة الثانية.
7 - إنّه يضحك فله أسنان و فم، و إنّه جسم.
و لعلّ المسلم - بعد اعتقاده بالقرآن العظيم - لا يشك في لا يتردّد في وضع هذه الرواية و أمثالها بعد ما تبين له مدلول الرواية، و مثلها كثير. نعم، البخاري يترك الحديث عن أئمة آل محمد (ص) و يحتاط في إخراجه عن الهاديين الصادقين الذين هم أعدال القرآن، و لكنه يروي عن مثل أبي هريرة و عمران بن حطّان الخارجي و أمثالهما. لعن الله العصبية الحمقاء.
ص: 23
المكان عند العامة هو ما يستقر عليه الجسم. و عند أهل العلم مختلف فيه على أقوال خمسة.
1 - إنّه سطح باطن الجسم الحاوي، كما عن أرسطو و من تبعه من المشّائين.
2 - إنّه البعد الموجود المجرد، كما عن أفلاطون و أتباعه الإشراقيين، و عليه المحقق الطوسي و الحكيم السبزواري و غيرهما.
3 - إنّه البعد الموهوم، كما عن جمهور المتكلمين.
4 - إنّه الهيولي.
5 - إنّه الصورة، و على كلّ من هذين القولين جماعة من الأوائل(1). ثم إنّهم جعلوا للمكان إمارات أربعاً.
الأولي: جواز انتقال الجسم عنه إلى غيره.
الثانية: استحالة حصول جسمين معاً فيما يشغله أحدهما.
الثالثة: أنّه ينسب إليه الجسم بلفظة «في» و ما في معناها.
الرابعة: أنّه يختلف بالجهات مثل فوق و تحت و غيرهما.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأصح كونه بعداً، و تحقيق المقال لا يناسب المقام، ثم الفرق بين المكان و المحلّ، إنّ المكان الواحد لا يجتمع فيه الجسمان، و المحلّ الواحد يجتمع فيه الحالان، كالطعم و اللون في جسم واحد.
و أمّا الفرق بينه و بين الجهة فهو أنّها مقصد المتحرك بالوصول إليه، و هو مقصد المتحرك بالحصول فيه. و عن المحقق الطوسي (قدس سره): أنّ طرف الامتداد بالنسبة إلى الامتداد نهاية و طرف، و بالنسبة إلى الحركة و الإشارة جهة، و أمّا الحيّز و المكان فهما مترادفان على القول المختار،
ص: 24
و لكنّ المشّائين - و هم أصحاب القول الأول - يجعلون الأول أعمّ من الثاني(1). فعن ابن سينا في بعض كلماته: لا جسم إلا و يلحقه أن يكون له حيز إمّا مكان و إمّا وضع وترتيب.
أقول: و مثّلوا للثاني بالجسم المحدد للجهات، إذ لا محيط فوقه على زعمهم، فهو جسم لا مكان له على هذا القول لكن يشار إليه فهو ذو وضع.
إذا تقرر ذلك فنقول: الواجب الوجود لا مكان له و لا جهة له، بل هو خالق الأحياز و الجهات، و الدليل عليه من وجوه:
1 - لو كان متحيزاً لكان حيزه قديماً بالضرورة، فإن كان واجباً يبطله أدلة التوحيد، و إن كان ممكناً يزيّفه دلائل حدوث العالم. نعم، إن فرضنا الحيّز موهوماً كما في القول الثالث فهذا البرهان لا يكفي لنفيه عنه تعالى؛ لعدم الدليل على بطلان أزلية الموهومات.
2 - لو كان متحيزاً لكان محاطاً لحيّزه، ضرورة إحاطة كلّ حيّز بمتحيّزه، وكلّ محاط محدود، و لا ريب عقلاً و نقلاً أنّ الواجب لا حدّ له أصلاً و في رواية ابن أذينة عن الصادق (ع) «... لأنّ الأماكن محدودة تحويها حدود أربعة، فإذا كان - أي حضوره تعالى للأشياء - بالذات لزمه الحواية»(2).
3 - لو كان مكانياً لكان مركباً، و التالي لاستلزامه الإمكان باطل فيبطل المقدم.
بيان الملازمة: أنّ المكان المذكور إمّا أن يقبل الانقسام خارجاً و إمّا أن لا يقبله. و الثاني فاسد لفساد الجزء الذي لا يتجزّأ بالضرورة، و الأول يوجب تركب الواجب. ثم إنّ هذا البرهان يجري في فرض كون المكان مادياً، و أمّا إذا كان مجرداً فلا، كما لا يخفى.
4 - لو كان متحيزاً لكان مفتقراً في تحيّزه إلى حيّزه بالضرورة، لكنّ الافتقار عليه تعالى محال، فلا يكون مكانياً.
أقول: و فيه بحث، إذ الممتنع عليه تعالى هو افتقاره في وجوده إلى غيره، و أمّا في غير الوجود فلا برهان على امتناعه عليه. و سيأتي تفصيله في المطلب الثامن من هذا المقصد إن شاء الله تعالى.
و ربما قرر هذا الدليل بتقرير آخر، و هو: أنّ المتمكن محتاج إلى مكانه بحيث يستحيل وجوده بدونه، و المكان مستغن عن المتمكن لجواز الخلاء فيلزم إمكان الواجب و وجوب المكان، و كلاهما باطل.
ص: 25
أقول: أمّا الشقّ الأول فقد دريت جوابه مما ذكرنا، و أمّا الشق الثاني ففيه: أنّ استغناء المكان عن تمكن المتمكن لا يدل على وجوبه، بل الموجب له هو استغناؤه في وجوه عن غيره، و هذا غير لازم في المقام.
5 - لو كان مكانياً فإمّا أن يكون في بعض الأحياز، أو في جميعها، و كلاهما باطل. أمّا الأول فلتساوي الأحياز في أنفسها؛ لأنّ المكان عند المتكلمين هو الخلاء المتشابه، و تساوي نسبة ذاته القديمة إلى الأحياز المذكورة، و حينئذٍ فيكون اختصاصه ببعضها دون بعض آخر منها ترجيحاً بلا مرجّح إن لم يكن هناك مرجح من خارج، أو يلزم احتياجه في تحيزه الذي لا تنفكّ ذاته عنه الى الغير، إن كان هناك مرجح خارجي، و أمّا الثاني فيلزم منه تداخل المتحيّزين؛ لأنّ بعض الأحياز مشغول بالأجسام. و التداخل المذكور محال و يلزم منه أيضاً مخالطته لقاذورات العالم، تعالى الله عنه.
أقول: دعوي تساوي نسبة الواجب إلى الأحياز دعوى بلا دليل، و مجرد تشابه الخلاء المذكور لا يكفي له قطعاً، و إنّما نقول به جهة أنّه غير متحيز، فيكون الاستدلال دورياً، هذا، مع أنّ الافتقار إلى المخصص المذكور غير بيّن البطلان كما أشرنا إليه، فلاحظ.
و خالف في المقام المشبّهة من أهل السنّة(1)! فقالوا: إنّه تعالى في جهة
ص: 26
الفوق(1)، و لهم في ذلك مقالات زائفة خرافية أعرضنا عن التحدث عنها. و الذي يمكن أن يستدل به لقولهم وجوه:
1 - إنّ كل موجود فهو متحيز، أو حالّ فيه بالضرورة العقلية.
2 - كل موجودين فإمّا أن يتصلا، أو ينفصلا، فالواجب إن كان متصلاً بالعالم أو منفصلاً عنه يكون متحيزاً؛ لأنّ الاتصال و الانفصال إنّما هما بالمكان.
3 - إنّه إمّا داخل العالم، أو خارجه، أو لا داخله و لا خارجه، و الثالث غير معقول، و الأوّلان فيهما المطلوب.
4 - الظواهر النقلية كقوله تعالى: اَلرَّحْمٰنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اِسْتَوىٰ (2)، و قوله: وَ جٰاءَ رَبُّكَ (3)، و نحوهما، و هو كثير في القرآن.
أقول: قد عرفت في أول هذا الكتاب أنّ الظواهر الشرعية متى تصادمت مع الأحكام العقلية القطعية لا بد من طرحها إن لا يثبت سندها، أو تأويلها إن صح سندها، و لذا قد ذكر العلماء لكلّ من هذه الآيات تأويلاً، و في المراجعة إلى أخبار أئمة أهل البيت - سلام الله عليهم - غنّى و كفاية.
و أمّا بقيّة الوجوه فهي من أحكام الوهم المجرّد، و لا يصدّقها العقل أبداً. بل العقل قد استقلّ بنفي المكان و الجهة عنه تعالى كما دريت. و السائر في المسائل العقلية لا بدّ من تخليص نفسه من حضيض الوهم إلى صقع العقل لينان الحقائق و المعارف. و إذن يمكن لنا أن نختار الشقّ الثالث، و أنّه تعالى ليس بداخل و لا خارج، و ليس بمتصل و لا بمنفصل. و لنا أن نختار الشقّ الأول، و أنّه داخل و متصل بالأشياء، لكن لا كدخول شيء في شيء و اتصال شيء بشيء كما يتوهّمه الوهم. و لنا أن نختار الشقّ الثاني، و أنّه تعالى خارج و منفصل عن الأشياء، لكن لا كخروج شيءٍ عن شيء و انفصال شيء عن شيء، كما لا يخفى على العقول الصافية. فهو في الأشياء كلّها غير متمازج بها و لا بائن عنها، و لم يقرب من الأشياء بالتصاق، و لم يبعد عنها بافتراق، كما روي عن الوصي (ع).
ص: 27
تأييد روحاني:
قال الرضا (ع) كما في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر: «إنّ الله تبارك و تعالى أيّن الأين بلا أين، و كيّف الكيف بلا كيف»(1). و قال الباقر (ع) على ما في رواية أبي بصير: «إنّ ربّي تبارك و تعالى كان و لم يزل حيّاً بلا كيف، ولم يكن له كان، و لا كان لكونه كون كيف و لا كان له أين، و لا كان في شيء، و لا كان على شيء، و لا ابتدع لمكانه مكاناً...»(2) إلى أن قال (ع): «و لا أين موقوف عليه، و لا مكان جاور شيئاً»(3).
سئل علي (ع)(4): أين كان ربنا قبل أن يخلق سماءً و أرضا؟ فقال (ع): اين سؤال عن مكان؛ و كان الله و لا مكان.
قال الصادق (ع) كما في رواية أبي بصير(5): «إنّ الله تبارك و تعالى لا يوصف بزمان و لا مكان، و لا حركة و لا انتقال و لا سكون، بل هو خالق الزمان و المكان و الحركة و السكون و الانتقال...» إلى آخره.
و قال (ع) أيضاً في رواية رواية حماد بن عمرو: «كذب من زعم أنّ الله عز و جل في شيء أو من شيء أو على شيء».(6)
و قال الكاظم (ع) كما في رواية يعقوب: «إنّ الله تبارك و تعالى كان لم يزل بلا زمان و لا مكان، و هو الآن كما كان، لا يخلو منه مكان، و لا يشتغل به مكان، و لا يحلّ في مكان...» إلى آخره(7).
و قال رسول الله (ع) كما في رواية عبد الأعلى عن الصادق (ع) في جواب يهودي: «هو في كل مكان، و ليس هو في شيء من المكان بمحدود...» إلى آخره(8).
و قال الصادق (ع) في رواية ابي بصير: «من زعم أنّ الله عز و جل من شيء، أو في شيء، أو على شيء، فقد كفر»، قلت: فسّر لي، قال: «أعني بالحواية: من الشيء له، أو بإمساك له، أو من
ص: 28
شيء سبقه»(1).
أقول: و الروايات كثيرة، و جملة منها تدل على أنّ المكان موجود، فتكون دليلاً على القول الثاني من الأقوال المتقدمة. لكن يحتمل أن يكون المراد بالأين و المكان هو ما يفهمه عامة الناس دون البعد.
ص: 29
اختلفت الأقوال حول الزمان و بيان حقيقة:
فمن قائل: إنّه جوهر مجرد عن المادة، لا يقبل العدم لذاته، فيكون واجباً بالذات. إذ لو عدم لكان عدمه بعد وجوده بعدية لا يجامع فيها البعد و القبل. و تلك هي البعدية بالزمان؛ لأنّ البعدية لا بالزمان يجامع فيها البعد و القبل. فمع عدم الزمان زمان، و هذ خلف، فحيث بطل عدمه فقد وجب وجوده. فتحصل: أنّه جوهر مجرد عن المادة و لواحقها قائم بذاته.
و من قائل: إنّه الفلك الأعظم؛ لأنّه محيط بكلّ الأجسام. كما أنّ الزمان محيط بها.
و من قائل: إنّه حركة الفلك الأعظم؛ لأنّها غير قارة. كما أنّ الزمان غير قارّ.
و من قائل - و هو أرسطو و قيل: و معه المشهور -: إنّه مقدار حركة الفلك الأعظم.
و من قائل - و هم الأشاعرة(1) -: إنّه ما يقدر به متجدد مبهم لإزالة إبهامه، و قد يتعاكس التقدير بحسب ما هو معلوم للمخاطب. فإذا قيل: متى جاء زيد؟ يقال: عند طلوع الشمس، إن كان السائل عالماً بطلوع الشمس. و إذا قيل: متى طلع الشمس؟ يقال له: عند مجيء زيد، إذا كان بعكس الأول.
و من قائل: إنّه مقدار حركة الطبيعة الفلكية، بناءً على الحركة الجوهرية، لكنّ شيئاً منها لا يصلح للتعويل عليه، فإنّ ما تفوّه به للوجه الأول - إن تمّ - يدل على نفي العدم اللاحق بعد وجود الزمان دون العدم السابق عليه، فلا يثبت وجوبه. و ما استدل للثاني و الثالث فهو استدلال بموجبتين من الشكل الثاني و لا نتيجة له، على أنّ الوسط في الثاني غير مكرر؛ إذ الإحاطة في الصغرى بمعنى و في الكبرى بمعنى. و يزيف الثالث أيضاً بأنّ الحركة توصف بالسرعة و البطء و لا يوصف بهما الزمان، و الأخير بما ذكره الجرجاني في شرح المواقف. و لعلّه لأجل ذلك ذهب بعضهم الى أنّه أمر متوهم لا وجود له أصلاً. لكن المستفاد من الروايات الكثيرة
ص: 30
أنّه أمر موجود خارجي.
و على الجملة: نحن نعلم أنّ حركة الأرض و بقية الكرات السامية لو بطلت و تعطلت كان هذا الامتداد و الاستمرار متحققاً، فالزمان في قوامه غير متصل بالحركة، فتفسير حقيقة الزمان محتاج إلى بيان آخر و لا يخلو تعقّله عن صعوبة.
إذا عرفت هذا فنرجع إلى المطلوب، قال بعض المتكلمين(1): و هذا - أي كونه ليس في زمان - مما اتفق عليه أرباب الملل، و لا نعرف فيه للعقلاء خلافاً، و إن كان مذهب المجسمة يجرّ إليه كما يجرّ إلى المكان.
و قال العلامة المجلسي (قدس سره) في بحاره: و اعلم أنّ عقل العقلاء في هذه المسألة متحير، فكثير من المحققين أثبتوا له سبحانه زماناً و قالوا: إنّه موهوم انتزاعي نفس أمري، ينتزع من بقائه سبحانه كما عرفت. و أكثر الحكماء والمحققين ذهبوا إلى استحالة عروض الزمان و متى للواجب تعالى و للعقول المجردة في الذات و الفعل التي كمالاتها بالفعل على زعم الحكماء(2). انتهى كلامه.
أقول: إضافته تعالى إلى الزمان و كونه زمانياً على أنحاء ثلاثة:
1 - أن يحيط به الزمان بحيث يتقدم جزء منه عليه تعالى و يتأخر جزء آخر منه عنه تعالى، و هو مقارن لجزء خاص منه، فيكون الجزء الأول ماضياً، و الجزء الثاني مستقبلاً بالنسبة إليه تعالى، مثل بقية الزمانيات، و هذا مما لا شك في امتناعه عليه تعالى؛ لأنّ الواجب لا يتقدم عليه شيء، و لا يحيط به ممكن، و لا سيما أنّ كل ممكن حادث كما سلف.
2 - أن يكون له تعالى مع الزمان معية قيومية نحو قيوميته مع الزمانيات، بل مع جميع ما سواه من الموجودات، كما قال: وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مٰا كُنْتُمْ (3)وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ اَلْوَرِيدِ(4)، و هذا مما لا شبهة في لزومه و تحتّمه بناءً على كون الزمان موجوداً خارجياً لا موهوماً اعتبارياً، ضرورة احتياج الممكن إليه حدوثاً و بقاءً كما تقدم.
و لكن صحة هذا القسم لا تصحح إطلاق الزماني عليه تعالى، كما لا يجوز إطلاق المكاني و الجمادي و النباتي و غيرها عليه تعالى، مع أنّ له معية قيومية مع الكل.
3 - مقارنته تعالى مع الزمان و تحققه معه في نفس الأمر من الأزل إلى الأبد، من دون إحاطة
ص: 31
الزمان به كما في الوجه الأول، و لا فيما يزال فقط كما في الوجه الثاني، بل من الأزل. فإن قلنا بأنّ الزمان موجود خارجي فيمتنع هذا القسم أيضاً، كالقسم الأول للبرهان القائم على حدوث كل ممكن موجود. و إن قلنا بأنّه أمر متوهم فلا دليل على بطلانه عقلاً، بل ما ورد في الشرع من اتصافه بالأزلي و الأبدي و الباقي و نحوها مما يتوقف مفهومه على الامتداد يؤيده. و أمّا الأخبار الكثيرة الدالة على نفي الزمان عنه تعالى فلا تنفي هذا القسم، فإنّها ناظرة إلى نفي الزمان الموجود عنه تعالى، فتأمّل.
و أمّا ما أفاده المحقق الطوسي في محكيّ شرح رسالة العلم: «أزليته تعالى إثبات سابقيته له على غيره و نفي المسبوقيه عنه، و من تعرض للزمان أو الدهر أو السرمد في بيان الأزلية فقد ساوق معه غيره في الوجود»، فهو قابل للمناقشة، إذ السابقية المذكورة لا تناسب إلا السبق الزماني، و غيره من أقسام السبق لا يرتبط بمحل الكلام و لو السبق بالعلية، فإنّه (قدس سره) قائل بحدوث العالم.
و على فرض المناسبة فحمل المنقول الظاهر في السبق الزماني على غيره محتاج إلى دليل مفقود، فإنّ فرض كونه تعالى زمانياً - بالمعنى المفروض - لا يوجب مساوقة غيره معه.
إلا أن يقال: إنّ هذا المعنى - و هو كونه تعالى مقارناً للامتداد المتوهم المسمّى بالزمان - إنّما هو من الوهم المتأنّس بالماديات الزمانية، و لا مجال له فيما هو أعلى منها، و الله العالم.
ص: 32
الذي يدلنا على امتناع جريان الحركة و السكون عليه تعالى أمور:
الأول: الحركة و السكون يستدعيان الحيّز بالضرورة، و حيث إنّ تحيّزه ممتنع، كما سبق فلا يجوز طريان الحركة و السكون عليه تعالى.
الثاني: الحركة و السكون حادثان، و سيأتي أنّ الواجب لا تحلّ به الحوادث، فلا يمكن أن يتصف بهما، إلا أن يدّعى عدمية السكون - كما عن الفلاسفة - فحينئذٍ لا مانع من أزليته، و يختص البرهان بنفي الحركة وحدها عنه تعالى. و لكن يمكن أن يقال حينئذٍ: إنّ السكون عدم الحركة عما من شأنه أن يكون متحركاً، فإذا استحال الحركة عليه تعالى بهذا البرهان يستحيل السكون عليه أيضاً، كما هو الحال في جميع أعدام الملكات، فافهم.
الثالث: لو فرض إنصافه تعالى بهما للزم كونه فاعلاً و قابلاً، و التالي محال - كما قالوا - فكذا المقدم.
الرابع: المتحرك لا بد له من محرك - كما قالوا - و الواجب لا محرك له، فلا حركة له.
الخامس: لو حلّت به الحركة أو السكون للزم كونه محلّاً للحوادث، و ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث بالضرورة، فتأمل.
السادس: ما ذكره بعضهم من أنّ المؤثر واجب التقدم بالوجود على الأثر، فذلك الأثر: إمّا أن يكون معتبراً في صفات الكمال فيلزم أن يكون تعالى ناقصاً بذاته مستكملاً بذلك الأثر، و النقص عليه محال. و إن لم يكن معتبراً في صفات كماله فله الكمال المطلق بدون ذلك الأثر، فكان إثباته له نقصاً في حقه؛ لأنّ الزيادة على الكمال المطلق نقصان، و هو عليه تعالى محال.
أقول: و ليتأمّل فيه.
السابع: لو كان متحركاً للزم أن يكون فيه تعالى ما بالقوة و ما بالفعل، و هذا هو التركّب المحال عليه تعالى كما قيل. و الواجب كما له غير الممتنع، واجب و محقّق بالفعل، و لا قوّة له و الاستعداد و الانتظار.
ص: 33
و عن الرضا (ع) في خطبته المشهورة(1): «لا تجري عليه الحركة و السكون، و كيف يجري عليه ما هو أجراه، أو يعود فيه ما هو ابتدأه؟! إذا لتفاوتت ذاته، و لتجزأ كنهه، و لا متنع من الأزل معناه...» إلى آخره.
أقول: لعل قوله (ع): «و كيف يجري عليه...؟!» ناظر إلى الدليل الثالث. و قوله (ع): «أو يعود فيه...» إلى آخره إلى الثاني و الخامس و السادس و السابع، و قوله (ع): «إذاً لتفاوتت ذاته» إلى الدليل السابع و الثالث و إلى الأول أيضاً، فإنّ المتحيّز مركب لا محالة كما مر. و كذا قوله (ع): «و لتجزّأ كهنه» فإنّه الانطباق على الدليل الأول و الذي هو أقوى الوجوه. كما أنّ قوله (ع): «و لا متنع من الأزل» يلائم الوجه الخامس جداً، و الله العالم.
الحركة هي الخروج تدريجاً من القوة إلى الفعل، كما عن القدماء. أو كمال أول لما بالقوة من حيث هو بالقوة، كما عن المعلم الأول و غيره. أو حصول الجسم في مكان بعد مكان آخر، كما عن المتكلمين. و هي على قسمين: توسّطية، و قطعية، و الأولى موجودة، و الثانية اعتبارية. ثم إنّها تقع في أربع مقولات: الكمّ، و الكيف، و الوضع، و الأين على المشهور. و قال صاحب الأسفار: إنّها تقع في الجواهر الطبيعية أيضاً، و سمّاها بالحركة الجوهرية، و صحح بها جملة من الأصول الفلسفية.
و أمّا السكون فهو عدم الحركة عما من شأنه الحركة، كما عن الفلاسفة. أو حصول الجسم في المكان الأول في الآن الثاني. أو حفظ نسبه مع الأجسام الثابتة على حالها، كما عن المتكلمين. فهو على الأول عدم ملكة، و على الثاني و الثالث أمر وجودي يضاد الحركة.
ثم إنّه وقع الخلاف في أنّ الحركة من أية مقولة؟ فذهب صاحب الأسفار و من تبعه في الحركة الجوهرية إلى أنّها خارجة عن المقولات كلها، بل هي نحو وجود السيالات، أي العالم الطبيعي.
و ذهب بعضهم إلى أنّها مقولة مستقلة في قبال سائر المقولات.
و قيل: إنّها اعتبارية فلا تدخل في مقولة.
و قيل: إنّها من حيث التحريك من مقولة الفعل، و من حيث التحرك من مقولة الانفعال.
و قيل: إنّه عرض غير داخل في إحدى المقولات، إذ لا دليل علِ حصر الموجودات الممكنة بها.
ص: 34
بعد ما تقرر من امتناع التحيز و الحركة و السكون فقد أصبح نفي الجسمية عنه تعالى أمراً واضحاً لا يمسه شك و لا ريب، فإنّ الجسم متحيز بالضرورة، و لا يخلو عن الحركة و السكون بالبداهة.
و أيضاً الجسم مركب بلا شك، و قد مرّ أنّه غير مركب، فإنّ التركب يستلزم الإمكان.
و أيضاً التجربة دلّت على أنّ الجسم لا يصح منه فعل الأجسام و إيجادها، فخالق الأجسام لا يكون بجسم. و أيضاً الجسم محدود، كما سيأتي برهانه عن قريب، و الواجب غير محدود.
قال الصادق (ع) على ما في رواية يونس بن ظبيان: «إنّ الجسم محدود متناه، و الصورة محدودة متناهية، فإذا احتمل الحد احتمل الزيادة و النقصان، و إذا احتمل الزيادة و النقصان كان مخلوقاً»(1).
أقول: سلب الجسمية عنه من المسلّمات القطعية بين الإمامية، و الروايات الواردة من أصحاب العصمة و أئمة الشريعة في ذلك كثيرة جداً، و وافقهم أكثر المسلمين. و ذهب جماعة من العامة - و هم المجسمة - إلى جسميته تعالى، و لهم عقائد خرافية زائفة لا ينبغي صرف الوقت في نقلها و إيرادها.
نعم، جملة من الآيات الكريمة القرآنية ظاهرة في ثبوت الجوارح له تعالى، كقوله تعالى:
وَ جٰاءَ رَبُّكَ (2)، و قوله: اَلرَّحْمٰنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اِسْتَوىٰ (3)، و قوله: كُلُّ شَيْ ءٍ هٰالِكٌ إِلاّٰ وَجْهَهُ (4) و قوله: لِمٰا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ (5)، و قوله: يَدُ اَللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، و قوله: تَجْرِي
ص: 35
بِأَعْيُنِنٰا (1) و قوله: عَلىٰ مٰا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اَللّٰهِ (2) و قوله: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سٰاقٍ (3)، و غير ذلك من الآيات الظاهرة في جسميته تعالى. لكن البرهان القطعي العقلي قائم على أنّه تعالى مجرد يمتنع عليه الجسمية. قلا بد من تأويل هذه الظواهر و صرفها إلى معان مناسبة للحكم العقلي، ضرورة عدم مقاومة الظني للقطعي، و لذا حملها جمهور علماء الإسلام على محامل، و أنت إذا راجعت الروايات الواردة من أئمة آل النبي الخاتم (ص) حول تفسير تلك الآيات لسكن قلبك و قنع عقلك، و لا ستغنيت عما تكلفه الباحثون.(4)
إنّ للفيلسوف الشهير مؤسس الفسلفة المتعالية صاحب الأسفار كلاماً في شرحه على أصول الكافي في نفي الجسم و الصورة عنه تعالى، لا بد من نقله.
قال: «إنّه قد يكون لمعنى واحد و ماهية واحدة أنحاء من الوجود بعضها أقوى و أكمل من بعض، كماهية العلم، فإن علم العالم بغيره عرض، و بذاته جوهر، و علم الواجب بنفسه و بغيره واجب.. إلى أن قال: إنّ ماهية الجسم و معناه يعني الجوهر القابل للأبعاد له أنحاء من الوجود، بعضها أخسّ و أدنى، و بعضها أشرف و أعلى، و من الجسم ما هو جسم هو أرض فقط أو ماء فقط... و منه ما هو مع كونه من العناصر... لكنه جماد فقط من غير نموّ و حسّ و لا صورة و لا حياة، و منه ما هو مع كونه جسماً حافظاً للصورة متغذياً نامياً مؤكداً حساساً ذو صورة. و منه ما هو مع كونه حيواناً ناطقاً مدركاً للمعقولات فيه ماهيات الأجسام السابقة موجودة بوجود واحد...».
إلى أن قال: «إنّ المعنى المسمّى بالجسم له أنحاء من الموجود متفاوتة في الشرف و الخسّة و العلوّ و الدنوّ من لدن كونه طبيعياً إلى كونه عقلياً، فليجز أن يكون في الوجود جسم إلهي ليس كمثله شيء و هو السميع البصير، المسمّى بالأسماء الإلهية المنعوت بالنعوت الربانية، على أنّ الواجب تعالى لا يجوز أن يكون له في ذاته فقد شيء من الأشياء الوجودية، و ليس في ذاته الأحدية جهة تنافي جهة وجوب الوجود. و ليس فيه سلب إلا سلب الأعدام و النقايص. و أيضاً وجوده علم بجميع الأشياء، فجميع الاشياء موجودة في هذا الشهود الإلهي بوجود علمه الذي هو وجود ذاته، و وجود أسمائه الحسنى و صفاته العليا بمعانيها الكثيرة الموجودة بوجود واحد
ص: 36
قيومي صمدي». انتهى.
أقول: و هذا منه عجيب، فإنّ الجسم - أي الجوهر القابل الأبعاد الثلاثة كما صرح به - يستلزم التركب لا محالة، ضرورة أنّ طوله غير عرضه، و عرضه غير عمقه، فيصير ممكناً و لا يجديه ما ذكره من كونه إلهياً ليس كمثله شيء... إلى آخره. و أيضاً لا يمكن تعقل الأبعاد الثلاثة إلا متناهية محدودة، و إلا لم تتحقّق الأبعاد المذكورة فيلزم تناهي الواجب، مع أنّه خارج عن الحد و التناهي اتّفاقاً و عقلاً و نقلاً. و أمّا ما ذكره من عدم جواز فقد شيء في ذاته فالظاهر أنّه أراد به قاعدة أنّ «بسيط الحقيقة كل الأشياء»، و سيأتي توضيحها و تزييفها إن شاء الله.
و منه بان بطلان ما ذكره ثانياً من كون وجوده علماً بجميع الأشياء، فإنّ دليل عموم علمه عنده هو هذه القاعدة كما مضى.
و بالجملة: علمه تعالى بالشيء لا يوجب تحققه في ذاته كما أشرنا إليه في جواب أدلة الإحسائي المتقدمة في الجزء الأول، فلاحظ.
و إنّي يعز عليَّ أن يسجّل اسم هذا الرجل في مثل هذا المقام، لكن الأمر واقع و لا مناص عنه.
و الإنصاف أنّ أكثر أصول الفلسفة الموروثة من اليونان لم تعن بحل المشاكل الاعتقادية، و لم تفد لتقرير الأصول المهمة الدينية، بل أحدثت مشاكل فيها كما يعلم ذلك من ملاحظة علم الكلام و الكتب الأصولية. و لو أنّ أربابها عنوا بطبعيات لعسى أن يفتحوا على المجتمع الإسلامي أبواب الرقي و التكامل الدنيوي كما فعل فلاسفة الغرب و غيره.
قال عبد الرحيم الخياط المعتزلي في كتابه الانتصار(1): «الرافضة تعتقد أنّ ربها ذو هيئة و صورة، يتحرك و يسكن و يزول و ينتقل، و أنّه كان غير عالم فعلم»(2).
قال الشهرستاني في ملله و نحله: «و من خصايص الشيعة: القول بالتناسخ و الحلول و التشبيه. انتهى.
أقول: إنّ هذه الافتراءات لا يحتاج بطلانها إلى دليل، حيث يعلم كل أحد بأنّ الشيعة من أبعد الناس عن مثل هذه المعتقدات، و أنّ المجسّمة من أهل السنّة لا سيّما الوهابيّة الدخيلة، أولى بها، و قد مرّ الحديث عن شيء من ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب.
ص: 37
أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اِتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰاهُ وَ أَضَلَّهُ اَللّٰهُ عَلىٰ عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلىٰ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلىٰ بَصَرِهِ غِشٰاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اَللّٰهِ أَ فَلاٰ تَذَكَّرُونَ (1) .
ص: 38
و الأول عبارة عن قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية بشرط امتناع قيامه بذاته. و حيث إنّ الواجب قائم بذاته فلا يعقل حلوله بغيره.
و الثاني عبارة عن صيرورة الشيئين شيئاً واحداً، و بما أنّ التغيّر و الانقلاب على الواجب ممتنع فلا معنى لاتحاده بغيره.
و استدل أيضاً على نفي الأول باحتياج الحالّ إلى المحلّ، و هو يستلزم الإمكان.
أقول: و فيه نظر مرّ في مبحث نفي المكان عنه تعالى، و بأنّ المحلّ إن قبل الانقسام لزم تركبه تعالى، و إن لم ينقسم كان الواجب أحقر الأشياء.
أقول: إذا فرضنا المحلّ مجرداً فلا يجري فيه هذا الترديد، كما لا يخفى.
إلا أن يقال في تتميمه: إنّ المجرد إن كان واجباً فتدفعه أدلة التوحيد، أو ننقل الكلام إليه حتى يتسلسل، فتدبر. و إن كان ممكناً فهو محدود لا محالة، و حلول الغير متناهي بالمحدود ممتنع، فافهم. و بأنّ المحلّ إن كان قديماً لزم تعدد القدماء، و إن كان حادثاً لزم حدوثاً لزم حدوث الواجب. لكن يمكن أن يورد عليه: بأنّ حدوث المحلّ يستلزم حدوث الحلول دون الحالّ. إلا أن يقال: إنّ ذلك يدل على استغناء الواجب عن المحلّ قبل حدوثه، فلا معنى لحلوله فيه بعده.
و استدلّ أيضاً على نفي الثاني: بأنّ الواجب لو اتحد بغيره لكان هذا الغير - لمكان أدلة التوحيد - ممكناً، فيكون الحكم الصادق على الممكن صادقاً على المتحد به، فيصير الواجب ممكناً.
بل الاتحاد في نفسه محال، فإنّ المتحدين المفروضين: إمّا أن يكونا بعد الاتحاد كما كانا قبله فلا اتحاد، أو يصيران معدومين معاً، أو يعدم أحدهما فلا اتحاد أيضاً، كما قالوا.
فالمتحصل: أنّ الاتحاد و الحلول مسلوبان عن الواجب القديم سلباً ضرورياً، ثم إنّ المخالف في المقامم هم النصارى و الصوفية، حيث نسبوا إلى الأول حلول الواجب أو اتحاده بعيسى، و إلى الثاني حلوله في قلوب العارفين و اتحاده بأبدانهم أو بنفوسهم. و ربّما ينسب إلى الغلاة اتحادة تعالى أو حلوله بالعترة الطاهرة، كل ذلك باطل عقلاً و شرعاً، و لا إيمان لقائله واقعاً، تعالى الله عمّا يقول الملحدون علوّاً كبيراً.
ص: 39
قال السبزواري - في حاشيته على الأسفار(1): القائل بالتوحيد إمّا أن يقول بكثرة الوجود و الموجود جميعاً، مع التكلم بكلمة التوحيد لساناً و اعتقاداً بها إجمالاً، و أكثر الناس في هذا المقام.
و إمّا أن يقول بوحدة الوجود و الموجود جميعاً, و هو مذهب بعض الصوفية.
و إمّا أن يقول بوحدة الوجود و كثرة الموجود, و هو المنسوب إلى أذواق المتألهين. و عكسه باطل.
و إمّا أن يقول بوحدة الوجود و الموجود جميعاً في عين كثرتهما, و هو مذهب المصنف (قدس سره) و العرفاء الشامخين.
و الأول توحيد عامّي, و الثالث توحيد خاصّي, و الثاني توحيد خاصّ الخاص, و الرابع توحيد أخص الخواص, فللتوحيد أربع مراتب على وفق مراتبه الأربع في تقسيم آخر, التي هي: توحيد الآثار, و توحيد الأفعال, و توحيد الصفات, و توحيد الذات.
ثم قال لتوضيح القول الأخير: كما إذا كان إنسان مقابلاً لمرايا متعددة, فالإنسان متعدد و كذا الإنسانية, لكنّهما في عين الكثرة واحد بملاحظة العكسية و عدم الأصيلية, إذ عكس الشيء ليس شيئاً على حياله, إلى آخر ما ذكر في بيان هذا المثال ممّا هو يناسب مقام الشعر و الشعراء.
أقول: و يدخل في القسم الأول مذهب جماعة ممن الفلاسفة المشّائية القاوئلة بتباين الوجودات, و مذهب المتكلمين الذين نفوا الوجود سوى مفهومه و حصصه, كما حكاهما في شرح منظومته, بل يمكن دخول مذهب الفهلوييّن أيضاً في هذا القسم بناءً على منافاة مراتب الوجود لوحدته, كما هو الصحيح. قال في منظومته:
الفهلويون الوجود عندهم *** حقيقة ذات تشكّك تعم
ص: 40
مراتباً غنىً و فقراً تختلف *** كالنور حيثما تقوّى و ضعف
و أمّا بناءً على عدم منافاتها لها كما ادعاه صاحب الأسفار و غيره فالقون المذكور هو عين القول الرابع.
ثم إنّ الذي يهمّنا بيانه هو القول الثاني و الرابع.
فنقول: أمّا بيان القول الثاني المنسوب إلى جهلة الصوفية, فهو أنّه يتوهمون أن لا بحقق بالفعل للذات الأحدية - المنعوتة بألسنة العرفاء بمقام الأحدية و غيب الهوية و غيب الغيوب - مجردة عن المظاهر و امجالي, بل امتحقق هو عالم الصورة و قواها الروحانية و الحسّية. و الله هو الظاهر المجموع لا بدونه.
قال في الأسفار ردّاً عليه: و ذلك القول كفر فضيح و زندقة صرفة, لا يتفوه به من له ادنى مرتبه من العلم... إلى آخر(1).
و علّق عليه السبزواري بقوله: بالحقيقة هذا الذي اعترفوا به مقام الوحدة في الكثرة. و قد أنكروا مقام الكثرة في الوحدة، و هو المراد بالوجود المجرد عن المجالي و المظاهر. و هو المراد بقول الفحول و منهم المصنف (قدس سره): بسيط الحقيقة كل الأشياء، لا مقام الوحدة في الكثرة... إلى آخره. فمحصّل هذا المذهب: أنّ للموجود مصداقاً واقعياً شخصياً يتطور بأطوار مختلفة و بشؤون متكثرة، فهو أرض و سماء و ملك و إنسان، و هكذا، و حيث إنّ هذه التكثرات أمور اعتبارية محضة فلا تضرّ بوحدة هذا الموجود الشخصي، و هو الواجب، و ليس له مجلى و مجال مجرد عن هذه المجالي الموجودة الممكنة.
أقول: و حيث إنّ هذه الموجودات ممكنة، بل حدوث كثير منها محسوس و مشهود فينجرّ مآل كلامهم إلى إنكار الواجب الوجود، فجوابهم ما ذكرناه - في المقصد الأول - في ردّ إخوانهم المادّيّين، بل هؤلاء أرذل شعوراً و أفسد رأياً منهم، حيث جعلوا الكثرة الحسّية اعتبارية فجمعوا بين المادية و السفسطة، كَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً(2).
و أمّا بيان القول الرابع فقد ظهر إجمالاً من كلام السبزواري، و أنه مقام الكثرة في الوحدة، فالوجود على هذا القول ذو حقيقة مجردة عن المجالي.
و قيل: إنّه - أي الوجود - بجميعه من المجرد عن المجالي و غيره واجب، و ليست مرتبة الواجبية عندهم مختصة بالمرتبة المجردة عنها المعبّر عنها بمرتبة بشرط لا، بل الكل من الدرّة الى الذرّة و القرآن الى القدم وجود الواجب، مع كون ما عدا تلك المرتبة بشرط اللائية مفتقرة الى
ص: 41
تلك المرتبة، بل عين الفقر إليها، و اذا سئلوا بأن الفقر ينافي الوجوب، يجيبون بعدم المنافاة؛ لأنّ هذا الفقر فقر إلى نفس الحقيقة، و الافتقار المنافي للوجوب هو الفقر إلى الغير، لا فقر الشيء إلى نفسه.
أقول: و هو كما ترى. و قال صاحب الأسفار(1): فكذلك هداني ربّي بالبرهان النيّر العرشي إلى صراط مستقيم، من كون الموجود و الوجود منحصراً في حقيقة واحدة شخصية، لا شريك له في الموجودية الحقيقة، و لا ثاني له في العين، و ليس في دار الوجود غيره ديّار.
و كلما يتراءى في عالم الوجود أنّه غير الواجب المعبود فإنّما هو من ظهورات ذاته و تجلّيات صفاته التي هي في الحقيقة عين ذاته(2). انتهى.
و قال في مقام آخر: إنّ لجميع الموجودات أصلاً واحداً و سنخاً فارداً هو الحقيقة، و الباقي شؤونه، و هذا الذات و غيره أسماؤه و نعوته، و هو الأصل و ما سواه أطواره و شؤونه، و هو الموجود و ما وراءه جهاته و حيثياته. و لا يتوهّمنّ أحد من هذه العبارات أنّ نسبة الممكنات إلى ذات القيّوم تعالى نسبة الحلول، هيهات، إنّ الحالية و المحلّية ممّا يقتضيان الاثنينية في الوجود بين الحالّ و المحلّ، و ها هنا - أي عند طلوع شمس التحقيق من أفق العقل الإنساني المتنور بنور الهداية و التوفيق - ظهر أن لا ثاني للوجود الواحد الأحد الحق، و اضمحلّت الكثرة الوهمية، و ارتفعت أغاليط الأوهام... إلى أن قال:
فما وضعناه أولاً أن في الوجود علةً و معلولاً بحسب النظر الجليل، قد آل آخر الأمر بحسب السلوك العرفاني إلى كون العلة منهما أمراً حقيقياً و المعلول جهة من جهاته، و رجعت علّية المسمّى بالعلة و تأثيره للمعلول إلى تطوره بطور و تحيّثه بحيثية، لا انفصال شيء مباين عنه(3). انتهى.
و قال في موضع آخر: و أشبه التمثيلات في التقريب، و التمثيل بالواحد و نسبته إلى مراتب الكثرة... فإنّ الواحد أوجد بتكرره العدد، إذ لو لم يتكرر الواحد لم يمكن حصول العدد، و ليس في العدد إلا حقيقة الواحد لا بشرط شىء، لست أقول: بشرط لا شيء و بينهما من الفرق كما بين الوجود المأخوذ لا بشرط، أي طبيعة الوجود الذي عمومه باعتبار شموله و انبساطه، لا باعتبار كليته و وجوده الذهني... و بين الوجود المأخوذ بشرط لا شيء و هو المرتبة الأحدية عند العرفاء و تمام حقيقة الواجب عند الفلاسفة، و الأول هو حقيقة الحق عند العرفاء؛ لإطلاقه
ص: 42
المعرّى عن التقيد، و لو التنزيه عن الماهيات الموجب لنوع من الشرط، فافهم. ثم يفصل العدد مراتب الواحد مثل الاثنين و الثلاثة و الأربعة و غير ذلك إلى ما لا نهاية، و ليست هذه المراتب أوصافاً زائدة على حقيقة العدد... إلى أن قال: فإيجاد الواحد بتكراره العدد مثال لايجاد الحقّ الخلق بظهوره في آيات الكون و مراتب الواحد مثال لمراتب الوجود... إلى آخره(1).
و قال في محلّ رابع(2): إنّ هذا الانقسام - أي قسمة الوجود إلى الممكن و الواجب - إنّما هو من حيث الامتياز بين الوجود و الماهية، و التغاير بين جهة الربوبية و العبودية. و أمّا من حيث سنخ الوجود الصرف و الوحدة الحقيقة فلا وجوب بالغير حتى يتصف الموصوف به بالإمكان بحسب الذات... إلى آخره.
و قال في موضع خامس(3): انظر أيّها السالك طريق الحق ما ذا ترى من الوحدة و الكثرة جمعاً و فرادى؟ فإن كنت ترى جهة الوحدة فقط فأنت مع الحق وحده، لارتفاع الكثرة اللازمة عن الخلق، و إن كنت ترى الكثرة فقط فأنت مع الخلق وحده، و إن كنت ترى الوحدة في الكثرة محتجبة و الكثرة في الوحدة مستهلكة، فقد جمعت بين الكمالين... إلى آخره.
أقول: لعلّك بعد ما عرفت هذه الكلمات علمت أنّ نفس المدّعى لا يخلو من تهافت؛ إذ دعوى الوحدة مع هذه الكثرات الحسّية غير قابلة للتصديق العقلي و الاعتقاد القلبي، و كل ما فيل في دفع هذا التهافت لا يرجع إلى محصل أبداً، و مع الغض عن هذه الجهة و فرض تعقل المدعى و صحته في نفسه فلا بد من لحاظ برهانه و التفتيش عن دليله. و العمدة في إثبات هذا المرام هي قاعدة: أنّ بسيط الحقيقة كل الأشياء، فلا بد من لفت النظر إليها ليعلم
ص: 43
أنّها صحيحة أو لا.
فنقول: إنّ صاحب الأسفار قد حرّرها تفصيلاً في موضعين من كتابه:
الأول: في مباحث العلة و المعلول. الثاني: في فنّ الربوبيات و مسائل الإلهيات بالمعنى الأخصّ، و إليك عبارته الثانية: قال:
فصل: في أنّ واجب الوجود تمام الأشياء و كل الموجودات، و إليه ترجع الأمور كلّها. هذا من الغوا مضى الإلهية التي يستصعب (لا يستصعب ظ) إدراكه على من آتاه الله من لدنه علماً و حكمة، لكنّ البرهان قائم على أنّ كل بسيط الحقيقة كل الأشياء الوجودية، إلا ما يتعلق بالنقائص و الأعدام. و الواجب تعالى بسيط الحقيقة واحد من جميع الوجوه، فهو كل الوجود، كما أنّ كله الوجود. أمّا بيان الكبرى فهو أنّ الهوية البسيطة الإلهية لو لم يكن كل الأشياء لكانت ذاته متحصلة القوام من كون شيء، و لا كون شيء آخر فيتركب ذاته و لو بحسب اعتبار العقل و تحليله من حيثيتين مختلفتين، و قد فرض و ثبت أنّه بسيط الحقيقة، فالمفروض أنّه بسيط إذا كان شيئاً دون شيء آخر، كأن يكون «ألفاً» دون «ب»، فحيثية كونه «ألفاً» ليست بعينها حيثية كونه ليس «ب»، و إلا لكان مفهوم «أ» و مفهوم ليس «ب» شيئاً واحداً، و اللازم باطل؛ لاستحالة كون الوجود و العدم أمراً واحداً، فالملزوم مثله، فثبت أنّ البسيط كل الأشياء.
و تفصيله: أنّا إذا قلنا: الإنسان - مثلاً - مسلوب عنه الفرسية أو أنه لا فرس فحيثية أنّه ليس بفرس لا يخلو: إمّا أن يكون عين حيثية كونه إنساناً، أو غيرها، فإن كان الشقّ الأول حتى يكون الإنسان بما هو إنسان لا فرساً، فيلزم من ذلك أنّا متى عقلنا ماهية الإنسان عقلنا معنى اللافرس، و ليس الأمر كذلك.
إذ ليس كل من يعقل بالإنسان يعقل أنه ليس بفرس فضلاً عن أن يكون تعقل الإنسان و تعقله ليس بفرس شيئاً واحداً. كيف و هذا السلب ليس سلباً مطلقاً و لا سلباً بحتاً، بل سلب نحو من الوجود، و الوجود بما هو وجود ليس بعدم و لا قوة و لا إمكان لشيء إلا أن يكون فيه تركيب؟ فكل موضوع هو مصداق لإيجاب سلب محمول مواطاة أو اشتقاقاً و قايست بينهما بأن تسلب أحدهما عن الآخر، أو يوجب سلبه عليه، فتجد أنّ ما به يصدق على الموضوع أنّه كذا غير ما به يصدق عليه أنّه ليس هو كذا، سواء كانت المغايرة بحسب الخارج فيلزم التركيب الخارج من مادة و صورة، أو بحسب العقل فيلزم التركيب العقلي من جنس و فصل أو ماهية و وجود.
فإذا قلت مثلاً: زيد ليس بكاتب و إلا لكان زيد من حيث هو زيد عدماً بحتاً، بل لا بد أن يكون موضوع مثل هذه القضية مركباً من صورة زيد و أمر آخر به يكون مسلوباً عنه الكتابة من قوة أو استعداد، فإنّ الفعل المطلق ليس بعينه عدم شيء آخر إلا أن يكون فيه تركيب من فعل
ص: 44
بجهة و قوة بجهة أخرى، و هذا التركيب بالحقيقة منشؤه نقص الوجود، فإنّ كل ناقص حيثية نقصانه غير حيثية وجوده و فعليته، فكلّ بسيط الحقيقة يجب أن يكون تمام شيء كل شيء.
فواجب الوجود لكونه بسيط الحقيقة تمام كلّ الأشياء على وجه أشرف و ألطف، و لا يسلب عنه شيء إلا النقائص و الإمكانات و الأعدام و الملكات، و إذ هو تمام كل شيء و تمام الشيء أحق من كل حقيقة كل شيء بأن يكون هو هي بعينها من نفس تلك الحقيقة بأن يصدق على نفسها..
فإن قلت: أليس للواجب تعالى سلبية ككونه ليس بجسم و لا بجوهر و لا بعرض و لا بكمّ و لا بكيف؟! قلنا: كل ذلك يرجع إلى سلب الأعدام و النقائص، و سلب السلب وجود، و سلب النقصان كمال وجود. انتهى.
هذا تمام بيانه و برهانه، لكنه منهدم الأساس، باطل الاركان، فاسد البنيان.
أمّا أولاً: فلأنّ الإمكان و الفقر و الحاجة لا ينفكّ عن الممكن أبداً، بل الفقر - على حد تعبير المستدل - عين الوجود الإمكاني، فحذف الفقر عنه بطلان نفسه.
و بالجملة: انقلاب الجهات الثلاث قطعي الفساد عقلاً و اتفاقاً. هذا من ناحية. و من ناحية اخرى أنّ الإمكان و الحاجة نقص يمتنع على الواجب الوجود بلا إشكال و خلاف. فإذاً نقول: لو تمّ بيانه و دليله لما و في بإثباته مرامه؛ إذ الموجودات الممكنة كلها داخلة في ما استثناه بقوله: إلا النقائص و الإمكانات... إلى آخره. و في قوله أخيراً: كل ذلك يرجع إلى سلب الأعدام. فسلب الوجودات الإمكانية على حذو سلب ماهياتها لا يستلزم التركيب.
و أمّا ثانيا: فلما مرّ في الجزء الأول في مبحث وجوب الواجب، من جميع الجهات، من عدم تحقق التركب من الوجود و العدم. و ما ذكره السبزواري في تصحيحه في ذلك المبحث و في هذا المقام (في مباحث العلة و المعلول و مسائل الإلهيات بالمعنى الأخص)(1) لا يرجع إلى معنى معقول كما أشرنا إليه في ذلك المبحث.
و أمّا ثالثا: فلأنّ التركب الذي قام البرهان على استحالته في حق الواجب البسيط هو التركب من الأجزاء المقدارية و المعنوية (المادة و الصورة)، و العقلية (الجنس و الفصل). و أمّا تركبه من مثل تينك الحيثيتين غير الراجعتين الى شيء من الأقسام الثلاثة المذكورة فامتناعه غير بيّن و لا بمبيّن، بل مرّ في الجزء الأول أنّ ما استدلوا به على نفي الماهية عنه تعالى غير سالم عن المناقشة. و ممّا يؤيد ما قلنا: لزوم تركب الإنسان - مثلاً - من أمور غير متناهية أو متناهية
ص: 45
كثيرة جداً، إذ يصدق عليه السلوب الكثيرة، فإنّه ليس بشيء ممّا عداه من الموجودات.
و أمّا رابعاً فلانتقاضه بسلب الأعدام و النقائص عنه تعالى، إذ يلزم تركبه من حيثية إيجابية و حيثية سلبية كما زعمه. و أمّا ما اعتذر به من رجوع هذا السلب إلى سلب السلب و أنّه وجود و كمال وجود، فهو غير مفيد؛ إذ الرجوع المذكور لا ينافي تعددالحيثيتين المزبورتين؛ لجريان جميع ما ذكره في استدلاله فيه بعينه، فتأمّل.
و أمّا: خامساً: فلأنّا دللنا على مسبوقية جميع الممكنات الموجودة بالعدم الفكّي المقابل، و برهنّا حدوث العالم، و ذكرنا: أنّ فاعليته تعالى ليست على نحو الرشح و التنزل كما في العلل الموجبة، بل هي بنحو الإبداع و الإيجاد - و ما شئت فسمها - لا من شيء. و نتيجة ذلك: امتناع كونه تعالى عين غيره من الموجودات، فإنّه كان موجوداً، و كان غيره عدماً صرفاً، و الضرورة قضت بتباين عينية الوجود و العدم.
و أمّا سادساً: فلأنّ القضية السالبة لا تحتاج إلى التحيّث أصلاً، كيف و هي تصدق بلا وجود الموضوع فينهدم أساس كلامه بتاتاً: و أمّا ما ذكره السبزواري في هامش الأسفار(1) من أنّ الكلام في الموضوع الموجود، و السلب البسيط عند وجود الموضوع يساوق الإيجاب العدولي و الموجبة السالبة المحمول و يؤول إليهما، فهو مدفوع بما ذكره نفسه في حاشيته على شرح منظومته (ص 90) من أن الفارق بين العدول و التحصيل هو القصد، بأن يتعلق بربط السلب أو سلب الربط، و عليه فنحن نجعل القضية سالبة محصلة فلا يتمّ شيء ممّا تخيّلة المستدل، فإنّه مبتنٍ على انعقاد القضية معدولة أو محصلة لكن بنحو الموجبة السالبة المحمول(2).
و أمّا سابعاً: فلجواز انتزاع المفاهيم الكثيرة من شيء واحد، و إن لم يجز انتزاع مفهوم واحد من الأمور المختلفة بما هي مختلفات، و لأجل الجواز المذكور تنتزع مفاهيم القدرة و العلم و الحياة و نحوها عن الذات الواجبة مع أنّه بسيطة عند الإمامية و الحكماء، و يرون صفاته عين ذاته تعالى؛ و عليه فلا مانع من انتزاع اللا إنسانية و اللاجمادية و غيرهما من الذات الواجبة أصلاً.
و أمّا ما أتى به السبزواري(3) من تخصيص هذا الجواز بما إذ لم يكن بين المفاهيم تعاند كالوجود و الوحدة و التشخص و العلم و القدرة و نحوها، و عدم جريانه فيما إذا كان بينها تعاند
ص: 46
كالعلية و المعلولية و المحركية و المتحركية و الايجاب و السلب، فهو على تقدير تماميته أجنبي عن المقام، إذ التنافي بين السلب و الإيجاب إنّما يتحقق إذا تواردا على مورد واحد بشروط مقررة، و إلا فلا منافاة بينهما، كوجود الحركة و عدم السكون، أو وجود الاستقبال و عدم الاستدبار، و هكذا، و المقام كذلك، فإنّ عدم الأشياء و سلبها عنه لا ينافي وجوده تعالى فتدبر جيداً.
ثم إنّ لصاحب الأسفار وجهاً آخر على إثبات هذه القاعدة، و هو: أنّ معطي الكمال لا يكون فاقداً له. قال في فنّ ربوبيات أسفاره: و هو كل الأشياء على وجه أبسط؛ و كذلك لأنّه فاعل كل وجود مقيد و كماله، و مبدأ كل فضيلة أولى بتلك الفضيلة من ذي المبدأ، فمبدأ كل الأشياء و فيّاضها يجب أن يكون هو كل الأشياء على وجه أرفع و أعلى... إلى آخره.
أقول: فيه أولاً أنّ الوجود الإمكاني إنّما هو كمال للممكن دون الواجب، كما عرفت وجهه آنفا، و لا شك أنّ الواجب بصفته كامل مطلق، فاقد للنقص و الحاجة.
و ثانياً: أنّ العلل الموجبة هي التي لا تخلو عن معاليلها بنحو مندمج، و أمّا من ليست فاعليته بنحو الشرح، بل الاختيار و الإبداع لا من شيء، فلا يجري فيه هذا الكلام. نعم، لا شك أنّ معطي كل شيء لا يكون عاجزاً عن إعطائه انه ينتقض بنفي التركب، فإن مخلوقاته و معاليله أو معظّمها مركبة، و معطى الشيء لا يكون فاقده. فهو في بساطة حقيقته مركب بوجه أعلى و أرفع!!.
فتحصل: أنّ ما تفوه به من كون بسيط الحقيقة كل الأشياء باطل ضعيف لا أساس له أصلاً، و منه انهدمت الكثرة في الوحدة؛ لأنّها نفس هذه القاعدة الزائفة.
و أمّا الوحدة في الكثرة فملخّصها: أنّ كل موجود ممكن له أمور: 1 - ماهية. 2 - وجود. إضافة وجوده إلى ماهيته. و الأول و الثالث اعتباريان، و الثاني هو الوجود المنبسط.
قال في الأسفار(1): فالحقائق موجودة متعدد في الخارج، لكنّ منشأ وجودها و ملاك تحققها أمر واحد و هو حقيقة الوجود المنبسط بنفس ذاته لا بجعل جاعل، و منشأ تعددها تعينات اعتبارية.
أقول: إن فرض الوجود المنبسط واحداً شخصياً لبطل هذا التكثر المحسوس الواقع في الوجودات، و لا يمكن تستّره بالكلمات الفارغة عن المعنى أبداً. و إن لم يكن بواحد شخصي فقد بطل الوحدة في الكثرة. و على أي تقدير هذا الوجود فعله تعالى، و لا بد من الحكم بإمكانه، بل بحدوثه كما مرّ برهانه، و التفوه بأنّه أثر الواجب و شأنه و أثر لشيء لا نفسه و لا غيره مما يبطله
ص: 47
العقل السليم في أول إدراكه و التفاته؛ لأنّه منزلة بين الإيجاب و السلب، و هذه الدعوى تشبه قول الأشاعرة: إن صفات الله القديمة لا هو و لا غيره، و هذا صادر عن غاية العجز و الفرار من الموازين العقلية. إلا أن يراد به نوع تشبيه و مجاز و مبالغة كما يصنعه الخطباء و الشعراء في مقاصدهم.
فالصحيح أنّ المقامين - الكثرة في الوحدة، و الوحدة في الكثرة - معاً باطلان جداً، فيكون القول الرابع المذكور أيضاً باطلاً فاسداً، و لا مجال للاعتماد على مجرد الدعاوى الخيالية و المتصورات الموهومة التي ربما عبّروا عنها بالكشف و الشهود.
ثم إنّ أقرب الأقوال - بناءٌ على أصالة الماهية - هو القول الثاني المنسوب إلى ذوق التألّه من الاعتراف بأصالة الوجود الواجب و أصالة الماهية في الممكن؛ إذ قد تقدم في مبحث نفي الماهية عنه أنّ حقيقة الواجب وجود صرف و إن قلنا بأصالة الماهية في الممكن. و أمّا بناءً على أصالة الوجود مطلقاً فالمتعين هو قول الفهلويين.
الروايات الواردة عن مجاري العصمة و معادن الحكمة في إبطال الحلول و الاتحاد و الوحدة كثيرة(1)، و نحن لم نكن بحاجة إلى ذكرها، لأنّ المطلوب واضح في الشرع جدّاً. و الحمد لله.
حق، حقست و خلق، خلق اول از ثانى برىء *** ثانى از اول معرّى نزد هر داناستى
ص: 48
مفهوم الواجب: أنّه مستغنٍ في ذاته و وجوده عن غيره، و حيث إنّ صفاته عين ذاته المقدسة فلا يحتاج فيها أيضاً إلى غيره. و أمّا ما سوى الله من بلايين مجرّات فهي من إيجاده وضعه و افتقارها إليه تعالى في حدوثها و بقائها. ثمّ إن ما به الاحتياج إلى غيره إن كان من المستحيلات فلا غير يمكن منه الاستعانة و إ، فرضناه واجباً فإن المحال لا يقبل الوجود، و إن كان ممكناً فوجوده تابع لإرادة الواجب و عدمه مستند إلى عدم إرادته، فلا يعقل الحاجة في حقّه. و أيضاً المحتاج إليه إن كان واجباً ننقل الكلام إليه حتى يتسلسل، أو يلزم الترجيح بلا مرجح، بل الترجّح بلا مرجّح. و إن كان ممكناً فقد جاء الدور، فإنّ الممكن يفتقر إلى الواجب حدوثاً و بقاءً فلا يصح العكس، و هذا الظاهر، إلا أن يقال: إنّ هذا التقريب ينفي المحتاج إليه، لا نفس الحاجة، فتأمّل.
أقول: لازم كلام من قال - كالأشعريين - بزيادة الصفات القديمة على ذاته تعالى، هو احتياج الواجب إليها. و يلحق بهم القائل بالصور المرتسمة في ذاته تعالى، حيث إنّ الواجب محتاج إليها في إيجاد العالم، و كذا لازم قول من قال بحلوله تعالى ببعض الأشياء أيضاً هو احتياجه. لكنّ مثل هذا الاحتياج لا يبطل بالدور المذكور و غيره، فإنّ الصفات و الصور و المحلّ محتاجة إلى ذاته تعالى من حيثية الوجود، و محتاج إليها من حيثية الحلول و الإيجاد و الإحاطة و نحوها، و من الظاهر أنّ تعدّد الحيثية التقييدية يبطل الدور من أساسه.
ثم إنّ هذا الافتقار لا يرجع إلى وجود الواجب فلا ينافي وجوبه، كما أنّ عدم الحلول و الصور و عدم زيادة الصفات ليس من الممكنات عند القائلين بها حتى ينافي الافتقار إليها عموم قدرته، فإنّها - أي حلوله و زيادة صفاته و ارتسام الصور فيه - ضرورية الثبوت له تعالى على زعمهم المزيف، كما لا يخفى، فلا بد لنفي هذا النحو نم الحاجة من التماس دليل آخر.
و أمّا ما عوّل عليه ابن سينا(1) من أنّ افتقاره في صفاته يستلزم إمكانه - لأن ذاته موقوفة
ص: 49
على وجود تلك الصفة أو عدمها المتوقفين على الغير - فلو تمّ لبطل مذهبه المتقدم في علمه التفصيلي بالأشياء، فتأمّل.
و حلّه: أنّ توقف الذات على الصفة ممنوع عند الخصم.
و أيضاً أنّه تعالى يحتاج إلى خلقه في صفاته الإضافية كالرازقية و الخالقية و الإحياء و الإماتة و التكلم و نحوها، و إلى وجود المحلّ في إيجاد الأعراض، فإنّ وجود العرض لا يعقل بلا وجود الموضوع، كما أشار إليه القاضي الشهيد (رحمه الله) أيضاً(1)، و قال أيضاً: لا يجوز أن يكون الواجب تعالى علة تامة لوجود الحادث، و إلا يلزم قدمه، فاحتاج إيجاده إلى حادث آخر، و هكذا... إلى آخره.
هذا، و قد دللنا على إبطال حلوله و تحيّزه و الصور المرتسمة الموهومة، و سيأتي البرهان على عينية صفاته لذاته، فلا معنى لاحتياجه إلى شيء، و أمّا توقف صفاته الإضافية على فعله و توقف بعض أفعاله على بعض آخر منها فهو ليس من الحاجة بشيء، فإنّه قادر على إيجاد الشرط و المشروط، فلا يصدق مفهوم الفقر في حقه الغني المطلق و غيره الفقير المحض.
على أن الصفات الإضافية، اعتبارية صرفة أو انتزاعية محضة تنتزع من أفعاله الاختيارية و لا مجال لفرض الحاجة إليها.
ص: 50
أمّا نفي اللّذة و الألم المزاجيين عنه تعالى، فلانتفاء المزاج عنه، و هو واضح، و أمّا نفي الألم العقلي فلأنّه لا منافي له في الوجود أصلاً ليتألّم من إدراكه، فإنّ الكل قائم بإرادته، موجود بمشيته. و هو الفاعل لما يشاء، و لا يفعل ما يشاء أحد غيره.
لا يقال: أليس معاصي العباد و تمرد المكلفين عن طاعته موجبةً لتألّمه؟! و كيف لم تكن موجبة له، و الحال أنّه يغضب و يسخط على الكافرين و الظالمين كما أخبر في قرآنه الكريم؟!
فإنّه يقال: جميع ما يصدر في دار الوجود بإرادة الله، كما يدل عليه أدلة التوحيد: قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اَللّٰهِ (1). و قُلِ اَللّٰهُ خٰالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ (2). و من الضروري أنّ المختار لا يوجد باختياره ما ينافره و يتألّم منه قطعاً، و أمّا غضبه و سخطه فهما ليسا بمعنى التألّم، بل معنى العقاب و العذاب غير المستلزم للتألّم، ألا ترى أنّ الرئيس ينتصف من الظالم للمظلوم حفظاً لنظام الرعية و أمان المملكة، مع أنّه قد لا يتألّم من مظلومية المظلوم لعدم ارتباطه به؟ فعقابه تعالى للكافرين ناشٍ من المصلحة الواقعية دون العواطف و التألم النفساني، و هذا واضح.
ثم لا أظنّ أن تتوهم ممّا ذكرنا من استناد الكلّ إلى إرادته تعالى الجبر و سلب الاختيار عن المكلفين، فإنّ ما ذكرنا لا ينافي الاختيار و الأمريين بين الأمرين، كما ستطلّع عليه في مباحث المقصد الخامس إن شاء الله.
و أمّا اللذّة العقلية فقد أثبتها الحكماء له تعالى، و قالوا: إنّ ذاته تعالى أجلّ مدرك بالكسر؛ لأنّ ذاته حاضرة لدى ذاته، لا ماهية له فضلاً عن المادة و الموضوع، و ما تناله المدارك بوجودات متشتتة، يناله بمدرك واحد جمعي هو ذاته المتعالية بأتمّ إدراك؛ لأنّ علمه حضوري ذاتي تفصيلي بغيره، فكيف بذاته؟ لأبهى مدرك لكونه غير متناهٍ في البهاء و الجمال، فهو مبتهج بذاته و عاشق لذاته بنهجة أقوى و بنحو أتمّ، فإنّ تمامية الابتهاج تدور على تمامية هذه الأشياء.
ص: 51
أقول: المقدمات كلها قطعية، لكنّ النتيجة غير مترتبة عليها إلا بقياس الغائب على الشاهد، و هو باطل و تخرّص محض، اين التراب و ربّ الارباب؛ و لذا خالفهم شركاء الفن فنفوها عنه تعالى، سوى ما نسب إلى ابن نوبخت (صاحب الياقوت) و غيره من المتكلمين، و كأنه الظاهر من عبارة التجريد للمحقق الطوسي أعلى الله مقامه، و الحق مع النافين كما عرفت. و الظاهر أن المثبتين أرادوا من اللذة و الابتهاج غير ما قصده المنكرون، فكأن النزاع بينهم لفظي. و الله العالم.
ثم إنّ جملةً من المتكلمين منعوا عن إطلاق لفظ «الملتذّ» عليه تعالى و لو على تقدير تمامية دليل الفلاسفة؛ لأنّ أسماء الله توقيفية و توظيفية لا اصطلاحية، و لم يرد اللفظ المذكور من الشرع.
ثم إنّ مسألة توقيفية أسماء الله تعالى و إن كانت مشهورة في الألسن، إلا أنّها غير محرّرة و معنونة في الكتب حق التعنون، فأحببت أن أتعرض لها بما يناسب هذه الوجيزة.
فنقول: الكلام يقع في مقامات:
المقام الأول: في بيان الأقوال
المنقول عنالمعتزلة و الكرامية: أنّه إذا دل العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية جاز أن يطلق عليه اسم يدل على اتصافه بها، سواء ورد بذلك الإطلاق إذن شرعي، أو لم يرد، و كذا الحال في الأفعال.
و قيل: باعتبار زائد عليه، و هو أن لم يكن إطلاقه موهماً لما لا يليق بكبريائه.
و قيل: إنّه لا بد مع ذلك الإشعار بالتعظيم حتى يصح الإطلاق بلا توقيف. و عن الأشعري و أتباعه التوقيف.(1)
قال شيخنا المفيد نوّر الله مضجعه(2): لا يجوز تسمية الباري تعالى إلا بما سمّى به نفسه.. و كذلك أقول في الصفات. و بهذا تطابق الأخبار عن آل محمد (ص)، و هو مذهب جماعة من الإمامية و كثير من الزيدية و البغداديين من المعتزلة كافة، و جمهور المرجئة و أصحاب الحديث... إلى آخره.
ص: 52
أقول: و ادّعى المحدّث النوري (رحمه الله) الإجماع عليها في النجم الثاقب(1)، و يظهر منه أنّ الاصطلاحية - أي عدم التوقيفية - من متفردات المحقق الطوسي (قدس سره). و كذا السيد الطبرسي ادّعى الإجماع عليها في كفاية الموحّدين(2)، بل ذكرها السيد المرتضى في «تبصرة العوام» من معتقدات الإمامية.
هذا، و لكن ذهب بعض الأماجد ممّن عاصرناه إلى الجواز على ما صرح لي شفاهاً، بل ذكر بعض الأفاضل ممّن أدركنا عصره في بعض تآليفه(3):
و ما شاع من المنع عن التسمية و التوصيف فلعلّه كان استصواباً من علماء الدين و كبراء الملّة، و سديد ملاحظة منهم أن لا يبقى الأمر فوضى فتقتحم العامة و القاصرون على استعمال كل ما يقع على ألسنتهم و يجري على خواطرهم من الأسماء التي لا تليق بقداسة تلك الحضرة المنيعة... و يحسب من بعدهم من القرون أنّها من الشريعة و ما هي منها... إلى آخره. و مثل هذا المضمون حكاه لي بعض السادة المعاصرين عن المجلسي (قدس سره) في بحاره.
فتحصّل: أنّ علماء الإمامية في ذلك مختلفون، غير أنّ المشهور على التوقيفية، فتأمل.
المقام الثاني: في تحرير محلّ البحث
قيل(4): و ليس الكلام في أسمائه الأعلام الموضوعة في اللغات، و إنّما النزاع في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال.
أقول: و وجهه أنّ أهل كل لغة يسمّونه بلغتهم(5)، و شاع ذلك بلا نكير، فكان ذلك إجماعاً كما قيل.
قال في الأسفار(6): و أمّا عند علماء الظاهر و أهل الكلام فلمّا كان إطلاق الأسماء عليه
ص: 53
تعالى بالتوقيف الشرعي فلا شبهة في عدم جواز إطلاق الوجود بل الموجود(1) أيضاً عندهم على ذاته تعالى تسمية ف و أمّا إطلاقه توصيفاً ففيه خلاف... إلى آخره.
قال المحدّث الكاشاني في الوافي(2): اعلم أنّ كل لفظ ليس هو من الألفاظ الكمالية فيما نعقله و نتصوره، فإنّه لا يجوز إطلاقه عليه سبحانه و تعالى بوجه من الوجوه أصلاً.
و أمّا الألفاظ الكمالية فإن لم يرد فيها من جهة الشرع إذن بالتسمية كواجب الوجود فذلك إنّما يجوز إطلاقه عليه سبحانه توصيفاً لا تسميةً، و ان ورد فيها الإذن بالتسمية ساغ الإطلاق توصيفاً و تسميةً، كالحي و العالم.
أقول: كلام شيخنا المفيد و غيره مطلق نفياً و إثباتاً، و هذا التفصيل الذي نقله صاحب الأسفار و تبعه الكاشاني و السبزواري، لم أجده في كلمات المتكلمين لحدّ الآن، و كيف ما كان فالمتّبع هو الدليل.
المقام الثالث: في بيان الأدلة على التوقيفية:
و هي أمور:
الأول: الإجماع المتقدّم، لكنّه إجماع منقول غير معتبر. و مما يدل على نفيه عبارة المفيد (رحمه الله) المتقدمة من نسبة القول المذكور إلى جماعة من الإمامية، فيعلم منها عدم انعقاد الإجماع عليه.
الثاني: ما ذكره الفاضل المقداد(3) من أنّه - أي التهجم بأسمائه و صفاته - و إن كان جائزاً في نظر العقل، لكنّه ليس من الأدب لجواز أن يكون غير جائز من جهة لا نعلمها.
قال في المواقف و شرحها: و ذلك للاحتياط احترازاً عما يوهم باطلا لعظم الخطر في ذلك، فلا يجوز الاكتفاء في عدم إيهام الباطل بمبلغ إدراكنا، بل لا بد من الاستناد إلى إذن الشرع.
أقول: كل ذلك لا يوجب نفي الجواز المستفاد من أصالة البراءة المقدّمة على قاعدة الاحتياط كما هو المقرر في أصول الفقه. نعم قضية هذا الوجه حسن التوقف و ترك التهجم و الاصطلاح بالأسماء و الصفات غير الواردة شرعاً إذا لم يحرز جهة حسنه تماماً، و أين هذا من الوجوب؟
ص: 54
الثالث: ما ذكره سبط النراقي(1) من أنّه لا سبيل لنا إلا معرفة الذات لكي نصفه و نسمّيه بما عرفناه.
أقول: و هو خارج عن محلّ النزاع، كما لا يخفى.
الرابع: قوله تعالى: وَ لِلّٰهِ اَلْأَسْمٰاءُ اَلْحُسْنىٰ فَادْعُوهُ بِهٰا وَ ذَرُوا اَلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمٰائِهِ سَيُجْزَوْنَ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ (2) و في تفسير التبيان: أنّ قوماً قالوا بدلالة الآية على التوقيفية.
أقول: الاستدلال به من وجهين:
الأول»: قوله تعالى: فَادْعُوهُ بِهٰا أي لا بغيرها، و لذا ذكر الرازي في تفسيره أنّ هذا يدل على أنّ أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية... إلى آخره.
الثاني: قوله: يلحدون في أسمائه. إذ قليل في تفسيره: يصفونه بما لا يليق به، و يسمّونه بما لا يجوز تسميته به، لا حظ تفسير مجمع البيان و غيره.
أقول: لا يستفاد الحصر من قوله: فَادْعُوهُ بِهٰا حتى لا يجوز دعاؤه بغير الأسماء الحسنى الواردة شرعاً، و إطلاق لفظ - وصفاً و تسميةً - أحرزنا صحة اتصافة تعالى بمعناه و مدلوله بل حسنه ليس من الإلحاد بشيء. فالآية الكريمة لا نظارة لها إلى محلّ البحث، مع أنّ لقوله تعالى: يُلْحِدُونَ معنى محتملاً آخر، فلا حظ كتب التفسير(3).
بل يمكن أن يقال. أنّ الاية الكريمة - على عكس ما اشتهر - تدل على الاصطلاحية، و أنّ كل اسم أو وصف كان حسناً يجوز إطلاقه عليه تعالى؛ إذ لا دليل على انحصار الأسماء الحسنى بأسماء معينة حتى لا يجوز التعدي عنها.
و منه يظهر الحال في قوله تعالى: أَيًّا مٰا تَدْعُوا فَلَهُ اَلْأَسْمٰاءُ اَلْحُسْنىٰ (4)، و أمّا قوله تعالى: أَسْمٰاءٌ سَمَّيْتُمُوهٰا أَنْتُمْ وَ آبٰاؤُكُمْ مٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ بِهٰا مِنْ سُلْطٰانٍ (5) فهو غير مربوط بالمقام.
الخامس: السنّة، و هي طوائف:
ص: 55
الطائفة الاولي: ما دل على النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى، و قد عقد ثقة الإسلام الكليني (قدس سره) باباً في الكافي(1) و عنونه بما ذكرنا، و أورد فيه اثنتي عشرة رواية دالة على ذلك، و لكنّ الأظهر من هذه الروايات لعلّه قول أبي الحسن (ع) في رواية فتح الجرجاني(2): «و أنّ الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، و أنّى يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه و الأوهام أن تناله...؟!» إلى آخره.
الثانية: قول الرضا (ع) في رواية سليمان المروزي المروية في توحيد الصدوق(3): «فليس لك أن تسمّيه بما لم يسمّ به نفسه...» إلى آخره.
أقول: و هذا نصّ على المطلوب.
الثالثة: صحيحة صفوان(4) قال: سألني أبو قرّة المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضا (ع)، فاستأذنته فأذن لي، فدخل فسأله عن الحلال و الحرام؟ ثم قال له: أفتقرّ أنّ الله محمول؟ فقال أبو الحسن: «كلّ محمول مفعول به مضاف إلى غيره محتاج، و المحمول اسم نقص في اللفظ... و قد قال الله: وَ لِلّٰهِ اَلْأَسْمٰاءُ اَلْحُسْنىٰ فَادْعُوهُ بِهٰا(5) و لم يقل في كتابه: إنّه المحمول، و لم يسمع أحد آمن بالله و عظمته قطّ قال في دعائه: يا محمول... و لا يقال: محمول و لا أسفل قولاً مفرداً لا يوصل بشيء فيفسد اللفظ و المعنى...» إلى آخره.
قال المجلسي: و إلا فيفسد اللفظ؛ لعدم الإذن الشرعي، و أسماؤه توفيقية، و أيضاً هذا اسم نقص، و المعنى لأنّه يوجب نقصه و عجزه.
أقول: و في الجميع بحث، فإنّ الطائفة الاولى بكثرتها ناظرة إلى منع الناس عن إثبات الصفات التي لا تليق به تعالى؛ لاستلزامها النقص و الإمكان. و أين هذا من إطلاق لفظ عليه باعتبار تضمّنه معنى ثابتاً له عقلاً أو شرعاً و لو بلفظ آخر، كالواجب فإنّ مفاده بعينه مفاد لفظ الثابت الوارد في النقل، فهذه الروايات أجنبية عن المقام. ثم الظاهر أنّ النهي عن الوصف في بعض تلك الروايات إرشادي يرشد إلى حكم العقل القطعي بعدم إحاطة الممكن بالواجب، كما سيأتي برهانه في ما بعد، إن شاء الله، لا أنه مولوي تعبدي محض، فلاحظ.
و أمّا الطائفة الثانية فهي صريحة في المراد، و التسمية المذكورة فيها أعمّ من التوصيف
ص: 56
و التسمية المصطلحة كما يظهر من ملاحظة الرواية، غير أنّ ضعف سندها مانع عن الاعتماد عليها، و توهّم انجبارها بالشهرة مدفوع بمنع الصغرى أولاً، و منع الكبرى ثانياً.
و أمّا الطائفة الثالثة فالتأمّل الصادق يلحقها بالأولى، كما لا يخفى، و أمّا ما تقدم في كلام الشيخ المفيد (رحمه الله) من تطابق الأخبار على المدّعى فلعلّه أراد بها ما ذكرنا، و إلا فلم نجد رواية تدل عليه.
فتحصّل: أنّه لم يقم دليل على التوقيفية المذكورة، و الأصل يقتضي الجواز، و لنا دليل قطعي على الجواز، و هو السيرة الجارية بين المؤمنين فإنهم يقرؤون الأدعية المأثورة و إن لم تثبت صحة أسانيدها و لم أر - لحدّ الآن - عالماً توقف في ذلك أو أفتى بحرمة الأدعية المشتملة على أسماء الله التي لم يثبت سندها بطريق معتبر شرعاً، فهذا التسالم العملي و السيرة القطعية دليل قوي على جواز اصطلاحية و عدم الاعتداد بالتوقيفية؛ إذ لو كان تسميته تعالى بالأسماء غير الثابتة شرعاً محرّمة لما جاز قراءة الأدعية المذكورة و لو رجاءً، فإنّ إتيان المحرّم لا يسوغه الرجاء و الاحتياط.
ثم إنّه لا ينقضي تعجّبي من القائلين بالتوقيفية، حيث استعملوا لفظة الواجب فيه تعالى مع أنّها غير واردة في الشرع، و هل هذا إلا فعل الحرام؟ و أمّا ما اعتذر به بعض الناس من أنّه صفة جرت على غير من هي له، إذ المعنى واجب وجوده كما في حسن الوجه، فهو مردود بأنّ هذه الحيلة لو تمّت في نفسها و لم تبطلها الأدلة المذكورة، لجرت في جملة من ألفاظ الصفات و الأسماء، و لا أظنّ الالتزام به حتى من المعتذر نفسه.
فالمتحصّل: أنّ الصحيح - حسب الموازين العلمية - هو القول الأول مع اعتبار عدم كون اللفظ موهماً لباطل، و الله العالم.
ينبغي ذكر أمور:
الأول: ربّما قيل بعدم جواز إطلاق العارف و الفقيه و العاقل و الطبيب و السخيّ عليه، فإنّ المعرفة قديراد بها علم يسبقه غفلة، و الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه، و ذلك مشعر بسابقة الجهل. و العقل علم مانع عن الإقدام على ما لا ينبغي (مأخوذ من العقال)، و إنّما يتصور هذا المعنى فيمن يدعوه الداعي إلى ما لا ينبغي، و الطبّ علم مأخوذ من التجارب، و السخيّ من يطعم و يطعم غيره.
أقول: كل ذلك غير ثابت، بل عدم جواز إطلاقها تعبدي من جهة ما دلّ على التوفيقية، و إلا فلا مانع من إطلاقها عليه تعالى.
ص: 57
بل لفظ «العارف» قد أطلق عليه تعالى في الأخبار(1)، و كذا الطبيب(2)، و في الدعاء: «ياذا الجود و السخاء»(3)، فإن قلنا بكفاية إطلاق المبدأ عليه تعالى في صحة استعمال المشتقّات في حقه فلا شك في جواز إطلاق السخيّ عليه تعالى، و إلا فلا.
و قيل: إنّ لفظ «الفاضل» لم يرد من الشرع في حقه تعالى، ورد بوروده في موضعين من دعاء أمّ داود و في دعاء المشمول.
أقول: و الموجود في الدعاءين هو «الفاصل» بالصاد المهملة دون الضاد المعجمة! نعم ورد «المفضل» و «ذو الفضل» و «دائم الفضل»، فافهم.
و أمّا لفظ «الموجود» فقيل بعد ثبوته في الشرع، لكنّه خطأ؛ لأنّا وجدناه في موارد كثيرة أطلق عليه تعالى(4)، و أيضاً أطلق عليه تعالى لفظ العلة، ففي آخر توحيد المفضّل: لأنّه جلّ ثناؤة علة كل شيء، و ليس شيء بعلّة له(5). ثم اعلم أنّ إطلاق كل ما ورد في الشرع عليه مشكل؛ إذ ربّما ينافي الأدب، كالماكر و المستهزئ، و أنّه يضلّ و غير ذلك، بمفرده كما ذكره الرضا (ع) فيما سبق فلا بد من مراعاة هذه النكتة.
الثاني: روى الصدوق (قدس سره) بإسناده، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ (ع) قال: «قال رسول الله (ص): إنّ عزّ و جلّ تسعة و تسعين اسماً، من دعا الله بها استجاب له، و من أحصاها دخل الجنة»(6). و بإسناده أيضاً عن الصادق، عن آبائه، عن عليّ (ع) قال: «قال رسول الله (ص)(7): إنّ الله تبارك و تعالى تسعة و تسعين اسماً مائة إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، و هي: الله، الإله، الواحد، الأحد، الصمد، الأول، الآخر، السميع، البصير، القدير القاهر، العليّ، الأعلى، الباقي، البديع، الباري، الأكرم، الظاهر، الباطن، الحيّ، الحكيم، العليم، الحليم، الحفيظ، الحقّ، الحسيب، الحميد، الحفيّ، الربّ، الرحمن، الرحيم، الذاري، الرازق، الرقيب، الرؤوف، الرائي، السلام،
ص: 58
المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبّر، السيدّ، السبّوح، الشهيد، الصادق، الصانع، الطاهر، العدل، العفوّ، الغفور، الغنيّ، الغياث، الفاطر، الفرد، الفتّاح، الفالق، القديم، الملك، القدّوس، القويّ، القريب، القيّوم، القابض، الباسط، قاضي الحاجات، المجيد، المولى، المحيط، المبين، المقيت، المصوّر، الكريم، الكبير، الكافي، كاشف الضرّ، الوتر، النور، الوهّاب، الناصر، الواسع، الودود، الهادي، الوفيّ، الوكيل، الوارث، البرّ، الباعث، التوّاب، الجليل، الجواد، الخبير، الخالق، خير الناصرين، الديّان، الشكور، العظيم، اللطيف، الشافي». انتهى.
و في صحيحة هشام بن الحكم(1) عن الصادق (ع): «لله تسعة و تسعون اسماً...». لكن إطلاقها يقيد بما في الروايتين المتقدمين، و أنّ المراد بها ما يوجب إحصاؤه دخول الجنة و إجابة الدعاء.
فلا دلالة للروايات المذكورة على نفي الزائد و انحصار أسمائه تعالى في هذا العدد. بل لا مفهوم للعدد كما تقرر في أصول الفقه. كيف، و لا شك في ثبوت أسماء له تعالى سوى هذه(2)؟ و إليك بعضها و هو: المريد، المدبر، المالك، سريع الحساب، شديد العقاب، القادر، العالم، الأكبر، الشاكر، خير الحاكمين، القهار، أرحم الراحمين، الشكور، ذو الجلال و الأكرام، الجميل، الحافظ، المبدئ و المعيد، الرافع، الواضع، المحيي، المميت، العظيم، الغالب، المحسن، المجمل، الكاشف، المنذر، المحيط، الطبيب، إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى و أوصافه العليا.
بل في رواية إبراهيم عن الصادق (ع)(3): فهذا الأسماء - أي المذكورة في الرواية - و ما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم ثلاثمائة و ستين اسماً... إلى آخره.
بل عن غوالي اللآلي(4) مرسلاً عن النبي الأعظم (ص): «إنّ الله أربعة آلاف اسم، ألف لا يعلمها إلا الله، و ألف لا يعلمها إلا الله و الملائكة، و ألف لا يعلمها إلا الله و الملائكة و النبيون. و أمّا الألف الرابع فالمؤمنون يعلمونه ثلاثمئة منها في التوراة، و ثلاثمئة في الإنجيل، و ثلاثمئة في الزبور، و مائة في القرآن، و تسعة و تسعون ظاهرة و واحدة منها مكتوم. من أحصاها دخل الجنة».
الثالث: أنّ جماعة من المتكلمين ذهبوا إلى مجرد التعطيل، و منعوا من إطلاق الشيء و الموجود و أشباههما عليه تعالى، محتجين بأنّه لو كان شيئاً لشارك الأشياء في مفهوم الشيئية،
ص: 59
و كذا لو كان موجوداً أو غيره.
قال المجلسي (رحمه الله): و ذهب إلى مثل هذا بعض معاصرينا، فحكم بعدم اشتراك مفهوم من المفاهيم بين الواجب و الممكن، و بأنّه لا يمكن تعقّل ذاته و صفاته بوجه من الوجوه، و بكذب جميع الأحكام الإيجابية عليه تعالى(1)... إلى آخره.
أقول: و لمن منع إطلاق لفظ الشيء عليه تعالى وجوه أخر(2):
فمنها: قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ (3)، أي ليس مثل مثله شيء، و ذات كل شيء مثل مثل نفسه، فالآية صريحة في أنّ الله لا يسمّى باسم الشيء. و احتمال زيادة الكاف ممنوع؛ لأنّ الزيادة الكاف ممنوع؛ لأنّ الزيادة لغو لا يصير إليها المتدين إلا عند الضرورة الشديدة المفقودة في المقام.
و منها: قوله تعالى: وَ لِلّٰهِ اَلْأَسْمٰاءُ اَلْحُسْنىٰ (4). و اسم الشيء ليس بحسن الإطاقه علي اخس الأشياء.
و منها: أنّ هذا اللفظ ما ورد في الكتاب و السنّة، و لا سمع من السلف، فوجب الامتناع منه.
و منها غير ذلك. لكنّ الكلّ لا يرجع إلى معنى محصّل، فإنّ دعوى محذورية الاشتراك في مفهوم الشيئية و نحوها لو تمت لما جاز اتصافه بشيء من الأوصاف و النعوت، فإنّ الاشتراك محقق، و الحال أنّه تعالى يقول: وَ لِلّٰهِ اَلْأَسْمٰاءُ اَلْحُسْنىٰ فَادْعُوهُ بِهٰا(5). و الالتزام بجواز الاستعمال و تعطيل العقل عن معانيها حماقة واضحة.
و حلّ الإشكال: أنّ الاشتراك الموجب للتركب إنّما هو الاشتراك في الذاتيّات، لا الاشتراك في المفهومات، فالواجب يشارك غيره في كثير من المفهومات مع بساطة ذاته الفاردة واحدية حقيقته الواجبة.
و بالجملة: انتزاع المفاهيم المتعددة عن الشيء الواحد أمر سائغ، و إنّما الباطل عكسه، و هو انتزاع المفهوم الفارد من الأشياء المتخالفة بما هي متخالفة.
أمّا الوجوه الثلاثة المذكورة فهي أيضاً لا تثبت ما راموه:
فإنّ الأول ناظر إلى نفي المثلية في جانب المعنى دون اللفظ(6).
ص: 60
و بالجملة دلالة الآية على نفي إطلاق لفظ الشيء عنه تعالى بعيدة جداً.
و الثاني ممنوع؛ لما ستعرفه من حسنية اللفظ المذكور، مع أنّه لو تم لجرى مث القوي و الحي و المريد و المختار و نحوها ممّا يطلق على الحيوانات.
و الثالث باطل؛ لورود اللفظ المذكور في الكتاب و السنّة، قال الله تعالى: كُلُّ شَيْ ءٍ هٰالِكٌ إِلاّٰ وَجْهَهُ (1)، و الاستثناء دليل على دخول المستثنى في ا لمستثنى منه. و قال تعالى: قُلْ أَيُّ شَيْ ءٍ أَكْبَرُ شَهٰادَةً قُلِ اَللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ (2).
و في صحيحة عبد الرحمن قال: سألت أبا جعفر (ع) عن التوحيد، فقلت: أتوهم شيئا؟ فقال: «نعم غير معقول و لا محدود...». و الظاهر أن المراد بالمعتلّ هو المتصوّر المتوهّم.
و في رواية الحسين بن سعيد قال: سئل أبو جعفر الثاني (ع): يجوز أن يقال الله: إنّه شيء؟ قال: «نعم يخرجه من الحدّين: حدّ التعطيل و حدّ التشبيه».
و قد عقد الكليني - أعلى الله مقامه - في الكافي(3)، و المجلسي في البحار(4) باباً للروايات الواردة في ذلك، فلاحظ.
الرابع: اختلفوا في لفظ الجلالة و أنّه جامد أو مشتق، و الأصح أنّه مشتق، كما يدل عليه صحيحة هشام بن الحكم(5) ففيها: الله ممّا مشتق؟ فقال الصادق (ع): «يا هشام، الله مشتق من إله، و إله يقتضي مألوها».
و الأظهر أنّه علم بمعنى المعبود، و التفصيل في غير هذا الكتاب. لكن أول ما اختاره الله لنفسه «العلي العظيم»؛ لأنّه أعلى الأشياء كلّها، على ما في خبر ابن سنان كما في الكافي(6).
و للمقام مباحث أخرى تركناها مخافة التطويلف و الله الموفق.
ص: 61
وقع البحث في أنّ الواجب الوجود، جلّ شأنه هل يصح كونه محلاً للحوادث، أم لا؟ و لا بد لنا من بيان ما هو المقصود بالبحث في هذه المسألة؟
فنقول: العارض: إمّا قديم، و إمّا حادث، و الحادث: إمّا أن يحتاج في عروضه إلى الجسم و الجسماني، و إمّا أن لا يحتاج، و غير المحتاج: إمّا أن يقوم بموضوعه قياماً صدورياً أو انتزاعياً أو وقوعياً، و بالجملة: قياماً غير حلولي، و إمّا أن يقوم به قياماً حلولياً، فهذه أربعة أقسام.
أمّا الأول - و هو العارض القديم - فقد تقدم بطلانه في الجزء الأول في مبحث علمه تعالى، حيث أبطلنا العلم الحصولي و ارتسام الصور في حق الواجب البسيط. و في مبحث حدوث العالم، و سيأتي بطلانه أيضاً في مسألة عينية صفاته مع ذاته ردّاً على الأشعرية.
و أمّا الثاني فينتفي عن الواجب بانتفاء موضوعه، و قد مضى أنّه ليس بجسم و لا جسماني.
و أمّا الثالث فلا شك في إمكانه و وقوعه، و هو ظاهر واضح.
و أمّا الرابع فهو المقصود من البحث هنا، و أنّه هل يجوز حلول الحوادث به تعالى، أم لا، بل هو مستحيل؟
ذهب المجوس - على ما حكي عنهم - الى جواز قيام الصفات الكمالية الحادثة به تعالى مطلقاً، و الكرامية - في محكيّ كلامهم - إلى جواز قيام كل صفة يفتقر إليه الواجب في إيجاد الخلق. فقال بعضهم: هي كلمة «كن»، و بعضهم: هي الإرادة. فهذه الصفة حالّة فيه تعالى، مستندة إلى قدرته، و خلق العالم مستند إليها.
أقول: قد تقدم أنّ إرادته تعالى نفس إيجاده، فهي قائمة به بالقيام الصدوري، و منه يظهر أنّ المراد بكلمة «كن» هو هذا الإيجاد.
و قد ذكرنا سابقاً أنّ العامة ما حصلوا أنحاء القيام على وجهها، فوقعوا في حيص و بيص في غير واحد من المسائل، و قد مرّ تحقيقها في مبحث تكلّمة تعالى، فلا حظ.
و في شرح الباب الحادي عشر: قالوا - أي الكرامية - إنّه لم يكن قادراً في الأول، و لم يكن عالماً ثم صار عالماً. و قريب منه ما في «طوالع الانوار» للبيضاوي و شرحها «مطالع
ص: 62
الأنظار» للإصبهاني.
أقول: هذا كفر بالله العظيم و راجع إلى قول الماديين، من استناد العالم إلى موجود فاقد للعلم و القدرة.
ثم الظاهر أنّ امتناع حلول الحوادث به تعالى ممّا تسالم عليه علماء الإمامية، بل قيل: إنّه المتسالم عليه بين جمهور أهل الملل و غيرهم. و الدليل عليه وجوه:
الأول: لو جاز قيام الحوادث به تعالى لجاز ذلك في القدم، و بطلان التالي يكشف عن بطلان المقدم، بيان الملازمة من وجهين:
1 - إنّ قيام الحادث متفرع على تحقق القابلية - أي جواز اتصافه بالحادث - و هي لا بد أن تكون أزلية، و إلا يلزم انقلاب الامتناع إلى الإمكان؛ إذ الذات قبل القابلية ممتنعة القبول للحادث المقبول، و بعدها ممكنة القبول, و لا شك أنّ الجهات الثلاث ممتنعة الانقلاب.
2 - لو لم تكن القابلية أزلية و لازمة لذاته تعالى لكانت عارضة, فتفتقر في حدوثها إلى قابلية أخرى في الذات لها, و هكذا حتى تنتهي ألى قابلية أزلية لئلّا تدور أو تتسلسل القابليات, فافهم.
و أمّا بطلان التالي فواضح, إذ معنى اتصافه بالحادث أزلاً هو تجويز و جوده أزلاً, و هو محال بالضرورة.
أقول: الملازمة متينة, لكنّ التالي غير باطل, فإنّ أزلية صحة الحادث و إمكانه لا يرتبط بأزلية وجوده؛ إذ يمكن أن يكون الحادث ممكناً أزلاً, أي يحكم العقل بعدم اقتضائه الوجود أو العدم, و لا يجوز أزلية وجوده لفرض حدوثه.
و باجملة: أزلية صحة الحادث لا تستلزم صحة أزلية الحادث. و هذا الدليل يدّل على الاُولى, و المقصود هو الثانية, فهذا الاستدلال غير مفيد.
كما أنّ قدم الحادث لا يلزم من أزلية إمكانه, كذلك أزلية الممكن لا تحصل من أزلية إمكانه. فإمكان الممكن شيء و وجوده في الأزل شيء آخر, ولعلّ هذا هو المشهور. نعم, ذهب بعض المتكلمين(1) إلى الملازمة, و قال: إنّ إمكانه إذا كان مستمراً أزلاً لم يكن هو في ذاته مانعاً من قبول الوجود في شيء من أجزاء الأزل, فيكون عدم منعه منه في شيء من أجزاء الأزل أمراً مستمراً في جميع تلك الأجزاء, فإذا نظر إلى ذاته من حيث هو اتصافه بالوجود في
ص: 63
شيء منها, بل جاز اتصافه في كلًّ منها, لا بدلاً فقظ, بل و معاً أيضاً, و جواز اتصافه به في كلًّ منها معاً هو إمكان اتصافه بالوجود المستمر في جميع أجزاء الأزل بالنظر إلى ذاته, فأزلية الإمكان مستلزمة لإمكان الأزلية... إلى آخره.
قلت: وجود الممكن أزلاً غير ممكن؛ لاستلزامه تحصيل الحاصل أو استغنائه عن العلة, كما قررناه في مسألة حدوث العالم, و كلا الأمرين محال باضرورة, فالأشياء في الأزل ممكنة بالإمكان الذاتي, لكن لا يمكن و قوعها لاستلزامه المحال المزبور.
الثاني: أنّ صفاته - تعالى - كمال, فخلوه عنها نقص, و النقص عليه محال إجماعا, فلا يكون شيء من صفاته حادثاً.
قال العالمة (قدس سره)(1): و لأنه إن كان صفة كمال استحال خلو الذات عنه, و إن لم يكن, استحال اتصاف الذات به.
أقول: هذا الاستدلال يتقوّم بأمرين:
1 - استحالة النقص عليه, و سيأتي بحثها في المطلب الآتي.
2 - أنّ كلّ ما يحلّ به تعالى لابد و أن يكون كمالاً.
أقول: فإن قال الخصم بحلول ما يصدر عنه تعالى اختياراً به فلا دافع عنه, فإنّ الكمال في الأفعال هو حسنها و كونها ذات مصالح, ومن المعلوم المتفق عليه أنّ مثل هذا الكمال لايستلزم قدم الكامل, كيف و جميع أفعاله الحادثة كمال بهذا المعنى؟
بل يمكن أن يقال: أنّه لا يلزم أن تدوم كمالية الحال ليجزي عليه هذا السؤال؛ لاحتمال كونه كمالاً وقت حلوله لا قبله, ألا ترى أنّ الغضب كمال لناحين الدفاع عن الناموس أو المظلوم؟ و ليس كذلك قبله, فمجرد خلوه عن كمال لا يوجب اتصافه بالنقص.
و ربما يقال(2) أيضاً: لِمَ لا يجوز أن يكون ثمّة صفات كمال متلاحقة غير متناهية لا يمكن بقاؤها و اجتماعها, و كل لا حق منها مشروط بالسابق على قياس الحركات الفلكية عند الحكماء, فلا ينتقل حينئذٍ عن الكمال الممكن له إلّا ألى كمال آخر يعقبه, و لا يلزم الخلو عن الكمال المشترك بين تلك الاُمور المتلاحقة, و أمّا الخلو عن كل واحد منها فإمّا لامتناع بقائه و لا نسلّم امتناع الخلو عن مثله, و إنّما الممتنع - و هو الخلو عن كمال - ممكن بقاؤه. و أمّا لأنّه لو لم يخل لم يمكن حصول غيره, فيلزم حينئذٍ فقد كمالات غير متناهية, فكان فقد كل واحد لتحصيل كمالات غير متناهية هو الكمال باحقيقة.
ص: 64
أقول: بعدما فرضنا سلسلة الكمالات المذكورة حادثة و مسبوقة بالعدم لا يمكن مصاحبتها مع الواجب القديم الذي لا يسبقه العدم, بل القول بعدم خلو الواجب القديم عن الكمال المشترك مع القول بحدوث أفراده من التناقض, فهذا الكلام و إن صدر مثله عن الفلاسفة أيضاً لكنّه غير تام. و ببالي أنّ المحقّق الطوسي في بعض كتبه أيضاً أورد عليه بمثل ما ذكرنا, فلا حظ.
الثالث: المقتضي للحادث الحالّ إن كان ذاته كان الحادث أزلياً, و إن كان غيره كان الواجب مفتقراً إلى الغير, و هو محال, ذكره العلامة (قدس سره) في شرح التجريد.
و يرد عليه: أنّ معني الاقتضاء الإيجادي هو صحة الفعل و الترك, و معنى الاقتضاء القبولي صحة اتّصانة بامقبول, و هذان المعنيان لا يستلزمان أزلية الحادث. و أمّا الشقّ الثاني فهو أيضاً غير تام, و تقدّم بحثه في المطلب الثامن من هذا المقصد, فلا حظ.
الرابع: المقتضي للصفة الحادثه إن كان ذاته أو شيئاً من لوازم ذاته لزم الترجيح بلا مرجّح؛ لاستواء نسبة الذات و لوازمها إلى الأوقات, و إن كان وصفاً آخر محدثاً ننقل الكلام إلى مقتضيه حتى ينتهي إلى الذات أو لوازمها.
ذكره البيضاوي في «طوالع الأنوار», و يرد عليه ما أوردناه على سابقيه.
الخامس: لو كان محلّاً للحوادث للزم تغيّره و انفعاله في ذاته, و هو ينافي الوجوب. و تصحيح الملازمة بوجوه ثلاثة:
1 - إنّ صفاته ذاتية, فتجدّدها مستلزم لتغيّر الذات و انفعالها.
2 - إنّ حدوث الصفة يستلزم حدوث قابلية في المحلّ لها, و هو مستلزم لانفعال المحلّ و تغيّره, ذكرهما الفاضل المقداد في «شرح الباب احادي عشر»(1).
3 - إنّ المقتضي لصفاته ذاته, و تغيّر الموجوب دالّ على تغيّر موجبه, فإنّه يمتنع أن يكون الموجب للشيء باقياً و الشيء منتفياً. ذكره في مطارح الأنظار.
أقول: و الأول أخصّ من المدّعى عرفت. و الثاني ممنوع؛ لأنّ المراد بقابلية المحلّ هو إمكان اتصافه بالحالّ, فحدوث الصفة لا يستلزم حدوثها, و الثالث مثل الأول, كما لا يخفى.
مع أنّه مبني على زيادة الصفات القديمة على ذاته, و كون الذات علّة موجبة لها, و سيأتي بطلانها و فسادها, و أنّ الحق الصراح هو عينية صفاته مع ذاته الواجبة.
و ربّما اكتفى بعضهم على مجرد بيان المقدَّم و التالي و لم يتعرض لبيان الملازمة, و لعلّهم
ص: 65
يعتقدون ضرورتهان لكنّه أيضاً غلط, فإنّ الحكم غير مبيّن في نفسه. فهذا الوجه أيضاً ساقط.
السادس: ما ذكره بعض أجلّاء العصر حينما سألته عن الدليل على هذه امسألة, فأجاب: بأن نسبة ذاته تعالى إلى جميع ما سواه نسبة واحدة, و هذه تمنع أن تختلف بالمعية و اللامعية, و إلّا فيكون بالفعل مع وجود الحادث به بالقوة مع عدمه, فيتركب ذاته سبحانه من جهتي فعل و قوة, و تتغير صفاته حسب تغير المتجددات المتعاقبات. بل نسبة ذاته التي هي فعلية صرفة و غناء محض من جميع الوجوه إلى اجميع - و إن كان من الحوادث الزمانية - نسبة واحدة و معية قيومية ثابتة غير زمانية, و لا متغيرة أصلاً, و الكلّ بغنائه تعالى بقدر استعداداتها مستغنيات, كل في وقته و محله, و إنّما فقرهاً بالقياس إلى ذواتها و قوابل ذواتها, و ليس هناك إمكان و قوة البتّة.
أقول: هذا الذي كتبه لي أخذه مما قرره الفيض الكاشاني في بحث: أنّ الأشياء بأسرها عنده تعالى حاضرة.(1) و لكنّه ليس بجيد, فإنّ حلول حادث فيه دون آخر لا يرتبط بمعيته القيومية مع الكل في وقته. و حديث التركب لو تمّ لجرى في غير الحوادث المقبولة أيضاً, و لازمة إمّا تركب الواجب, أو عدم تغير العالم أصلاً, و كلاً الأمرين محال. و قد تقدم في مبحث عموم علمه - في الجزء الأول - أنّ حضور الأشياء عند الواجب أزلاً كلام لا دليل على إثباته, فلا حظ. و أمّا قوله: بل تسبة ذاته التي هي فعلية صرفة... إلى آخره فهو ناظر بظاهره إلى أنّ الواجب من جميع جهاته.
و قد أقبتنا في فوائد المدخل بطلانه. و الإنصاف أنّ الوجه ضعيف جداً.
السابع: ما أفاده المحقق الطوسي (قدس سره) في قواعد العقائد(2): و لا يجوز أن يكون قابلاً لشيء من الأعراض و الصور...؛ لأنّ اجتماع الفاعلية و القابلية فيه يقتضي التركيب.
قال العلّامة الحلي (رحمه الله) في شرحه: فإنّ جهة الفعل مغايرة لجهة القبول؛ إذ الفاعل يجب عنه الفعل, و القابل لا يجب عنه القبول, و الشيء الواحد لا يكون نسبته إلى الشيء الواحد باوجوب و الإمكان.
ثمّ اعتراض عليه بقوله: و ليس بجيد, فإنّ نسبة الوجوب باعتبار الفاعلية لا تنافي نسبة الإمكان باعتبار القابلية, إنّما الممتنع لو اتحد الاعتبار.
أقول: حيثية الفاعلية و القابلية إن كانت تعليلية فلا يرتفع بها تنافي الوجوب و الإمكان, كما هو ليس بسر, فلابد من فرض التكثر كما هو مراد المستدل. و إن كانت تقييدية فقد جاء التركب ابتداءً, فالاعتراض ساقط لا محالة, فتدبّر, على أنّ هنا تقريباً آخر للحجّة لا يرد عليه
ص: 66
هذا الاعتراض, و سيأتي ذكره.
المشهور من الحكماء امتناع كون البسيط قابلاً و فاعلاً مطلقاً في شيء واحد من حيث هو واحد. و احترز بقيد وحدة الحيثية عن مثل النار تفعل الحرارة بصورتها و تقبّلها بمادتها. و المتأخرون على جوازه مطلقاً(1)، و الذي تمسك به للأول حجّتان:
الأولى: أن القبول و الفعل أثران، فلا يصدران عن واحد.
و جوابه أولاً: قاعدة عدم جواز صدور الكثير عن الواحد، إن تمّت لما شملت المقام، كما حققناه في مبحث قدرة الله تعالى.
و ثانياً: أنّ القبول ليس بأثر، و إلا لكان القبول فعلاً، و هذا خلف.
الثانية: أنّ نسبة القابل إلى مقبوله بالإمكان، و نسبة الفاعل إلى فعله بالوجوب، فلو كان شيء واحد قابلاً و فاعلاً لشيء لكان نسبته إلى ذلك الشيء ممكنة و واجبة، و هما متنافيان، و تنافي اللوازم مستلزم لتنافي الملزومات.
و حيث إنّ الوجوب نسبة مختصة بالشيء و علته التامة فقط دون جميع أقسام الفاعل، قرّر الاستدلال بعض المدقّقين هكذا: أنّ نسبة القابل إلى مقبوله بالقوة، و هي تستلزم فقدان القابل لمقبوله في نفسه، و نسبة الفاعل إلى فعله بالفعل المستلزم لوجدانه حقيقة فعله و كمال وجوده، و لو اتخذ الفاعل و القابل لكان الشيء في نفسه واجداً لأثره فاقداً له بعينه، و هو محال.
أقول: و ممّا يدلّ أيضاً على أنّ جهة الفعل تغاير جهة القبول أمران آخران:
الأول: أنّ الفعل للفاعل قد يكون في غيره، و القبول للقابل لا يكون في غيره.
الثاني: أنّهما لو كانتا جهة واحدة لكان كل ما فعل بنفسه قبل و كل ما قبل بنفسه فعل، و الحسّ يكذّبه.
قال صاحب الأسفار(2): و التحقيق أنّ القبول إن كان بمعنى الانفعال و التأثر فالشيء لا يتأثر عن نفسه، و كذا إذا كان المقبول صفة كمالية للقابل فالشيء لا يستكمل بنفسه، و أمّا إذا كان بمجرد الاتصاف بصفة غير كمالية تكون بعد تمام مرتبة الذات الموصوفة فيجوز كون الشيء مقتضياً لما يلزم ذاته و لا ينفك عنه، كلوازم الماهيات البسيطة ففي الجميع ما عنها و ما فيها معنى واحد... إلى آخره.
ص: 67
و المقام بعد محتاج إلى مزيد مقال و سديد تأمل.
و الذي ينبغي أن يستدل به للمقام هو: أنّ الواجب غير محدود عقلاً و اتفاقاً، و كل ممكن محدود متناهٍ، و عروض المتناهي و حلوله بغير المتناهي يكشف عن تبعّض غير المتناهي و تكثره المستلزم للإمكان، فالواجب الوجود لا يكون محلّاً لشيء من العوارض. و هذه الحجة لا تختص بالحوادث كما هو ظاهر، بل تنفي عروض مطلق العوارض، سواء كانت قديمة كما يدين بها الأشعريون في باب صفاته تعالى، و المشّاؤون و أتباعهم في مسألة الصور المرتسمة، أم حادثة كما يقول به المجوس و الكرامية من أهل السنّة، و الله الهادي.
ص: 68
و هذا بحث شريف و مطلب شامخ، و مع ذلك لم أر لم عنواناً في الكتب العقلية الموجودة عندي. و الدليل على أنّه كامل مطلق و يمتنع عليه النقص وجوه:
1 - النقص: عبارة عن فقد الوجود، أو فقد كمال للوجود، و الواجب لذاته لو فرض ناقصاً، يلزم أن يكون فاقداً لمرتبةٍ من الوجود، أو فاقداً لكمالٍ من كمالات الوجود، و هذا ينافي وجوب وجوده، فإنّ فاقد الخير أو فاقد كمال الخير يحتاج إليه، فيخرج حينئذٍ عن الوجوب إلى الإمكان، فافهم.
2 - كل ما هو كمال للوجود المطلق أو للموجودات من حيث هو موجود من غير تخصص بأمر طبيعي أو مقداري أو عددي، فلا بد من ثبوته لمبدأ الوجوداً و فاعله؛ إذ الفاعل المعطي للوجود و كماله أولى بذلك الكمال، ذكره صاحب الأسفار في بحث حياته تعالى. و هو متين جداً، لكنّه أخص من المدّعى، كما لا يخفى.
3 - كل كمال ممكن الوجود المطلق أو للموجود من غير تخصص بشيء آخر ممكن (أي غير محال) للواجب الوجود، و كل ما أمكن في حقّه وجب، كما مرّ في مدخل الكتاب في الجزء الأول. فالواجب جامع لجميع الكمالات و الخيرات، سواء كانت ثابتة للممكن أم لا، فلا يعقل تطرق النقص إليه تعالى أصلاً.
4 - الفطرة، فإنّ كل أحد يقرّ بارتكازه الفطري أنّ الله الخالق كامل لا نقص فيه بوجه، بل هو فوق كل كمال.
قال المحقق الطوسي في محكيّ «رسالة العلم»: إنّ العقلاء قصدوا وصفه بالطرف الأشرف من طرفي النقيض... إلى آخره.
قال العلاّمة المجلسي(1): و النقض عليه تعالى محال ضرورة، بدليل إجماع العقلاء عليه، و من المحال عادة إجماعهم على نظري، و لئن لم يكن ضرورياً فنظريّ ظاهر متّسق الطريق
ص: 69
واضح الدليل. و استحالة إجماعهم على نظري لا يكون كذلك أظهر. انتهى. و مثلها غيرهما.
أقول: كل ذلك من جهة حكم الفطرة كما قلنا.
و أمّا الأشاعرة فقد قال إمامهم الرازي - على ما نقله القاضي الشهيد في إحقاق الحق(1) -: إنّ القول بالكمال و النقص خطابي!
أقول: و ذكر بعضهم: أن قولهم - أي قول العلماء -: وجوب الوجود يستلزم التنزه عن سمات النقص ليس بضروري و لا بمبرهن! و يظهر من جملة منهم - في مبحث صدقه تعالى - أنّ امتناع النقص عليه تعالى من جهة الإجماع!
أقول: و أنت تعلم أنّ دعوى الإجماع التعبّدي في مثل المقام في غاية الضعف و نهاية الوهن، لكنّ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اَللّٰهُ لَهُ نُوراً فَمٰا لَهُ مِنْ نُورٍ(2).
ص: 70
لا يسع الممكن أن يدرك كنه ذات الواجب تعالى، فإنّ جميع قواه العقلية و الجسمية محدودة، و الواجب غير متناه. فلو أحاط الممكن به - و لو إجمالاً - لزم الخلف من أحد الجانبين.
و عن السجاد (ع)(1): «لبعده أن يكون في قوى المحدودين؛ لأنّه خلاف خلقه».
دليل اخر، و هو: أنّ حقيقته تعالى ليست بضروري التصور، فإن أمكن بمعرفتها فبالكسب و النظر، لكنّه في المقام غير ممكن، فإنّ الرسم لا يفيد عرفان حقيقة المعرف، مع أنّه لا عوارض للواجب. و الحد متفرع على تركب المحدود من الجنس و الفصل المنفيّين عن الواجب البسيط. نعم، يمكن أن يقال بعدم انحصار تحصيل المسائل النظرية بالتعريف، بل يمكن حصولها بإلهام الله تعالى روحيه لكنّ جريان ذلك في المقام محلّ نظر. فهذا الدليل، غير تامّ.
وجه آخر: إدراك الشيء ظهوره عند المدرك و تجلّيه عليه، و هو إمّا بالصفة، أو بالكينونة، و الثاني يستحيل في درك الأثر للمؤثر؛ لأنّ كينونة ذات الأثر رتبة صفة المؤثر، لا ذاته، فلا يصل إليها، بل منقطع دونها؛ لامتناع خروج الشيء عن مقام ذاته، فنفسه حجابه. ذكره بعضهم(2)، و فيه نظر.
و استدل بعض المتكلمين على نفي وقوع معرفته - دون إمكانها - بوجهين اخرين(3):
1 - إنّ المعلوم منه أعراض عامة كالوجود، أو سلوب، كالوجوب، أو إضافات. و لا شك أنّ العلم بها لا يوجب العلم بالحقيقة، بل يدل على أنّ ثمّة حقيقة متميزة في نفسها عن سائر الحقائق.
ص: 71
أقول: و هذا الادّعاء مستند إلى استقراء ناقص، ضرورة عدم إحاطة هذا المدّعي بجميع العارفين، و هذا واضح فلا اعتداد به.
2 - إنّ كل ما يعلم منه من كونه موجوداً عالماً قادراً... - إلى آخره - لا يمنع تصوره الشركة فيه؛ و لذلك يحتاج في نفيه عن الغير - و هو التوحيد - إلى الدليل، و ذاته المخصوصة يمنع تصورها من الشركة، فليس المعلوم ذاته.
و فيه أيضاً ما مرّ، مع أنّ لازمه أنّ من عرف وحدانيته و أقرّ بتوحيده فقد عرف ذاته؛ لعدم احتمال الشركة حينئذٍ، فافهم.
و قال المحقق اللاهجي في شوارقه(1): إنّ حقيقة الواجب إنّما يمتنع حصولها في العقل؛ لكونها عين حقيقة الوجود، و حقيقة الوجود الخارجي يمتنع حصولها في الذهن، و إلا لانقلب الذهن خارجاً. و هذا الامتناع ليس مختصاً بالواجب، بل كل ما هو فرد للوجود الخارجي سواء كان قائماً بذاته أو بماهيته يمتنع أن يحصل في الذهن، إلا أنّه لمّا كان الممكن حقيقته و ذاته غير وجوده و حقيقة الواجب عين وجوده اختص امتناع حصول الكنه الذي هو الذات و الحقيقة في العقل بالواجب دون ممكن، فلو كان للواجب ذات سوى الوجود لم يمتنع حصولها في العقل... إلى آخره. و قريب منه ما ذكره في «گوهر مراد»(2).
أقول: قد عرفت أنّ الواجب غير محدود، و الممكن محدود، و لا يعقل إحاطة المحدود بغير المحدود و إن كان ذا ماهية مغايرة للوجود، فما ذكره أخيراً غير تمام و لصاحب الأسفار كلام يناسب ذكره هنا، قال(3): أمّا أنّ حقيقة الواجب غير معلومة لأحد بالعلم الحصولي الصوري فهذا مما لا خلاف فيه لأحد من الحكماء و العرفاء، و قد أقيم عليه البرهان. كيف، و حقيقته ليست إلاّ نحو وجوده العينى الخاص به؟ و ليس الوجود الخاص للشيء متعدداً، فلا يمكن تحققه في الذهن، و إلا لزم الانقلاب، بخلاف الماهية فإنّها أمر مبهم لا يأبى تعدد أنحاء الوجود لها، و العلم بالشيء ليس إلا نحواً من أنحاء وجود ذلك الشيء للذات المجردة. و أمّا أنّ حقيقته غير معلومة لأحدٍ علماً اكتناهياً و إحاطياً عقلياً أو حسّياً فهذا أيضاً حقّ لا يعتريه شبهة؛ إذ ليس للقوى العقلية أو الحسّية التسلط عليه بالإحاطة و الاكتناه، فإنّ القاهرية و التسلط للعلة بالقياس إلى المعلول و المعلول إنّما هو شأن شؤون علته، و له حصول تام عندها، و ليس لها حصول تام عنده. و أمّا أنّ ذاته لا يكون مشهوداً لأحد من الممكنات أصلاً فليس كذلك، بل لكلّ منها أن
ص: 72
يلاحظ ذاته المقدسة عن الحصر و التقييد بالإمكنة و الجهات و الأحياز على قدر ما يمكن للمفاض عليه أن يلاحظ المفيض... إلى آخره.
أقول: حقيقة الواجب، هو وجوده الخارجي و لا يمكن حصوله في الذهن كما ذكره صاحب الأسفار و تلميذه اللاهيجي، و هذا برهان قطعي لي استحالة الاكتفاه به تعالى في حقّ الممكنات قاطبة.
و أكثر العقلاء يعرفون الله تعالى بتوسط مفاهيم كلية يحصل وحدته تعالى من انضمام بعضها إلى بعض كمفاهيم الحي العالم القادر الخالق الأزلي الأبدي الواجب الحكيم و...
هذا كل من ناحية القضاء العقلي، و اما من جهة البيان الشرعي فالكتاب ناطق بأنّه: لاٰ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً(1)وَ عَنَتِ اَلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ اَلْقَيُّومِ (2)، و بأنّه: مٰا قَدَرُوا اَللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ (3).
و السنّة متواترة به تواتراً معنوياً(4)، ففي بعض الروايات: «ما توهّمتم من شيء فتوهّموا الله غيره». و في بعضها: «كل ما وقع في الوهم فهو بخلافه».
و عن مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة و السلام(5): «و ممتنع عن الإدراك بما ابتدع من تصريف الذوات، و خارج بالكبرياء و العظمة من جميع تصرف الحالات، محرّم على بوارع ناقبات الفطن تحديده، و على عوامق ثاقبات الفكر تكييفه، و على غوائص سابحات النظر تصويره... ممتنع عن الأوهام أن تكتنهه، و عن الأفهام أن تستغرقة(6)، و عن الأذهان أن تمثله، قد يئست من استنباط الإحاطة به طوامح العقول، و نضبت عن الإشارة إليه بالاكتناه بحار العلوم، و رجعت بالصغر عن السموّ إلى وصف قدرته لطائف الخصوم، واحد لا من عدد، و دائم لا بأمد، و قائم لا بعمد.
و ليس بجنس فتعادله الأجناس، و لا بشبح فتضارعه الأشباح. و لا كالأشياء فتقع عليه الصفات، قد ضلّت العقول في أمواج تيار إدراكه، و تحيّرت الأوهام عن إحاطة ذكر أزليته، و حصرت الأفهام عن استشعار وصف قدرته، و غرقت الأذهان في لجج أفلاك ملكوته... «إلى
ص: 73
أخره». من جملات ذهبية نورانية أفيضت على روحه العظيمة و نفسه القدسية، و لمثل هذا الكلام قالوا ان نهج البلاغة أخ القرآن و هودليل على امامته العظمى.
المستفاد من الروايات الشريفة المشار إليها: أنّ علة احتجابه تعالى و عدم إدراكه وجوه:
1 - عدم كونه محدوداً و متناهياً. تضمنته عدة من الروايات.
2 - لا كيفية له حتى يعرف بها. كما ذكر، و تاليه في جملة من الروايات.
3 - لا شبه له حتى يقاس عليه. فإذا لم تكن له كيفية و شبه فلا معرّف له تعالى.
4 - كل ما في الخلق لا يوجد في خالقه، و كل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه، فافهم.
5 - إنّ الحجاب ليس إلا نفس الخلق. و كل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه، فافهم.
أقول: أمّا الثلاثة الاولى فقد مرّ منّا وجه الاستدلال بها، و أمّا الرابع فيمكن أن يكون راجعاً إليها، و يحتمل أن يكون تعليلاً نفسياً، و أنّ العقل يحكم بذلك.
و أمّا الأخير فيمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكره جمع من الفلاسفة من أنّ الحجاب قصور الإدراك.
قال المحقق السبزواري في أول شرح المنظومة: يا من هو اختفى لفرط نوره، أي لا حجاب مسدول و لا غطاء مضروب بينه و بين خلقه إلا شدة ظهوره، و قصور بصائرنا عن اكتناه نوره، إذ المحيط الحقيقي لا يصير محدوداً مستوراً، فالحجاب مرجعه أمر عدمي و هو قصور الادراك... إلى آخره. و إليه يؤول ما عن النبي الأكرم (ص): إنّ الحجاب نوره تعالى».
فتحصل أنّ إدراكه تعالى و عرفانه اكتناهاً غير ممكن. هذا و ولكن في رواية عبد الله الخراساني(1)، عن الرضا (ع): «إنّ الحجاب عن الخلق لكثرة ذنوبهم».
و في رواية الثمالي، قال: قلت لعليّ بن الحسين (عليهم السلام): لأي علة حجب الله عز و جل الخلق عن نفسه؟ قال: «لأنّ الله تبارك و تعالى بناهم بنية على الجهل، فلو أنّهم كانوا ينظرون إلى الله عز و جل لما كانوا بالذين يهابونه و لا يعظّمونه...(2) إلى آخره. بل عن الكافي، عن الصادق (ع): «إنّ الله لو شاء لعرّف عباده نفسه، و لكن جعلنا أبوابه و صراطه...» إلى آخره.
فيكون معرفته ممكنة. لكنّ الحديث الأخير غير مربوط بالمقام؛ إذ المراد بالمعرفة هو التصديق بوجوده و صفاته كما يفهم من ذيل الحديث المذكور، و أمّا الأوّلان فهما ضعيفان سنداً
ص: 74
فلا عبرة بهما. و في ذيل الرواية الأولى تصريح بعدم إدراكه تعالى و عرفانه، فلا بد أن يكون المراد بهذا الحجاب المعلل بكثرة الذنوب و عدم المهابة: عدم القرب المعنوي منه تعالى، لا عن معرفة ذاته و كنه حقيقته.
اعتصام الورى بمعرفتك *** عجز الواصفون عن صفتك
تب علينا فإنّنا بشر *** ما عرفناك حقّ معرفتك
و أمّا قول علي (ع): «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً» فهو على تقدير صدوره عنه (ع) محمول إمّا على أحوال الآخرة، أو سائر المغيبات سوى المعرفة، أو على بلوغه في معرفة الخالق إلى أقصى الدرجات الممكنة للعاقل المحدود، فافهم.
و أمّا ما في «طوالع الأنوار» و شرحها من ذهاب المتكلمين إلى جواز العلم بحقيقته تعالى، و هو الظاهر من المواقف، بل ذهاب كثير من المتكلمين نم الأشاعرة و المعتزلة إلى وقوعه(1)، فهو باطل، بل القول الثاني واضح الفساد. و غفلة عن الأحكام القطعية العقلية.
ص: 75
قال الرضا (ع) على ما في توحيد الصدوق(1): «إنّ الله تبارك و تعالى لا يسخر و لا يستهزئ و لا يمكر و لا يخادع، و لكنّه عز و جل يجازيهم السخرية و جزاء الاستهزاء و جزاء المكر و الخديعة، تعالى الله عمّاً الظالمون علوّاً كبيراً».
و قال (ع)(2) جواباً لمن سأله عن قوله تعالى: نَسُوا اَللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ (3)؟:
«إنّ الله تبارك و تعالى لا ينسى و لا يسهو، و إنّما ينسى و يسهو الخملوق المحدث، ألا تسمعه عز و جل يقول: وَ مٰا كٰانَ رَبُّكَ نَسِيًّا(4)؟، و إنّما يجازي من نسيه و نسي لقاء يومه بأن ينسيهم أنفسهم، كما قال عز و جل: وَ لاٰ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اَللّٰهَ فَأَنْسٰاهُمْ أَنْفُسَهُمْ (5)...» إلى آخره.
و قال مولانا أمير المؤمنين و سيّد الموحدين (ع)(6): «... هو، في الأشياء كلها غير متمازج بها، و لا بائن عنها، ظاهر لا بتأويل المباشرة، متجلّ لا باستهلال رؤية، بائن لا بمسافة، قريب لا بمداناة، لطيف لا بتجسّم، موجود لا بعد عدم، فاعل لا باضطرار، مقدّر لا بحركة، مريد لا بهمامة، سميع لا بآلة، بصير لا بأداة، لا تحويه الأماكن، و لا تصحبه الأوقات، و لا تحدّه الصفات، و لا تأخذه السنات، سبق الأوقات كونه، و العدم وجوده، و الابتداء أزله، بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له، و بتجهيزه الجواهر عرف أن لا جوهر له، و بمضادته بين الأشياء عرف أن لا قرين له».
إلى غير ذلك من الكلمات القيّمة الذهبية التي خرجت من معادن الحكمة و العصمة، و هي
ص: 76
أكثر من أن تحصى، و لعمري أنّ مثل هذه الجملات العالية الصادرة عن أمير المؤمنين و أولاده الطاهرين (عليهم السلام) لا تبقي للموحّد حاجة و منقصة في استكماله بالمعارف الحقّقه و الأسرار الإلهية، و المقامات الربانية من جهة.
و هي أكبر برهان للأفاضل المعتبرين على نبوة جدّهم خاتم المرسلين و إمامة أنفسهم صلوات الله عليهم أجمعين، فراجع و لا حظ أيّها الراكب على السفينة المنجية المحمدية، و اعلم أنّ تلك الجواهر من خصائص مذهبك، و لا حظ لغيرك منها، و ما ظلمهم الله و لكن كانوا أنفسهم يظلمون.
ص: 77
ص: 78
المقصد الرابع في توحيد
الضابطة الأولى: في نفي الشريك في الواجبية
الضابطة الثانية: في توحيد الصانع و المدبّر
الضابطة الثالثة: في انحصار العبادة له تعالى
الضابطة الرابعة: في نفي الضدّ و المثل و غيرهما عنه تعالى
الضابطة الخامسة: في أنّه تعالى بسيط لا جزء له
الضابطة السادسة: في نفي المعاني عنه تعالى
ص: 79
ص: 80
التوحيد: إمّا في مقابل التعدد و الشركة في الواجبية. و إمّا في مقابل التركب و الكثرة. و إمّا في مقابل الشركة في الصنع و الخلق، أو التدبير و الرزق، و أمّا في مقابل تعدّد المعبودين. و إمّا في مقابل زيادة صفاته و تعدد القدماء. و أمّا في مقابل الضدّ و المشل، ففي هذا المقصد ضوابط ستّ:
ص: 81
لم أجد في هذا المقام مخالفاً أصلاً(1) حتى من المجوس، فإنّ ذهابهم إلى أزلية بعض الأشياء غير ظاهر في وجوبه، بل الظاهر من بعضهم إمكانه، فيكون خلافهم في الضابطة الثانية، لا في هذه الضابطة. نعم، ذهب بعض أهل السنّة إلى تعدد الواجب الوجود، كما سيأتي نقله عن التفتازاني في الضابطة السادسة. و كيفما كان فقد استدل أهل المعقول من المتكلمين و الفلاسفة على وحدانية الواجب و امتناع التعدد بوجوه عديدة، و إليك ما وقفنا عليه في كتبهم:
الأول: أنّه لو تعدد الواجب و أراد أحدهم إيجاد شيء فهل يمكن للآخر إرادة إعدام ذلك الشيء أو إيجاد ضده، أو لا يمكن؟ الثاني يستلزم عجز الواجب الثاني، و الترجيح بلا مرجّح، و كلا الأمرين باطل. و الأول مستلزم لاجتماع الضدين أو النقيضين إن وقع مراد كليهما. أو عجز إلهين، و ارتفاع النقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما إن لم يقع مراد كليهما، أو عجز أحدهما و الترجيح بلا مرجح إن وقع مراد أحدهما دون الآخر. و بطلان الأقسام كلها دليل على بطلان المقدم، فيثبت نقيضه و هو وحدة الواجب.
أقول: و يرد عليه أولاً: أنّه أخصّ من المدّعى؛ إذ مفاده نفي الواجبين المختلفين في الإرادة، دون نفي الواجبين، كما هو المطلوب، فتأمل.
و ثانياً أنّا نختار الشقّ الثالث، و عدم وقوع مراد كليهما، و هذا لا يستلزم عجز الإلهين المفروضين؛ لأنّ القدرة و العجز إنّما يلاحظان بالنسبة إلى الأمور الممكنة دون الممتنعة، و حيث إنّ اجتماع النقيضين أو الضدين محال فلا يمكن أن يقع تحت إرادة القادر أبداً.
و بالجملة: المقام بعينه من قبيل إرادة الشيء مع فرض تحقق علة ضده أو نقيضه، و معلوم
ص: 82
أنّ إيجاد الشيء مع فرض ضده أو نقيضه غير ممكن، و خروجه عن دائرة القدرة لا يستلزم العجز و النقص في القادر الفاعل، كما في عرفت مباحث قدرته تعالى.
لا يقال: هب أنّه لا يستلزم عجز الإلهين، لكنه يستلزم ارتفاع النقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما. فإنّه يقال: المبرهن عليه أنّ علة عدم المعلول ليست شيئاً موجوداً خارجياً، بل هي عدم علة الوجود، فوجود المعلول مستند إلى وجود العلة و عدمه إلى عدمها.
و حينئذٍ نقول: لو أراد أحدهما وجود شيء و الآخر عدمه، يكون الشيء المذكور موجوداً لا لأجل غلبة الواجب الأول على الثاني حتّى نخرج به عن الفرض، بل لأنّ عدم إرادة أحدهما لوجود شيء لا ينافي إرادة الآخر لوجوده، ألا ترى أنّ اللازم الأعمّ يتحقق بوجود أحد ملزوماته و إن عدمت البقية. هذا في النقيضين، و أمّا في الضدين اللذين لا ثالث لهما فنقول: إنّه لا يوجد حينئذٍ - أي حين تزاحم إرادتي الواجبين - موضوع هذين الضدين، فينتفيان بانتفاء الموضوع و هذا النحو من الارتفاع جائز بلا شك.
و بالجملة: الجسم - مثلاً - لا يوجد إلا بحركة أو سكون على سبيل مانعة الجمع و الخلوّ، و حيث إنّ إرادتي الواجبين تعلقتا بوجودهما في الجسم المذكور في زمانٍ واحدٍ، و هو ممتنع فيمتنع موضوعهما و لا يوجد الجسم من أصله. فهذا الدليل المشهور المسمّى بدليل التمانع المعروف عن المتكلمين غير صحيح عندي.
الثاني: لو فرض التعدد لكان لمجموع الواجبين وجود غير الآحاد سواء كان ذلك الوجود عين مجموع الوجودين أو أمراً زائداً عليه، و كان هذا الوجود محتاجاً إلى وجود الأجزاء، و المحتاج إلى الغير ممكن محتاج إلى المؤثر في الشيء يجب أن يكون مؤثراً في كل واحد من أجزائه، و إلا لم يكن مؤثراً في ذلك الشي،، و قد ادّعوا الضرورة فيه، و لا يمكن التأثير فيما نحن فيه في شيء من الأجزاء؛ لكون من الجزءين واجباً.
فالشريك يستلزم التأثير فيما لا يمكن التأثير فيه، أو إمكان ما فرض وجوبه.
أقول: و ضعفه ظاهر، ضرورة أنّ الوجود المجموعي الزائد ليس إلا مفهوم الوجود الانتزاعي، و إن أريد به نفس الوجودين فالاحتياج غير معقول أصلاً.
و بالجملة: لا وجود متأصل هناك غير وجود كل فرد.
الثالث: لو تعدد الواجب: فإمّا أن يكون بينهما تلازم في الوجود، أولا، و على الأول تلزم معلوليتهما أو معلولية أحدهما كما هو شأن التلازم. و على الثاني يلزم جواز تحقق أحدهما مع عدم الآخر، فيلزم إمكان عدم الواجب الآخر.
أقول: و بطلانه واضح؛ لأنّه خلط بين الإمكان الذاتي و الإمكان القياسي، و المنافي
ص: 83
للوجوب هو الأول، و اللازم من الاستدلال هو الثاني، و لا شك أنّ الواجب ممكن - بالإمكان القياسي - بالنسبة إلى الواجب الآخر، و هذا لا ينافي وجوبه الذاتي.
الرابع: لو فرض التعدد لا يخلو: إمّا أن تكون قدرة كل واحد منهما و إرادته كافيتين في وجود العالم، أو لا شيء منهما كافٍ، أو تكون قدرة أحدهما فقط و إرادته كافيتين. و على الأول يلزم اجتماع المؤثرين التامّين على معلول واحد. و على الثاني يلزم عجزهما؛ لأنّهما لا يمكن لهما التأثير إلا باشتراك الآخر. و على الثالث لا يكون الآخر خالقاً فلا يكون إلهاً. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟
أقول: لو تمّ هذا، لدل على توحيد الصانع دون الواجب فإنّه عندنا مختار، فيمكن أن يكون الواجب موجوداً و ليس بخالق. مع أنّ الحجة ضعيفة، فإنّا نقول: إنّ كلا الواجبين قادر على خلق العالم. و إرادة كلّ منهما كافية لوجوده، لكنّ اجتماع العلتين المستقلتين على المعلول الشخصي حيث يكون ممتنعاً كان وجود الأشياء مستنداً إلى إرادة كليهما على نحن تكون إرادة كل منهما جزء العلة، لا تمامها، كما إذا حمل الاثنان حجراً يمكن لكل منهما بانفراده حمله، فإنّ قوتهما علة تامة لحمله في صورة الاجتماع، أو على نحو التبعيض بأن يكون بعض المنظومات الشمسية معلولاً لأحدهما و بعضها الآخر للآخر.
الخامس: أنّ التفرد بالصنع كمال فوق كل كمال، و سلب الكمال عن ذات الواجب محال، فلا يكون له شريك.
أقول: نطالبه بدليل استحالة مثل سلب هذا النحو من الكمال من الواجب.
السادس: أنّه تعالى غني بوجوب ذاته عمّا سواه، فيكون غنياً عن الشريك.
أقول: هذا الوجه يدل على بطلان اتخاذه شريكاً له في أفعاله للاحتياج إليه، و هو ليس بمحلّ الكلام، فإنّ المدّعى هو نفي وجود الواجب الثاني بالذات، بل نفي إمكانه، و بون بعيد بين الأمرين.
السابع: أنّ الشركة نقص؛ إذ التصرف الكامل لا يجوز لأحد الشريكين، فيكون كل منهما ناقصاً.
أقول: إن أريد بالجواز هو الجواز التشريعي فمن البيّن أنّه لا حاكم عليهما، و إن أريد الإمكان العقلي فقد مرّ جوابه في إبطال الحجة الأولى.
الثامن: أنّ كلاً منهما إن لم يقدر على إقامة النظام كانا عاجزين عن الإلوهية، غير لائقين بها، و إن قدر كلّ منهما عليها كان الآخر عبثاً، و إن كان أحدهما قادراً دون الآخر فهو الإله.
ص: 84
أقول: و هذا بيان عجيب، فإنّ الواجب ليس من صنع صانع حتى يتصور العبثية في الصنع المذكور.
التاسع: أنّ الكثرة إن كانت نوعية فبالماهيات، و إن كانت عددية: فإن كانت في الجواهر فبالمادة و لواحقها، و إن كانت في الأعراض فبالموضوعات، و الواجب حيث لا ماهية له و لا مادة، و لا موضوع له فهو واحد لا يمكن تكثّره.
أقول: المعقول العرضية لا مادة و لا موضوع لها و لا ماهية لها عند المستدل، تبعاً للسهروردي الإشراقي، مع أنّها متعددة.
و بالجملة: انحصار أسباب التكثّر في الثلاثة المذكورة غير بيّن و لا مبيّن، فافهم.
العاشر: الوجود الواجبي: إمّا أن يقتضي الكثرة في نفسه، و إمّا الوحدة كذلك، أو لا يقتضي شيئاً منهما، فعلى الأول يلزم انتفاء الواجب رأساً، فإنّ الكثرة لا تحصل إلا بالوحدة؛ إذ الوحدة مبدأ الكثرة، و هذا الواحد حيث إنّه على طباع الكثير فهو أيضاً كثير، و هكذا كل ما نفرضه واحداً فهو كثير، فلا يتحقق الواحد، فلا يتحقق الكثير، و هذا خلف. و على الثاني ثبت المطلوب. و على الثالث كان كل من الوحدة و الكثرة عرضياً له فيكون معلّلاً في وحدته بالغير، و يلزمه جواز ارتفاع الواجب بالذات، و هو كما ترى.
و يمكن أن يورد عليه: بأنّ الكثرة إنّما تنافي الوحدة إذا أخذت بشرط لا، و أمّا إذا أخذت بشرط الشيء فهي عين الكثرة، و عليه فإذا اختير الشق الأول لا دافع له. لكنّ الحقّ أنّ الواحد حيث إنّه فرد من تلك الحقيقة المقتضية للكثرة، و لا سيما أنّ الواجب تشخّصه بنفس حقيقته يتكثر و هكذا فلا يوجد فرد أصلاً.
نعم، تتوقف صحته على أصالة الوجود و وحدته، و إلا لاتّجه عليه إشكال ابن كمّونة الآتي.
الحادي عشر: برهان الإحاطة، و هو: أنّ الواجب محيط بكل شيء، خارجياً كان أو ذهنياً، فلو فرض في الوجود واجبان للزم وجود المحيطين المطلقين، و هو غير معقول.
أقول: إن أريد بالإحاطة: القدرة الكاملة فنمنع الملازمة؛ إذ الواجب قادر على كل ممكن، لا على كل موجود، كما مرّ بحثه في الجزء الأول. و إن أريد بها العلم فبطلان التالي غير واضح، إذ لا مانع من تعلق علم الواجب بواجب آخر كتعلق علمه بنفسه، و هذا واضح. و إن أريد بها قاعدة «أنّ بسيط الحقيقة كل الأشياء» فقد مرّ إبطالها، مع أنّ المستدل من المصرّين على أصالة الماهية و ماوراء ذلك لا نعقل للإحاطة معنى صحيحاً.
الثاني عشر: إنّ تعدد الواجب فكل شيء إن أوجداه مستقلين لزم توارد المعلتين المستقلتين على معلول واحد. و إن أوجده أحدهما دون الآخر فهو ترجيح بلا مرجح؛ لتساوي الجميع إلى
ص: 85
الواجبين من جميع الجهات، و كذا تساويهما إليه، فلا معنى لاختصاص أحدهما بالإيجاد دون الآخر. و إن أوجداه معاً لا على سبيل الاستقلالية بأن تكون إرادة كل منهما جزءاً للعلة، ففيه: أنّ إرادة كل منهما كانت علة تامة مستقلة للفعل في صورة الانفراد، فتحوّلها إلى الجزئية في فرض الاجتماع انقلاب العلة التامة إلى الناقصة بلا تنقيص، و هو محال.
و فيه أولاً: منع الترجيح بلا مرجح؛ لأنّ الواجب مختار له أن يفعل، و له أن لا يفعل.
و ثانياً: أنّ انقلاب العلة التامة إلى الناقصة غير ممتنع، بل هو واقع محسوس، كما أشرنا إليه في ردّ الدليل الرابع.
الثالث عشر: التعدد لو كان منافياً للوجوب فهو، و إلا يلزم وجود ما لا يتناهى من الواجب؛ لأنّ ما أمكن من الواجب فهو ثابت.
أقول: بطلان التالي غير مسلّم، بل هو عين الدعوى، فالبيان مصادرة.
الرابع عشر: لو تعدد الواجب: فإن قدر كل منهما على الآخر فليسا بواجبين؛ لأنّ كل مقدور ممكن. و إن لم يقدر كل منهما على الآخر فكذلك؛ لأنّ كل عاجز ممكن. و إن قدر أحدهما على الآخر دون العكس فهو الواجب وحده.
أقول: و بطلانه واضح؛ لأنّ عدم القدرة على غير الممكن ليس من العجز في شيء، كما مرّ في بحث قدرته تعالى، و لذا لا يكون الواجب قادراً على نفسه، خلافاً لبعض البسطاء النواصب.
الخامس عشر: لو كان في الوجود واجب آخر لبانت آثاره و ظهرت آياته.
أقول: و هذا الدليل موقوف على إحراز استناد الكائنات إلى إرادة الواجب الأول، و هو أول الكلام في المقام. نعم، نقل عن مولانا أمير المؤمنين أنه قال لابنه الحسن المجتبى صلوات الله عليهما و آلهما(1): «و اعلم أنّه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، و لرأيت آثار ملكه و سلطانه، و لعرفت صفته و فعاله، و لكنّه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضاده في ذلك أحد و لا يحاجه، و أنّه خالق كل شيء» انتهى.
أقول: هذا الاستدلال لمثلهما متين، لعلمهما الكثير، فيريان استناد الأشياء إلى الواحد القيوم. و أمّا لنا فلا؛ إذ من المحتمل أن يكون للواجب الثاني رسل و آثار في بقية المنظومات الشمسية و الكرات السامية.
السادس عشر: التعدد يستلزم نفي الممكن الموجود رأساً؛ للتدافع الحاصل بين الواجبين في التأثير، فإنّ كلاً منهما يمنع الآخر عن الفاعلية حتى يكون هو المؤثر التام.
ص: 86
و ضعفه ظاهر، ضرورة عدم التدافع بين العالمين بالواقعيات، الحكيمين في إبداع الموجودات. و يمكن إرجاع هذا التلفيق إلى الحجة الأولى، و لكن قد عرفت أنّها أيضاً غير صحيحة.
السابع عشر: الاحتياط يقتضي نفي الشريك؛ إذ لا ضرر من قبل الواجب المجهول، و إلا للزم العقاب بلا بيان. و أمّا من قبل الواجب المعلوم فالعقاب مقطوع، و لا أقلّ من احتماله؛ إذ الشركة نقص في كبريائه.
أقول: و هذا تلفيق غريب؛ فإنّ الاحتياط راجع إلى البناء القلبي جوازاً و حرمة، و لا نظارة له إلى نفي الشريك واقعاً كما هو المقصود.
الثامن عشر: لا يمكن تعدد الواجب، و إلا فالتعيّن الذي به الامتياز إن كان نفس الماهية الواجبة أو معلّلاً بها أو بلازمها فلا تعدد، و إن كان معلّلاً بأمر منفصل فلا وجوب بالذات؛ لامتناع احتياج الواجب في تعيّنه إلى أمر منفصل؛ لأن الاحتياج في التعيّن يقتضي الاحتياج في الوجود؛ إذ الشيء ما لم يتعيّن لم يوجد.
أقول: إتمام الشقّ الأول من هذا الدليل موقوف على إبطال شبهة ابن كمّونة الآتية، و إلا فجوابه واضح كما لا يخفى.
التاسع عشر: لو كان الواجب أكثر من واحد لكان لكلّ منهما تعيّن ضرورة، و حينئذٍ: إمّا أن يكون بين الوجوب و التعيّن لزوم، أو لا؟ فإين لم يكن بل جاز انفكاكهما لزم جواز الوجوب بدون التعيّن، و هو محال؛ لأنّ كل موجود متعيّن، أو جواز التعين بدون الوجوب، و هو ينافي كون الوجوب ذاتياً، بل يستلزم كون الواجب ممكناً، حيث تعيّن بلا وجوب. و إن كان بين الوجوب و التعين لزوم: فإن كان الوجوب بالتعيّن لزم تقدم الوجوب أو كلاهما بالذات لزم خلاف المفروض و هو تعدد الواجب؛ لأنّ تعيّن المعلول لازم غير متخلف فلا يوجد الواجب بدونه. و إن كان التعيّن و الوجوب لأمر منفصل لم يكن الواجب واجباً بالذات؛ لاستحالة احتياجه في الوجوب و التعيّن إلى أمر منفصل، و هو ظاهر.
أقول: إذا اختير كون التعيّن بالوجوب أو أنّ كليهما بالذات لا دافع عنه. و أمّا قوله: «لزم خلاف المفروض» فهو ممنوع؛ لاحتمال أنّ لكلّ واجب حقيقة متبائنة مع حقيقية الاخر، كما سيأتي في شبهة ابن كمّونة.
العشرون: لو فرض إلهان: فإمّا أن يصح عليهما التخالف، أو لا، و الأول محال؛ لكونه مستلزماً للعجز، على ما مرّ في برهان التمانع. و كذا الثاني؛ للزوم أن لا يقدر شيء منهما على ما
ص: 87
يخالف الآخر فيلزم عجزهما.
أقول: هذا راجع إلى برهان التمانع فلا يحسن ذكره في قباله، و جوابه أيضاً يعلم ممّا تقدم.
الواحد و العشرون: لو فرض إلهان لا بد من امتياز كلّ منهما عن الآخر، و ما به الامتياز إن كان معتبراً في الإلهية لم يكن الخالي عنه إلهاً. و إن لم يكن بمعتبر فيها لم يكن الاتصاف به واجباً، فيفتقر إلى المخصّص، فالموصوف به محتاج فلا يكون بإله.
أقول: و يرد عليه: أنّ امتياز كلّ منهما محصّل للإلهية.
و بالجملة: خصوصية كلّ منهما توجب الإلهية بلا حصر و اختصاص، فالبرهان غير تام.
الثاني و العشرون: لو فرض إلهان لكانا ممتازين، و ما به الامتياز إن كان صفة كمال فالخالي عنها ناقص. و إن لم يكن صفة كمال فالموصوف به لا يكون كاملاً، بل ناقص، و الناقص لا يكون إلها.
أقول: ما به الامتياز في كلّ منهما يكون كمالاً، ففقدانه كمال الآخر لا يستوجب نقصانه، فكلّ منهما فاقد لكمال الآخر و لكنه ليس بناقص.
و دعوى استحالة مثل هذا الفقدان على الواجب محتاجة إلى إقامة دليل، فتدبّر.
الثالث و العشرون: لو تعدد الواجب بالذات لا يكون بينهما علاقة لزومية، فإنّ الملازمة بين الشيئين لا تنفكّ عن معلولية أحدهما للآخر أو معلولية كلّ منهما لأمر ثالث، و هي خرق فرض الواجبية لهما، فإذن لكلّ منهما مرتبة من الكمال و حظّ من الوجود و التحصل لا يكون هو للآخر، و لا منبعثاً عنه و مترشّحاً من لدنه، فيكون كل واحد منهما عادماً لنشأة كمالية، و فاقداً لمرتبة وجودية، سواء كانت ممتنعة الحصول له، أو ممكنة. فذات كل منهما ليست محض حيثية الفعلية و الوجوب و الكمال، بل يكون ذاته بذاته مصداقاً لحصول شيء و فقد شيء آخر من طبيعة الوجود و مراتبه الكمالية، فلا يكون واحداً حقيقياً. و التركيب بحسب الذات و الحقيقة ينافي الوجوب الذاتي، فالواجب الوجود يجب أن يكون من فرط التحصل، و كمال الوجود جامعاً لجميع النشات الوجودية... إلى آخره.
و ادّعى هذا المستدل أنّ هذا البرهان مختص به و لم يذكر أحد قبله، و لكنه موقوف على أنّ بسيط الحقيقة كل الأشياء، كما هو ظاهر، و حيث إنّا هدمنا أساس تلك القاعدة و أبطلنا أصولها فيما مضى، و لذا لم نلتزم أيضاً بأنّ الواجب واجب من جميع جهاته كما مرّ في الجزء الأول، فلا محالة يسقط هذا البرهان.
الرابع و العشرون: لو فرضنا موجودين واجبي الوجود لكانا مشتركين في هذا المفهوم و متغايرين بحسب ذاتيهما بأمر من الأمور، و ما به الامتياز: إمّا دن يكون تمام الحقيقة في كلّ
ص: 88
منهما، فيكون وجوب الوجود المشترك بينهما خارجاً عن حقيقة أحدهما، و هو مستحيل؛ لما مرّ من أنّ وجوب الوجود نفس حقيقة الواجب. و إمّا أن يكون جزء حقيقته، فيلزم التركيب فيه، و التركيب يستلزم الاحتياج إلى الأجزاء، و كل محتاج ممكن و إمّا أن يكون خارجاً عن الحقيقة، فيلزم أن يكون الواجب في تعيّنه محتاجاً إلى غيره؛ لان تعيّن الشيء إذا كان زائداً على حقيقته عرضيا لها يلزم أن يكون معلّلاً؛ لأنّ كل ما هو عرضي لشيء فهو معلّل إمّا بذلك الشيء و هو ممتنع؛ لأنّ العلة بتعينها سابقة على المعلول و تعينه، فيلزم تقدم الشيء على نفسه. و إمّا بغير ذلك الشيء فيكون محتاجاً إليه في وجوده، كما في تعينه؛ إذ التعيّن للشيء إما عين وجوده، أو في مرتبة وجوده، و الاحتياج في الوجود ينافي وجوب الوجود لذاته.
أقول: و عليه إشكال مشهور، و قد سمّاه بعضم بافتخار الشياطين، بل نقل عن بعض المحققين أنّه قال: لو أدركت ولي العصر - عجّل الله فرجه - ما طلبت منه معجزة سوى حلّ هذا الإشكال! و هو شبهة ابن كمّونة، من أنّه «لم لا يجوز أن يكون هناك هويتان بسيطتان مجهولنا الكنه، مختلفتان بتمام الحقيقة فيكون كل منهما واجب الوجود بذاته، و يكون مفهوم واجب الوجود منتزعاً منهما مقولاً عليهما قولاً عرضياً، فيكون الاشتراك بينهما في هذا المعنى العرضي المنتزع عن نفس ذات كل منهما، و الافتراق بصرف حقيقة كل منهما».
قال صاحب الأسفار في إلهيّاتها: و الشبهة مما أوردها هو - أي صاحب الإشراق - أوّلاً في المطارحات تصريحاً و في التلويحات تلميحاً، ثم ذكرها ابن كمّونة، و هو من شرّاح كلامه في بعض مصنفاته، و اشتهرت باسمه، و لإصراره على اعتبارية الوجود، و أنّه لا عين له في الخارج تبعاً لهذا الشيخ الإشراقي، قال في بعض كتبه: إنّ البراهين التي ذكروها إنّما تدل على امتناع تعدد الواجب مع اتحاد الماهية، و أمّا إذا اختلف فلا بد من برهان آخر و لم أظفر به إلى الآن، لكنّ القائلين بأصالة الوجود - و في طليعتهم صاحب الأسفار - أجابوا عن الشبهة المذكورة: بأنّ مفهوم الوجود و إن كان منتزعاً من الماهية بسبب عارض لكنّه منتزع من كل وجود خاص حقيقي بحسب ذاته بذاته، فإذن نسبته إلى الوجودات الخاصة نسبة المعاني المصدرية الذاتية إلى الماهيات، كالإنسانية من الإنسان و الحيوانية من الحيوان، حيث ثبت أنّ اشتراكها معنى تابع لاشتراك ما تنتزع هي منه، و كذلك تعددها فيه تابع لتعدد ما ينتزع منه، فإنّ الإنسانية - مثلاً - مفهوم واحد ينتزع من ذات كل إنسان، و لا يمكن انتزاعها من ماهية فرس أو بقر أو غير ذلك. فاتحادها في المعنى مستلزم لاتحاد جميع ما صدقت هي عليها بحسب ذاتها معنى، سواء كان ذلك المعنى جنساً أو نوعاً. فإذن لو كان في الوجود واجبان لذاتيهما كان الوجود الانتزاعي مشتركاً بينهما، كما هو مسلّم عند الخصم، و كان ما بإزائه من الوجود الحقيقي الذي هو مبدأ
ص: 89
انتزاع الموجودية المصدرية مشتركاً أيضاً بوجه ما، فلا بد من امتياز أحدهما عن الآخر بحسب أصل الذات؛ إذ جهة الاتفاق بين الشيئين إذا كانت ذاتية لا بد و أن تكون جهة الامتياز و التعين أيضاً ذاتية، فلم تكن ذات كلّ منهما بسيطة، و التركيب ينافي الوجوب.
أقول: فالشبهة بناءً على أصالة الوجود و وحدته و أن اختلفت مراتبه مندفعة, و أما بناءً أصالة الماهية أو تباين الوجودات الأصيلة - كما عليه طائفة من المشّائين - فهي غير واضح.
و اعلم أنّا سنبرهن - ببراهين شديدة القوة - أنّ صفاته الكمالية عين ذاته عين ذاته تعالى, و هذه العينية لا تعقل إلّا بناءً على أنّ الواجب الوجود وجود بحت؛ إذ الماهية مثار الكثرة و المغايرة, فهذا دليل قطعي على أصالة الوجود في الواجب و إن قلنا بأصالة الماهية في الممكن. هذا من جهة.
و من جهة ثانية: أنّ ما ذهب إليه بعض المشّائين من تباين الوجودات يقيني البطلان, فيظهر من ذلك ما هو الأساس لإبطال الشبهة المذكورة من أصالة الوجود و وحدته مفهوماً و إن اختلفت مراتبه كما عليه البهلويون. و على ضوء ذلك تتمّ هذه الحجة و الحجة التاسعة عشرة و الحجة الثامنة عشرة, و إذا انضمّ إليها الحجة الخامسة و العشرون تكون أدلة التوحيد القويمة أربع.
الخامس و العشرون: النقل كتابا و سنّةً, بل توحيده تعالى من أوضح الضروريات الإسلامية و أبده البديهيات الدينية. و ظاهر أن حجّية الشرع لا تتوقف عليه, و إنّما تتوقف على وجوده و علمه و قدرته و حكمته, فإذا عرفنا الله بهذه الصفات بدلالة العقل ثم أخبرنا الله بتوحيده يحصل القطع بصدقه, و هذا ظاهر.
لا يقال: الواجب إن أمكن تكثّره فقد وجب لقاعدة الملازمة, و إلّا فهو مستحيل عقلاً, فأين مورد التعبد. فإنّه يقال: هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت و قضاء العقل, فإنّه إن أدرك إمكانه يقطع بوقوعه, و إن أدرك عدم إمكانه يحكم باستحالته. و أمّا إذا شك في إمكان التكثر المذكور و عدمه و لم يهتدِ إلى أحد الطرفين فينفعه إخبار الشارع المحيط بالمواقع المعصوم عن الخطأ و الكذب. ثم إنّ إخبار الشارع و إن كان ناظراً إلى نفي الوقوع - فتدبر - لكنه ينفي إمكان الشريك قهراً؛ لانتفاء الإمكان الخاص في حق الواجب, كما ذكرنا في الجزء الأول.
السادس و العشرون: تعدّد الواجب الوجود مستلزم لمحدودية كلّ منها أو عنهم فيكون الواجبان أو الواجبون ذو و ماهيته, فإن الحدّ هو الماهية.
فلا يكون أحدهما بوالجب فإن واجب الوجود غير محدود و لا بمتناه و هذا البرهان الأخضر لا يتوقّف على سوى استحالة الحدّ على الوجود المطلق.
ص: 90
الوحدة في الوجوب في الصنع, و أنّه لا صانع غير الواجب القديم, فإنّه لو تعدد لكان الصانع الثاني ممكناً, و الممكن محتاج في وجوده إلى الواجب حدوثاً و بقاءً فضلاً عن احتياجه إليه في أفعاله. فأنّى له الاستبداد و الاستقلال في صنعه و إيجاده؟ فكل صانع مصنوع له تعالى في وجوده مستفيض عنه في أفعاله. قُلْ مَنْ رَبُّ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ قُلِ اَللّٰهُ قُلْ أَ فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيٰاءَ لاٰ يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَ لاٰ ضَرًّا(1) قُلْ هَلْ يَسْتَوِي اَلْأَعْمىٰ وَ اَلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي اَلظُّلُمٰاتُ وَ اَلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكٰاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشٰابَهَ اَلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ (2), قُلِ اَللّٰهُ خٰالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ هُوَ اَلْوٰاحِدُ اَلْقَهّٰارُ(3).
و إمّا إذا أعمضنا النظر عن التوحيد الوجوبي, فهل لنا سبيل إلى إثبات وحدة الصانع, أم لا؟ ذهب الفلاسفة إلى الأول, و دليلهم عليه يلتئم من أمور:
1 - إنّ شكل العالم الطبيعي كروي.
2 - انحصار العالم في هذا العالم. و مراده من العالم, الكرّة الأرضية!!(4)
3 - امتناع الخلأ.
4 - العالم موجود شخصي لا بمجرد الاتصال و الاجتماع, كوحدة الدار - مثلاً - الحاصلة من اجتماع اللِبن و الطين و غيرهما, بل له وحدة طبيعية كما تدل عليها وجوه ثلاثة:
الأول: أنّ العقل و النفس الكلّيين يوجبان وحدة العالم, فهو إنسان كبير, كما يوجب العقل و النفس الجزئيين وحدة الإنسان الصغير. و للعرفاء كلمات عجيبة حول تطبيق أجزاء العالم
ص: 91
على أجزاء الانسان.
الثاني: أنّ الوجود في الكل عين الهوية و الوحدة الحقّة الظلّية, و لا سيما بالنظر إلى وجهه إلى الواجب الوجود فإنّه ظلّ له و ظلّ الواحد واحد.
الثالث: ارتباط أجزاء العالم بعضها ببعض و تلازمها, و هو يستلزم الانتهاء إلى علة واحدة. فكل جسم و جسماني ينتهي وجوده إلى تلك العلة.
فإنّ العقول و النفوس التي أثبتوها هي إمّا علل متوسطة لهذه الأجسام, أو صور مدبرة لها متصرفة فيها. و ثبوت مجردات لا تكون عللاً و لا مدبرات لهذا العالم غير معلوم, بل هي غير موجودة, فالكل منتهٍ إلى القيوم الواحد.
5 - استحالة اجتماع العلتين المستقلين على معلول واحد. فاذا تمهّدت هذه الأمور نقول:
لو فرض عالم آخر وراء عالمنا لكان كروياً، بحكم المقدمة الأولى، و الكرتان إذا لم تكن إحداهما محيطة بالأخرى لزم الخلأ فيما بينهما؛ لأنّ تماس الكرتين بالنقطة و الخلأ محال، بحكم المقدمة الثالثة. و عليه فقد تمّت المقدمة الثانية، و أمّا المقدمة الرابعة و الخامسة فهما مبينتان، بل الخامسة مسلّمة عند العقلاء، و يثبت من جميع ذلك وحدة الصانع جلّ جلاله.
أقول: المقدمات - سوى خامستها - بأسرها ممنوعة باطلة، و لا سيما الرابعة فإنّها سخيفة جداً، فهذه التلفيقات المبنىّ أكثرها على الهيئة البائدة قد اتضح فسادها في هذه الأعصار، فلا نشتغل بتفاصيلها و نقدها و نقضها.
نعم، في صحيحة هشام بن الحكم(1)، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما الدليل على أنّ الله واحد؟ قال: «اتصال التدبير، و تمام الصنع كما قال عزّ و جلّ: لَوْ كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اَللّٰهُ لَفَسَدَتٰا(2).
و هي غير ناظرة إلى الوجه المتقدم كما هو ظاهر، و أمّا سبكها في قالب البرهان فهو لم يتيسّر لي. و فوق كلّ ذي علم عليم.
فامتحصّل: أنّ تعدد الصانع المستقل غير معقول من جهة وحدة الواجب؛ لأنّ كل ممكن فهو مستند إليه. و أمّا بعنوانه فلا دليل على وحدة الصانع. و منه يظهر بطلان قول المجوس و أشباههم بتعدد الخالق.
و أمّا الصانع غير المستقل فقد نفاه المجبّرة - أتباع جهم بن صفوان، و مقلّدوا إسماعيل الأشعري، و قالوا: لا مؤثر في الوجود إلاّ الله.
ص: 92
و هذه هي المسألة المعروفة ب - «مسألة الجبر و التفويض و الأمر بين الأمرين»، و مسألة عموم إرادة الله تعالى، و بعض مسألة التوحيد الفعلي. و هي مسألة معضلة قد زلّت أقدام كثير من الأقوام، و سنتعرض لها في المقصد الخامس إن شاء الله من هذا الكتاب.
و ملخّص كلامنا هنا: أنّه لا حول و لا قوة إلا بالله العظيم، و أنّ الله خالق كل شيء، و أنّه ما يشاؤون إلا أن يشاء الله، و لكن مع ذلك الكفر و الفسوق و القبائح من سوء أفعال الناس. فسبحان من تنزّه عن القبيح و الفحشاء، و لا يدخل في ملكه إلا ما يشاء، و هذا هو الأمر بين الأمرين الذي لم تصل إليه أفهام أكثر الناس، و بيّنه آل محمدٍ (ص) لشيعتهم بياناً شافياً، و هو أوسع مما بين الأرض و السماء، و هو المنزلة بين المنزلتين، و هو اللطف من ربك، و هو سرّ الله، و هو ما وصل إلى الأئمة(1). فلا إلى الجبر الشنيع، و لا إلى التفويض الفضيح، أيّها المسلم العاقل، بل إلى ما يقول به كتاب الله و عترة رسوله (عليهم السلام)، فإنّهم السفينة من تيّار الجهالة و الضلالة.
و ستجد مطلوبك - إن كنت طالباً للحق - منّا فيما بعد إن شاء الله، و ستتيقن أنّ المعتقد بعموم قوله تعالى: قُلِ اَللّٰهُ خٰالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ (2) ليس إلا الامامية! فلا تعجب، و اصبر فإنّ الصبر مفتاح الفرج.
و أعلم كما صانع العالم و خالق الكون و أحد لا شريك له في الإيجاد و الإبداع و التكوين و الخلق، كذلك هوالمدبّر و المتصرّف في الكون، و لا مدبّر و لا مربّي و لا محوّل إلا الله تعالى و أن الملائكة المدبّرات يعملون بأمره و إذنه و قوته تعالى، فإنّه لا حول و لا قوّة إلا بالله تعالى.
فالإرادة المؤثرة في الابتداء و الاستدامة هو إرادة الله النافذة المدبّرة. سبحانه و تعالى عمّا يشركون.
ص: 93
بعد ما ثبت التوحيد الذاتي و الفاعلي فقد ظهر أنّه لا مستحق للعبادة إلا الله الواحد القهار، و بيان ذلك يتمّ في ضمن فوائد:
الفائدة الأولى: العبادة بمعنى الخضوع و التذلّل و الطاعة، و يراد منها في عرف المتشرعة هذا المعنى بعينه، لكن بنحو التألّه. فالعبادة هي الخضوع محفوفاً ببناء القلب بجعله شعاراً و تديناً.
و حاصل مقصودنا في هذا المقام: أنّه لا يستحق أحد أن يتألّه له إلا الواجب الخالق قُلْ إِنَّمٰا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اَللّٰهَ وَ لاٰ أُشْرِكَ بِهِ (1).
نعم، مطلق الخضوع و إن لم يكن عن تألّه لا يخص الله سبحانه، لعدم دليل عليه من العقل و الشرع، بل يجوز لغير الله تعالى أيضاً، كما تقتضيه الفطرة الإنسانية في أخلاقه الاجتماعية و نظمه المدنية، بحيث لو لاه لاختلّت السلاسل الأدبية، فكيف يأمر الله تعالى بإهماله و هو مدبّر النظام؟! بل هو سبحانه أكّد هذه السيرة العقلائية بقوله مخاطباً لنبيه: وَ اِخْفِضْ جَنٰاحَكَ، لِمَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ (2). لكنه إذا لم يستلزم الخضوع للغير و طاعته نقصاً في الغاية الخلقية، و إلا يحرم بتاتاً؛ لأنّ الغاية المذكورة فوق الغايات و غاية النهايات. قال الله سبحانه: وَ لاٰ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً(3). حتى و إن كان هذا الغير رباً صغيراً كالأبوين وَ إِنْ جٰاهَدٰاكَ عَلىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاٰ تُطِعْهُمٰا(4). و من هذا القبيل: السجود لغير الله تعالى و لو على غير نحو التألّه، لقوله تعالى: لاٰ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لاٰ لِلْقَمَرِ وَ اُسْجُدُوا لِلّٰهِ اَلَّذِي
ص: 94
خَلَقَهُنَّ (1)، و قد أجمع المسلمون عليه أيضاً(2).
و على الجملة: أنّ الخضوع على أنحاء:
فمنها: الخضوع بنحو التديّن و التألّه، و هذا النحو مختصّ بالله سبحانه، و لا يجوز إشراك أحد غيره فيه، و من أشرك فيه غيره - و لو كان هذا الغير رسولاً كريماً - كان خارجاً عن الإسلام و داخلاً في زمرة المشركين.
قال الله تعالى: قُلْ يٰا أَهْلَ اَلْكِتٰابِ تَعٰالَوْا إِلىٰ كَلِمَةٍ سَوٰاءٍ بَيْنَنٰا وَ بَيْنَكُمْ أَلاّٰ نَعْبُدَ إِلاَّ اَللّٰهَ وَ لاٰ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لاٰ يَتَّخِذَ بَعْضُنٰا بَعْضاً أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اَللّٰهِ (3)، و قال تعالى: وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ (4)، و قال تعالى: إِنَّكُمْ وَ مٰا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهٰا وٰارِدُونَ لَوْ كٰانَ هٰؤُلاٰءِ آلِهَةً مٰا وَرَدُوهٰا وَ كُلٌّ فِيهٰا خٰالِدُونَ (5).
و منها: الخضوع بنحو التدين دون التألّه، و هذا كما في خضوع الناس للأنبياء و الأوصياء (عليهم السلام)، بل للعلماء. و هذا جائز بلا إشكال، كيف و قد أمر الله الناس بخضوعهم لوالديهم كما في القرآن: وَ اِخْفِضْ لَهُمٰا جَنٰاحَ اَلذُّلِّ مِنَ اَلرَّحْمَةِ (6)، فتأمل.
و في الحقيقة أنّ هذا الخضوع لله تعالى؛ لأنّه يقع من المكلف بأمر الله تعالى، و لا داعي له في ذلك سوى امتثال أمره و الإتيان بحكمه، فالخضوع للأنبياء و الأولياء و إن كان عن تدين و جعله شعاراً إلا أنّه ليس بنحو التألّه و اتخاذهم آلهةً و معبودين مستحقين للعبادة ذاتاً، بل لأجل تعيين الله إيّاهم و فرضه طاعتهم علينا، فبين الطاعتين فرق، و لعله من أجل هذا الفرق كرر كلمة «أطيعوا» في قوله تعالى: أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ (7)، فكأنّ الآية مخبرة بأنّ طاعة الله تغاير طاعة الرسول و الولي، و يدخل في هذا القسم سجود الملائكة لآدم (ع) على الأظهر.
نعم، لو كان الذي يخضع له تديناً غير منصوب من قبل الله تعالى يكون الخاضع له مشرّعاً
ص: 95
و مبتدعاً و ضالّاً، بل ربما يصير كافراً.
و منها: الخضوع بغير تدين، و هذا سائغ جائز من كل أحد لكل أحد كما دريت، إلا أن يصادم ذلك عنواناً محظوراً آخر فيحرم.
الفائدة الثانية: دواعي الخضوع للغير أمور:
1 - دفع الضرر الحاضر أو المترقب.
2 - جلب المنفعة.
3 - تحصيل رضى هذا الغير.
4 - أداء شكر النعمة.
5 - استعظامه و استحقاقه العبادة لعظمته و فخامته من دون طمع إلى نعمته، و لا خوف من نقمته، و لا أداء لنعمته، بل و إن لم تكن له نعمة.
و هذه الدواعي مما لا شك في صحتها و وقوع الخضوع من العقلاء لأجلها.
كما أنّه لا شك في صحة العبادة التي يعملها المكلفون لله تعالى بداعي تحصيل رضائه أو استعظامه و إن لم يعلم الأخير من غير المعصومين. و أمّا إتيانها بداعي دفع الضرر أو جلب المنفعة ففيه خلاف.
فعن الشيخ البهائي (قدس سره)(1): ذهب كثير من علماء الخاصة و العامة إلى بطلان العبادة إذا قصد بفعلها تحصيل الثواب أو الخلاص من العقاب، و قالوا: إنّه منافٍ للإخلاص، بل نقله في المستمسك عن المشهور(2)، بل عن الفخر الرازي(3) اتفاق المتكلمين على البطلان.
و عن العلامة الحلّي (قدس سره) في جواب المسائل المهنّائية: اتفاق العدلية على عدم استحقاق الثواب بذلك.
أقول: و الحق صحة العبادة و ترتب الثواب عليها(4)، و إن أتي بها بداعي دفع الضرر أو جلب المنفعة كما هي من المسلّمات الفقهية في الأعصار الأخيرة، و يدل عليها قوله تعالى: وَ اُدْعُوهُ
ص: 96
خوفاً و طمعاً(1)، و قوله: و يدعوننا رغباً و رهباً(2)، و قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً و طمعاً(3). و يدل على صحة المأتيّ به بالداعي الرابع قوله: لئن شكرتم لازيدنكم(4) كما قيل.
هذا، و قال بعض المفسرين(5) بعد ما نقل اتفاق المتكلمين على أن من عبد و دعا لأجل الخوف من العقاب و الطمع في الثواب لم تصح عبادته: و التوفيق بين الآية و القول: أنّ المراد من قوله: وَ اُدْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً(6) الخوف من وقوع التقصير في الشرائط المعتبرة في الامتثال الذي وقع، و الطمع في حصول الشرائط و قبولها بكرمه و فضله، فحصل التوفيق، و يؤيد هذا المعنى نحو قوله تعالى: يُؤْتُونَ مٰا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ (7).
أقول: ما ذكره خلاف الظاهر، و القول المذكور غير ظاهر، ضرورة صحة عبادة المسلمين شرعاً، مع أنّهم لا يؤتونها إلا لخوف العقاب - كما هو الأكثر - أو لطمع الثواب قطعاً(8). و لا يمكن لأحد أن يلتزم ببطلان أعمالهم شرعاً، فالصحيح أنّ هذه الدواعي الخمسة كلها علل للخضوع للخالق و المخلوق، و إن كان بعضها أفضل من بعض.
ففي صحيحة هارون بن خارجة: «العبادة ثلاث (العباد ثلاث نسخة): قوم عبدوا الله عزو جل خوفاً فتلك عبادة العبيد، و قوم عبدوا الله تبارك و تعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء و قوم عبدوا الله حباً له فتلك عبادة الأحرار و هي أفضل العبادة»(9).
الفائدة الثالثة: العبادة بنحو التألّه مختصة بالله سبحانه، فإنّه الواجب الخالق، و لا تجوز لغيره؛ لما صرح به القرآن المجيد في جملة من آياته. و أمّا الخضوع لا بهذا العنوان فهو و إن كان جائزاً لغيره، بل ربما يكون لازماً عقلاً أو شرعاً، غير أنّ المستحق له واقعاً أيضاً هو الله تعالى فقط؛ لأنّ غيره ممكن، و كل ممكن محتاج في قوام وجوده و صدور أفعاله إليه حدوثاً و بقاءً،
ص: 97
فكل مستفيض استفاد من أحد شيئاً فقد استفاض من الله تعالى؛ لأنه مسبّب الأسباب، و أنّه خالق كل شيء، و أنّه المؤلّف بين القلوب أَمَّنْ يُجِيبُ اَلْمُضْطَرَّ إِذٰا دَعٰاهُ وَ يَكْشِفُ اَلسُّوءَ، فحصول الدواعي المترتبة عليها العبادة لا يمكن إلا من الله و له، فإنّه القادر العالم بكلّ شيء و الكلّ من عنده، فلا دافع و لا معطي إلا هو، و هو المستجمع لجميع صفات الكمال، فلا استعظام إلا له، و هو الباقي الأبدي المؤثر فلا يهم إلا تحصيل رضائه، فالحمد و الشكر و الخضوع و الحاجة و المدد كلها له و إليه و منه، و ما بكم من نعمة فمن الله، و إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اَللّٰهِ لاٰ تُحْصُوهٰا فإياك نعبد و إيّاك نستعين.
و مما يدل على انحصار مطلق الخضوع به تعالى بالنظر الدقي: أنّ كل منعم إنّما ينعم على غيره بداعٍ راجع إلى نفسه أولاً من تحصيل شوكة، أو نفوذ كلمة، أو تسكين عاطفة، و لا أقلّ من إرضاء الله سبحانه و استحقاقه ثوابه الأخروي أو فضله الدنيوي إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ (1). و أمّا إنعام الله سبحانه على عباده فليس لغرض عائد إليه أصلاً، كما يأتي بحثه في المقصد الخامس إن شاء الله. و أيضاً كل إحسان و عمل من كلّ أحد لا يكون خالياً عن نقص ما؛ لعدم إحاطة المحسن بجميع الجهات الواقعية، بخلاف إحسان الحكيم فإنّه على وفق الحكمة و المصلحة، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىٰ شٰاكِلَتِهِ (2)، فهو أحقّ بالخضوع و العبادة، و غيره مستأهل له عرضاً.
الفائدة الرابعة: الذي يجب على المسلم و يشترط في صحة إسلامه هو أن يعتقد بوحدانية الله تعالى، و أنبه لا شريك له في الخلق، و استحقاق العبادة، و لا يجب الاعتقاد باستحالة الشركة و امتناع الشريك؛ لعدم دليل عليه عقلاً و شرعاً، و من هنا يمكن أن يقال: إنّ الخبر المقدّر في كلمة «التوحيد» هو لفظ موجود، و ما أورد عليه من عدم دلالته على نفي إمكان إله آخر غير وارد، فإنّ الاعتقاد به غير لازم و إن كان حقاً في الواقع.
ثم إنّ الشرك في كلّ من الواجبية و الصانعية و العبادة يستلزم الشرك في الآخر. نعم، الشرك في الواجبية لا يستلزم الشرك في الصانعية، و أمّا العكس فاللزوم ثابت، كما لا يخفى على المتأمل فتأمل.
ثم إنّ الاعتقاد بالشركة في كل هذه المقامات الثلاثة و إن يوجب خروج الشخص عن الإسلام لكنّه من جهة دلالة الشرع دون العقل، كما هو واضح.
تنبيه: و أمّا التوحيد في الرزق فسيأتي في المقصد الخامس إن شاء الله.
ص: 98
الضدّ(1) يقال بحسب المشهور على ما يعاقب غيره م الذوات على المحلّ «كالصورة»، أو الموضوع «كالعرض» مع التنافي بينهما غايته، و يطلق أيضاً على مساوٍ في القوة و ممانع. و المثلان ذاتان وجوديتان يسدّ كلّ منهما كلّ منهما مسدّ صاحبه في الموضوعية، فيقال: زيد إنسان، مكان أن يقال: بكر إنسان(2).
المشابهة: وحدة الشيئين في الكيف. المساواة: وحدتهما في الكمّ، و المناسبة في الاضافة «كالأخوين في الأخوة»، و المشاكلة في الخاصة، و المطابقة في اتحاد الأطراف، و الموازاة في اتحاد وضع الأجزاء، «كخطّي القطار»، و المجانسة في الجنس، و المماثلة في النوع، و التماثل في الفصل، كما قيل.
و حيث إنّ الحلول و قبول التعدد في الوجوب و عروض الأعراض و التركب عليه تعالى ممتنعة عقلاً كما عرفت، فلا ضدّ له و لا مثل ولا مشابه و لا مساوي و لا مناسب و لا مشاكل و لا مطابق و لا موازي و لا مجانس و لا مماثل و لا متماثل، و كلّ ذلك ظاهر.
و عن أبي هاشم الاعتزالي: أنّه جعل ذاته تعالى مساوية لغيره من الذوات، و إنّما تخالفها بحالة توجب الأحوال الاربعة - أي العالمية و القادرية و الحييّة و الموجودية - و هي الإلهية.
أقول: و سيأتي بطلان الأحوال المذكورة، مع أنّ التساوي في الذات يستلزم التساوي في اللوازم، فيلزم إمكان الواجب و وجوب الممكن، و هو ضروري الاستحالة.
ص: 99
الأجزاء: إمّا موجودة بوجود واحد في العين، و إمّا موجودة بوجودات متعددة. و على الأول إمّا أن تعتبر في الذهن لا بشرط فهي الأجزاء الحملية، و إمّا أن تعتبر بشرط لا فهي الأجزاء الوجودية الذهنية، كالمادة و الصورة الذهنيتين. و على الثاني: إمّا أن تكون متباينة في الوضع فهي الأجزاء المقدارية، و إمّا ليس كذلك، فهي الأجزاء الخارجية كالمادة و الصورة الخارجيتين(1).
ثم إنّ البرهان على امتناع تركّبه و لزوم أحديته تعالى من وجوه:
1 - الأجزاء المفروضة: إمّا ممكنة بأسرها، و إمّا واجبة كذلك، و إمّا بعضها ممكن و بعضها واجب، و لا شقّ رابع. و الأول باطل؛ لعدم تعقل تحصل الواجب من الممكن، فلو كانت الأجزاء ممكنة لكان المركب أيضاً ممكناً، و هذا خلف، و أيضاً علة هذه الأجزاء الممكنة إن كان هذا الواجب فهو ضروري الاستحالة، و إن كان واجباً آخر لزم التسلسل أو الانتهاء إلى واجب غير مركب من الأجزاء الممكنة. و الثاني فاسد؛ لعدم إمكان التركب من الأجزاء الواجبة، فإنّ كل واجب ممكن بالقياس إلى الواجب آخر، و لا علاقة لزومية بين الواجبين بوجه، و إلا لزم معلولية أحدهما أو كليهما، و من المسلّم القطعي لا بدّية الارتباط و التعلّق بين الأجزاء و احتياج بعضها إلى بعضها، و على ضوء ذلك يتقلّب تركب الواجب المفروض إلى تعدده، و هو خلف، و من بطلان هذين الشقين يخرج فساد الشق الثالث أيضاً، كما ليس بسرّ.
2 - كل مركب محتاج في تحققه إلى كل جزء منه، و بالبداهة أنّ كل جزء غير المركب، و من الضروري منافاة الاحتياج في الذات إلى الغير مع الوجوب.
3 - واجب الوجود لا ماهية لا، فلا جزء حدّي و حملي له؛ إذ الماهية ليست إلا الجنس و الفصل، فلا جزء خارجي له، فإنّ كل بسيط ذهناً بسيط خارجاً، و لا عكس فهو بسيط.
ص: 100
4 - المركب من شيئين أو أشياء لابد له من مركّب - بالكسر - لعدم اقتضاء الأجزاء نفسها التركب, و حيث إنّ المؤثر في المركب نفسه فيلزم إمكانه؛ إذ لا مؤثر في الواجب, و أيضاً المركب - بالكسر - إن كان واجباً فننقل الكلام إليه حتى ينتهي إلى البسيط غير متجزّء دفعاً للدور و التسلسل, و إن كان ممكناً فالأمر أفحش.
5 - وجوب الوجود لاينقسم بأجزاء القوام, مقدارياً كان أو معنوياً, و إلّا كان كل جزء منه: إمّا واجب الوجود فيتكثّر واجب الوجود. و إمّا غير واجب الوجود فهو أقدم بالذات من الجملة فتكون الجملة أبعد من الجزء في الوجود.
أقول: أقدمية الواجب إنّما هي من الممكنات المعلولة له, لا من مطلق الممكنات, فتأمّل, فلابد في الشق الثاني أيضاً من فرض التوحيد و امتناع التعدد في الوجوب؛ لينحصر استناد الممكنات قاطبة إلى هذا الواجب. هذا, وقد عرفت أن الواحدية موقوفة على الأحدية؛ في كثير في أدلّة التوحيد. إذ لا دافع للشبهة المشهورة عن ابن كمّونة إلّا امتناع التركب على الواجب الوجود. فلو أثبتنا البساطة بالوحدة للزم الدور, فتأمّل.
6 - كل مركب إذا نظر العقل إليه و إلى جزئه و قايس نسبة الوجود إليهما وجد نسبة الوجود إلى جزئه أقدم من نسبته إلى الكل تقدماً بالطبع, و إن كان معه بالزمان أو ما يجري مجداه فيكون بحسب جوهر ذاته مفتقراً إلى جزئه, متحققاً بتحققه, و إن لم يكن أثراً صدراً عنه, و كل ما هو كذلك لم يكن واجب الوجود لذاته, بل لغيره, فيكون ممكنا.
الوجه الأول ينتفي التركب بمعانيه الأربعة المتقدمة, و أمّا الوجه الثاني فقال اللاهجي(1): إنّ ما ينافي الوجوب هو الحاجة في الوجود الخارجي, و الأجزاء العقلية أجزاء تحليلية عقلية وجودها في العقل فقط, و المركب منها من حيث هو مركب منها بسيط في الخارج ليس فيه تركيب بحسب الوجود الخارجي... إلى آخره. فيكون الدليل مختصاً بنفي الأجزاء الخارجية, مقدارية كانت أو معنوية, أي المادة و المصورة.
و أورد عليه جماعة منهم السبزواري(2): بأنّ المركب محتاج إلى الأجزاء الحملية الحدّية في تقوّمه, بل الحاجة في مرتبة قوام الذات أمحل من الحاجة في مرتبة خارجة منه, فتأمّل.
ثم إنّ هذا الإشكال إن تمّ لم يشمل الوجه الخامس, كما هو ليس بسرّ, فما يظهر من الحكيم
ص: 101
اللاهجي من إجرائه فيه أيضاً غير متين, بل هو مختص بالوجه الثاني فقط. و أمّا الوجه الثالث فهو كالأول في العموم. و أمّا الرابع فهو مخصوص بنفي الأجزاء الخارجية دون الحدية, فإنّها لاتحتاج إلى مركّب (بالكسر), بل يكفيها التحليل العقلي. وك أمّا الخامس فهو أيضاً عام يشمل جميع الأقسام الأربعة, و أمّا السادس فقال صاحب الأسفار: هذا يشمل جميع الأقسام الأربعة, و أمّا السادس فقال صاحب الأسفار: و هذا البيان يجري فيما سوى الأجزاء المقدارية؛ لأنّ تلك الأجزاء ليست في الحقيقة متقدمة, بل نسبة الجزئية إليها بالمسامحة و التسبيه.
أقول: و فيه تأمل. هذا, و الأمر في نفي الأجزاء المقدارية عنه تعالى بعدما تقدم من نفي جسميته تعالى - في المقصد السابق - سهل.
و يمكن أن نزيد في البرهان المذكور و نقول: إنّ تقدم الجزء على المركب تقدم بالطبع وجوداً, و تقدم بالعلية عدماً؛ إذ عدم كل جزء علة تامة لعدم المركب, و الواجب حيث ممتنع العدم لا علة لعدمه فلا جزء له. هذا و لكن الظاهر رجوع هذا الوجه إلى الوجه الثاني, فافهم.
لعل قائلاً يقول: أليست الصفات - كالعالم و القادر و الرحيم و نحوها - تطلق عليه تعالى و على غيره؟ أليس مفهوم الوجود و الشيئية و نحوهما يشتمل الواجب و الممكن؟ فإن كان منشأ انتزاع هذه المفاهيم هو الذاتي فقد وجب امتيازه تعالى عمّن يشاركه فيها بذاتي, و هذا هو التركب. و إن كان منشأه أمراً عرضياً فأيضاً ينتهي إلى الذاتي؛ لأنّ كل عرضي معلَّل فيعود المحذور.
و أجاب عنه جماعة بعدم دخول الواجب تحت شيء من المفاهيم العامة, و قالوا: إنّها تطلق على الواجب بمعنى, و على الممكن بمعنى. و بعبارة أوضح: تلك الألفاظ تستعمل في حقهما بنحو الشتراك اللفظي دون المعنوي فلا محذور.
أقول: و هذا الجواب ظاهر الفساد, بل خلاف الوجدان فهو اقرب إلى السفسطة من الفلسفة فلا نقيم له وزناً.
فالصحيح أن يقال: أمّا الاشتراك في الصفات الفعلية فهو غير ضائر, فإنّ الامتياز بتمام الذات, و هكذا الاشتراك في صفاته الذاتية بناءً على زيادتها على الذات كما زعمها قوم من الناس. و أمّا بناءً على العينية كما يقول بها أهل الحق فنقول:
المشترك فيه هو مفاهيم هذه الصفات دون مصاديقها, فالواجب و الممكن و إن يطلق عليهما العالم و القادر غير أنّ حقيقة علم الممكن قدرته حقيقة عرضية, و حقيقة علم الواجب و
ص: 102
قدرته حقيقة واجبية, فهما و إن اشتركتا في الكشف و صحة الفعل و الترك غير أنّهما حقيقتان مختلفتان, فما به الامتياز هو تمام المصداق, و ما به الشتراك هو المفهوم المنتزع عن الواجب من نفس ذاته المقدسة, و عن الممكن باعتبار انضمام ثفة وجودية زائدة على ذاته, بملاك الانكشاف و صحة الفعل و الترك و نحوها, فافهم جيداً.
و أمّا مفهوم الوجود و الشيئية فينتزع عن نفس ذاتيهما بلحاظ كونهما في الخارج, غير أنّ حقيقة وحود كل منهما وشيئيته مختلفتان.
ص: 103
قد مضى في الجزء الإول أنّ صفاته تعالى: إمّا فعلية, و إمّا مدحية, و إمّا كمالية. و لا ريب في أنّ قيام الأولى بذاته المقدسة قيام صدوري. و هي زائدة على أصل ذاته تعالى بالضرورة. كما أنّ قيام الثانية بها قيام وقوعي اعتباري, و إنّما الكلام في الثالثة, و أنّ قيامهما به تعالى هل هو حلولي أو ذاتي أو انتزاعي(1) و بكل قائل؟
و بعبارة واضحة: لا شك لأحد من الملّيين في اتصافة تعالى بالصفات الكمالية و أنّه عالم, قادر, حيّ... و لكن هل هي زائدة على ذاته تعالى, أو لا تحقق لها أصلاً, و إنّما تتصف الذات بها باعتبار آثارها, أو هي عين ذاته الأحدية؟ فيه خلاف و نزاع, و إليك بيان الأقوال:
الأول: أنّ صفاته عين ذاته, علم و قدرة و حياة, و علمه, قدرة و حياة و ذات, و قدرته علم و حياة و ذات, و هكذا, فذاته و صفاته شيء واحد مصداقاً و عيناً, لكن مفاهيمها مختلفة ضرورة تباين مفهوم العلم مع مفهوم القدرة, و تباينهما مع مفهوم الذات, و هكذا.
الثاني: أنّ صفاته موجودة قديمة زائدة على ذاته تعالى, قائمة به تعالى قياماً حلولياً. فهو عالم بعلم زائد على ذاته قادر بقدرة, و حيّ بحياة, و باقٍ ببقاء كما في صفاتنا الحالَّة بنا.
الثالث: أنّها زائدة, حادثة, قائمة به تعالى قياماً حلولياً.
الرابع: أنّها لا ذاته تعالى و لا غيرها!
الخامس: أنّ ذاته مماثلة لسائر الذوات في الحقيقة, و إنما تمتاز عنها بأحوال أربعة: الموجودية, و الحيية, و العامية, و القادرية.
و قيل: إنّ ذاته تعالى ممتازة بحالة تسمّى الإلوهية (الإلهية), و هي توجب تلك الأحوال الأربعة, و هي لا موجودة و لا معدومة.
السادس: إنكار وجود الصفات, و أنّ ذاته تنوب منابها, بمعنى بروز آثار الصفات من ذاته تعالى بلا وجود تلك الصفات, فيصدر الأشياء عنه متقنة و منكشفة لديه بلا علم و قدرة!
ص: 104
القول الأول: هو المعروف هن الإمامية و الحكماء, و يعلم ذلك من ملاحظة كتبهم أيضاً.
قال شيخنا المفيد (رحمه الله)(1): إنّ الله - عزّ و جلّ اسمه - حيّ لنفسه لا بحياة, و إنّه قادر لنفسه و عالم لنفسه لا بعمنى... و هذا مذهب الإمامية كافة, و المعتزلة, إلّا من سمّيناه - يعني أصحاب الأحوال - و أكثر المرجئة و جمهور الزيدية و جماعة من أصحاب الحديث و الحكمة(2).
و قال أيضاً قبل ذلك: و أحدث رجل من أهل البصرة يعرف بالأشعري قولاً خالف فيه ألفاظ جميع الموحّدين و معانيهم.. و زعم أن لله عز و جل صفات قديمة, و أنّه لم يزل بمعنى (بمعانٍ خ) لا هي هو و لا غيره.... و زعم أن لله عز و جل و جهاً قديماً, و سمعاً قديماً, و بصراً قديماً, و يدين قديمتين, و هذا قول لم يسبقه إليه أحد من منتحلي التوحيد فضلاً عن أهل الإسلام.
أقول: المستفاد من هذا الأشعري, نعم يظهر من بعض رواياتنا وجود قائل به - أي بزيادة صفاته على ذاته تعالى - قبل هذا الرجل, لكنّه شاذّ.
و قيل(3): إنّ القول باعينية من المسلَّمات القطعية عند الإمامية, بل حُكي عن بعضهم(4) أنّه من أصول الإمامية. و منكره مخلد في النار.
و عن المجلسي (رحمه الله)(5): فما ثبت في الدين بالآيات و الأخبار المتواترة: أنّه تعالى أحدي المعنى, ليس له صفات زائدة بل صفاته عين ذاته. انتهى.
و قال اللاهجي في «گوهر مراد»(6): إنّه مذهب جميع الحكماء و العتزلة من المتكلّمين و الإمامية بأجمعهم.
أقول: المقصود إثبات هذا القول من الإمامية و موافقيهم, و ما نقلناه كافٍ له, و إلّا ففي بعض هذه الكلمات نظر, كما لا يخفى, و سيظهر لك وجه النظر في بعضها فيما بعد.
قال العضدي بعد نسبة هذا القول إلى الحكماء و الشيعة(7): مع خلاف للشيعة في إطلاق الأسماء الحسنى عليه.
ص: 105
و قال الجرجاني في شرحه: فمنهم من لم يطلق شيئاً منها عليه, و منهم من لم يجوِّز خلوه عنها.
هذا, و لكنّه لم يذكر أنّ أيّة طائفة من الشيعة اختلفت في ذلك, و إنّي إظن هذه النسبة كاذبة, فإنّي لم أقف عليها لحدّ الآن, و أما الطائفة الإمامية فالمقطوع من سيرتهم توصيف الله تعالى بحميع الصفات الكمالية و الجمالية, تبارك ربنا ذوالجلال و الإكرام.
و صفوة القول المذكور: إنّ صفاته الكمالية بما لها من المفاهيم المختلفة عين ذاته تعالى, و إنّ ذاته المقدسة بمجردها بلا صفة زائدة منضمّة إليها يعلم الأشياء و يقدر عليها, و هو حي, و باقٍ, و سميع, و بصير بلا حياة و بقاء و سمع و بصر زائدة, بل بنفس ذاته الأحدية.
قال صاحب الأسفار(1): فصفاته الجمالية كلها عين ذاته, أي وجودها بعينه وجود الواجب, فهي كلها واجبة الوجود من غير لزوم تعدد الواجب.
و إليه الإشارة بقول الفارابي: يجب أن يكون في الوجود وجود بالذات, و في العلم علم بالذات, و في القدرة قدرة بالذات... حتى تكون هذه الأمور في غيره لا بالذات. و قال لعد هذا بأسطر: لا كما فهمه المتأخرون و الذاهبون إلى اعتبارية الوجود, فجعلوا معنى عينية الصفات في الباري تعالى أنّ مفاهيمها مفهوم واحد, و أنّه يترتب على ذاته بذاته ما يترتب على تلك الصفات في غيره.
أقول: و يظهر منه و من السبزواري في أول شرح منظومته أنّ القول بالعينية إنّما يصح بناءً على أصالة الوجود؛ إذ الماهيات مثار الكثرة و الاختلاف, و لذا ذهب القائلون بأصالتها في المقام إلى القول السادس كما يظهر من هذه العبارة المنقولة من الأسفار.
و بالجملة: ما ذكره صاحب الأسفار في معنى العينية عندي صحيح متين.
و أمّا القول الثاني فهو معروف عن الأشاعرة(2), و نسبه الدواني(3) إلى جمهور المتكلّمين.
و توضيحه: أنّ الله تعالى فاقد في مرتبة ذاته بذاته عن كل صفة كمالية, لكنّ ذاته تستلزم صفاتها, فالصفات أمور لازمة لذاته, ممكنة صادرة عنه بالإيجاب دون الاختيار, نعم ذكر بعضهم أنّها لقدمها لا تحتاج إلى العلة حتى يقع الكلام في اختيارها و إيجابها, لكن أورد عليه بعض منهم: أنّها ممكنة لأدلة التوحيد, و الممكن لابد له من سبب.
و بالجملة: الصفات الكمالية عندهم ممكنة ذاتاً واجبة الثبوت لذاته تعالى, أرلاً قائمة به
ص: 106
قياماً حلولياً, فالواجب بانسبة إليها علة موجبة, لا فاعل مختار, و هذا الذي ذكرناه في تفسير هذا القول مستفاد من كلمات جملة منهم صريحاً و ظاهراً.
نعم، ذكر التفتازاني في شرحه على عقائد عمر النسفي عند البحث عن قدمه تعالى ما لفظه: و في كلام بعض المتأخرين كالإمام حميد الدين ضرير و من تبعه تصريح بأنّ واجب الوجود لذاته هو الله تعالى و صفاته، و استدلوا على أنّ كل ما هو قديم فهو واجب لذاته، بأنّه لو لم يكن واجباً لذاته لكان جائز العدم في نفسه فيحتاج في وجوده إلى مخصص، فيكون محدثاً... إلى آخره.
و أمّا الناقل نفسه فقد تحيّر فكره و اضطرب عقله و لم يدر إلى ماذا يذهب؟ فقال: و هذا كلام في غاية الصعوبة، فإنّ القول بتعدد الواجب لذاته مناف للتوحيد، و القول بإمكان الصفات ينافي قولهم بأن لا كل ممكن حادث... إلى آخره.
أقول: لم أجد القول بتعدد الواجب لذاته من فرقة حتى المجوس، و ليس هناك طائفة مشركة في الواجبية إلا هؤلاء من أهل السنّة.
و أمّا القول الثالث فهو منقول عن الكرامية، و قد تقدم إبطاله، و ربما يظهر ذلك من جماعة من أهل السنّة كما سلف في بعض مباحث العلم، و قد تقدم أيضاً نسبة إنكار العلم قبل الإيجاد إلى الإشراقيين.
و أمّا القول الرابع فهو منقول عن أبي الحسن الأشعري، و من الناقلين: المحقق الطوسي (قدس سره) و الدواني(1)، لكنّ المذكور في المواقف و شرحها(2) أنّه قول الأشعريين و قول مشايخهم، و هو بظاهره تناقض بحث، و لذا تصدّوا لتوجيهه، فقيل: المراد من نفي غيرية الصفات للذات هو عدم جواز الانفكاك، فصفاته تعالى حيث لا تنفك عنه فهي ليست بغيره.
أقول: و عليه فهذا القول راجع إلى القول الثاني بلا فرق أصلاً سوى تغيير في العبارة، و للعضدي توجيه آخر لهذاالكلام، قال(3): إنّها لا هو بحسب المفهوم و لا غيره بحسب الهوية، و معناه أنّهما متغايران مفهوماً و متحدان هوية، كما يجب أن يكون الحال كذلك في الحمل، و لمّا لم يكونوا - أي مشايخ الأشعريين - قائلين بالوجود الذهني لم يصرحوا بكون التغاير بين الصفة و الموصوف، و بين الجزء و الكل في الذهن، و الاتحاد في الخارج، كما صرح به القائلون بالوجود الذهني. انتهى.
ص: 107
أقول: و هذا هو القول الأول بعينه، فقد اعترف بالحق من حيث لا يشعر «الحق ينطق منصفاً و عنيداً»، و لذا لم يرتضه الجرجاني، فقال في شرحه: و الظاهر أنّهم فهموا من التغاير الانفكاك من الحانبين، فأقدموا على ما قالوا. و أيضاً لمّا أثبتوا صفات موجودة قديمة زائدة على ذاته لزمهم كون القدم صفة لغير الله تعالى، دفعوه بذلك! و أيضاً لزمهم أن تلك الصفات مستندة إلى الذات، أمّا بالاختيار فيلزم التسلسل فيها، و يلزم أيضاً كون الصفات حادثة.
و أمّا بالإيجاب فيلزم كونه تعالى موجباً بالذات و لو في بعض الأشياء، فتستّروا عن هذا بأنّها إنّما تكون محتاجة مستندة إلى علة إذا كانت مغايرة للذات. انتهى.
أقول: إن أرادوا بهذا التستّر الفرار من الحق و من إفحام أهله إيّاهم فلا بأس به؛ إذ ربّما يبتلى الشخص بالتقليد، أو بالبناء على أم تعصّباً و مجازفة، فيتمجمج في قبال خصومه ليخلص عن الإشكال، كما فعلوا ذلك في مسألة رؤيته تعالى، و الكلام النفسي، و غيرهما. و إن أرادوا منه دفع الاعتراضات واقعاً فأنت تعلم أنّ الأمر ليس كذلك، فإنّ الممكن لا بد له من علة بالضرورة، سواء كانت موجبة أو مختارة، و مجرد كونه لا ينفك عن موصوفه لا يخرجه عن الافتقار إلى علة، كمان لا يخفى، و لذ صرح جملة منهم أنّها صادرة عنه تعالى بالإيجاب، فالقول المذكور سفسطة محضة.
و أمّا القول الخامس فهو لأبي هاشم الجبائي، و هو مخترعه، كما نقله شيخنا المفيد(1) و المحقق الطوسي(2) - قدس الله أسرارهما - و تبعه جماعة من إخوانه الاعتزاليين. و قيل(3): إنّه مذهب قدماء المعتزلة، والمشهور بإثباتها البهشمية.
أقول: و حيث إنّ الواسطة بين الموجود و المعدوم ضروري البطلان فالقول المذكور لا يحتاج إلى إبطال.
و بالجملة: الذي سمّاه حالّاً شيء اعتباري منشأ انتزاعه الصفات القائمة بالذات قيامً ذاتياً كما هو القول الأول، أو قياماً حلولياً كما هو القول الثاني.
و أمّا القول السادس فنقله الحكيم السبزواري(4) عن المعتزلة، و لعله أخذه من الدواني، فإنّه بعد ما نسب القول الأول إلى الحكماء و المعتزلة قال(5): و أمّا المعتزلة فظاهر كلامهم أنّها
ص: 108
عندهم من الاعتبارات العقلية التي لا وجود لها. انتهى.
و يؤيده ما في المواقف و شرحه، حيث نقل احتجاج المعتزلة على نفي علمه و قدرته تعالى(1).
أقول: و يمكن أن يكون غرضهم هو نفي العلم الزائد و القدرة الزائدة رداً على الأشاعرة، بل هو الظاهر من بعض احتجاجتهم. و أمّا ما ذكره الداوني فهو استظهار منه من كلامهم، لا نقل لأقوالهم. فحينئذ ما نسبه السبزواري إليهم غير ثابت، و لا يحضرني كتب المعتزلة حتى أنظر فيها، بل الظاهر من كلام شيخنا الأقدام المفيد (رحمه الله) أنّ المعتزلة سوى أبي هاشم و أتباعه و يتّبعون الإمامية في العينية، فلهم قولان: القول الأول - و عليه جمهورهم - و الخامس و عليه جماعة منهم، و ربّما نسب إلى بعضهم اختيار القول الثاني أيضاً، و الله العالم.
نعم، يمكن أن يقال: إنّ القائل بهذا القول هم الفلاسفة القائلون بأصالة الماهية، كما يستفاد من كلام صاحب الأسفار المتقدم في تحرير القول الأول، فلاحظ.
ذكر بعض البسطاء المغرورين الذين يريدون إطفاء نور الله بأيديهم، و لا يشعرون أنّ الله أبى إلا أن يتمّ نوره و لو كره الكاذبون في كتابه المسمّى ب - «التحفة الاثني عشرية» المملوء من الافتراءات و الأكاذيب الجلية على الإمامية ما نصّه(2):
و قال الإمامية كلهم: ليس لله تعالى صفات أصلاً، و لكن تطلق على ذاته تعالى الأسماء المشتقة من تلك الصفات، فيجوز أن يقال: إنّ الله حيّ و سميع و بصير و قدير و قوي و نحو ذلك، و يمتنع أن يقال: إنّ له حياةً، و علماً و قدرةً، و سمعاً، و بصراً و نحوها. انتهى.
و حيث إنّك عرفت معتقد الإمامية مفصلاً تعلم كذب هذا الرجل و من تبعه في هذه النسبة إلينا، و إنّ هذا الذي افتراه علينا - و هو القول السادس - لم يعلم قائله من المتكلمين لحدّ الآن.
و أنت إذا راجعت كتابه نجد معظم مسائله من هذا القبيل، يكذب و يفتري و يسبّ و يثرثر و يهجر من غير خوف من الله القهار، و لاحياء من الناس! و كم لهذا الرجل الثرثار الهندي من نظير وَ سَيَعْلَمُ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (3).
ص: 109
القول الثالث باطل بما تقدم من أنّه تعالى ليس محلّاً للحوادث، بل هو قطعي الفساد بيّن الضلال؛ إذ لا يقبل وجدان عاقل نفي الصفات الكمالية عن الله تعالى أزلاً، و التفوّه بحدوثها و تجددها فيما لا يزال، و هذا واضح.
و أمّا القول الخامس فقد عرفت أنّه أولى بالبطلان و بديهي الفساد. و أمّا الرابع فإن لم يرجع إلى الثاني فهو كالخامس في خروجه عن طور العقل.
و أمّا الأخير فهو يرجع إلى قول الماديين، فإنّهم ينفون العلم و القدرة عن المبدأ، و لكن يعترفون بإتقان العالم و أحكامه. و قد سلف أنّ العقل بأول إدراكه يحكم حكماً بتّياً قطعياً أنّ هذا النظام الأجمل لا يمكن صدوره إلا عن عليم قدير حكيم.
و بالجملة: كل ما أوردناه على الماديين و ذكرناه في إثبات علم المبدأ و قدرته دليل على إبطال هذا القول أيضاً بلا فرق، فهذا القول مزيف جداً، لكنّني بعد لم أحرز القائل به. و أمّا القول إبطال هذا القول أيضاً بلا فرق، فهذا القول مزيف جداً، لكنّني بعد لم أحرز القائل به. و أمّا القول الثاني فلا دليل عليه أصلاً، و لم يستدل عليه بشيء سوي ما تخيل بعضهم من التشبّث باختلاف مفاهيم الصفات، و لكنّنا ذكرنا أنّ العينية راجعة إلى المصداق دون المفهوم.
و ما يظهر من آخر من الاتكال على أصالة زيادة الصفات قال(1): و الدليل عليه: أنّا نفهم الصفات الإلهية من صفات الشاهد، و كون علة(2) الشيء عالماً في الشاهد هي العلم، فكذا في الغائب، و حدّ العالم ها هنا من قام به العلم، فكذا حدّه هناك، و شرط صدق المشتق على واحد منّا ثبوت أصله، فكذا شرط فيمن غاب عنّا، و كذا القياس في باقي الصفات، ثم نأخذ هذا من عرف اللغة و إطلاقات العرف، فإنّ العالم لا شك أنّه من يقوم به العلم، و لو قلنا بنفي الصفات لكذّبنا نصوص الكتاب و السنّة... و عندي أنّ هذا هو العمدة في إثبات الصفات الزائدة، فإنّ الاستدلالات العقلية على إثباتها مدخولة. انتهى.
أقول: و يزيّفه أولاً: بطلان قياس الغائب على الشاهد، كما اعترف به - أي ببطلان القياس المذكور - عدة من أصحابه أيضاً، و كيف يقاس ربّ الأرباب بالتراب؟ و أين الخالق من المخلوق؟! لكن هذا القائل لم يخرج عن محيط الحسّ و سلطان الحدوث فذهب إلى ما ذهب!
ثم نقول له: نعم، علة كون الشيء عالماً هو العلم، و حدّ العالم من قام به العلم، و شرط صدق المشتق هو ثبوت أصله و نحن لا نكذب بالنصوص كما هو لازم القول السادس، بل نقول: إنّ العلم مثلاً قائم به تعالى، لكن لا قياماً حلولياً كما في الأجسام و الجسمانيات، بل قياماً ذاتياً، و أنّ
ص: 110
العلم هو نفس ذاته المقدسة، فوجود صفاته عين وجود ذاته.
و قد تقدم أنّ قيام المبادئ بذويها على أنحاء مختلفة، و المشتقّات لم توضع لواحد معين بخصوصه، بل لمجرد القيام، و الخصوصية مستفادة من الخارج(1)، ألا ترى أنّ قيام العقل ربما يكون حلولياً كما في قولنا: زيدا عاقل، و ربما يكون ذاتياً كما في قولنا: العقل عاقل - عالم -، و قيام الضوء ربما يكون صدورياً، و ربما حلولياً، و ربما ذاتياً، كقولنا: الشمس مضيئة القبّة مستضيئة و الضوء مضيء؟
و بالجملة: لا مجال لقياس الواجب على الممكن؛ لتباين أحكامهما و تفاوت آثارهما.
أليس العلم مثلاً لازماً لذاته تعالى عندهم؟! و ليس كذلك لنا، أليس الرضا و الغضب فينا بمعنى يمتنع عليه تعالى؟ فهل يعقل أن يقال: إنّ العرف لا يفهم من الغضب و الرضا إلا ما يحلّ بنا فنقيس الغائب على الشاهد؟!
و بالجملة م العرف إنّما هو يتبع في بيان المفهومات فقط، و أمّا تشخيص المصداق و خصوصيات الأفراد و كيفية تطبيق هذه المفاهيم على مصاديقها فهو بحكم العقل. فنحن نتبع العرف في أنّ مفهوم العالم من انكشف لديه الأشياء، و أمّا كيفية هذا الانكشاف و قيام العلم بذات العالم فهما تابعان لخصوصية الموارد و المصاديق. فافهم حتى لا تكون من المشبّهة و من الذين قلّدوا العوامّ في أصول دينهم فكان عاقبة أمرهم خسراً.
فتحصّل أنّ هذا الفاضل و إن تفرد - بزعمه - عن أصحابه في الاستدلال، لكنه ما أتى بشيء يجدي لرفع تحيرهم. و غاية كلامه متابعة أهل السوق في فهم أسرار التوحيد!!
و بعد ذلك كله فقد حان أن نقبل القول الأول و ندين به، فإنّ بطلان الأقوال الخمسة المذكورة يعيّن الالتزام به، و لأنّه أليق بذاته تعالى، و لأنّه لا محذور فيه أصلاً، و هذا هو مذهب أئمة أهل بيت نبينا (ص) و مذهب الإمامية و كثير من المسلمين من غيرهم، كما مر في كلام شيخنا المفيد (رحمه الله).
و الذي يدل من العقل و النقل على صحة القول بالعينية و نفي الزيادة الذي سمّاه أمير المؤمنين (ع) بكمال الإخلاص و ابنه الرضا (ع) بنظام التوحيد و كماله، أمور:
1 - حلول الصفات المتباينة المذكورة الثمانية - أو أكثر منها - بذاته تعالى، و قيامها بها،
ص: 111
يوجب تكثّره و تركبه لا محالة فلا يكون بواجب؛ إذ كل مركب ممكن كما مرّ، و قد فرضناه واجباً.
2 - لو كانت صفاته زائدة لكانت ممكنة؛ لأدلة التوحيد، و أكثر الأشاعرة أيضاً تسالموا على إمكانها، و كل ممكن محدود. و لا شك أنّ قيام المتناهي بغير المتناهي - قياماً حلولياً - يوجب تبعّض غير المتناهي و يبطل بساطته، فيكون ممكناً، و هذه الحجة تتم و لو كانت الصفة الزائدة واحدة، بخلاف الحجة الأولى، كما لا يخفى.
3 - القدرة الواجبة و العلم الواجب - مثلاً - غير ممتنعان على الله سبحانه، فيكونان(1) ثابتين له بنحو العينية دون الزيادة؛ لاستحالة تعدد الواجب.
4 - لو كانت صفاته زائدة على ذاته: فإمّا أن تكون واجبة، و إمّا ممكنة، و الأول محال؛ لأدلة التوحيد. و علي الثاني: فإمّا أن تكون معلولة لغيره تعالى، و إمّا أن تكون معلولة له، و الأول محال عقلاً و اتفاقاً، و على الثاني فصدورها عنه تعالى: إمّا بالاختيار، و إمّا بالإيجاب، و الأول ممتنع؛ لما مرّ في الجزء الأول من بطلان استناد القديم إلى المختار، و هذا مما توافق عليه الأشاعرة ايضاً، بل قال التفتازاني: إنّه ممّا اتفق عليه الفلاسفة و المتكلمون. و قد مرّ بحثه و لا نعيد.
و هنا نقول: لو سلّمنا صحة استناد القديم إلى المختار لما سلّمناها في المقام؛ إذ صدور العلم و القدرة و الاختيار و الحياة و الإرادة عن الاختيار المتوقف على هذه الأوصاف دور صريح.
و هذا واضح جداً؛ و لذا اعترف به جملة من متكلّميهم و صرحوا باختيار الشقّ الثاني، و هو صدورها عنه بالإيجاب، و لعله مختار أكثرهم، لكنّه أيضاً باطل غير معقول، فيثبت ما ذهبنا إليه من العينية بالضرورة.
وجه البطلان: أنّ المعلول مترشح من العلة و يعدّ من شؤونه، و إن شئت فقل: إنّ المعلول هي العلة في مرتبتها النازلة، كما يشاهد ذلك في العلل الموجبة و معاليلها الحسّية. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى أنّه لا يعقل ترشح القدرة و العلم و الحياة و الإرادة و نحوها من الصفات الكمالية عن ذات فاقدة لها في مرتبة ذاتها، كيف و معطي الشيء لا يكون فاقده، و فاقده لا يكون معطيه بحكم الوجدان و الفطرة؟!
و حق القول: إنّ مذهبهم هذا راجع إلى مسلك الدهريّين، غاية الأمر أنّهم يقولون بفقدان المبدأ للصفات المذكورة في ذاته و في صدور صفاته. و الماديين في ذاته و أفعاله!!
ص: 112
فإن قلت: إنّها غير صادرة عنه تعالى و لو بالإيجاب، بل هي من لوازم ذاته، كالإمكان بالنسبة إلى الإنسان مثلاً.
قال صاحب الأسفار(1) في ضمن كلام له: فلقائل أن يقول: صفاته تعالى لوازم ذاته، و لوازم الذات لا تستدعي جعلاً مستقلاً، بل جعلها تابع لجعل الذات وجوداً و عدماً، فإن كانت الذات مجعولة كانت لوازمها مجعولة بذلك الجعل، و إن كانت الذات غير مجعولة كانت لوازمها غير مجعولة بالجعل الثابت للذات، و لا يبعد أن يكون هذا قول من ذهب من المتكلمين إلى أنّ صفاته تعالى واجبة الوجود لوجوب الذات. انتهى.
قلت: لوازم الذات لا تكون إلا أموراً عقلية كالزوجية و الإمكان و نحوها، و المفروض أنّ الصفات التي اخترعها الأشاعرة موجودة خارجاً؛ لأنّها من الكيفيات النفسانية، فلا بد أن تكون صادرة عنه بالإيجاب، كما صرح به جماعة منهم، فافهم جيداً فإنّه دقيق.
5 - لو لم تكن صفاته عين ذاته، بل كانت زائدة عليها لكان الواجب بالنسبة إليها علة موجبة، و علة طبيعية؛ إذ المفروض خلوّه في ذاته و مرتبة فاعليته لهذه الصفات منها، و عليه فنقول: الطبيعة الواحدة لا يصدر عنها إلا شيء واحد، و لا يعقل صدور أمور كثيرة عنه، فلو كان الأمر كما يتخيل هؤلاء لكان للواجب صفة واحدة لا صفات ثماني أو أكثر.
ثم إنّ الفرق بين هذه الحجة و سابقتها: أنّ هذه تتم في صورة تعدد الصفات، بخلاف تلك فإنّها تجري و إن كانت صفته واحدة، كما هو ليس بسرّ.
6 - الفاعلية الإيجابية نقص، و النقص عليه تعالى محال. أمّا الصغرى فهي مسلّمة عند الخصم و عندنا. و أمّا الكبرى فقد تقدم برهانها، و لا يظنّ بهم أن يجوزوا النقص في حقّه تعالى، و إن جعل بعضهم القول بالكمال و النقص خطابياً.
و قال الشريف الجرجاني: و دعوى أنّ إيجاب الصفات كمال و إيجاب غيرها (أي الأفعال) نقصان مشكلة.
أقول: فالأشاعرة كما لا يلتزمون بإيجابه في أفعاله لا بد و أن يلتزموا به في صفاته أيضاً. لكن الذي يمكن أن يعتذر به عن هذا الفرق هو عدم التمكن من رفض تقليد شيخهم الأشعري!
7 - لو كانت صفاته زائدة على ذاته لم يكن الواجب إلهاً، و التالي باطل بالضرورة الدينية فكذا المقدم.
بيان الملازمة: أنّ الإله: إمّا بمعنى المعبود، و إمّا بمعنى الفاعل، و من الظاهر أنّ الواجب في
ص: 113
نفسه حيث فاقد لجميع الكمالات، لا يستحق عبادة و لا ثناءً، و لا أنّه فاعل لشيء، و إنّما يكون إلها إذا اعتبرت معه صفاته. و هذا ظاهر، فحينئذٍ الإلوهية موقوفة على حلول جملة من الموجودات الممكنة به تعالى، و ذاته الواجبة بلا حيثية تقييدية ليست بإله، و هذا هو التالي الباطل شرعاً.
8 - لو كانت صفاته زائدة لكانت ممكنة كما مرّ. و كل ممكن حادث، فيلزم كونه تعالى محلّاً للحوادث، و عدم اتصافه أزلاً بصفاته الكمالية، بل يلزم اتصافه بأضدادها، كما مرّ عن الكرامية، و هذا باطل عقلاً و اتفاقاً من الأشاعرة. و أمّا حدوث كل ممكن فمن أجل أنّه مفتقر إلى المؤثّر بالضرورة، و تأثّر المؤثّر: إمّا في حال وجوده فيلزم تحصيل الحاصل، و إمّا حال عدمه فهو المراد و قد مرّ تفصيله في آخر الجزء الأول في مسألة حدوث العالم. و إمامهم الرازي و من تبعه منهم أيضاً ذهب إلى عدم استناد القديم إلى المؤثّر مطلقاً، موجباً كان أو مختاراً.
9 - لو كانت صفاته الكمالية زائدة على ذاته، و كانت الذات في نفسها خالية عنها لكان استكمالها بها، فلا كمال و لا بهاء للواجب إلا بصفاته الممكنة! و العقل الفطري السليم يرفض رفضاً بتّياً قطعياً استكمال الواجب بالممكن.
10 - لو كانت زائدةً على ذاته لكانت الذات محتاجة إليها في أفعاله؛ و قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: اَللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعٰالَمِينَ (1)، و صفاته الممكنة داخلة في العالم. و الاعتذار بأنّها لا هو و لا غيره سخيف كما مرّ.
و ربما استدل بعض الأجلاّء من متكلّمي أصحابنا على بطلان التالي: بأنّ الاحتياج ينافي وجوبه الذاتي. لكن فيه نظر(2)، فالصحيح ما ذكرنا، و الدليل حينئذٍ يكون نقلياً لا عقلياً.
11 - لو كانت زائدة على ذاته، و كانت ذاته من حيث هي فاقدة للكمالات لكان الله تعالى ناقصاً في حقيقته و ذاته، و من الظاهر أنّ العقل و الدين متفقان على أنّ الواجب لا يكون ناقصاً في ذاته.
12 - لو كانت زائدة لكانت ممكنة كما مرّ، و كل ممكن محدود، فيلزم تناهي صفاته و تحديدها، و قد اتفقوا على أنّ صفاته تعالى غير متناهية ذاتاً و تعلّقاً.
13 - لو كانت زائدة و صادرة عنه بالإيجاب لكانت إرادته أيضاً كذلك؛ لانها من جملة الصفات عندهم. و الإرادة متعلقة بأحد طرفي النقيضين أو الضدين لذاتها(3)، فحينئذٍ يلزم
ص: 114
إيجابه في أفعاله أيضاً.
و على الجملة: إيجابه في صفاته مستلزم لإيجابه في أفعاله، تعالى الله عنه، نعم، هذا الدليل جدلي، فإنّ إرادته تعالى عندي و عند جملة كثيرة من أجلاّء الإمامية - كما مرّ بحثها في المقصد الأول - نفس فعله و تكوينه، فافهم.
14 - لو كانت زائدة و صادرة عنه أزلاً - كما هو مذهبهم - للزم تعدد القدماء، و التالي باطل، و الالتزام به كفر، و لذا كفرت النصارى. قال الرازي(1): النصارى كفروا بأنّهم أثبتوا ثلاثة قدماء، و أصحابنا قد أثبتوا تسعة، و أجاب عنه المثبتون بأنّ الكفر إثبات ذوات قديمة، لا إثبات ذات و صفات قدماء.
وردّ أولاً: بأنّ الموجب للكفر هو مجرد تعدد القدماء، لا حيثية كونها ذواتاً؛ حتى لا يجري الإلزام المذكور على الأشعري.
و ثانياً: أنّ النصارى أيضاً لم يثبتوا ذوات ثلاث، و إنّما هذا شيء افتراه عليهم أصحاب الصفات عند إرادة التفصّي عن مشاكلهم، مستدلّين عليه: بإنّهم قالوا بانتقال أقنوم العلم إلى المسيح و المستقلّ بالانتقال لا يكون إلاّ ذاتاً. و هو مدفوع: بأنّه لا يفيد كون الأقانيم ذوات، و إنّما يفيد كون أقنوم واحد ذاتاً.
أقول: في أصل الحجة و جوابها و ردّه نظر و بحث، فتأمّل.
15 - مذهب الأشاعرة: أنّ العرض لا يبقى زمانين، فالأعراض بجملتها غير باقية عندهم. بل هي على التقضّي و التجدد، ينقضي منها واحد و يتجدد آخر مثله. و إنّما ذهبوا إلى ذلك لأنّهم قالوا بأنّ السبب المحوج إلى المؤثّر هو الحدوث، فلزمهم استغناء العالم حال بقائه عن الصانع، فدفعوا ذلك بأن شرط بقاء الجوهر هو العرض، و لمّا كان هو متجدداً محتاجاً إلى المؤثّر دائماً كان الجوهر أيضاً حال بقائه محتاجاً إلى ذلك المؤثر بواسطة احتياج شرطه إليه فلا استغناء أصلاً(2).
أقول: و صفاته تعالى إذا كانت زائدة على ذاته حالّةً به لكانت أعراضاً، كما هو ظاهر، و حيث العرض لا يبقى زمانين بل يتبدل في كل آنٍ فحينئذٍ يلزم كونه تعالى محلاً للحوادث، مع أنّهم أنكروا ذلك على إخوانهم الكرامية. هذا، مع أنّ علة الاحتياج لو كانت هي الحدوث للزم استغناء تلك الصفات عن المؤثر مع كونها ممكنة، و هو الترجح بلا مرجح. و هذا الدليل جدلي كما لا يخفي. و أمّا ما يوجد في بعض كلماتهم من خروج صفاته تعالي - مع إمكانها - من
ص: 115
الأعراض فهو قريب من الهذيان و لا يستحقّ الالتفات.
16 - لو كانت زائدة للزم افتقار الواجب في صفاته تعالى إلى المعاني المذكورة؛ إذ لو لاها لم يكن عالما قادراً حيّاً. و كل مفتقر إلى الغير ممكن.
17 - لو كان الله موصوفا بهذه الصفات، و كانت قائمة بذاته كانت حقيقته الإلهية مركبة، و كلّ مركب محتاج إلى جزئه، و كلّ محتاج ممكن.
18 - لا قديم سوى الله تعالى؛ لأنّ كلّ موجود سواه فهو مستند إليه، و قد بيّنا أنّه مختار، و فعل المختار حادث.
19 - لزوم إثبات ما لا نهاية له من المعاني القائمة بذاته تعالى، من القول بزيادتها.
بيان الملازمة: أنّ العلم بالشيء مغاير للعلم بما عداه، فإنّ من شرط العلم المطابقة، و محال أن يطابق الشيء الواحد أمورا متغايرة متخالفة في الذات و الحقيقة، لكنّ المعلومات غير متناهية لا مرّةً واحدةً، بل مراراً غير متناهية، باعتبار كل علم يفرض في كل مرتبة من المراتب الغير المتناهية؛ لأنّ العلم بالعلم بالشيء مغاير للعلم بذلك الشيء، ثم العلم بالعلم بالشيء مغاير للعلم بالعلم بالعلم بذلك الشيء و هكذا إلى يتناهى. و في كل واحد من هذه المراتب مراتب غير متناهية. و هذا عين السفسطة؛ لعدم تعقّله بالمرّة، ذكر هذه الوجوه الأربعة العلامة الحلّي قدّس الله نفسه(1).
أقول: و فيها بحث. أمّا الوجه الأول فيمكن نقضه بصفاته الفعلية، و حلّه بأنّ الاحتياج في غير الوجود لا ينافي الوجوب كما مرّ. فالأحسن أن تجعل الكبرى نقلية، فإنّ الله تعالى غني عن العالمين، كما صنعنا من قبل.
و أمّا الوجه الثاني: فإن أريد بالإلهية الواجبية فالملازمة ممنوعة؛ لإمكان الصفات، و إن أريد بها الفاعلية أو مستحقية العبادة فالتالي لا يثبته التعليل المذكور، كما لا يخفى على المتأمّل. نعم، يصح إبطال التالي المذكور بما قدمناه في الحجة السابعة، فلاحظ.
و أمّا الوجه الثالث فهو متين إن قام الخصم باختياره تعالى بالنسبة إلى صفاته الكمالية، و قد عرفت أنّ مذهبهم هو إيجابه، تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوّاً كبيراً، فلا بد من إرجاع هذا الوجه إلى الوجه الثامن ليتم المقصود.
و أمّا الوجه الأخير فالظاهر أنّه ينحلّ إلى وجهين:
الأول: عدم تناهي علومه بعدم تناهي معلوماته، ضرورة لزوم مطابقة العلم مع المعلوم
ص: 116
كما أفاده.
الثاني: عدم تناهيه؛ لتعلق علمه بعلمه بشيء، و هكذا ضرورة امتناع الجهل البسيط عليه تعالى.
و أمّا ما أفاده القاضي الشهيد - نوّر الله مضجعه - في تفسير هذا الوجه، فمع كونه خلاف الظاهر من عبارة العلامة (قدس سره) لا يتمشّى على الخصم أيضاً، فلا حظ كلامه، بل هذان الوجهان أيضاً ضعيفان؛ فإنّهما مع نقضهما على القول بالعينية يندفع الأول بمنع تعدّد العلم بتعدد المعلوم، كما مرّ في مباحث علمه تعالى في الجزء الأول نعم، أجاب بعض الأجلاّء - أعلى الله مقامه - عن النقض المذكور، لكنّه غير متين. و الثاني بأنّ العلم بالعلم بنفس العلم الأول، كما أشرنا إليه في مبحث العلم أيضاً، فتدبر جيداً.
20 - لو كانت الصفات زائدة على وجوده تعالى لم يكن في مرتبة وجود ذاته مصداقاً لصدق هذه الصفات الكمالية، فيكون ذاته بنفس ذاته عارياً عن معاني هذه النعوت، و التالي باطل؛ لأنّ ذاته مبدأ كل الخيرات و الكمالات، فكيف يكون ناقصاً في ذاته متكملاً بغيره؟! فيكون للغير فيه تأثير، فيكون منفعلاً من غيره، و أنّه فاعل لما سواه، فيلزم تعدد جهتي الفعل و الانفعال، و هو محال.
21 - لو كانت زائدة يلزم أن يستدعي فيضانها من ذاته على ذاته بجهة أشرف ممّا عليه الواجب الوجود، فيكون ذاته أشرف من ذاته؛ إذ لو كفت جهة ذاته في أن يكون موجباً لإفاضة العلم - مثلاً - لكان ذاته بذاته ذا علم ليفيض من علمه علم آخر كما في أصل الوجود، و التالي محال؛ لأنّ جهة النقص و الخسّة تخالف جهة الكمال و الشرف، فكذا المقدم، و لا مجال؛ لتوهّم فيضانها من غيره عليه، و إلا يلزم أن يكون معلوله أشرف منه، و هذا أشدّ استحالةً من الأول.
22 - بديهة العقل حاكمة بأن ذاتاً لها من الكمال ما هو بحسب نفس ذاتها فهي أفضل و أكمل من ذات لها كمال زائد على ذاتها؛ لأنّ تجمّل الأولى بذاتها، و تجمّل الثانية بصفاتها، و ما تجمّل بذاته أشرف ممّا يتجمّل بغير ذاته و إن كان ذلك الغير صفاته. و واجب الوجود يجب أن يكون في أعلى ما يتصور من البهاء و الشرف و الجمال، لأنّ ذاته مبدأ سلسلة الوجودات، و واهب كل الخيرات و الكمالات، و الواهب المفيض لا محالة أكرم و أمجد من الموهوب له المفاض عليه، فلو لم يكن كماله تعالى بنفس حقيقته المقدسة، بل مع اللواحق لكان المجموع من الذات واللواحق أشرف من الذات المجردة، و المجموع معلول، فيلزم أن يكون المعلول أشرف و أكمل من علته و هو بين الاستحالة.
23 - لو كانت زائدة للزم تركب الواجب، و بطلان التالي دليل على فساد المقدّم.
ص: 117
بيان الملازمة: أن الصفة - سواء كانت حادثة أو قديمة - إذا كانت عارضة له كانت مغايرة للموصوف بها، و كل متغايرين متمايزان بشيء و مشارك له بشيء آخر؛ و ذلك لاشتراكهما في الوجود، و محال أن تكون جهة الامتياز عين جهة الاشتراك (هكذا)، و إلا لكان الواحد بما هو واحد كثيراً، بل الوحدة بما هي وحدة بعينها كثرة، هذا محال، فإذن لا بد أن يكون كلّ منهما مركباً من جزء به الاشتراك و جزء به الامتياز فيكون الواجب مركباً!
ذكر هذه الوجوه الأربعة الفيلسوف الشهير صاحب الأسفار. لكنّها غير نقية عندي. أمّا الوجه الأول فالمقدّم فيها عين التالي، و هو عين دعوى الأشعري و ما قاله في إبطاله مصادرة؛ إ الخصم لا يسلّم أنّ ذاته الواجبة - وحدها - مبدأ الكائنات، بل المبدأ هي مع صفاتها الكمالية. فالصحيح أن يقرر هكذا: لو كانت زائدة لكانت ذاته مستكملة بغيره، و هو محال؛ لاستلزامه التركب لتغاير جهتي الفعل و الانفعال.
لكن يرد عليه: منع الاستكمال المستلزم للتركب كما أشرنا إليه سابقاً، و ذكره السبزواري في حاشيته على هذا المقام.
و أمّا الوجه الثاني ففيه منع الملازمة في الشرطية الثانية، إلا أن يرجع إلى ما قرّرناه في الحجة الرابعة، بل في ملازمة الشرطية الأولى أيضاً نظر، فلا حظ و تدبّر.
و أمّا الوجه الثالث فقوله: لأنّ ذاته مبدأ سلسلة الوجودات في مقام التعليل مصادرة، كما عرفت آنفاً، فلا بد من حذفه، و جعل الحكم - و هو وجوب كون الواجب أكمل ما يتصور - بيّناً عند العقل الفطري، أو مبيّناً بما تقدم منّا في مبحث استحالة النقص عليه تعالى، فتدبّر جيداً.
و أمّا قوله: فلو لم يكن كماله تعالى و مجده... فيصحّ جعله دليلاً مستقلاً، و لا يحتاج إليه في تكميل الوجه المذكور، لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال أو منع.
و أمّا الوجه الرابع فهو ساقط جداً، و إلا لجرى في أفعاله أيضاً، فلا بد من الالتزام إمّا بتركب الواجب، أو نفي الممكن الموجود رأساً، و هو كما ترى، و حلّه ما مرّ منّا سابقاً فتذكّر.
24 - لو كانت زائدة لكانت متأخرة ذاتاً عن الذات الواجبة، و كان الواجب في هذه المرتبة المتقدمة على الصفات المذكورة خالياً عنها و حاملاً لإمكانها.
و بالجملة: تلك المرتبة المتقدمة ظرف إمكان الصفات دون وجودها على الفرض، فيكون الواجب مشتملاً على جهة إمكانية، و الحال أنّ الواجب واجب من جميع الجهات.
25 - الوجود الواجبي أكمل أنحاء الوجودات بالضرورة، و كل واحد من الوجودات الناقصة الإمكانية محتاج في صدور آثاره عنه إلى صفات يصدر بواسطة كل قسم منها نوع أثر، فالاحتياج إلى الصفة في الصدور الأثر نقص في الوجود، فالوجود المستغني عنها أكمل أنحاء
ص: 118
الوجودات، و نتيجة ذلك عدم احتياج الواجب إلى الصفات في صدور الآثار، فلا تكون زائدة على ذاته تعالى.
26 - لو كان الواجب محلّاً لصفاته لكان قابلاً لها، و لا محالة يكون فاعلاً لها أيضاً، فيلزم كونه تعالى فاعلاً و قابلاً، و هو ممتنع.
استدل بهذه الوجوه الثلاثة اللاهيجي على العينية و بطلان الزيادة(1).
لكنّ الأول ممنوع؛ لما مرّ في فوائد المدخل في خواص الواجب في الجزء الأول من بطلان القاعدة المذكورة، أعني وجوب الواجب من جميع الجهات. و ثانياً أنّ تلك القاعدة - على فرض صحتها - لا تنافي إمكان الممكنات، بل مقتضاها وجوب الأشياء بالقياس إليه تعالى، و الأشعري قائل به، فإنّه يرى ضرورية ثبوت الصفات له تعالى خارجاً، و لأجل هذا صرح السبزواري في شرح المنظومة بأنّ هذه القاعدة لا تبطل مذهب الأشعري، بل مذهب الكرامية، و لعلّ كلامه تعريض بصاحبنا المستدلّ.
و الثاني ليس بمفيد لليقين، بل هو خطابي، فتدبّر.
و الثالث منسوب إلى مشهور المتأخرين، و قد مرّ بعض الكلام على أصل الكبرى، و هي امتناع كون الواحد فاعلاً و قابلاً، و لصاحب الأسفار حول هذا الوجه بحث طويل(2).
27 - لو كانت زائدة لكانت مرتبة الذات الخالية عنها، و معلوم أنّها خالية عن مقابلاتها أيضاً، و إلا لكانت مرتبة الذات عين السلوب لهذه الكمالات، و الخلوّ إنّ كان موضوعه الماهية التعمّلية كان إمكاناً ذاتياً، لكن لا ماهية للواجب تعالى، فموضوع ذلك الخلوّ وجود صرف هو حاقّ الواقع و متن الأعيان، و الخلوّ و الإمكان الذي في الموضوع الواقعي إمكان استعداي، و حامله مادة، و المادة لا بد لها من صورة، و المركب منهما جسم، تعالى عن ذلك.
و هذا الاستعداد هو مراد القوم من القبول المأخوذ في دليلهم، أي المتقدم هنا تحت رقم 26، و ليس مجرد الاتصاف، فلا غبار عليه عندي، ذكره المحقق السبزواري في حاشية الأسفار و شرح المنظومة.
و لكن أورد عليه بعض المعاصرين: بأنّ خلوّ الذات في مرتبته عن الكمال بمعني عدم كون الكمال نفس الذات، و لا جزءاً منها، لا يستلزم أن يكون نسبة هذا الكمال إليه بالإمكان، بل يمكن أن يكون ذاتياً له بالذاتي في باب البرهان... ثم إمكان الكمال يستدعي الموضوع، و هو الماهية التعمّلية التي هي ماهية ذاك الكمال، لا الماهية للموصوف و المعروض لذاك الكمال،
ص: 119
فتأمّل فيه.
هذا ماأردنا ذكره، و هنا وجوه أخر استدل بها على العينية، و لكن تركنا نقلها لظهور حالها ممّا مرّ، و الله ولي الهداية و الإرشاد.
الفائدة الأولى: في نقل روايات من أئمة آل محمد (ص)، إذ بها اطمئنان النفوس و اقتناع العقول، فإنّهم أعدال القرآن و أحد الثقلين، و الحقّ معهم و فيهم و بهم و منهم، و هم السفينة المنجية المحمدية، فإليك جملةً من كلماتهم الشريفة المباركة الحقّة:
1 - صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع)(1) أنّه قال في صفة القديم: «إنّه واحد صمد، أحدي المعنى ليس بمعاني كثيرة مختلفة»، قال: قلت: جعلت فداك، يزعم قوم من أهل العراق أنّه يسمع بغير الذي يبصر، و يبصر بغير الذي يسمع، قال: فقال: «كذبوا و ألحدوا و شبّهوا، تعالى الله عن ذلك، إنه سميع بصير، يسمع بما يبصر، بما يسمع...».
2 - رواية أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:(2): «لم يزل الله عز و جل ربنا و العلم ذاته و لا معلوم، و السمع ذاته و لا مسموع، و البصر ذاته و لا مبصر، و القدرة ذاته و لا مقدور...». و رواها الشيخ الطوسي (قدس سره) بنحو آخر(3).
3 - رواية هشام بن الحكم(4)، قال في حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد الله (ع): أنّه قال له: أتقول إنّه سميع بصير؟ فقال أبو عبد الله (ع): «هو سميع بصير، بغير جارحة، و بصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه و يبصر بنفسه، و ليس قولي: إنّه سميع بنفسه، إنّه شيء و النفس شيء آخر، و لكنّي أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولاً، و إفهاماً لك إذ كنت سائلاً، فأقول: يسمع بكلّه لا أنّ كلّه له بعض، لان الكل لنا «له خ» بعض، و لكن أردت إفهامك، و التعبير عن نفسي، و ليس مرجعي في ذلك كله إلا أنّه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف ذات و لا اختلاف معنى.
4 - رواية الحسين بن خالد(5)، قال: سمعت الرضا عليّ بن موسى (ع) يقول: «لم يزل الله تبارك و تعالى عالماً قادراً حيّاً قديماً سميعاً بصيراً»، فقلت له: يا ابن رسول الله، إنّ قوماً يقولون:
ص: 120
إنّه عزّ و جلّ لم يزل عالماً بعلم و قادراً بقدرة، و حيّاً بحياة، و قديماً بقدم، و سميعاً بسمع، و بصيراً به ببصر، فقال (ع): «من قال بذلك و دان به فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى، و ليس من ولايتنا علي شيء». ثم قال (ع): «لم يزل الله عزّ و جلّ عالماً حيّاً قديماً سميعاً بصيراً لذاته...».
5 - رواية أبان الأحمر، عن الصادق(1) (ع)، ففيها: فقلت له: إنّ رجلاً ينتحل موالاتكم أهل البيت، يقول: إنّ الله تبارك و تعالى لم يزل سميعاً بسمع، و بصيراً ببصر، و عليماً بعلم، و قادراً بقدرة، قال: فغضب (ع) ثم قال: «من قال ذلك و دان به فهو مشرك! و ليس من ولايتنا على شيء، إنّ الله تبارك و تعالى ذات علاّمة سميعة بصيرة قادرة».
6 - رواية هارون بن عبد الملك(2)، ففيها: قال الصادق (ع): «و الله نور لا ظلام فيه، و حيّ لا موت فيه، و عالم لا جهل فيه، و صمد لا مدخل فيه، ربنا نوري الذات، حيّ الذات، عالم الذات، صمدي الذات».
7 - رواية جابر، عن الباقر (ع)(3) قال: «إنّ الله تبارك و تعالى كان و لا شيء غيره، نوراً لا ظلام فيه، و صادقاً لا كذب فيه، و عالماً لا جهل فيه، و حيّاً لا موت فيه، و كذلك هو اليوم، و كذلك لا يزال أبداً».
أقول: قد مرّ وجه عدّ الصدق من الصفات الذاتية في ا لجزء الأول.
8 - رواية هشام بن سالم(4)، قال: دخلت على أبي عبد الله (ع) فقال لي: «أتنعت الله؟»، قلت: نعم، قال: «هات»، فقلت: هو السميع البصير، قال: «هذه صفة يشرك فيها المخلوقون»، قلت: فكيف ننعته؟ فقال: «هو نور لا ظلمة فيه، و حياة لا موت فيه، و علم لا جهل فيه، و حقّ لا باطل فيه».
9 - رواية ابن عيسى(5)، عن الصادق (ع)، ففيها: «لم يزل الله عليماً سميعاً بصيراً، ذات علاّمة سميعة بصيرة».
10 - صحيحة هشام بن الحكم، عن الصيقل، عن الصادق (ع)(6) قال: «إنّ الله علم لا جهل فيه، حياة لا موت فيه، نور لا ظلمة فيه».
ص: 121
11 - رواية يونس(1)، قال: قلت لأبي الحسن الرضا (ع): روينا أنّ الله علم لا جهل فيه، حياة لا موت فيه، نور لا ظلمة فيه. قال: «كذلك هو».
12 - رواية جابر الجعفى(2)، عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: «إنّ الله نور لا ظلمة فيه، و علم لا جهل فيه، و حياة لا موت فيه».
13 - مرسلة جامع الأخبار(3)، عن السجاد (ع): «قولوا: نور لا ظلام فيه، و حياة لا موت فيه، و صمد لا مدخل فيه».
14 - رواية فتح الجرجاني، عن ابي الحسن (ع)(4)، ففيها: «إنّه يسمع بما يبصر و يرى بما يسمع...».
15 - ما عن أمير المؤمنين(5) (ع): «تعالى عن ضرب الأمثال و الصفات المخلوقة علوّاً كبيراً».
16 - ما عنه أيضاً في خطبته المعروفة(6): «أول الدين معرفته، و كمال معرفته التصديق به، و كمال التصديق به توحيده، و كمال توحيده الإخلاص له، و كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كل صفة أنّه غير الموصوف، و شهادة كل موصوف أنّه غير الصفة، فمن وصف الله فقد قرنه، و من قرنه فقد ثنّاه، و من ثنّاه فقد جزّأه، و من جزّأه فقد جهله...».
17 - ما في خطبة الرضا (ع) المعروفة(7): «أول عبادة الله معرفته، و أصل معرفة الله توحيده، و نظام توحيد الله نفي الصفات عنه، لشهادة أنّ كل صفة و موصوف مخلوق، و شهادة كل موصوف أنّ له خالقاً، ليس بصفة ولا موصوف، و شهادة كل صفة و موصوف بالاقتران و شهادة الاقتران، بالحدث...». و مثله ما في خطبة أخرى لأمير المؤمنين (ع).
18 - مكاتبة فتح الجرجاني، عن الرضا (ع): «أول الديانة معرفته، و كمال المعرفة توحيده، و كمال التوحيد نفي الصفات عنه...».
هذا ما فزنا به عاجلاً، و م الظاهر أنّ المتتبّع يجد أكثر من ذلك، و كثرتها تجبر ضعف
ص: 122
أسانيد أكثرها إن شاء الله. و هذه الروايات الشريفة بين ما هو صريح، و بين ما هو ظاهر في عينية الصفات و إبطال زيادتها على الذات بلا شك و ريب. مع ذلك قال العلامة المجلسي (رحمه الله)(1): اعلم أنّ أكثر أخبار هذا الباب تدل على نفي زيادة الصفات، أي على نفي صفات موجودة زائدة على ذاته تعالى. و أمّا كونها عين ذاته تعالى بمعنى أنّه تصدق عليها، أو أنّها قائمة مقام الصفات الحاصلة في غيره تعالى، أو أنّها أمور اعتبارية غير موجودة في الخارج، واجبة الثبوت لذاته تعالى فلا نصّ فيها على شيء منها، و إن كان الظاهر من بعضها أحد المعنيين الأوّلين.
أقول: هذا من مثله عجيب جداً، بل و لم يكن متوقعاً منه، لكنّ الجواد قد يكبو. كيف و الروايات بأسرها - سوي الأربع الأخيرة الظاهرة في نفي الصفات - بين ما هو صريح و بين ما هو ظاهر في العينية؟! و قد مرّ عنه دعوى تواتر الأخبار عليها!
فتحصّل: أنّ العقل و النقل متّفقان على العينية و نفي الزيادة.
الفائدة الثانية: أنّ جملةً من أصحابنا - رضوان الله عليهم - أرجعوا صفاته الكمالية إلى نفي نقايضها، فمنهم الشيخ الصدوق، قال في توحيده(2): و إذا وصفنا الله تبارك و تعالى بصفات الذات فإنّما ننفي عنه بكل صفه منها ضدها. ثم ذكر أنّ المراد بالحياة و العلم و السمع و البصر و العزة و الحكمة(3) و العدل و الحلم و القدرة: هو نفي الموت و الجهل و الصمم و العمى و الذلة و الخطأ و الجور والعجلة و العجز. ثم علّل ذلك بقوله: و لو لم نفعل ذلك أثبتنا معه أشياء لم تزل معه. إلى آخره.
و منهم الفاضل المقداد(4)، قال: و إن شئت كان مجموع صفاته صفات جلال، فإنّ إثبات قدرته باعتبار سلب العجز عنه... و كذا باقي الصفات. و في الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس إلا السلوب و الإضافات، و أمّا كنه ذاته و صفاته فمحجوب عن نظر العقول، و لا يعلم ما هو إلا هو. انتهى كلامه. و قريب منه ما ذكره السيد شبّر(5) و غيره.
أقول: هذه النظرية رديئة جداً باطلة جزماً، و هي تفريط في باب المعارف الإلهية. كيف و قد عرفت أنّ العقل و الشرع يناديان بإثبات الصفات الثبوتية له، و أنّ الله علماً و قدرة و حياة و سمعاً، و بصراً؟! فارجاعها إلى نفي أضدادها تقهقر و ارتجاع عن السير العقلاني.
ص: 123
و اما ما ذكره الصدوق (رحمه الله) فهو ساقط بأن الصفات المذكروة عين الذات فلا شيء مع الله ازلاً.
و بالجملة: تعليله ينفي قول الأشعري القائل بزيادة الصفات على الذات، و لا ربط بما هو محلّ الكلام. و يلحق به في الضعف و البطلان ما ذكره المقداد (رحمه الله)، فإنّ اختفاء كنهه تعالى و امتناع الإحاطة بذاته و صفاته أجنبي عن المقام، فإنّا نعلم بالضرورة أنّه حيّ عالم قادر و إن لم نعلم حقيقة حياته و قدرته و علمه.
و بالجملة: المصير إلى ما دل عليه العقل و النقل متعين.
نعم، في رواية أبي هاشم الجعفري(1): قال الجواد (ع): «فقولك: إنّ الله قدير خبّرت أنّه لا يعجره شيء، فنفيت بالكلمة العجز و جعلت العجز سواه، و كذلك قولك: عالم إنّما نفيت بالكلمة الجهل، و جعلت الجهل سواه...».
لكن الرواية غير صالحة للاعتماد عليها؛ لعدم صحتها سنداً أولاً، و لمعارضتها بما عرفت ثانياً، و لعدم دلالتها على مرامهم حق الدلالة ثالثاً.
و يمكن أن يورد على هذا القول أيضاً: بأنّ تلك السلوب إن كانت متكثّرة متمايزة لزم تميّزها بأمر وجودي؛ لعدم الميز في العدم من حيث العدم، فيلزم التكثّر المنافي للوحدة. و إن لم تكن كذلك فهو بعينه نفي الصفات، كما قيل، فتأمل فيه.
و بالجملة: هذا القول ضعيف غايته.
الفائدة الثالثة: أنّ جمعاً من الجمهور تقليداً لشيخهم الأشعري ذهبوا إلى أنّ الله باقٍ ببقاء زائد على ذاته تعالى.
أقول: و هذا إنكار للواجب صريحاً، فإنّ احتياج الواجب في وجوده بقاءً إلى أمر ممكن - و هو صفة البقاء - عبارة أخرى عن إنكار الواجب الوجود خارجاً مجرّد انكار له بل انكار من طريق محال و هو احتياج الواجب إلى ممكن الوجود المحتاج إلى الواجب. و إن سألت الحق فلم يعرف الله و لم يعبده قوم غير الإمامية المتمسّكين بأذيال آل الرسول (ص). نعم، صدق نبينا الأعظم (ص) حيث قال: «مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا و من تركها هوى.
و الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا الله.
ص: 124
المقصد الخامس
في عدله تعالى
القاعدة الأولى: في أنّه تعالى لا يفعل القبيح
القاعدة الثانية: في أنّه تعالى لا يريد القبائح
القاعدة الثالثة: في حكم الشرع بما يحكم به العقل
القاعدة الرابعة: في تبعية أفعاله تعالى للأغراض
القاعدة الخامسة: في إبطال الجبر و التفويض، و تحقيق الأمر بين الأمرين
القاعدة السادسة: في وجوب الأصلح عليه تعالى
القاعدة السابعة: في وجوب اللطف عليه تعالى
القاعدة الثامنة: في حسن التكليف و لزومه و شرائط
القاعدة التاسعة: حول الآلام
القاعدة العاشرة: في الأعواض
القاعدة الحادي عشرة: في الرزق
القاعدة الثانية عشرة: في وضع ما يتوهّم تصادمه مع عدله حكمة تبارك و تعالى
ص: 125
ص: 126
عقد هذا المقصد للبحث عن كيفية أفعاله تعالى من حيث الحسن و القبح، و أنّ ما يصدر عنه تعالى كله حسن كله قبح فيه. و هذا المعنى و إن كان مسلّماً بين جميع المسلمين ظاهراً، بل و لعلّه بين الملّيّين قاطبة، إلا أنّ للأشاعرة مذهباًً يوجب اتصاف أفعاله بالقبح و الظلم و العبث، تعالى عنه، فعنون المتكلمون من الإمامية و من وافقهم من المعتزلة و غيرها هذا المقصد تنزيهاً لأفعاله تعالى عمّا يتزعّمه الأشعريون و أشباههم، و إيضاحاً لموارد يمكن أن يتوهّم فيها النقص في أفعاله، و الخلل في حكمته البالغة، و الجور في حكومته العادلة.
و أما تسميته ب - «العدل» فهي. إمّا من قبيل تسمية الكل باسم جزئه؛ إذ من مباحثه أنّه تعالى عادل لا يظلم عباده. و إمّ من جهة إرادة الوسط الحقيقي من العدل، و أنّ أفعاله تعالى منزّهة عن الإفراط والتفريط و سمّي المنزّهون ب - «العدلية» في مقابل مخالفيهم الأشاعرة.
و ممّا ذكرنا اتضح الفرق بين هذا المقصد و المقصد الثاني باعتبار تضمنه البحث عن صفاته الفعلية؛ إذ الهدف هناك إثبات أصل المعنى الفعل و كيفيته كما مرّ، بخلافه هنا فإنّ البحث من حيثية حسن أفعاله و نفي القبح عنها فقط(1). كما أنّه ظهر الفرق بينه و بين المقصد الثالث و الرابع، حيث إنّ الغرض منهما تنزيه ذاته المقدسة عن النقص و لوازم الإمكان، و المطلوب هنا تنزيه أفعاله عن القبح و اللغو، و ما لا ينبغي لحكمته البالغة، و جلالته الكريمة.
و أمّا ما ذكره المحقق اللاهيجي و ابنه من أنّ المراد بالعدل وجوب اتصاف واجب الوجود بالفعل الحسن و تنزيهه عن القبح ففيه نظر، فإنّه: إن أريد من الوجوب المزبو الوجوب الذي عنه فهو باطل، كما حقّقنا وجهه في مبحث الاختيار و إن أريد منه الوجوب الذي عليه فهذا و إن كان حقّاً غير أنّه مربوط بحكمته تعالى، فافهم، فالأصحّ ما ذكرناه أولاً من أنّ المراد بالعدل وجوب اتصاف أفعاله تعالى بالحسن و تنزيهها عن القبح.
ص: 127
من الضروريات البتّية: أنّ الأفعال الاختيارية تتصف بالحسن و القبح العقليين، بمعنى أنّ بعضها مذموم و بعضها ممدوح، و يكون فاعل الأول مستحقاً للذمّ و التحقير، كما أنّ فاعل الثاني مستأهل للمدح و التوقير. و هذا أمر واضح بديهي عند العقلاء، سواءكانوا من المتشرّعة، أم من الكفرة و الزنادقة و البراهمة، و بلا تفاوت فيه بين قوم و قوم، و حال و حال؛ و ذلك لأجل أنّ استحقاق المحسن للمدح، و المسيء للذمّ ممّا ارتكز في أذهان جميع البشر، و ممّا أودعه الله في كينونة الإنسان، فهو - بما له من الطوارئ المقسمة له من الأمكنة و الأزمنة و العنصرية و اللغة واللونية و الديانة و نحوها - مفطور و مجبول على الحكم بالمدح على بعض الأفعال و الذمّ على بعضها الآخر، فقولنا: إنّ بعض الأفعال حسن و بعضها قبيح - أي يستحق بعضها المدح و بعضها الذمّ من العقلاء - بمنزلة قولنا: إنّ الأكل يسدّ الجوع، و إنّ تعظيم الناس يسرّهم، و إنّ النائم غافل، و نحوها من الأمور الواضحة.
و إنّي لا أظنّ بأحد من العقلاء أن ينكر ذلك، بل إنّ نفسي مطمئنة بأنّ الجماعة الموسومة بالأشاعرة الذين كتبوا إنكار الحسن و القبح العقليين في بطون الأوراق(1) هم مثل غيرهم من العقلاء يعاملون معاملة المدح و الذمّ، فإنّ التخلّف عن الفطريات غير ممكن، فالإنكار مختص بالكتابة أو المناظرة فراراً من إلزامات خصومهم اللازمة لهم من بعض مذاهبهم الفاسدة، و إلا فالاشعري الناس! و لو وجد أحد ينكر الحسن و القبح لساناً و قلباً و عملاً فأنا أقسم صادقاً أنّه محروم من العقل، و أنّه غير مكلّف بشيء.
و بالجملة: حال المنكر للمقام حال الجبري و السوفسطائي، حيث إنّهما ينكران الاختيار و وجود الأشياء حين الكتابة و المناظرة فقط، و إلا فهما مثل الاختياري و الفلسفي في مرحلة الحياة العملية.
فهل يمكن لأشعريّ أن لا يمدح المحسن و لا يرضي ضميره بفعله الحسن، و لو فرضناه جاهلاً بالحكم الشرعي؟ و هل يمكن لجبري أن لا ينتقم من المجرم و الظالم، و يعامل مع القاتل مثلاً معاملة السيف في المعذورية؟! و هل يمكن لسوفسطائي أن لا يفرّ من موارد الضرر، بل و لا
ص: 128
يدفع الضرر المحتمل؟ كلاّ!
فإذا كان حديث التحسين و التقبيح العقليين بهذه المثابة من الجلاء و الظهور فمن اللغو أن نستدل على إثباتهما بشيء و العيان يغني عن البيان: «آفتاب آمد دليل آفتاب»(1).
ثم إنّ بعض المنكرين لمّا رأوا سخافة إنكارهم و شناعة كلامهم اخترعوا شيئاً و زعموا إمكان التستّر به، فجاؤوا بالتقسيم الثلاثي، و قالوا: إنّ للحسن و القبح معانٍ ثلاثة(2):
الأول: صفة الكمال و النقص، فالحسن كون الصفة صفة كمال، و القبيح كون الصفة صفة نقصان، يقال: العلم حسن، أي لمن اتصف به كمال و ارتفاع شأن، و الجهل قبيح، أي لمن اتصف به نقصان و اتضاع حال، و لا نزاع في أنّ هذا المعنى أمر ثابت للصفات في أنفسها، و أنّ مدركها العقل و لا تعلق له بالشرع.
الثاني: ملائمة الغرض و منافرته. فما وافق الغرض حسن، و ما نافره قبيح، و قد يعبّر عن الحسن و القبح بهذا المعنى بالمصلحة و المفسدة، فيقال: الحسن ما فيه المصلحة، القبح ما فيه المفسدة، و ما خلا عنهما لا يكون شيئاً منهما، و ذلك أيضاً عقلي، و يختلف بالاعتبار، فإنّ قتل زيد مصلحة لأعدائه و موافق لغرضهم، و مفسدة لأوليائه و مخالف لغرضهم.
الثالث: تعلق المدح و الثواب بالفعل عاجلاً و آجلاً، أو الذم و العقاب كذلك. فما يتعلق به المدح فهو حسن، و ما يتعلق به الذمّ قبيح. قالوا: و هذا الثالث هو محلّ النزاع، فهو عندنا شرعي، فإنّ الأفعال كلها سواسية ليس شيء منها في نفسه بحيث يقتضي مدح فاعله و ثوابه، و لا ذمّ فاعله و عقابه، و إنّما صارت كذلك بواسطة أمر الشارع بها و نهيه عنها.
و استدلوا عليه بوجهين:
الأول أنّ العبد مجبور في أفعاله، و الفعل الجبري لا يتصف بالحسن و القبح اتفاقاً.
الثاني: لو كان قبح الكذب ذاتياً لما تخلّف، و اللازم باطل، فإنّه قد يحسن إذا كان فيه عصمة دم مؤمن، بل يجب.
أقول: أمّا القسم الأول فهو و إن كان صحيحاً لكن نقول: هل تحصيل الكمال ممدوح عقلاً - و لو مع الغضّ عن الشرع - أم لا؟ و هل إبقاء النفس على النقيصة مذموم أم لا؟ فإن قالوا بالأول فقد بطل مذهبهم، و إن تلفّظوا بالثاني فقد كابروا وجدانهم، فكون الصفة كمالاً و حسنة أو نقصاناً و قبيحة لا ينفعهم شيئاً في محلّ النزاع، بل هو يستلزم المدح و الذمّ على الفعل، أي على
ص: 129
تحصيلهما استلزاماً عقلياً وجدانياً قرآنياً، فإنّ الله تعالى يمدح طالب الكمال و يذمّ الراجع إلى النقصان، فالتفكيك بينهما من التفكيك بين العلّة و المعلول.
و أمّا المعنى الثاني فهو من الأحكام العقلية بمراحل، فإنّه من الأمور الطبعية و الميول الغريزية؛ و لذا يختلف الحال باختلاف الطبائع و الأغراض، كما اعترفوا به، و من العجيب أنّهم ينكرون الحكم العقلي ثم ينسبون إليه ما ليس منه، و إن هو إلاّ الغيّ الفضيح.
و أمّا الثالث فقد عرفت أنّه في الجلاء و الظهور نظير قولنا: الكل أعظم من الجزء، فإنكاره سفسطة لا يعتنى به، و كيف يمكن التسوية بين العدل و الجور، و الجود و البخل، و الصدق النافع و الكذب الضارّ، و الإحسان و الإساءة؟ و كيف ينكر استحقاق المدح و الذمّ فيها؟ فهذا التثليث الأشعري لا ينفع شيئاً للفرار عن تلك الفضاحة و الشناعة، و هل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟!
و أمّا الوجه الأول من الاستدلال فلك أن تستدل على بطلان الكبرى ببطلان الصغرى، و لك أن تستدل على فساد الصغرى بفساد الكبرى، أو تترك الاستدلال و تحكم ببطلان كلتيهما معاً بلا بيان، فإنّ المقدمتين كل منهما ضروري البطلان بديهي الفساد.
و أمّا الوجه الثاني فيزيّفه ما سيأتي من أنّ الحسن و القبح ليسا بذاتيين، بل هما بالوجوه و الاعتبار، على أنّهما لو كانا ذاتيين لم يكن فيه إشكال أيضاً، فلا حظ المطوّلات.
ثم إنّ إنكار الحسن و القبح العقليين - مع كونه مخالفاً للضرورة - يستلزم أموراً شنيعة:
1 - عدم إمكان إثبات صدقه تعالى، كما مرّ في محله، فتسقط الشريعة و النواميس الدينية من رأس!
2 - عدم إمكان إثبات نبوة الأنبياء، كما مرّ أيضاً، و إنّ إجزاء المعجزة على يد الكاذب إذا لم يكن في نفسه قبيحاً لكان ممكن الصدور من الله تعالى، و معه لا دلالة للمعجزة على صدق صاحبها. و أما الاعتذار بجريان عادة الله تعالى الجاري مجرى المحال العادي على عدم مثل هذا الصدور، فمن أرذل الكلام و أسخف المقال.
فإنّا نقول: من أخبركم بجريان هذه العادة؟ هل القرآن بقوله: وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اَللّٰهِ تَبْدِيلاً(1) فهو نفسه محتمل الكذب حينئذ، أو الإجماع، فحاله حال الآية كما مضى، أو سوّلت لكم أنفسكم؟ و لأجله حكي عن بعض الحنفية أنّهم قالوا بهما (أي بالحسن و القبح الشرعيين) في أفعال العباد فقط! لئلاّ يتوقف وجوب تصديق النبي على الشرع فيدور.
3 - مخالفة القرآن المجيد، إذ فيه آيات بيّنات تدل على الحكم العقلي المذكور، فمنها
ص: 130
قوله: إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يَأْمُرُ بِالْفَحْشٰاءِ... (1)قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ (2)قُلْ إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ وَ اَلْإِثْمَ وَ اَلْبَغْيَ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ (3).
و منها قوله: إِنَّ اَللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْإِحْسٰانِ وَ إِيتٰاءِ ذِي اَلْقُرْبىٰ وَ يَنْهىٰ عَنِ اَلْفَحْشٰاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ وَ اَلْبَغْيِ (4)، و هي كثيرة جداً، فقد أخبر الله تعالى عن تحقق الفحشاء و الإثم و البغي و المنكر، و العدل و الإحسان و القسط قبل الأمر و النهي، فإن الموضوعات متقدمة على الأحكام، ثمّ تعلّق أمره بالطائفة الثانية، كما أنّ نهيه توجّه إلى الطائفة الأولى. و هذا واضح لكل عاقل، فلو فرض توقف هذه العناوين على الحكم الشرعي لزم الدور المحال، كما لا يخفى. و لا بد للأشعريين أن يؤوّلوا هذه الآيات على أصلهم الفساد هكذا: إنّ الله لا يأمر بما ينهى، أمر ربي بما أمر. إنّما حرم ربّي ما نهى...، و فساده واضح.
فتحصل: أنّ النواميس العقلية و الموازين الدينية تزيّفان موقف هؤلاء الناس في المسائل الأصولية.
فإن قلت: الحسن ما يثاب عليه، و القبيح ما يعاقب عليه، و من الظاهر أنّ الثواب و العقاب من قبل الله تعالى و بإخباره، و لا علم بهما لغيره، و هذا معنى كون الحسن و القبح شرعيين كما ذكره بعضهم. قلت: قد أجيب عنه بأنّ الموقوف على الشرع هو خصوصية الثواب و العقاب، و أمّا أصلهما فهو ثابت عقلاً.
أقول: الثواب و العقاب لا مدخلية لهما في تحقّق الحسن و القبح، بل الذي يلزمهم هو المدح و الذمّ العقلائيان. نعم، و حيث إنّ الله خالق العقلاء و عالم بالواقعيات و الأمور نفس الأمرية و ذو حكمة بالغة فيأمر بالحسن و ينهى عن القبيح، و يمدح المحسن بإحسانه و المسيء بإساءته، و مدحه ثوابه أو شيء آخر في الدنيا، و ذمّه على المحرّمات عقابه، و أمّا على المكروهات فهو شيء آخر كالعتاب أو حطّ المقام أو منع بعض الألطاف و نحوها، بل استحقاق الثواب غير لازم للحسن؛ لاشتراطه بالإيمان فضلاً عن الإسلام، و الموافاة عليه و قصد القربة و نحوهما. و كذلك العقاب مشروط بعدم العفو من الله تعالى و الشفاعة من أوليائه و التوبة من المذنب، مع أنّ الذّم لا يقبل الإسقاط عن القبيح، فلا ربط للعقاب و الثواب بالمدح و الذمّ، فافهم فإنّه حقيق به.
ص: 131
هل الحسن و القبح من الأحكام العقلية الأولية الداخلة في الضروريات، أو ممّا تطابقت عليه آراء العقلاء لعموم المصالح و حفظ النوع، فيكونان من المشهورات الداخلة في الجدليات؟ ظاهر المحق اللاهيجي بل صريحة هو الأول(1)، و واقفه السبزواري في محكيّ شرح الأسماء(2)، فحكم ببداهة مثل هذه القضايا، بل قال: إنّ الحكم ببداهتها أيضاً بديهي.
و نصّ بعض المحققين على الثاني، و إليك شطراً من كلامه(3)، قال:... و من الواضح أنّ استحقاق المدح و الذمّ بالإضافة إلى العدل و الظلم ليس من الأوليات بحيث يكفي تصور الطرفين في الحكم بثبوت النسبة، كيف و قد وقع النزاع فيه من العقلاء...؟ فثبت أنّ أمثال هذه القضايا غير داخلة في القضايا البرهانية، بل من القضايا المشهورة، و أمّا حديث كون حسن العدل و القبح الظلم ذاتياً فليس المراد من الذاتي ما هو المصطلح عليه في كتاب الكلّيات؛ لوضوح أنّ استحقاق المدح و الذمّ ليس جنساً و لا فصلاً للعدل و الظلم. و ليس المراد منه ما هو المصطلح عليه في كتاب البرهان؛ لأنّ الذاتي هناك ما يكفي وضع نفس الشيء في صحة انتزاعه منه، كالإمكان بالإضافة إلى الإنسان مثلاً، و إلا لكان الإنسان في حدّ ذاته إمّا واجباً، أو ممتنعا.
و من الواضح بالتأمّل أنّ الاستحقاق المزبور ليس كذلك؛ لأنّ سلب مال الغير - مثلاً - مقولة خاصة بحسب أنحاء التصرف، و بالإضافة إلى كراهة المالك الخارجة عن مقام ذات التصرف ينتزع منه أنّه غصب، و بالإضافة إلى ترتب اختلال النظام عليه بنوعه - و هو أيضاً خارج عن مقام ذاته - ينتزع منه أنّه مخلّ بالنظام و ذو مفسدة عامة، فكيف ينتزع الاستحقاق المتفرع على كونه غصباً و كونه مخلاً بالنظام، عن مقام ذات التصرف في مال الغير؟
بل المراد بذاتية الحسن و القبح...: أنّ العدل بعنوانه و الظلم بعنوانه يحكم عليهما باستحقاق المدح و الذمّ من دون لحاظ انداراجه تحت عنوان آخر، بخلاف سائر العناوين فإنّها ربّما تكون مع حفظها معروضة لغير ما يترتب عليه لو خلّي و نفسه كالصدق و الكذب فإنّهما مع حفظ عنوانهما في الصدق المهلك للمؤمن و الكذب المنجي للمؤمن يترتب استحقاق الذمّ على الأول بلحاظ اندراجه تحت الظلم على المؤمن، و يترتّب استحقاق المدح على الثاني لاندراجه تحت عنوان الإحسان إلى المؤمن، و إن كان لو خلّي الصدق و الكذب و نفسهما يندرج الأول تحت العدل في القول، و الثاني تحت عنوان الجور، فضلاً عن سائر الأفعال التي في نفسها لا
ص: 132
تندرج تحت عنوان ممدوح أو مذموم. انتهى كلامه.
أقول: اختلاف بعض العقلاء في شيء لا ينافي بداهته و أوليته، و لذا عدّوا احتياج الممكن من الأوليات، مع أنّ بعضهم أنكروه، و قالوا بالصدفة، فخفاء التصديق لأجل خفاء التصور أو لمانع آخر ممكن، و قد تقدم ذلك في الجزء الأول أيضاً، على أنّ الاختلاف الواقعي في المقام غير ثابت، بل إنكار المنكرين مجرد لقلقة لسانية و بناء قلبي من غير اعتقاد واقعي، كما أشرنا إليه عن قريب. و أمّا ذاتية قبح الظلم فيمكن أن تكون من ذاتيات كتاب البرهان، فإنّ الظلم - و هو سلب مال الغير بلا وجهٍ قانوني - يترتب عليه - بالضرورة - استحقاق الذمّ و اللوم، و هذا ممّا لا يقبل التشكيك أصلاً، فالظلم و إن لا ينتزع من مجرد التصرف في مال الغير و لا يصدق بمجرده، بل مع لحاظ عدم رضا المالك أو كراهته، لكنّ القبح لازم عنوان الظلم حين تحققه.
و بالجملة: الظلم ليس من لوازم مجرد سلب المال و ضرب اليتيم مثلاً، بل من لوازم السلب و كراهة المالك و الضرب بلا قصد التأديب، كما أفاده هذا المحقق، لكنّ هذا لا ينافي كون القبح لازماً - أي ذاتياً في كتاب البرهان - لعنوان الظلم مثلاً، فإنّا لا نعني بالذاتي إلا ما لا يمكن انفكاكه عن موضوعه بوجه، و المقام كذلك.
فإن قلت: الحكم بحسن العدل و قبح الجور ليس من أحكام العقل النظري، و لا يجزم به بمجرده، كما يظهر ذلك لمن فرض نفسه مخلوقه الساعة بلا ممارسة شيء، فهذا دليل على أنّه من المشهورات دون الأوليات.
قلت: و هذا السؤال هو العمدة في المقام، و جوابه: أنّ أصل القضية ضرورية أولية، غير أنّ تصور الموضوع - و هو العدل و الظلم - موقوف على الممارسة و إدراك ألم الظلم و راحة العدل، و هذا كما أنّ الحكم بأعظمية الكلّ من الجزء موقوف على مشاهدتهما أو معرفتهما من تعريف معرّف.
و على الجملة الأوّلي هو النسبة التصديقية، لا تصور الموضوع، فافهم، و لعلّ هذا هو مراد المحقق اللاهيجي، حيث ذكر أنّ العقل النظري بحكم به بواسطة العقل العملي، على أنّ الفرق بين الأحكام العلمية و العملية محلّ خلاف، و على بعض الأقوال يدخل المقام في الأول دون الثانية، و أمّا عدّهما - أي حسن العدل و قبح الجور - من المشهورات في كتب المنطق فلعلّه لاءجل التمثيل للمصلحة و المفسدة العامتين المقرون بهما قبول عموم الناس، لا طائفة مخصوصة، و هذا غير منافٍ لبداهتهما؛ إذ القضية الواحدة يمكن دخولها في اليقينيات و المقبولات باعتبارين، كما ذكره المحقق اللاهيجي و المحقق السبزواري أيضاً.
ثم لو فرضنا أنّ الحكم المزبور من المشهورات فلا شك في اعتباره و قطعيته أيضاً؛ إذ كون
ص: 133
قضية من المشهورات لا يوجب اندراجها في المظنونات، كيف و هي تقابل المشهورات في التقسيم المتقدم ذكره في الجزء الأول؟ بل المشهورات التي يتطابق عليها عموم الآراء تفيد العلم، و لكن لا يعتبر فيها مطابقة الواقع، بل المطابقة لآراء العقلاء، الكاشفة عن حكم رب العقلاء الكاشف للواقع. و هذا بخلاف الضروريات فإنّها تفيد العلم و تطابق الواقع أيضاً(1).
الأمر الأول: لا شك في حسن الواجب و المندوب، كما أنّه لا ريب في قبح الحرام، و إنّما الكلام في المباح و المكروه، ظاهر كلام المحقق الطوسي (قدس سره) بل صريحه في التجريد أنّهما داخلان في الحسن، قال: الفعل المتصف بالزائد إمّا حسن أو قبيح، و الحسن أربعة... إلى آخره. و لا بد حينئذٍ من تفسير الحسن بما لا مدح فيه و لا ذم، كما صنعه العلامة (رحمه الله) في شرحه(2)، فإنّ المباح كذلك، و أمّا المكروه فالمدح يتعلق بتركه و لا يستحق الذم بفعله. و أمّا غير المتصف بأمر زائد فمثّل له بحركة الساهي و النائم.
هذا، و أدرج بعضهم المكروه في القبيح، لكنّ الأصح إخراج المباح من الحسن و اختصاصه بالواجب و المندوب فقط، فإنّ الحسن ليس إلا ما استحق فاعله المدح، و هذا غير جارٍ في الإباحة، و أمّا الكراهة فالأوفق درجها في القبيح؛ لترتب الذم على فعلها و إن كان أخف من الذم المتعلق بالحرام، فالمباح كحركة النائم - مثلاً - ليس من الحسن و لا من القبيح.
فالمتحصّل: أنّ الأحكام العقلية خمسة(3): الوجوب و الحرمة و الإباحة و الكراهة و الاستحباب، اثنان منها حسن، و اثنان منها قبيح، و واحد منها غير متصف بشيء منهما.
نعم، اصل وجود المباح العقلي قد وقع محلّ النزاع، حيث إنّ المحقق القمي (قدس سره) استشكل فيه، و يظهر من مطارح الأنظار ارتضاؤه إيّاه. و لكنّ صاحب الفصول (رحمه الله) قال بصحة المباح المذكور و لم يحسن توجيه القوانين، فلاحظ.
الأمر الثاني: أنّ الحسن و القبح يختصان بالأفعال الاختيارية و صورة العلم بالموضوع،
ص: 134
ضرورة عدم تعقل الذم و اللوم و المدح و الثناء على الأفعال الاضطرارية، فإذا قتل أحد مؤمناً صالحاً باعتقاد أنّه ملحد مفسد أو اضطر إلى قتله لا يستحق اللوم. نعم، القبح و الحسن الفعليان (أي المفسدة و المصلحة الواقعيتان) لا يتعلقان بالعلم و الجهل و الاختيار و الاضطرار، فافهم، فقتل المؤمن خطاً و جهلاً و إن لم يكن له قبح فاعلي، بل ربما يكون له حسن فاعلي لكن له مفسدة نفس أمرية غير قابلة للزوال لأجل الجهل مثلاً. و مثله الحسن و القبح بمعنى الكمال و النقصان و موافقة الطبع و منافرته فإنّهما لا يختصان بصورة الاختيار، كما لا يخفى.
الأمر الثالث: اختلف المتكلمون و غيرهم في كيفية اتصاف الأفعال بالحسن و القبح على أقوال:
فمنها: أنّ الشرع أوجب اتصافها بهما، و قد عرفت أنّه ضروري البطلان.
و منها: أنها لذاتها تتصف بهما.
و منها: أنّ اتصافها بهما لأجل صفة كائنة فيها، و في مطارح الأنظار: أنّ المراد هي الصفات اللازمة لنفس الماهيات على وجه يكفي في انتزاعها تحقق الماهية.
و منها: أنّ الاتصاف بالقبح لأجل الصفة المذكورة، و أمّا بالحسن فلا؛ إذ انتفاء الصفة المقبحة يكفي لحسن الفعل.
و منها: التفصيل بحسب الموارد، بمعنى كونهما ذاتيين في بعضها، أي أنّ الفعل علة تامة لهما، و بالاقتضاء في بعضها و بالوجوه و الاعتبار في بعضها اختاره بعض الأصوليين في حواشيه على رسائل الشيخ الأنصاري (قدس سره)، و كذا المحقق النائيني (قدس سره)(1).
و منها: التفصيل بحسب الموارد أيضاً، و أنّهما في بعض الموارد ذاتيين، و في بعضها الآخر بالوجوه و الاعتبار. و لعلّه يرجع إلى السابق بأن يراد من الذاتي ما هو الجامع بين الضرورة و الاقتضاء.
ذهب إليه الأصولي المحقّق صاحب الفصول (قدس سره) و قال: و هذا بعد التنبيه عليه مما لا خفاء فيه. فكأنّه جعله من الضروريات. و الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) على ما في تقريرات بعض تلامذته المسماة ب - «مطارح الانظار»، بل فيها: و لعلّ هذا ما ذهب إليه الإمامية بأجمعهم على حسب ما يظهر منهم...، و لذا لا يلتزمون بالنسخ في جميع الأحكام، كما صرح به الشيخ في العدّة و العلامة في النهاية، و جماعة من متكلمي الإمامية... إلى آخره.
و منها: أنّ ثبوت الحسن في الجملة بمجرد الذات دون القبح؛ لتوقفه على بعض
ص: 135
الاعتبارات، مال إليه بعض الأجلاّء في كتابه هداية المسترشدين. (حاشية معالم الأصول)
و منها: إناطتهما بعلم الشخص بالمفسدة والمصلحة، و عدمهما بعدمه.
و منها: أنّهما بالوجوه و الاعتبار مطلقاً(1)، فهذه ثمانية أقوال.
و الصحيح الأحقّ بالتصديق هو القول الأخير، و ما سواه باطل لا يحسن الاعتماد عليه.
بيان ذلك: أنّ ما يصدر عن الإنسان - مثلاً - من أفعاله الاختيارية له اعتبارات مترتبة:
1 - نفس الفعل و ذاته بلا اعتبار تحيّثه بحيثية تعليلية أو تقييدية أصلاً، كحركة اليد، و حركة اللسان، و حركة الرجل، و حركة العين، أو عضو آخر من أعضاء بدنه. و من الواضح عدم اتصاف اللسان، و حركة الرجل، و حركة العين، أو عضو آخر من أعضاء بدنه. و من الواضح عدم اتصاف الفعل في هذه المرحلة بحسن و قبح و لا ذم و مدح.
2 - الفعل مع اعتبار تعنونه بعنوانه الأولي، كتعنون حركة اليد بالضرب، و إيتاء المال، و الإمرار على رأس اليتيم، و الأخذ، و الكتابة، و الخياطة، و نحوها. و تعنون حركة اللسان بالتلفظ، و اللسع، أو بالأكل و الشرب مع ضميمة حركة الفم. و تعنون حركة الرجل بالمشي، و تعنون حركة العين بالنظر، إلى غير ذلك من العناوين، و هي و إن توجب تنوع الفعل و انقسامه إلى أنواعه - كما لا يخفى - لكنّها لا تقتضي ذمّاً و لا مدحاً بمجردها، و لا تتصف بالحسن و القبح عند العقلاء، و هذا أيضاً ظاهر لاخفاء فيه.
3 - الفعل مع تعنونه بعنوانه الثانوي، كالإيذاء، و التأديب، و الإحسان، و الاغراء، و التصرف في مال نفسه أو في مال غيره، و الدعاء، و الإرشاد، والتحية، و السبّ، و الغيبة، و الكذب، و سدّ الجوع، و الأكل بلا شهوة. و الذهاب إلى مسجد أو ملعب. و النظر إلى خضرة أو مصحف أو أجنبية، إلى غير ذلك من العناوين، و هذه العناوين المذكورة لا تكون منوعة للفعل بل مقسّمة له إلى أصنافه.
و الفعل في هذه المرتبة غالباً يتصف بالحسن أو القبح، و يترتب عليه المدح أو الذم، فيلام المؤذي على إيذائه، و المغري علي إغرائه، و يمدح المحسن على إحسانه، و الواعظ على وعظه، و هكذا، و هذا بيّن.
و إنّما قلنا غالباً لأنّ العنوان المذكور ربما لا يقتضي الحسن أو القبح، بل يحتاج في عروضه إلى عنوان ثالث، كالتصرف في المال فإنّه إن كان في مال نفسه بغير إسراف فهو مباح، و إن كان في مورد ضروري فهو حسن، و إن كان صرف على نحو الإسراف فهو كالتصرف في مال
ص: 136
الغير من غير إذنه قبيح، و هكذا.
ثم إنّ عنوان المحسن أو المقبح إمّا علة تامة للحكم المذكور بحيث يستحيل زواله مع التحفظ عليه - أي على العنوان المذكور - كالعدل و الظلم، فإنّ الأول حسن دائماً، و الثاني قبيح كذلك. و إمّا مقتضٍ له بحيث يمكن زواله بطروء مانع كالصدوق و الكذب، فإنّ هذين العنوانين بنفسهما يقتضيان الحسن و القبح، و لكن إذا صار الصدق ضارّاً و الكذب نافعاً ينعكس الحكم، و هذا أيضاً ظاهر.
إذا تقرر ذلك فقد اتضح لك صحة القول الأخير، فلا نطوّل المقام بإبطال بقية الوجوه واحداً واحداً.
و أمّا ما ذكره في مطارح الأنظار من استظهار القول الخامس من الإمامية فهو غير ثابت، و ما ذكره دليلاً له غير صالح، كما لا يخفى على البصير العارف.
و يمكن أن يجمع بين الأقوال السبعة و جعل النزاع لفظياً، بأن يراد بالذاتية الأفعال بعناوينها الثانوية، أو الثالثة، و بالصفة الوجوه و الاعتبار، و بالحسن في التفصيل الثالث ما لا يذم و لا يمدح على فعله كما هو أحد الاصطلاحين، و مثله القول السادس. و في التفصيل الرابع و الخامس بالذاتية ما عرفت كعنوان الظلم، و بالمقتضي كعنوان الصدق مثلاً، و بالوجوه و الاعتبار تحقق الفعل بعنوانه الأولي. و أمّا انتفاء الحكمين في صورة الجهل فقد عرفت سرّه في الأمر الثاني، فالقول السابع ليس من التفصيل في شيء، فافهم.
قال في مطارح الأنظار: ثم إنّ أصحاب هذا القول - أي الأخير - بين معمّم في الوجوه و الاعتبارات حتى العلم و الجهل، سواء كانا متعلقين بالصفة أو الموصوف. و مخصص بالموصوف فقط، و مخصص بغيرهما. فعلى الأول ما لم يعلم بالظلم و لقبحه(1) لا يكون قبيحاً. و على الثاني لو جهل بالظلم لا يكون قبيحاً. و على الثالث فهو قبيح مطلقاً. انتهى.
أقول: الصحيح هو القول الوسط؛ فإنّ كون العلم و الجهل من الوجوه و الاعتبارات ممّا اتضح في الأمر الثاني. و أمّا اختصاصهما بالموصوف دون الصفة فلأجل الدور؛ فإنّ العلم بالحسن و القبح موقوف على الحسن و القبح المذكورين، ضرورة تبعية العلم للمعلوم، فلو توقّفا على العلم بهما للزم الدور.
و بالجملة: التصويب غير ممكن، سواء في الأحكام الشرعية و الأحكام العقلية. إذا تقررت هذه المقدمات نرجع إلى البحث عن نفس المقصد و تكميله في ضمن قواعد:
ص: 137
تنزيه فعله عن القبيح مما لا خلاف فيه، بل قيل: إنّ الملّيين أجمعوا عليه.
أقول: و دليله واضح، فإنّ الواجب عالم بجميع جهات الأشياء، و اعتباراتها المحسّنة و المقبّحة، و قادر على جميع الأمور الممكنة، و غني عن كل شيء، و ليس له شهوة و حاجة إلى شيء.
و على الجملة: ليس فيه مبدأ سوى المبدأ الفكري العقلي، فلا يعقل القبيح بالضرورة، بل مرّ في مبحث حكمته تعالى أنّه لا يصدر الفعل عنه إلا على أكمل أنحاء ما يمكن صدوره.
و على الجملة: اتصاف أفعاله بالحسن ممّا لا خفاء فيه بعد التوجه إلى ثبوت الحسن و القبح للأفعال في أنفسها، مع قطع النظر عن الشرع، فإنّ القبيح مما يتنافره العقول فكيف بخالق العقول و العلوم؟
و أمّا المنكرون للحسن و القبح فيقولون: لا قبح بالنسبة إليه! فكل ما يفعله - و لو كان تعذيب أنبيائه المعصومين - فهو حسن! فأسندوا جميع القبائح الموجودة إلى الله تعالى، و التزموا - في مقام البحث - بأنّ أفعال العبد مخلوقة لله تعالى و مع ذلك كان العبد هو المسؤول المعاقب على قبائحها!! و لكنّه ظلم بحث أسندوه إلى الله تعالى و الله - بحكمته و عدله - بريء عنه، قال الله تعالى: وَ مَا اَللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبٰادِ(1)، و قال: وَ لاٰ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً(2)، و قال: وَ مٰا ظَلَمْنٰاهُمْ وَ لٰكِنْ كٰانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (3) إلى غير ذلك من الآيات القرآنية، فقد أخبر أنّه عادل لا يظلم أحداً. و هذه الآيات ظاهرة في أنّ هنا قوانين نفس أمرية لا بد من رعايتها، و أنّ التعدّي عن حدودها ظلم و قبيح؛ و لذا نفاه الله عن نفسه. و توهّم أنّ نفيه تعالى الظلم عن نفسه بانتفاء الموضوع، و أنّه لا موضوع للظلم في حقه؛ لأنّه المالك المطلق تمزيق لدلالة الآيات الشريفة
ص: 138
المتقدمة، كما لا يخفى على العارف باللغة.
و أمّا حديث ملكيته تعالى فهو لا يفيدهم شيئاً؛ لأنّ للملكية حدوداً معينة لا يجوز تجاوز المالك عنها، ألا ترى أنّ المالك لعبد إذا أراد تعديبه و إحراقه بلا جهة أعدّ عند العقلاء سفيهاً ظالماً يستحق اللوم و الذم. فالملكية لا تبيح القبائح العقلية أصلاً(1) قال الله تعالى: وَ مٰا كٰانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ اَلْقُرىٰ بِظُلْمٍ وَ أَهْلُهٰا مُصْلِحُونَ (2)، فالله سبحانه و إن كان قادراً على كل شيء لكنّ حكمته البالغة لا تجوز له فعل القبيح أصلاً.
فتحصّل: أنّ أفعاله متصفة بالحسن، بل مرّ أنّ فعل الحسن لازم عليه، فافهم.
قد تكرّر في لسان العدلية في مباحث هذا المقصد: أنّه يجب على الله تعالى كذا، و أنّه لا يجوز له كذا، و ظن بعض من لا تحصيل لهم أنّ هذا يستلزم كونه تعالى مأموراً لغيره، و أنّ غيره حاكم و آمر عليه، فلذا أنكروه قائلين: إنّه لا آمر بالنسبة إليه تعالى، بل هو الحاكم المطلق، و حينئذٍ لا بد من بيان الوجوب المذكور ليتضح الحال.
فنقول: إنّهم عرّفوا الواجب بتعاريف ثلاثة:
1 - إنّه ما يستحق تاركه الذم عند العقل.
2 - إنّه ما لا يلزم صدوره؛ لإخلاله بالحكمة لو لم يصدره.
3 - إنّه ما على الله أن يفعله البتّة و إن جاز تركه.
أقول: مرجع الكل شيء واحد كما هو ظاهر. نعم، لا بد من تقييد الذم الماخوذ في التعريف الأول بمرتبة خاصة؛ لئلاّ يشمل المستحب العقلي أيضاً، فتأمل. و المراد بالجواز في التعريف الأخير هو الإمكان، فإنّ القبيح مقدور يمكن صدوره عن الله تعالى، لكنّه لا يفعله لحكمته، و هذا كما أنّ العقلاء قادرون على القبائح و لكنّهم لا يرتكبونها؛ لدلالة عقولهم على قبحها و لزوم الاجتناب عنها.
و الحاصل: أنّه تعالى قادر على كل شيء، لكنّه لكمال ذاته و جلال وجهه لا يفعل ما هو مذموم و شنيع البتّة بحكم العقل و إدراكه، و نسمّي هذا الإدراك بالوجوب، فإذا قلنا: إنّه يجب
ص: 139
على الله تعالى كذا، نعني به أنّ الله تعالى يفعل الأمر لحكمته البالغة البتّة.
و بتعبير آخر: الوجوب الذي نثبته على الله تعالى ليس بمعنى البعث إلى متعلقه، و لا الزجر عن تركه كماهما المتبادران من الحكم، بل المراد به إدراك العقل، الواقع و ما هو ثابت في نفس الأمر، على حذو قولنا: العقل يحكم باستحالة اجتماع النقيضين(1)، لكنّ المنكرين خلطوا بين الموردين، فاعترضوا بأنّه لا حاكم - أي لا باعث و لا زاجر - على الله تعالى!
و أنت بملاحظة ما ذكرناه تقدر على إبطال جميع أغلاطهم و شبهاتهم في المقام، كقولهم: إنّ الوجوب حكم، و الحكم لا يثبت إلا بالشرع، فإنّ الحكم في الصغرى بمعنى الإدراك فتبطل الكبرى.
و قولهم: لو وجب عليه تعالى شيء فإن لم يستوجب الذم بتركه لم يتحقق الوجوب؛ لأنّ الواجب ما يستحق تاركه الذم، و إن استوجب تركه الذم كان الباري ناقصاً لذاته مستكملاً بفعله؛ فإنّه حينئذٍ تخلص بفعله من المذمة، و هو محال. نختار الشق الثاني، و لا يلزم منه النقص و الاستكمال، فإنّ المذمة غير متحققة قبل فعله؛ حتى لا يمكن التخلّص عنها إلا بفعله الحسن، بل المراد أنّه لا يفعل شيئاً يستحق به الذم المترتب عليه، فأين هذا من النقص؟! و الشبهة سخيفة جداً و قولهم - إيراداً على التعريف الثاني -: و لله تعالى في كل فعل ترك مصالح لا تحصى فلا يخلّ بالحكمة، و لو سلّم فلزوم الصدور المذكور يوجب عدم تمكنه من الترك، و هو ينافي الاختيار.
نقول: إنّ الشقّ الأول رجم بالغيب، و افتراء على القادر الحكيم العادل، بل هو لا يترك مصالح غير مزاحمة بما هو أقوى منها. و الشقّ الثاني ساقط جداً، فإنّ اللزوم المذكور لا ينافي اختياره، بل هو معلول اختياره، فإنّه باختياره لا يفعل القبيح، و هذا ظاهر، فإنّ العقلاء مع قدرتهم على القبيح وجداناً لا يفعلونه اختياراً.
و نختم الكلام في هذه القاعدة بما روي عن مولانا أمير المؤمنين (ع)(2): «التوحيد أن لا تتوهّمه، و العدل أن لا تتّهمه».
و عن ابنه مولانا الصادق (ع)(3): «أمّا التوحيد فأن لا تجوز على ربك ما جاز عليك، و أمّا العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لآمك عليه».
و هاتان الكلمتان القيّمتان مشتملتان على جميع مباحث العدل و التوحيد.
ص: 140
ذهب الإمامية و المعتزلة إلى أنّه تعالى لا يريد القبائح، و لا يكره المحاسن، بل يريد المحاسن و يكره المساوي. و قيل: إنّه من أصول الإمامية، و منكره خارج عن المذهب، و برهانهم عليه أمور:
1 - إنّ إرادة القبيح مثل فعله، و كراهة الحسن كتركه قبيحتان. قال المحقّق الطوسي على ما في نسخة القوشجي: و إرادة القبيح قبيحة، و كذا ترك إرادة الحسن قبيح، و كذا الأمر بما لا يراد قبيح، و النهي عمّا يراد أيضاً قبيح.
2 - لو كان القبيح مراداً له لكان العاصي مطيعاً بعصيانه، حيث أوجد مراد الله و عمل على وفقه، و ضرورة بطلان التالي تبطل المقدّم.
3 - إنّ الله تعالى أمر بالطاعات و نهى عن المعاصي، و الأمر و النهي يستلزمان الإرادة و الكراهة بالضرورة.
4 - لو لم يكن مريداً للمحاسن و كارهاً للقبائح، بل أراد الكل للزم أن يأمر بما يكره؛ لأنّه أمر الكافر بالإيمان و كرهه منه حيث لم يوجد - كما يتخيّله الأشعري - و أن ينهى عمّا يريد، لأنّه تعالى نهاه عن الكفر و أراد منه حيث وجد، و هذه سفاهة بيّنة ينزه عنها فعل الحق الحكيم العدل.
5 - لو أراد الكفر من الكافر كان الأمر بإيمانه تكليفاً بما لا يطاق، فإنّ خلاف مراده تعالى ممتنع الصدور، و التالي باطل عقلاً و نقلاً.
6 - لو كان مريداً للجميع لكان مريداً لكثير ممّا كرهه الأنبياء و أراده الشياطين، و لو كان كارهاً لكل ما لم يقع لكان كارهاً لكثير ممّا أراده الأنبياء وكرهه الشياطين، و التالي باطل قطعاً و اتفاقاً، و الملازمة ظاهرة.
7 - الكتاب العزيز، ففيه آيات بيّنات على ذلك فمنها قوله تعالى: سَيَقُولُ اَلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شٰاءَ اَللّٰهُ مٰا أَشْرَكْنٰا وَ لاٰ آبٰاؤُنٰا وَ لاٰ حَرَّمْنٰا مِنْ شَيْ ءٍ كَذٰلِكَ كَذَّبَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (1)، و منها
ص: 141
قوله: وَ مَا اَللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبٰادِ(1) و منها قوله: كُلُّ ذٰلِكَ كٰانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً(2)، و منها قوله تعالى: وَ اَللّٰهُ لاٰ يُحِبُّ اَلْفَسٰادَ(3)، و منها قوله: وَ لاٰ يَرْضىٰ لِعِبٰادِهِ اَلْكُفْرَ وَ إِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ (4)، إلى غير ذلك.
و ذهب الأشاعرة إلى أنّه تعالى مريد لجميع ما وقع، و كاره لكل ما لم يقع، فكل كائن مراد، و ما ليس بكائن ليس بمراد، و استدلوا على القضية الإيجابية أولاً: بأنّه خالق الأشياء كلها، و خالق الشيء بلا إكراه مريد له بالضرورة.
و ثانياً(5): بأنّ الأشياء مقدورة له، فلا بد من اختصاص بعضها بالوقوع و بأوقاتها المخصوصة من مخصص و هو الإرادة، فإنّها هي الصفة المرجّحة لأحد المقدورين.
و على القضية السلبية أولاً بأنّه لو أراد من الكافر الإيمان و من العاصي الطاعة لزم أن لا يحصل مراد الله تعالى، و يحصل مراد العاصي و الكافر؛ إذ المفروض وقوع مرادهما، لا مراده تعالى، فيكون مغلوباً لهما في إرادته.
نقلوا أنّ عبد الجبار المعتزلي دخل دار صاحب بن عباد الإمامي، فرأى أبا إسحاق الأشعرى، فقال: سبحان من تنزّه عن الفحشاء، فقال الأشعري المذكور: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء!
و ثانياً: أنّه علم وقوع ما ليس بكائن فعلم استحالته؛ لاستحالة انقلاب علمه جهلاً، و العالم باستحالة الشيء لا يريده البتّة، و لو أراده فإمّا يقع فهو يستلزم جهله تعالى عنه، و إمّا لا يقع فهو يستلزم عجزه.
و ثالثاً: بالكتاب المجيد، كقوله تعالى: وَ لَوْ شٰاءَ اَللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اَلْهُدىٰ (6)، و قوله: أَنْ لَوْ يَشٰاءُ اَللّٰهُ لَهَدَى اَلنّٰاسَ جَمِيعاً(7)، و قوله: أُولٰئِكَ اَلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اَللّٰهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ (8)، و تطهير القلب بالإيمان فلم يرد الله إيمانهم.
ص: 142
و أيّدوا قولهم بإجماع السلف على إطلاق قول النبي الأكرم (ص): «ما يشاء الله كان، و ما لم يشأ لم يكن».
هذا ما ذكره أهل الحق و خصومهم في المقام، و يقع البحث في أصل المدّعى أولاً، و في صحة الدلائل و سقمها ثانياً.
فنقول: أمّا مدّعى الأشعرية فهو ظاهر، فإنّهم يزعمون استناد جميع الموجودات و منها أفعال الحيوان الاختيارية إلى إرادة الله تعالى ابتداءً، من دون التزام بقانون العلّية و المعلولية الذي هو من قطعيات الحكمة النظرية، و من دون إقرار بقاعدة التحسين و التقبيح التي هي من ضروريات الحكمة و العملية، و لا شك في بطلان هذه المقالة و سخافتها كما عرفت هنا، و ستعرفه أيضاً في مسألة إبطال الجبر و التفويض و إثبات الأمر بين الأمرين.
و أمّا مدّعى العدلية فهو بظاهره لا يخلو من غموض، فإنّهم بعد ما أنكروا على الأشاعرة عموم تعلق إرادته تعالى بجميع الأشياء قالوا: إنّ أفعاله كلها مرادة له؛ لأنّها لا تكون إلا حسنة، و أمّا أفعال غيره الاختيارية: فإن كانت حسنة فهي مرادة له تعالى، و إلا فليست بمرادة.
أقول: و هذا باطل قطعاً و اتفاقاً، فإن معناه أنّ المحاسن واقعة بقدرة الله و إرادته، و المعاصي واقعة بإرادة العبد، و الأول جبر محض، و الثاني تفويض صرف، فافهم. و هذا التفصيل مما لم يلتزم به أحد فيما أعلم، فإنّ المعتزلة تقول بالتفويض في جميع الأفعال، و الإمامية تذهب إلى الأمر بين الأمرين مطلقاً، فما معنى هذا التفصيل؟!
هذا، مع أنّ البحث عن تعلق إرادته بالقبيح بعد البحث عن أنّه لا يفعل القبيح - كما تقدم - لغو، ضرورة أنّ تركه القبيح يستكشف عن عدم تعلق إرادته النافذة به، و إلا لم يتخلّف عنها، فتدبر، و لا سيّما إذا فسّرنا إرادته تعالى بنفس الإيجاد و الإحداث كما لعله مذهب معظم الإمامية و جملة من المعتزلة على ما سلف تحقيقه و تفصيله في الجزء الأول فإنّ المسألتين تتحدان حينئذٍ.
لكنّ الظاهر أنّ مرادهم بالإرادة هنا هي الإرادة التشريعية بمعنى الطلب، فمعنى كلامهم أنّ الله يطلب الطاعات دون المعاصي، و هذا شيء لا يمكن الشك فيه أبداً، فإنّه من أوضح البديهيات عند الملّيين. و ممّا يدل على إرادتهم هذا المعنى من الإرادة المبحوث عنها في المقام: عبارة المحقق الطوسي (قدس سره) في قواعد العقائد(1): و المعتزلة قالوا: إنّه يريد ما يفعله، و أمّا يفعله العباد
ص: 143
فهو يريد طاعته و لا يريد معصيته. و هذه الإرادة غير الإرادة الأولى في المعنى. انتهى. أي غير إرادته المتعلقة بفعله فإنّها تكوينية قطعاً.
و قال العلاّمة الحلّي (رحمه الله) في شرحها:... مريداً له لا بمعنى الإرادة المخصصة للفعل؛ فإنّ الفعل إنّما يقع بإرادة العبد عندهم، بل الله مريد له، بمعنى أنّه يطلب منه إيقاعه على وجه الاختيار... و إن كان معصية لم يكن مريداً لها بالمعنى الأول - يعني به الإرادة التكوينية - و لا الثاني، أعني الطلب لحكمته تعالى... إلى آخره. و القرائن على ذلك في كلامهم كثيرة.
أقول: فكأنّ الأشعرية لم يفهموا مرادهم من الإرادة، و إلاّ فلم يستنكفوا من قبوله، فإنّ الله أمر بالطاعات و نهى عن المعاصي بالضرورة، و الأمر يستلزم الطلب باتفاق منهم كما صرّحوا به.
و التحقيق في المقام: أنّ مقالة الأشعرية باطلة كما مرّ، و التفصيل بين المعاصي و المحاسن في الإرادة التكوينية لا محصّل له، و كذا في الإرادة التشريعية بالمعنى الذي قررناه في الجزء الأول؛ فإنّ الله كتب جميع الأشياء في اللوح المحفوظ. نعم، هو - أي التفصيل المذكور - يصحّ في الإرادة بمعنى الطلب كما عرفت. و عمدة الكلام إنّما هو في كيفية تعلق إرادة الله التكوينية بالأفعال الاختيارية للمكلفين، و هي مسألة غامضة مشكلة جداً، فإنّ تفويض الاعتزالي كجبر الأشعري مخالف للعقل و الدين، و الحق الصراح أنّ الإرادة تعلقت بكل شيء، و لا يدخل في ملكه ما لا يشاؤه، لكنّه منزّه عن فعل الفحشاء و القبائح.
و هذا هو مذهب الأئمة من آل محمد (ص) و شيعتهم من الطائفة الإمامية، و هو المسمّى بالأمر بين الأمرين الذي لم يصل إليه أحد غيرهم، و به يجمع بين العقل و النقل، و به يرتفع التعارض المترائي بين الآيات القرآنية، و أمّا بيانه فسيمرّ بك في القاعدة الخامسة من هذا المقصد إن شاء الله، فانتظر.
و أمّا الكلام حول أدلتهم فنقول: الوجه الأول من أدلة العدلية واضح ضروري كما عرفت، و هو يبطل الجبر الذي تخيّله خصومهم.
و الوجه الثاني غير متين، فإنّ العامل بناءً على استناد عمله إلى الله تعالى ابتداءً، لا يعدّ عاصياً و لا مطيعاً، فالصحيح أن يبطل المقدّم باستلزامه إبطال التكليف و استحقاق الثواب و العقاب كما سيجيء بحثه فيما يأتي.
و الوجه الثالث يدل على تعلق الطلب بالطاعات، و الزجر بالمعاصي، و هذا أمر لا ينكره أحد. و المخالفون حيث زعموا أنّ الإرادة المذكورة في الدليل هي الإرادة التكوينية أجابوا عنه: بأنّ الأمر و النهي يستلزمان الطلب دون الإرادة، و لكنّه واضح الفساد، فإنّ الطلب و إن كان مغاير اللإرادة على القول الأظهر غير أنّ الأمر و النهي يستلزمان الإرادة بالضرورة، كما ننبّه عليه
ص: 144
إن شاء الله.
و الوجه الرابع ردّ بمنع كون الأمر بما لا يريد سفهاً و باطلاً، و إنّما يكون كذلك لو كان الغرض منحصراً في إيقاع المأمور به، و ليس كذلك؛ لأنّ الممتحن لعبده أنّه هل يطيعه أم لا؟ قد يأمره و لا يريد منه الفعل.
أقول: و هذا من أسخف القول؛ إذ في الأوامر الامتحانية و نحوها و إن لم تكن الإرادة الجدية متعلقة بالمأمور به، إلا أنه لا شكّ في تحققها و تعلقها به في غير موارد الامتحان، فإن كل من يأمر بشيء و يطلبه فهو يريده، و هذا بديهي جداً، و المقام من القسم الثاني، فإنّ ما طلبه الله تعالى من الناس من الإيمان و العمل الصالح و ترك الكفر و الفسق ليس بطلب امتحاني، بل هو طلب واقعي نشأ عن إرادة جدية.
لا يقال: كيف يكون التكليف جدّياً، و الحال أنّه تعالى يعلم أنّ الكافر و الفاسق لا يمتثله؟
فإنّه يقال: الغرض من التكليف ليس هو فعلية الدعوية نحو متعلقه، و إلا لبطل في مثل ما يرغب الطبع فيه، كالأكل و النكاح و... أو عنه، كأكل القاذورات، فإنّ الإتيان بالأول و الانصراف عن الثاني ليسا بانبعاث من التكليف الإلهي، بل بداعٍ نفساني كما هو واضح، بل الغرض منه هو إمكان دعويته إلى ما تعلق به، و هذا المناط موجود في المطيع و العاصي، ضرورة أنّ تمردّ الكافر و الفاسق عن الامتثال لا يبطل إمكان داعوية التكليف، و إنّما يبطل فعليتها، و سيأتي بعض الكلام فيه في قاعدة تعلّل أفعاله بالأغراض إن شاء الله. و الوجه الخامس متين جداً، و ما اعتذر به ركيك قطعاً، و مهما كان فالجبر يبطل التكليف، و مثله الوجهان الأخيران، فافهم.
و أمّا ما لفّقه الأشاعرة فيزيّف وجه الأول بما سيأتي من كيفية استناد أفعال العباد الاختياري إليه تعالى، مع أنّ الكبرى منتقضة بالرضا، فإنّ خالق الشيء بلا إكراه راضٍ به بالضرورة، و هم لا يلتزمون به؛ لأنّ الله لا يرضى لعباده الكفر، و منه يظهر الحال في الوجه الثاني أيضاً، و أما الوجوه الثلاثة المستدل بها على القضية السلبية فهي ظاهرة الفساد.
أمّا الأول فلأنّ المراد بتعلق إرادته بإيمان الكفّار هو تعلق الإرادة التشريعية دون التكوينية؛ إذ ليس للإنسان إلا ما سعى، و لو شاء الله إيمانهم بالمشيئة التكوينية لآمنوا بلا ريب.
و أمّا تعلق إرادته التكوينية بالأفعال فسيأتي بيانه إن شاء الله، و ستعرف أنّه منزّه عن الفحشاء، و لا يدخل في ملكه ما لا يشاء، و هذا أمر لطيف غامض لم يصل إليه نظر الأشعري و لا عقل المعتزلي!
و أمّا الثاني فسيأتي حلّه فيما بعد كما وعدناك من قبل هذا أيضاً.
و أمّا الثالث فالمشيئة فيها محمولة على المشيئة الجبرية و القسرية، فهي دليل آخر على
ص: 145
بطلان الجبر. و أما الرواية المذكورة فهي موجودة في بعض أدعيتنا أيضاً بسند معتبر، و مفادها متين، و لا دلالة لها على مذهب الخصم، و سيأتي الكلام حولها إن شاء الله تعالى في مبحث الأمر بين الأمرين. و أمّا إجماع سلفهم على إطلاق الرواية المذكورة فهو عندنا موهون لا قيمة له، فكن على بصيرة من أمرك و الله الموفّق.
ص: 146
وللبحث عنها مقامات أربعة:
من البديهي أنّ العلم كاشف عن الواقع، و طريق إلى ما تعلق به عند العالم، و لا يمكن ردعه بوجه، و عليه يترتب التنجّز و التعذّر، و أنّ العلم منجزّ و معذّر؛ و ذلك لجواز عقاب من خالف مقتضي قطعه عقلاً و لو كان جهلاً مركباً، و عدم جوازه إذا تحرك على وفقه و لو كان مخالفاً للواقع، فحسن المؤاخذة و قبحها يدوران مدار العمل على وفق و عدمه، سواء في الموالي العرفية أو المولى الحقيقي، و يترتب على هذا انزجار القاطع و انبعاثه، و هذا هو معنى لابدّيه العمل على وفق قطعه. فالطريقية مستلزمة للتنجّز و التعذّر من جهة حسن الجزاء كما عرفت، و هو يستلزم وجوب العمل على طبق قطعه. و الأول ذاتي، و الثاني عقلي، و الثالث فطري بمناط دفع الضرر، كما مرّ توضيحه في أوائل الجزء الأول. كل ذلك مما لا يدخله ريب، و إن نسب إلى بعض الأخباريين الخلاف في حجية القطع في الأحكام الشرعية في الجملة، لكنه على تقدير صحّته لا يعتدّ به.
إذا أدرك العقل العملي(1) حسن شيء أو قبحه فهل يدرك أنّ الشارع الأقدس جعل حكمه على وفاقه، أم لا؟ فيه أقوال خمسة:
1 - ما لعلّه المشهور من الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع، بل أدّعي عليه إجماع العدلية.
2 - ما ذهب إليه جمع منهم المحقق صاحب الفصول من عدم الملازمة بينهما.
ص: 147
3 - ما اختاره بعض المحققين من أهل التدقيق(1) من عدم إمكان حكم الشارع بخلافه و لا بوفاقه مولوياً. أمّا الأول فلأنّ التحسين و التقبيح العقليين ممّا توافقت عليه آراء العقلاء، فلا محالة لا يعقل الحكم على خلافه من الشارع؛ إذ المفروض أنّه مما لا يختص به عاقل دون عاقل، و الشارع رئيس العقلاء.
و أمّا الثاني فلأنّ التكليف المولوي هو الإنشاء بداعي جعل الداعي، و هذا لا يمكن إلاّ بلحاظ ما يترتب على موافقته من الثواب و على مخالفته من العقاب، و حيث إنّ المفروض أنّ العدل يوجب استحقاق المدح و الظلم يوجب استحقاق الذم عند العقلاء و منهم الشارع فهو كافٍ في الدعوة من قبل الشارع بما هو عاقل، ولا مجال لجعل الداعي بعد ثبوت الداعي من قبله؛ فإنّ اختلاف حيثية العاقلية و حيثية الشارعية لا يرفع محذور ثبوت داعيين متماثلين مستقلين في الدعوة بالإضافة إلى فعل واحد؛ لأنّ الواحد لا يعقل صدوره عن علّتين مستقلين في الدعوة.
4 - ما ذكره جماعة من إثبات الملازمة في الأحكام الراجعة إلى الأصول، و إنكارها في الأحكام المتعقلة بالفروع.
5 - ما عليه بعض الأفاضل من إنكارها في النظريات خاصة، نقلها صاحب الفصول.
أقول: الصحيح هو القول الأول، فإنّ الحسن و القبح المذكورين: إمّا من الأوليات، و إمّا من المشهورات، فإن كانا من الأوليات - و هي القضايا الموافقة لما عليه الوجود و نفس الأمر - فعدم حكم الشارع بما حكم به العقل: إمّا من جهة أنّ الممدوح الواقعي ليس ممدوحاً عنده، و المذموم الواقعي ليس مذموماً عنده، فيلزم جهله بنفس الأمر، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً. و إمّا من جهة أنّ الحسن و القبح لا يوجبان استحاق المدح و الذم عنده، فهذا ترجح بلا مرجّح، فإنّ الاستحقاق المذكور متساوي النسبة إلى الشارع و غيره من العقلاء، فكيف يحكم به العقلاء دون الشارع بما هو عاقل؟ و كذا إن كانا من المشهورات فإنّ الشارع كأحدٍ من العقلاء، بل رئيسهم و المفروض أنّها ممّا تطابقت عليه أراؤهم لأجل حفظ مصالحهم و بقاء نوعهم فيكون الشارع حاكماً بها.
أقول: و يمكن أن يورد عليه: بأنّ المشهورات المذكورة ليس لها واقع سوى تطابق الآراء عليها المسبب عن حفظ النوع والمصلحة و المفسدة العامتين كما دريت، و هذا السبب لا يجري في حقّه تعالى؛ إذ لا نوع له، و شخصه محفوظ بذاته و لا يعقل رجوع المصلحة و المفسدة إليه، فإذن كيف نعلم أنّه يحكم بما يحكم به العقلاء لأجل السبب المذكور؟
ص: 148
و بالجملة: العلة مخصصة للحكم المذكور بالعقلاء، و لا تعمّ الواجب و إن كان رئيساً للعقلاء، فلا بد أن يقال في تتميم الاستدلال و دفع الإشكال: بأنّ الله مدبّر العقلاء و مصلح أحوالهم، و لذا جرى حكمه في حق عباده بما جرت عليه أحكامكم على مراعاة ما يحفظ به نوعهم و يدفع به المفاسد عنهم و يجلب به مصالحهم، و قد أخبر بذلك كله، حيث قال: وَ اَللّٰهُ لاٰ يُحِبُّ اَلْفَسٰادَ(1)، و قال: إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يُصْلِحُ عَمَلَ اَلْمُفْسِدِينَ (2) و قال: إِنَّ اَللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْإِحْسٰانِ (3)... إلى آخره. و الآيات القرآنية في ذلك كثيرة، و لا سيّما أنّ الأصلح واجب عليه تعالى كما يأتي.
فتحصّل: أنّ ما حكم به العقل يحكم به الشرع، و أنّ الحكم المذكور لا يختص بالعقل، بل هو شأن كل من انكشف له الواقع كما عرفت وجهه(4). و أمّا ما تقدم من بعض المحققين العباقرة من عدم إمكان الحكم المولوي على وفق حكم العقل، فهو مبني على أن يكون الثواب و العقاب عين المدح و الذم كما يظهر من تقريبه، و لذا قال أيضاً تأكيداً له: إنّ المدح و الذم اللذين يترتب عليهما حفظ النظام عند العقلاء ما يعمّ الثواب و العقاب، أعني المجازات بالخير و المجازات بالشرّ، و لذا جزم غير واحد من أرباب النزاع في المسألة بأنّ مدح الشارع ثوابه، و ذمّه عقابه، مع وضوح أنّ ترتب الثواب و العقاب عند الجمهور من الأصوليين بل المتكلمين على موافقة البعث و الزجر و مخالفتهما بحكم العقلاء لا بنصب الشارع، و ليس الوجه فيه إلا أنّ موافقة التكليف الواصل عدل في العبودية، فيستحق المدح و الثواب، و مخالفته خروج عن زيّ الرقية فيكون ظلماً على المولى، فيستحق الذم و العقاب، و إلا فلا حكم آخر من العقل في باب الثواب و العقاب بالخصوص، فيعلم منه أنّ استحقاق المدح عندهم يعمّ الثواب، و استحقاق الذم عندهم يعم العقاب. انتهى.
أقول: المدح و الذم لا يستلزمان المجازات دائماً عند العقلاء، كما إذا سرق محتاج مالاً قليلاً من غني فإنّه يستحق الذم دون المجازات(5). و قد تقدم أيضاً ما يدل على تغايرهما في
ص: 149
التمهيد، و هذا - أي تغاير المدح و الذم مع الثواب و العقاب - هو الظاهر من المحقق الطوسي أعلى الله مقامه، أو صريحه(1)، و كذا من غيره، بل يمكن نسبته إلى جمع كثير من متكلّمي العدلية، كما يظهر لمن راجع مباحث الثواب و العقاب في باب المعاد و غيره.
و عليه فلا بد من تكليف الشارع مولويا ليترتب على موافقته أو مخالفته المجازات الرادعة عن القبائح الباعثة إلى المحاسن، ضرورة أنّ مجرد المدح و الذم لا يكفيان لارتداع أكثر النفوس. و يدل على ما ذكرنا - في الجملة - قوله تعالى: إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ (2)، و قوله تعالى: وَ يَنْهىٰ عَنِ اَلْفَحْشٰاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ وَ اَلْبَغْيِ (3)، و حملهما على الإرشاد بعيد جداً.
ثم إنّ هنا و جوهاً أخر من الدلائل على الملازمة ذكرها المثبتون و نحن ننقلها من مطارح الأنظار.
1 - الإجماع المحصّل و المنقول بسيطاً و مركباً، إذ علماء الإسلام بين من أنكر الحسن و القبح، و بين ما أثبتهما و قال بالملازمة، فالتفصيل بين الالتزام بهما و إنكار الملازمة باطل.
أقول: و قد أتعب المقرر نفسه الذكية في تقرير الإجماع و تثبيته، لكنّ تحقق الإجماع التعبدي في مثل هذه المسألة المستدل عليها بالعقل و النقل بعيد جداً، بل لا يمكن عادةً تحصيل العلم برضى المعصوم (ع) منه، و هذا ظاهر. هذا، مع ما عرفت من الأقوال الخمسة من القائلين بالحسن و القبح العقليين، فأين الإجماع المركب(4)؟
2 - الكتاب الكريم، و فيه آيات، فمنها: قوله تعالى في مدح نبيه (ص): يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهٰاهُمْ عَنِ اَلْمُنْكَرِ(5).
و التقريب: أنّ المعروف و المنكر هما الحسن و القبيح العقليان، و المستفاد من السياق بدلالة وقوعه في مقام المدح هو العموم، و الأمر فيه محمول على مطلق الطلب لعموم المعروف للمستحب.
و منها: قوله تعالى: إِنَّ اَللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْإِحْسٰانِ... وَ يَنْهىٰ عَنِ اَلْفَحْشٰاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ وَ
ص: 150
اَلْبَغْيِ (1). وجه الدلالة: أنّ العدل من كل شيء وسطه و مستقيمه، و مستقيم الأفعال حسنها. و العموم أيضاً مستفاد من المقام كما عرفت(2).
و منها: قوله تعالى: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى اَلْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ(3).
و منها: قوله حكايةً عن لقمان في وصيته لابنه:... وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اِنْهَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ(4).
أقول: في الاستدلال بهذه الآيات الكريمة على الملازمة المذكورة نظر؛ فإنّ ما أفيد في الآية الأولى فهو يجري في قوله تعالى: وَ يُحِلُّ لَهُمُ اَلطَّيِّبٰاتِ...(5) إلى آخره، مع أنّ الطيّب و الخبيث ليسا من الأحكام العقلية، بل من الأمور الطبيعة: إذ الطبيب ما يرغب فيه الطبع، و الخبيث ما يستنفر عنه الطبع فتأمل. و لا شك في بطلان الملازمة بين ما رغب الطبع فيه أو عنه و ما حكم به الشرع، مع أنّ الطبع مختلف باختلاف الأقوام و الأعصار، بل الأفراد. و أيضاً المدح لا يقتضي العموم؛ لحصوله بطبيعي الأمر و النهي المذكورين، كما يقال: «زيد يبذل المال» فإنّه مدح له، و لا يدلّ على بذل تمام أمواله.
و أمّا ما ذكر في الآية الثانية ففيه احتمال إرادة ضدّ الظلم من العدل، فلا عموم فيه، و يؤيده أنّ لازمه كون الإحسان و الإيتاء من العطف التفسيري، و هو خلاف الظاهر.
و أمّا ما ذكر في الآية الثانية ففيه احتمال إرادة ضدّ الظلم من العدل، فلا عموم فيه، و يؤيده أنّ لازمه كون الإحسان و الإيتاء من العطف التفسيري، و هو خلاف الظاهر.
و أمّا الآيتان الأخيرتان و نظائرهما ممّا ورد في موضوع الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فهي أجنبيه عن مقامنا بالكلّية، فإنّ الأمر و النهي المذكورين متأخران عن تعلق الأمر و النهي الشرعيين، و لا شك أنّ ما تعلق به أمر الشارع أو نهيه فهو معروف أو منكر. و بعبارة واضحة: أنّ المراد بالمعروف و المنكر هو الواجبات و المحرّمات الشرعيتين اللتين أمر الله المكلفين بتبليغهما، فالآيات الشريفة ناظرة إلى مرحلة الامتثال، دون مرتبة التشريع التابع للمصلحة و المفسدة، و لذا جعل المكلفين آمرين و ناهين مع ضرورة عدم كونهم مشرّعين، و الملازمة المبحوث عنها إنّما هي في مرتبة العلل دون المعاليل؛ فلذا يستقلّ العقل بحسن الإطاعة
ص: 151
و الإنقياد، مع أنّه لا يمكن كشف وجوبهما شرعاً(1).
3 - السنّة، فمنها: ما روى عن أبي جعفر (ع): «... دع القبيح لأهله فإنّ لكل شيء أهلاً»(2).
أقول: و فيه أولاً: أنّها مرسلة. و ثانياً: أنّ إطلاق القبيح عليه لعلّه لأجل حرمته الشرعية؛ فإنّ سوق الكلام للنهي عن المنكر، فهي كالآيات الدالة على الأمر بالمعروف، و قد عرفت حالها.
و منها: قول النبي الأكرم (ص) في يوم الغدير: «ألا ما من شيء يقرّبكم إلى الجنة و يبعدكم عن النار إلا و قد أمر الله به، ألا ما من شيء يقرّبكم إلى النار و يبعدكم عن الجنة إلا و قد نهاكم عنه».
أقول: و الظاهر أنّ دلالة الرواية تامة على المطلوب، لكنّني لم أجد الرواية بهذه العبارة عاجلاً، و الموجود في الكافى(3): عن أبي جعفر (ع) هكذا: «خطب رسول الله (ص) في حجة الوداع فقال: يا أيّها الناس، و الله ما من شيء يقربكم من الجنة و يباعدكم عن النار إلا و قد أمرتكم به، و ما من شيء يقربكم من النار و يباعدكم من الجنة إلا و قد نهيتكم عنه...» إلى آخره. و في البحار(4) نقلها عن المحاسن بعبارة أخرى.
و ذكر المحقق النائيني (قدس سره) في أجود التقريرات(5) تواتر الأخبار بهذا المضمون، و كيف ما كان فبناءً على لفظ الكافي الاستدلال غير تام، فإنّ أمر النبي و نهيه (ص) إنّما هو بعد تعلق أمر الله و نهيه، و لا شك أنّ متعلقهما مقرب إلى النار و الجنة حتى عند الأشعري، فالرواية ناظرة إلى مرحلة الامتثال دون التشريع، و لا دلالة لها على المطلوب، و إن ادّعى المحقق النائيني صراحتها في انبعاث الأحكام عن المصالح و المفاسد في الأفعال، بل لا يمكن الاستدلال بها حتى بناءً على القول بتفويض أمر التشريع إلى النبي (ص) كما هو المختار و، سياتي بحثه في محله، فان ما
ص: 152
شرعه النبي (ص) أحكام محدودة، و مفاد الرواية عامّ كما هو ظاهر، فافهم و تأمل.
4 - ما ذكره المحقق القمي(1) من الأخبار الواردة في العقل و الجهل، و أنّه ما يثاب به و يعاقب، و أنّه مما يكتسب به الجنان.
أقول: هذه الأخبار تدل على اشتراط التكليف بالعقل، و أنّ المجنون غير مكلف، و الأحمق و قليل العقل ثوابهما قليل، و أنّ العقل سبب امتثال الأحكام الشرعية، كل ذلك أجنبي عن بحث الملازمة رأساً.
نعم، قول الكاظم (ع) على ما في رواية هشام(2): «إنّ الله حجتين: حجة ظاهرة، و حجة باطنة، فأمّا الظاهرة فالرسل و الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام)، و أمّا الباطنة فالعقول» يشمل بإطلاقه المقام، لكنّ سند الرواية ضعيف.
5 - ما ذكره هو أيضاً من أنّه ثبت بالضرورة و الأخبار أنّ لكل شيء حكماً من الله تعالى، و ثبت من الأخبار أنّ الأحكام موجودة عند المعصومين و إن لم يصل إلينا كلّها. و بناءً عليه فكل ما يدرك العقل حسنه أو قبحه لا بد أن يكون مأموراً به أو منهياً عنه؛ لأنّ الله لا يأمر بالقبيح و لا ينهى عن الحسن.
أقول: و حاصله أنّ العقل يدلّ على أنّ الله لا يأمر بالقبيح و لا ينهى عن الحسن و الأخبار تدل على حكمه بالحسن و نهيه عن القبيح، خلافاً للقول الثاني، فذكر الأخبار المذكورة مع التعليل المذكور في الدليل ليس بلغوٍ كما زعمه بعض الأعلام، فافهم. نعم، دعواه الضرورة غير ثابتة، و أمّا الأخبار الدالة على ذلك فهي كثيرة(3) فيها الصحيح و المعتبر، لكنّ استفادة عدم خلوّ الوقائع من الحكم المولوي مشكلة، فلاحظ، فالعمدة في المقام ما ذكرنا، و الله الأعلم.
حديث الملازمة يخصّ أفعال المكلفين، و أنّ العقل إذا أدرك حسن بعضها أو قبح بعضها يدرك أنّ الشارع حكم عليه بحكم خاص، و لا يعمّ أفعال الواجب تعالى؛ لعدم تعقل اتصافه بالأحكام الشرعية، و هذا واضح.
ثم إنّ المراد بالحكم الشرعي الملازم للحكم العقلي ليس هو الخطاب الفعلي الصادر عن الشرع الواصل إلى المكلفين، و لا الشاني الواصل إلى أمنائه (عليهم السلام) غير الواصل إلى العباد لمانع أو
ص: 153
فقد شرط، فإنّ العقل لا يستقل بشيء منهما، بل المراد طلبه الفعلي من غير جهة العلم، فطبعاً يكون معناه هو كتابته في اللوح المحفوظ التي فسّرنا بها الإرادة التشريعية، فافهم فإنّه دقيق.
و اعلم أنّ المراد من هذه الكبرى - أي «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» - ليس بأنّ الشرع يحكم بعين ما حكم العقل، بمعنى تصديق الشرع إيّاه ليكون الحكم واحداً و الحاكم اثنين؛ إذ لا بعث و زجر للعقل، بل حكمه إدراكه، فمعنى هذه القاعدة حينئذٍ أنّ الشارع يصدّق العقل في إدراكه، و هذا يرجع إلى ما تقدم من إثبات الحسن و القبح العقليين، خلافاً للأشعرية، و لا بمعنى أنّ حكم العقل عين حكم الشرع، بدعوى أنّ العقل رسول الشارع في الباطن، كما أنّ الرسول عقل في الظاهر، فحكم الشرع قائم بالعقل، حيث إنّه لسان الشرع، ليكون الحكم واحداً و الحاكم أيضاً واحداً، كما يظهر من بعض أهل المعقول و بعض كلمات بعض الأصوليين، بل بمعنى أنّ ما يحكم به العقل - أي يدركه - يحكم به الشرع، فيكون هنا حكمان و حاكمان، كما عرفت وجهه.
هذا كله في صحة القول الأول، و أمّا القول الثاني فله وجوه من الاستدلال، لكنّها ضعيفة بأسرها، و المقام لا يسع نقلها و ردّها.
نعم، للمحقق صاحب الفصول (رحمه الله) تفصيل آخر، و هو: أنّ الملازمة المذكورة تامة في مقام الإثبات عملاً بعموم الآيات و الأخبار، و أصالة عدم الجهة المعارضة و غيرها، لا في مقام الثبوت لوجوه ذكرها في فصوله، و إنّما الملازمة فيه بين حسن التكليف عقلاً و وجوب صدوره من الشارع؛ لأنّ علمه و حكمته و غناه و قدرته تمنع وقوع خلاف ذلك منه، و جهات الفعل المحسّنة أو المقبّحة لا تكفي لحسن التكليف به؛ لاحتمال المانع في نفس التكليف، و استدل على ذلك بوجوه ستّة كلها غير صالحة للاستدلال، عمدتها أنّ الصبي المراهق إذا كان كامل العقل لطيف القريحة تثبت الأحكام العقلية في حقه كغيره من الكاملين، و مع ذلك لم يكلفه الشارع؛ لأنّ في ترك تكليفه مصالح. و هنا وجه آخر ذكره الفاضل التوني - كما في مطارح الأنظار - من أنّ التكليف بما يستقل به العقل لطف كما قاله أصحابنا و المعتزلة، و العقاب بدون اللطف قبيح، فالعقاب بدون التكليف قبيح، فإذن بطل حديث الملازمة.
أقول: و أجاب في مطارح الأنظار عن الأول: بأنّ الأحكام الشرعية أيضاً ثابتة في حق الصبي المذكور بعد ما أدرك الحكم العقلي، كحرمة الظلم، أو وجوب ردّ الوديعة، غاية ما في الباب أنّه معفوّ عنه بالشرع تفضّلاً، كما في المعاصي الصغيرة مثلاً، مع أنّ الحكم بثبوت العفو في بعض المقامات كما لو فرضنا فيما لو قتل الصبي قبل بلوغه بساعة مع كمال عقله و إدراكه نبياً أو وصي نبيٍّ في غاية الصعوبة، فإنّا ربما يخالف العدل على ما لا يخفى.
ص: 154
أقول: و فيه نظر، و الصحيح في الجواب أن يقال: إنّ تخطئة الشارع العقل في مورد لا يدل على سقوط حكمه مطلقاً. ففي الحقيقة أنّه خارج عن مفروض الكلام. و أمّا الوجه الثاني فهو ضعيف صغرى و كبرى، أمّا صغرى فلأجل أنّ حكم العقل - بناءً على الملازمة - يكشف عن التكليف الشرعي أيضاً، كما عرفت تفصيله، فلا يقبح العقاب على مخالفته. نعم، الخطاب الشرعي لا يستكشف به؛ لما مرّ، غير أنّ حسن العقاب غير موقوف عليه قطعاً، سيما بعد وجود الخطابات العامة الحاثّة على الطاعات و الزاجرة عن المعاصي. و أمّا كبرى فسيأتي ما فيها في القاعدة السابعة إن شاء الله، و أمّا القولان الأخيران فأدلتهما مع جوابها مذكورة في بعض كتب الأصول فلا نطيل المقام بذكرها فراجع.
قال بعض الأعلام(1): إنّ القضايا المشهورة المتمحّضة في الشهرة على أقسام:
منها: ما فيه مصلحة عامة، كالعدل حسن، و الجور قبيح، و عبّر عنها بالتأديبات الصلاحية.
و منها: ما ينبعث عن الأخلاق الفاضلة، كالحكم بقبح كشف العورة؛ لانبعاثه عن الحياء و هو خلق فاضل.
و منها: ما ينبعث عن رقّة أو حمية أو أنفة أو غير ذلك، و استلزام الحسن و القبح عقلاً للحكم الشرعي بالمعنى المتقدم فيما كان منشؤه المصالح العمومية واضح؛ لأنّ الشارع يرى المصالح العمومية و كذا ما ينبعث عن الأخلاق الفاضلة؛ لأنّ المفروض أنّها ملكات فاضلة، و المفروض انبعاث الحكم بالحسن و القبح عنها، و أمّا ما ينبعث عن انفعالات طبيعية من رقة أو حمية أو أنفة أو غير ذلك فلا موجب لاشتراك الشارع مع العقلاء، و لذا ترى أنّ الشارع ربما يحكم لحكمة و مصلحة خاصّة بما لا يلائم الرقّة البشرية، كالحكم بجلد الزاني و الزانية غير ذات البعل مع كمال التراضي...، و الحكم بقتل الكافر و سبي ذرارية، و أشباه ذلك. انتهى.
أقول: إنّما نقلنا كلامه لترتب فوائد مهمة عليه في موارد كثيرة، و به يرتفع الاشتباه و التحيّر الحاصل من الخلط بين العاديات و العقليات.
ثم إنّ الأقوى الحاق القسم الثاني بالثالث دون الأول؛ لانبعاث الأخلاق غالباً من العادات، بمعنى، أنّ مصاديقها و ما به تبرّزها تؤخذ من الرسوم القومية و العادات غير العامة؛ و لذا ترى أن كشف العورة غير قبيح عند جميع الناس، فقد رأينا في بعض الأسفار أناسا كاشفي العورة
ص: 155
مجيبين حين استنكارنا عليهم: أنّ العورة كبقية أعضاء البدن!
قد ثبت أنّ ما حكم به العقل يحكم به الشرع، بمعنى أنّ إدراك العقل حسن شيء - مثلاً - يلازم إدراكه حكم الشارع به، و الحكمان متلازمان و معلولان للمصلحة الواقعية نفس الأمرية الكائنة في الفعل، و هو العقل أيضاً يحكم بما حكم به الشرع، أم لا؟ أنكره صاحب الفصول (قدس سره)؛ لوجوه ضعيفة كما أشرنا سابقاً، و الصحيح - و لعلّه مذهب المعظم - هو الأول، فالملازمة ثابتة من الطرفين.
نعم، حكم العقل بما حكم به الشرع حكم إجمالي، ضرورة عدم إحاطته دائماً بتمام الملاكات الواقعية، و المناطات نفس الأمرية التي تدور عليها أحكام الشرع، و لكنّه حيث أدرك أنّ أفعاله تابعة للمصالح و المفاسد و أنّ إرادته - سواء كانت تكوينية أم تشريعية - لا تنبعث إلا عن علل صحيحة؛ لبطلان الترجيح بلا مرجح، و ترجيح المرجوح على الراجح الواقعي لا جرم يجزم بأن كل ما يصدر عنه له ملاك و إن لا يدركه تفصيلاً، و لعل هذا هو مراد المحقق القمي في قوانينه(1)، حيث قال: إنّ كل ما حكم فيه الشرع بحكم لو اطّلع العقل على الوجه الذي دعا الشارع إلى تعيين الحكم الخاص في ذلك الشيء لحكم العقل مواقفاً له، فافهم.
و لبعض المحققين الأعلام كلام في المقام لا بأس بنقله، قال (رحمه الله)(2): إنّ الحكم الشرعي لا يكشف عن المصلحة و المفسدة إلا إجمالاً، فلا يعقل الحكم من العقل بحسنه أو قبحه تفصيلاً، و أمّا الحكم بحسنه أو قبحه إجمالاً بأن يندرج تحت القضايا المشهورة بقسميها فلا دليل عليه؛ لأنّ المصالح و المفاسد التي هي ملاكات الأحكام الشرعية المولوية لا يجب أن تكون من المصالح العمومية التي يحفظ بها النظام و يبقى بها النوع، كما أنّ الأحكام الشرعية غير منبعثة عن انفعالات طبيعية من رقة أو حمية أو أنفة أو غيرها، و لا ملاك للحسن و القبح العقليين إلاّ أحد الأمرين.
نعم، العقل يحكم بأنّ الأحكام الشرعية لم تنبعث إلا عن حكم و مصالح خاصة راجعة إلى المكلفين بها، فالحكم بالعلّة لمكان إحراز المعلول أمر، و الحكم بالحسن و القبح العقلائيين أمر آخر. هذا هو الحق الذي لا محيص عنه، بناءً على ما عرفت من حقيقة الحسن و القبح العقليين، و أنّ قضيتهما داخلة في القضايا المشهورة، لا القضايا البرهانية، و أنّ حقيقتهما بلحاظ توافق
ص: 156
الآراء واقعية لهما غير ذلك فتدبره جيداً. و إن كان خلاف ظاهر كلمات الأصوليين، بل غير واحد من أهل المعقول.
أقول: ما ذكره صحيح، لكن ربما يكون الحسن و القبح عقليين فقط، و لا يكونان من منبعثات بقاء النوع و مصالح العامة و مفاسدهم الاجتماعية، كما في حسن تحصيل الدقيقة العلوم العالية و الجب الشديد و التعلّق العميق بالخالق جلت عظمته، فتأمّل. و قبح البقاء على النقصان، فإنّ العقل يحكم بذلك و لو مع الغضّ عن المصلحة والمفسدة الراجعتين إلى النوع و بقائهم.
ص: 157
و هذا البحث من مهمّات بحوث الفنّ؛ إذ تبعية أفعاله تعالى للأغراض الزائدة على ذاته تبطل مذهب الفلاسفة في كيفية اختياره تعالى، و بها يخرج الواجب عن تحت القاعدة القائلة: «الواحد لا يصدر منه إلا الواحد»، و بها يرتبط حدوث العالم و لو ارتباطا ما، فالمقام يستحق مزيد العناية به، فنقول و على الله الاعتماد:
الأقوال الرئيسية في المسألة ثلاثة:
الأول: إنّه تعالى أنّما يفعل لغرض و حكمة و فائدة و مصلحة ترجع إلى المكلّفين، و هذا مذهب الإمامية، كما نصّ عليه العلاّمة الحلّي (قدس سره)(1).
و قيل: إنّه من أصول المذهب، و منكره خارج عنه، و تبعهم عليه المعتزلة و جمع من الأشاعرة.
الثاني: أنّ أفعاله تعالى ليست معلّلة بالأغراض، بل لا يمكن تعلّلها بها، و هذا مذهب الأشاعرة(2)، سوى جمع عدلوا إلى الحقّ في هذه المسألة.
الثالث: قول الفلاسفة، و يكفي لفهم حقيقته كلام خاتمهم الحكيم الشيرازي، قال في مبحث إرادة الله من ربوبيات كتاب الأسفار: إنّ هذه المعاني الأربعة - أعني العلّة الغائية و الفاعل و الغاية و الغرض - كلها(3) في فعل الله سبحانه شيء واحد، و هو ذاته الأحدية، و مرجعها إلى العناية التي
ص: 158
هي العلم التام بوجه الخير للنظام، و الإرادة الحقة لفعل الخير بالذات مطلقاً، فإذن العالم الأكبر و هو الإنسان الكامل الأعظم فاعله و غايته أولاً و آخراً و مبدءاً و مصيراً هو الله سبحانه بحسب نفس ذاته، فأمّا كل جزء من أجزاء نظام الوجود فالغرض القريب و الغاية القريبة بحسب الخصوصية شيء غير ذاته، كما أنّ فاعله القريب بحسب الخصوصية شيء غير الحق الأول... و ليس معنى هذا الكلام أنّ فعله المطلق لا غاية و لا غرض له، بل إنّ غايته و غرضه ذاته المقدسة، و إلاّ رجع الأمر إلى مذهب الأشعرية، تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً.
فقد استبان و ظهر أنّ الحكماء إنّما ينفون عن فعل الله المطلق غرضاً و غاية أخيرة غير ذاته تعالى، و يقولون: إنّه غرض الأغراض...؛ لكونه علّة العلل... و لا ينفون الغرض و الغاية و العلة و الغائية، بل يثبتون أغراضاً و غايات و كمالات مترتبة منتهية إليه سبحانه، بخلاف الأشاعرة فإنّهم يسدّون باب التعليل مطلقاً، و بخلاف المعتزلة أيضاً فإنهم يثبتون في فعله المطلق غرضاً غير ذاته... إلى آخره، و مثله غيره من كلامه(1)، فلاحظ.
و من هذا يظهر أنّ ما ذكره الجرجاني و غيره من أنّ جهابذة الحكماء و طوائف الإلهيين موافقون لنا (يعني في نفي الغرض) غير صادق، بل هو من الجهالة بمذهب الفلاسفة.
الرابع: مذهب فقهاء العامة من أنّ أفعاله تعالى تابعة لمصالح العباد تفضّلاً و إحساناً، و إن لم تكن التبعية المزبورة واجبة.
الخامس: ما عن ابن هيثم - من الظاهرية - من أنّ أفعاله غير معلّلة عقلاً، لكن حيث دلت النصوص و الظواهر الكتابية على كونها معلّلة فلا بد من الأخذ بها(2).
السادس: ما عن شارح المقاصد من التفصيل، قال: الحقّ أنّ تعليل بعض الأفعال لا سيما شرعية الأحكام و المصالح ظاهر، كإيجاب الحدود، و الكفّارات، و تحريم المسكرات، و ما أشبه ذلك، و النصوص أيضاً شاهدة بذلك، كقوله تعالى: مٰا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاّٰ لِيَعْبُدُونِ (3)،
ص: 159
و قوله: مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنٰا عَلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ...(1)، و قوله: فلما قضى زيد... لكيلا يكون(2)، و لذا يكون القياس حجة إلا عند شرذمة، و أمّا تعميم فمحل بحث. انتهى.
أقول: القول السادس يرجع إلى القول الأول في الحصة المثبتة، و أمّا التوقف في الكلّية فيظهر حاله من صحة القول الأول أو بطلانه، و الخامس أيضاً يرجع إلى الأول، و إنّما الاختلاف بينهما في الدليل، حيث يقول ابن هيثم: إنّه التعبد المحض، و يقول العدلية: إنّه العقل و النقل، و نظيره القول الرابع فإنّ افتراقه عن الأول في وجوب التعلل، لا في أصله.
و أمّا القول الثالث فمحصّله: أنّ الواجب الوجود أعظم مبتهج بذاته، و ذاته مصدر لجميع الأشياء، و كل من ابتهج بجميع ما يصدر عن ذلك الشيء من حيث كونه صادراً عنه، فالواجب تعالى يريد الأشياء لا لأجل ذواتهامن حيث ذواتها، بل من حيث إنّها صادرة عن ذاته تعالى، فالغاية له في إيجاد العالم نفس ذاته المقدسة.
ذكره في الأسفار(3) تبعاً لابن سينا(4)، و قال أيضاً(5): ما وجد في كلامهم من أنّ العالي لا يريد السافل لا ينافي ما ذكرنا؛ إذ المراد من المحبة و الالتفات المنفيين عن العالي بالنسبة إلى السافل هو ما هو بالذات و على سبيل القصد، لا ما هو بالعرض و على سبيل التبعية، فلو أحبّ الواجب تعالى فعله و إرادته لأجل كونه أثراً من آثار ذاته... لا يلزم من إحبابه لذلك الفعل كون وجوده بهجة و خيرا له، بل بهجته إنّما هي بما هو محبوبه بالذات، و هو ذاته المتعالية... إلى آخره، و إليه ينظر قول بعض الأعلام(6) في منظومته:
و القصد من نفي زيادة الغرض *** ليس على الإطلاق حتى بالعرض
بل نفي كلّ غاية بالذات *** و حصرها في غاية الغايات
فإن قلت: العلة الغائية كما صرحوا هي ما يقتضي فاعلية الفاعل، فيجب أن يكون غير ذات الفاعل، ضرورة مغايرة المقتضي للمقتضى فكيف يكون الخالق نفس العلّة الغائية؟
قلت: قد أجيب عنه(7): بأنّ هذه المسامحات في كلامهم كثيرة، فإنّهم كثيراً ما يطلقون
ص: 160
الاقتضاءعلى الأعم منه الذي هو عدم الانفكاك، و إلا فلا برهان على مغايرة الفاعل و الغاية، فإنّ الفاعل هو ما يفيد الوجود، و الغاية هي ما يفاد لأجله الوجود، سواء كان عين ذات الفاعل أو أعلى منها.
فإن قلت: الغاية متأخرة وجوداً عن الفعل، مع أنّ تأخر الواجب عن فعله وجوداً غير معقول.
قلت: قد اعتذر عنه بأنه إنّما يتمّ إذا كانت الغاية من الكائنات، و أمّا إذا كانت ممّا هو أرفع من الكون فلا تتأخر عن الفعل.
أو يقال: إنّ الواجب أول الأوائل من جهة كونه علة فاعلية لجميع الأشياء، و علة غائية و غرضاً لها، و هو بعينه آخر الأواخر من جهة كونه غاية و فائدة تقصده الأشياء و تتشوق إليه طبعاً و إرادة(1).
أقول: و يتخلّص هذا القول إلى أمور ثلاثة: الأوّل: لا غاية ذاتية مباينة لفعله، الثاني: غايته من فعله نفس ذاته، الثالث: لكلّ فعل من أفعاله غاية أو غايات عرضية زائدة على ذاته تعالى، كالمصالح و المنافع مثلاً، فإنّها و إن لم تكن علة لفاعلية الحق - كما هي معني العلة الغائية - لكنّها مترتبة على الفعل ذاتاً لا عرضاً.
أقول: هذا القول مزيّف؛ فإنّ الأمر الأول يفسده ما يفسد القول الثاني بلا فرق، و ستعرف إن شاء الله أنّ ما دعاهم إليه ضعيف البنيان مختلّ الأساس.
و أمّا الأمر الثاني فهو ممنوع جداً، فإن ذاته تعالى لا تصلح لصيرورتها علة غائية، فإنّ الغائية متقدمة ذهناً و متأخرة وجوداً، و هذا المعنى غير متأتّ في حقّ الواجب. و أمّا الاعتذار المتقدم فهو ممّا لا طائل تحته بكلا وجهيه، كما لا يخفى على الخبير. و أمّا ما لفّق في تقرير هذا الأمر من أنّه مبتهج بذاته فيبتهج بآثاره فقد ذكرنا غير مرّة أنّه كلام شعري بحت، يتوقف صدقه على بناء فاسد و هو قياس الواجب على الممكن، أين التراب و ربّ الأرباب؟! و إلا الابتهاج و الحب و الرضا و نحوها من الكيفيات النفسانية الحيوانية غير معقولة في حق جناب المجرد القديم، و إن أريد بها معنى آخر فلا بد من تصويره و تقريره حتى ينظر فيه. هذا، مضافاً إلى استلزامه عدم اتصافه تعالى بالجود حقيقةً، و عدم كونه منّافاً و جواداً على الإطلاق، فإنّه إذا كان فعله لحب ذاته لا لمجرد نفع الغير لا يحصل له كمال الإحسان، كما هو كذلك بناءً على القول الأول، فتأمّل.
ص: 161
و أمّا القول الثاني فهوظاهر الفساد و واضح البطلان؛ فإنّ الفعل الخالي عن الغرض قبيح قطعاً، و الحكيم العدل منزّه عنه، بل هو ممتنع؛ لاستلزامه الترجيح من غير مرجح كما هو ظاهر، و قد عرفت في الجرء الأول استحالته بما لا مزيد عليه.
و أمّا ما اعتذر به بعضهم من أنّ القبيح ما يخلو من الفائدة دون الغرض فهو ضعيف جداً، ضرورة عدم زوال قبح العبث بمجرد اشتمال الفعل على فائدة ما لم يكن الفعل المذكور مستنداً إليها استناد المعلول إلى علّته الغائية.
فإذن تعيّن القول الأول و بان صحته، لكن للفلاسفة و الأشاعرة عليه إيرادات لابد من النظر فيها، و أنّها صحيحة أم لا؟ و إليك بيانها:
1 - من طريق امتناع الاستكمال، بيانه: أنّه لو كان لفعله غرض من تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة لكان هو ناقصاً في ذاته مستكملاً بتحصيل ذلك الغرض، لأنّه لا يصلح غرضاً للفاعل إلا ما هو أصلح له من عدمه، فإنّ ما استوى وجوده و عدمه بالنظر إلى الفاعل لا يكون باعثاً له على الفعل و سبباً لإقدامه بالضرورة، فكل غرض لا بد أن يكون وجوده أصلح للفاعل و أليق به من عدمه، و هو معنى الكمال، فإذن يكون الفاعل مستكملاً بوجوده و ناقصاً بدونه.
لا يقال: هذا إذا رجع الغرض إلى الفاعل، و أمّا إذا كان عائداً إلى غيره فلا يلزم الاستكمال، و الغرض في فعله تعالى من قبيل الثاني لتعاليه عن التضرر و الانتفاع.
فإنّه يقال: إنّ العائد إلى الغير إن كان أولى بالنسبة إليه تعالى من عدمه جاء الإلزام المذكور، و إلا لم يصلح لأن يكون غرضاً له بالضرورة.
أقول: و لعلّه عمدة الوجوه، استدل به الأشاعرة على نفي الغرض مطلقاً، و الفلاسفة على إنكار الغرض الزائد على ذاته، و لكنّ الأشاعرة لا يجوز لهم التشبّث بهذا الوجه لتجويزهم استكماله تعالى بصفاته الزائدة على ذاته، كما اعترف بعضهم به في المقام.
و أمّا الشبهة في نفسها فالصحيح عدم تماميتها؛ إذ الغرض من فعله تعالى هو إيصال النفع إلى الغير مثلاً، قولهم: «العائد إلى الغير إن كان أولى له من عدمه فقد جاء الاستكمال» خالٍ عن التحصيل، فإنّه إن أريد بالاستكمال تخلّص ذاته من النقصان و تحلّيها بالكمال فالتالي و إن كان ممتنعاً، لكنّ الملازمة فاسدة؛ لأنّ البحث في أفعاله دون ذاته و صفاته الذاتية التي هي متساوية النسبة إلى جميع الممكنات. و إن أريد به نفي القبح عن فعله كما هو المناسب للمقام فهذا مما لا شك في صحته، ضرورة قبح الفعل الخالي عن الغاية.
فنقول: أفعاله تعالى تابعة للأغراض الزائدة على ذاته، و وجوداتها أولى بالنسبة إليه تعالى من أعدامها، و لكنّ هذه الأولوية لا تستلزم استكماله تعالى في ذاته، و لا إزالة استحقاق الذمّ
ص: 162
الثابت قبل وجود الغرض ليستوجب ذلك اتصاف الحكيم بقبيح الفعل (في حين)، بل هي تدفع القباحة المتفرعة على خلوّ الفعل عن الغرض، و كم فرق بين الأمرين! فإنّ الأول يضرّ بعظمته الذاتية أو بحكمته البالغة، و الثاني حاكٍ عن كمال قدرته و علمه و عدله و حكمته.
فالالتزام به لازم فضلاً عن كونه جائزاً، فافهم المقام حتى ينبثق لك بطلان الشبهة بوضوح وجلاء.
2 - من طريق خالقيته تعالى، و ذلك لأنّ الغرض أمر خارج عن الفعل حاصل بتوسّطه، و مثل ذلك غير معقول في أفعاله تعالى، فإنّه خالق كل شيء ابتداءً بلا توسّط غرض، فجعل بعض أفعاله غرضاً ليس أولى من جعل البعض الآخر غرضاً، نسجه بعض الأشاعرة، و فساده واضح، فإنّ توقف بعض الأمور على بعضها ممّا لا شك فيه، كتوقف الأعراض في وجودها على الجواهر، و المعلول على العلة، أليس خلق الأكل محالاً بلا إيجاد الآكل، و اللذة بلا وجود الملتذّ، و العبادة بلا وجود العابد؟! فقولهم بخالقية الواجب لكل شيء ابتداءً من أسخف القول، و قد اضطرّ بعضهم إلى الاعتراف بأنّ توقف بعض الأشياء على بعضها واقع ضرورة و عقلاً، و أنّ معنى خالقيته تعالى لكل شيء ابتداءً هو ما يقابل كلام الفلاسفة في صدور الأشياء عنه تعالى بالترتيب.
3 - من طريق التسلسل؛ إذ لو كان فعله معلّلاً بالغرض فلا بد من الانتهاء إلى ما هو الغرض و المقصود في نفسه، و إلا لتسلسلت الأغراض إلى ما لا نهاية له، ولا يكون ذلك الغرض في نفسه لغرض آخر؛ لأنّه خلاف المفروض، و إذا جاز ذلك بطل القول بوجوب الغرض، إذ قد انتهت أفعاله إلى فعل لا غرض له، و هو الذي كان مقصوداً في نفسه، استدل به الأشاعرة(1) على نفي الغرض مطلقاً، و الفلاسفة على نفي الغرض الزائد.
قال في الأسفار(2): إذ الغايات كسائر الأسباب تستند إليه، فلو كان لفعله غاية غير ذاته فإن لم يستند وجودها إليه لكان خرق الفرض، و إن استند إليه فالكلام عائد فيما هو غاية داعية لصدور تلك الغاية المفروضة كونه غير ذاته تعالى، و هكذا حتى ينتهي إلى غاية هي عين ذاته تعالى.
أقول: و فيه أولاً: أن وجوب تعلّل أفعاله بالأغراض ليس من أحكام العقل النظرية المجرد ليكون عدمه ممتنعاً عقلاً، فيكون نقضه بموردٍ دليلاً على بطلان أصل الحكم؛ لاستواء حكم الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز، بل هو من أحكام العقل العملية، و لا شك أنّها تطرأ على الأمور
ص: 163
الممكنة دون الممتنعة، فإذن لو فرضنا عدم تعلّل فعل من أفعاله بالغرض لأجل محذور التسلسل لما ضرّ بلزوم جريانه في غيره، و هذا واضح.
و ثانياً: أنّ الغاية ربما لا تكون من فعله تعالى حتى تحتاج إلى غاية أخرى، و لنأخذ مثلاً: أنّ الله تعالى خلق الإنسان بطبعه و وصفه هذا ليكلّفه، و سبب التكليف هو تكامله و ارتقاء نفسه من حضيض النقص إلى ذروة الكمال و الشرف، و من المعلوم أنّ التكامل المذكور ليس من فعل الله تعالى حتى يحتاج إلى غاية، و هذا أيضاً ظاهر، و قس عليه غيره.
و ربما تقرر شبهة التسلسل بنحو آخر، فيقال(1): إنّ الغرض من اختصاص الحادثة المعينة بوقتها المعين؛ إن وجد قبل وقت الحادثة المعينة لزم أن تكون الحادثة المعينة أيضاً قبل ذلك الوقت؛ لامتناع تأخر الشيء عن غرضه، و لزم أن لا يكون الغرض غرضاً؛ لامتناع أن يكون غرض الشيء قبله. و إن وجد الغرض من اختصاص الحادثة المعينة بوقتها المعين في ذلك الوقت عاد الكلام في اختصاص الغرض المذكور بذلك الوقت المعين، فإن لم يكن لغرض لزم التنزيه عن الغرض. و إن كان لغرض فإن وجد الثاني قبله لزم ان يكون الغرض الأول أيضاً قبله و إن لا يكون الغرض غرضاً. و إن وجد الغرض الثاني في ذلك الوقت عاد الكلام فيه و يلزم التسلسل أو التنزيه عن الغرض.
أقول: العلّة الغائية ما يتقدم بوجوده الذهني على مغيّاه و يتأخر بوجوده الخارجي عنه، فوجوده بعد تحقق مغيّاه من قبيل ترتب المعلول على العلة، و أمّا اختصاص الغرض بوقت دون وقت فهو لأجل علله التكوينية، كتحصيل المال بالتكسّب و الشبع بالأكل و نحو ذلك، و لعمري إنّ هذا التلفيق مجرد لقلقة لسانية لا معنى تحته أبداً، لكنّ تقليد شيخهم الأشعري دعاهم إلى هذه الترّهات، و الله العاصم.
4 - من طريق الإرادة، بيانه: أنّ كون الإرادة مرجحة صفة نفسية، و الصفات النفسية و لوازم الذات لا تعلّل، كما لا يعلّل كون العلم علماً و القدرة قدرة. نقله في الأسفار(2) عن الأشاعرة، ثمّ زيّفه بقوله: فإنّ مع تساوي طرفي الفعل كيف يتخصص أحد الجانبين؟ و الخاصية التي يقولونها هذيان، فإنّ تلك الخاصية كانت حاصلة أيضاً لو فرض اختيار الجانب الآخر الذي فرض مساوياً لهذا الجانب.
أقول: و قد أشرنا سابقاً أنّ كلامهم في إرادته تعالى يستلزم جبره تعالى، فهم بمبانيهم هذه
ص: 164
- من استحلال المحرمات العقلية النظرية و العلمية - أبعد خلق الله من القواعد العقلية والموازين الدينية.
5 - من طريق كمال فاعليته تعالى. قال في الأسفار(1): الفاعل الأول يجب أن يكون تاماً في فاعليته، و لا يمكن أن يتوقف على غيره في الفاعلية، لكن لا يلزم من ذلك نفي الغاية و الغرض عن فعله مطلقاً، فلك أن تجعل علمه تعالى بنظام الخير الذي هو عين ذاته علة غائية و غرضاً في الإيجاد. و قال في موضع سابق على هذا: فلو احتاج في فعله إلى معنى خارج عن ذاته لكان ناقصاً في الفاعلية، و كذا ذكره غيره أيضاً.
و قال ابن روزبهان(2): و لكن ليست أفعاله محتاجة إلى علة غائية كأفعالنا الاختيارية، فإنّا لو فقدنا العلة الغائية لم نقدر على الفعل الاختياري، و ليس هو تعالى كذلك؛ للزوم النقص و الاحتياج.
أقول: كل ذلك لا يرجع إلى معنى معقول أصلاً، فإنّ الله تامّ الفاعلية لا يحتاج في إنفاذ إرادته إلى أحد، إنّما أمره إذا أراد شيئاً أنّ يقول له: كن فيكون، و له الحكم كيفما إراد، لكنّه لحكمته البالغة لا يفعل إلا الأصلح، فاعتبار المصلحة في فعله - بصفتها علة غائية - من جهة الحذر عن اللغوية و العبثية، و أين هذا من النقص في فاعليته تعالى؟ و منه يخرج الجواب عن الثاني، فإنّ فقدان العلة الغائية لا يدل على عدم القدرة، بل على اللغوية و السفاهة، و أيضاً قد تقدم أنّ بعض أفعاله موقوف على بعضها الآخر بحيث لا يمكن إيجاده إلا بالترتيب.
و العجب من الفلسفي كيف يذكر هذا الوجه، و هو يزعم توسط العقول في فاعليته تعالى بحجة أنّ الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد! و هل هي إلا تقييد فاعليته المطلقة الكاملة؟ أفليس من التهافت أن يقيد فاعلية الحق بتخيل السنخية بلا استيحاش، ثم ينكر العلة الغائية حذراً من لزوم النقص في فاعليته تعالى؟!
و أمّا الأشعري فله ما يقول، و لا بحث معه إلا بمقدار ما يتضح الواقع للمبتدئين.
6 - من طريق جوده، فإنّ الواجب جواد مطلق، و الجواد لا يفعل لغرض، و إلا كان معاملاً، ذكره غير واحد من اصحاب الفلسفة، و هو سخيف جداً؛ فإنّ الغرض - كما دريت - جود آخر منه على غيره، بل الفعل الخالي عن الغرض ليس بجود، فإنّه إفادة ما ينبغي لا لعوض، و ما لا غرض فيه ليس على ما ينبغي، ففاعله لا يكون جواداً.
ص: 165
7 - من طريق عدم قصد العالي للسافل. قال في الأسفار(1): إنّ كل فاعل يفعل فعلاً لغرض غير ذاته، فقير مستفيض يحتاج إلى ما يستكمل به، فما يستكمل به يجب أن يكون أشرف و أعلى منه، فكل فاعل لغرض يجب أن يكون غرضه ما هو فوقه و إن كان بحسب الظنّ، فليس للفاعل غرض حق فيما دونه، و لا قصد صادق لأجل معلوله؛ لأنّ ما يكون لأجله قصد يكون ذلك المقصود أعلى من القصد بالضرورة... إلى آخره.
أقول: قد عرفت أنّ حديث الاستكمال في المقام واضح الاضمحلال. و أمّا أشرفية المقصود من الفاعل القاصد فهي غير مطّردة، و دعوى الضرورة غير مسموعة، ألا ترى أنّ الإنسان يعمل لأجل حصول الأجرة، و يأكل لأجل الشبع، و هكذا، مع أنّ ما يستكمل به من أخذ الأجر و الشبع لا يكونان أكمل من الإنسان قطعاً. و أمّا ما اعتذر به السبزواري في حاشيته على المقام فهو لا يرجع إلى محصّل، فلاحظ.
فحق القول: إنّ الله لا يريد إلا غيره لغيره، قال الله تعالى: إِنَّمٰا يُرِيدُ اَللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ اَلرِّجْسَ أَهْلَ اَلْبَيْتِ...(2)، و القرآن مشحون بأمثاله.
8 - من طريق ملكيته تعالى، و حاصله: أنّ العالم ملكه تعالى، و المتصرف في ملكه لا يقال له: لم فعلت ذلك؟ ذكره الرازي في تفسيره حول قوله تعالى: لاٰ يُسْئَلُ عَمّٰا يَفْعَلُ (3)، و هو واضح الفساد، فإنّ اللغوية و السفاهة المترتبة على الفعل الخالي عن الغرض غير مختصّ بملك الغير بلا شبهة، ألا ترى أنّ العقلاء يذمّون من يلقي أمواله في البحر بلا جهة، و يحكمون بسفاهته مع علمهم بمالكيته، و له تلفيقات واهية أخرى يظهر فسادها ممّا ذكرنا.
9 - من طريق النقل و السنّة، استدل صاحب الوافي(4) على قول الحكماء بالروايات الدالة على أنّه غاية الغايات، و أنّه لا غاية له.
أقول: الظاهر أنّه (رحمه الله) اشتبه في ذلك، فإنّها ناظرة إلى أمر آخر غير المقام، فلاحظها.
10 - من طريق الكتاب المبين، مثل قوله تعالى: لاٰ يُسْئَلُ عَمّٰا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ، و قوله: يَفْعَلُ اَللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ و يَحْكُمُ مٰا يُرِيدُ، و قوله: اَللّٰهُ خٰالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ، و قوله:
ص: 166
وَ اَللّٰهُ اَلْغَنِيُّ، و قوله: وَ إِلَيْهِ اَلْمَصِيرُ، استدل ببعضها صاحب الأسفار، و ببعضها الرازي في تفسيره ذيل قوله تعالى: مٰا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاّٰ لِيَعْبُدُونِ، لكنّ القرآن لا يثبت هذه النظرية الفاسدة، بل يبطلها و يزيّفها كما ستعرف.
أمّا الآية الأولى فهي تدل على أنّه لا آمر عليه تعالى حتى يسئل عن فعله كما يسئل الناس عن افعالهم، أو على أنّه لا معنى للسؤال عنه تعالى، لأنّه لا يفعل إلا الأصلح، و لا يعقل الخلل في صنعه، فإنّ أفعاله تابعة للمصالح و المفاسد الراجعة إلى العبادة و غيرهم(1). و الإنصاف أنّه لا إشعار - و لو ضعيفاً - في الآية بما زعمه الرازي و غيره أصلاً.
و أمّا الاية الثانية فمفادها نفي المانع من تأثير إرادته تعالى، و أين هذا من نفي تبعيتها للغرض؟
و أمّا الثالثة فقد تقدم وجه عدم دلالتها على مرادهم.
و أمّا الرابعة فهي تنفي الغرض الراجع إليه تعالى دون مطلق الغرض.
كما أنّ الخامسة تدل على رجوع الأشياء إليه، و لا ربط له بالمقام، فالاستدلال بهما - كما صدر عن صاحب الأسفار - عجيب جداً.
قد استبان ممّا تقدم أنّ القول الأول هو المتعيّن حسب القواعد العقلية، و أنّ ما ذهب إليه الفلاسفة و الأشاعرة لا أساس له أصلاً، و ما لفّقوه في تصحيح مقالتهم و إبطال القول الأول واهٍ جداً كما عرفته مفصّلاً، و نحن لم ندع شيئاً من كلماتهم عن الذكر إلا ما هو مغاير لما نقلناه عنهم لفظاً لا معنى، أو ما هو واضح الفساد استيفاءً لحقّ المسألة، و خدمة للسعاة السفرة إلى مركز الحقيقة. و لنرجع الآن إلى القرآن الفاصل لنستمع قضائه في المقام، و حيث إنّ موارد حكمه الجازم على المقام متعددة فنحن نقتصر على بعضها:
1 - مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنٰا عَلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ.
ص: 167
2 - إِلاّٰ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ.
3 - مٰا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاّٰ لِيَعْبُدُونِ مٰا أُرِيدُ....
4 - خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً.
5 - لُعِنَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا... ذٰلِكَ بِمٰا عَصَوْا.
6 - كِتٰابٌ أَنْزَلْنٰاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ اَلنّٰاسَ مِنَ اَلظُّلُمٰاتِ إِلَى اَلنُّورِ.
7 - أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمٰا خَلَقْنٰاكُمْ عَبَثاً.
8 - وَ مٰا خَلَقْنَا اَلسَّمٰاءَ وَ اَلْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا لاٰعِبِينَ.
9 - قُلْ مٰا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لاٰ دُعٰاؤُكُمْ.
10 - لِنَجْعَلَهٰا لَكُمْ تَذْكِرَةً.
11 - لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً.
12 - لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ نَبٰاتاً.
13 - لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجٰارَةً.
14 - لِنُرِيَهُ مِنْ آيٰاتِنٰا.
ص: 168
15 - وَ مٰا أَصٰابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمٰا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ.
16 - لِنُرِيَكَ مِنْ آيٰاتِنَا اَلْكُبْرىٰ.
17 - لِتَعْلَمُوا عَدَدَ اَلسِّنِينَ وَ اَلْحِسٰابَ.
إلى غير ذلك من الآيات البينات و هي كثيرة جداً، و هي بأسرها ناصّة على بطلان مقالة الأشاعرة.
و لذا قال بعض الشافعية(1) في حقّ شيخهم: اعلم أنّه (رحمه الله) قد يرعوي إلى عقيدة جديدة بمجرد اقتباس قياس لا أساس له، مع أنّه منافٍ لصرائح القرآن و صحاح الأحاديث، مثل: أنّ أفعال الله غير معللة بغرض إلى آخره.
ثم إنّ العلاّمة الحلّي - قدس الله روحه الطاهرة - ذكر في إلزامهم أموراً نذكر منها وجوهاً ثلاثة:
الأول: أنّه يلزم أن لا يكون الله سبحانه محسناً إلى العباد و لا منعماً عليهم و لا راحماً لهم...، و كل هذا ينافي نصوص الكتاب العزيز و المتواتر من الأخبار النبوية و إجماع الخلق كلهم من المسلمين و غيرهم، فإنّهم لا خلاف بينهم في وصف الله تعالى بهذه الصفات على سبيل الحقيقة، لا على سبيل المجاز. و بيان لزوم ذلك: أنّ الإحسان إنّما يصدق لو فعل المحسن نفعاً لغرض الإحسان إلى المنتفع، فإنّه لو فعله لغير ذلك لم يكن محسناً؛ و لذا لا يوصف مطعم الدابّة لتسمن حتى يذبحها بالإحسان في حقّها...
الثاني: عدم إثبات النبوّات فإنّه موقوف على أنّ الله أجرى المعجزة لأجل تصديق مدّعي النبوة، فلو فرضناه عدم تعلّله به فلا تكون المعجزة دليلاً على دعواه، فلا تثبت نبوّته أبداً.
الثالث: يلزم تجويز تعذيب المطيعين و إثابة العاصين و لو كان المطيع نبياً و العاصي شيطاناً مريداً، فإنّ فعله إذا لم يكن لغرض بحيث يثيب المطيع لطاعته و يعاقب العاصي لعصيانه، كان نسبتهما إلى الثواب و العقاب متساوية(2).
و ابن روزبهان الأشعري المتصدي لردّ كلامه لجأ من الإلزام الأول إلى مذهب الفلاسفة، و ترك مذهب شيخه كما يظهر من كلامه، فقد سلّم الإلزام من حيث لا يشعر! تمجمج في دفع
ص: 169
الإلزام الثاني بما لا يرجع إلى معنى صحيح، و لعلّه أيضاً لم يفهم ما قال.
و اضطرّ في دفع الإلزام الثالث إلى الاعتراف بقول الحق في حين إنكاره، فقال: هذا الوجه بطلانه أظهر من أن يحتاج إلى بيان؛ لأنّ أحداً لم يقل بأنّ الفاعل المختار الحكيم لم يلاحظ غايات الأشياء و الحكم و المصالح فيها!
أقول: و لا نعني بالفعل و المعلّل بالعلة الغائية إلاّ إيجاد الأشياء بلحاظ مصالحها و حكمها و رعاية غاياتها، و هذا هو الذي لم يقل به كل من فرض تقليد الأشعري على نفسه.
المسألة الأولي: حاول الحكيم اللاهيجي التوفيق بين مذهب الإمامية و مقالة الحكماء، فقال في شوارقه(1): فإن قلت: أليس أفعال الله عند الإمامية معلّلة بالأغراض؟! قلت: نعم، لكنّهم يفرّقون بين الغرض و الغاية، فلا يجعلون الغرض علة لفاعليته تعالى، فيعنون بالغرض الحكم و المصالح التي تشتمل عليها الأفعال ممّا يجده العقل و يحكم به، و يصير به الفعل حسناً و قبيحاً، فهم في ذلك يوافقون الحكماء بحسب المعنى و إن لم يطلق عند الحكماء لفظ «الغرض» عليها، بل يجعلون لفظي «الغرض» و «الغاية» مترادفين، بخلاف الأشاعرة فإنّهم يوافقون الحكماء في هذه المسألة بحسب اللفظ فقط... إلى آخره.
أقول: مراده من الغاية هي العلة الغائية، فلا تغفل. و قال في مبحث إرادة الله تعالى(2): فاعلم أنّ الأشبه أنّ مراد محقّقي المعتزلة من كون الإرادة عين الداعي الذي هو العلم بالأصلح إنّما هو الذي ذهب إليه الفلاسفة على ما ذكرنا، فيكون الواجب تعالى عندهم أيضاً فاعلاً بالعناية، و إن لم يقولوا به بحسب اللفظ... فكل من قال بكون الإرادة عين العلم... مراده أنّه تعالى فاعل بمجرد العلم المتعلّق بالخيرية و المصلحة في الفعل، فتكون الإرادته عقلية محضة، و هذا هو مراد الفلاسفة من الفاعل بالعناية... إلى آخره. و قريب منه ما ذكره في گوهر مراد(3) فراجع.
و الحق عدم صحة ما ذكره، فإنّ النزاع بين العدلية و الفلاسفة معنوي كما يظهر لمن راجع كتبهم، و أمّا ما قاله في توجيه مذهب الإمامية من مغايرة الغرض و الغاية، و أنّهم يثبتون الأول بمعنى اشتمال فعله تعالى على الحكمة و المصلحة و ينفون الثاني و يريدون منه العلة الغائية فهو من متفرّداته، و لا أثر له في عبارات الإمامية، بل هو إرجاع للقول الأول إلى القول الثالث بلا
ص: 170
رضا القائلين به فلا عبرة به.
المسألة الثانية: قال بعض الأعاظم من الأصوليتين (رحمه الله)(1) في بيان تبعية الأحكام الشرعية للمصالح و المفاسد: إنّ للأشاعرة في ذلك قولين، الأول: إنّ الأحكام بأجمعها جزافية...، و ليس هناك مصلحة و مفسدة أصلاً، و هذه الطائفة أنكروا وجود الحسن و القبح بالكلّية، و التزموا بعدم قبح الترجيح بلا مرجح، و لا ريب أنّ هذا القول منافٍ لضرورة العقل و الوجدان، لكنّ الالتزام به ممّن لا يلتزم بالعقل و ينكر كل بديهي ليس بعزيز. الثاني: أنّ الأحكام إنّما جعلت لمصلحة اقتضت التشريع، و حفظاً لتلك المصلحة لا بد من إيجاب أمور و تحريم أمور، و حيث إنّ الأفعال بعضها مشتملة على المصلحة و بعضها الآخر على المفسدة فهما صارتا مرجحتين في إيجاب ما فيه المصلحة و تحريم ما فيه المفسدة، و إلا فليست المصلحة و المفسدة بنفسها مناطين لجعل الوجوب أو الحرمة، و هذا القول ربما مال إليه بعض العدلية تبعاً لهم، و لا يخفى اشتراك هذا القول مع القول الأول في الفساد، فإنّ الضرورة قاضية بعدم المصلحة في جعل المكلّفين في الكلفة إلا إيصال المصالح إليهم و تبعيد المفاسد عنهم، و إلا فأيّ مصلحةٍ تقتضي جعلهم في الكلفة مع عدم رجوع المنفعة إليهم؟!... إلى آخره.
أقول: الأمر كما ذكره.
المسألة الثالثة: أصناف الفاعل عند الحكيم الشيرازي ستّة(2)، و هي: الفاعل بالطبع، و الفاعل بالقسر، و الفاعل بالجبر، و الفاعل بالقصد، و الفاعل بالعناية بالمعني الاعم، و الفاعل بالعناية بالمعنى الأخص، و ربما سمّي بالفاعل بالتجلّي أيضاً.
و عند الحكيم السبزواري(3) ثمانية بزيادة الفاعل بالرضا و الفاعل بالتسخير. و عند السادة من محشّي الأسفار: أربعة، بإرجاع الفاعل بالجبر و العناية بالمعنى الأعم إلى الفاعل بالقصد.
و اختلفوا في فاعلية الحق. فعن المشائين: أنّه فاعل بالعناية، أي يتبع فعله علمه التفصيلي الزائد على ذاته تعالى السابق عليه، بلا مقارنة للداعي الزائد على ذاته تعالى، بل يكون نفس العلم منشأ لوجود المعلول.
و عن الإشراقي أنّه فاعل بالرضا، أي علمه بفعله عين فعله.
و عن صاحب الأسفار و من تبعه: أنّه فاعل بالتجلّي، أي أنّ علمه بفعله سابق عليه و سبب له، و هو عين ذاته تعالى، و هو العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي.
ص: 171
و عن جمهور المتكلمين: أنّه فاعل بالقصد، أي يكون علمه بفعله سابقاً عليه، يقرن بالداعي الزائد على ذاته.
أقول: و أنت بملاحظة الأصول الحقّة المبرهنة في هذا الجزء و الجزء الأول تستيقن ببطلان القول الأول و الثاني و الثالث، و بصحة القول الأخير، لكنّ الأنسب أن نعبّر عنه بالفاعل بالاختيار، فإنّ إطلاق القصد على المجرد عن المادة و الروح، و المنزّه عن الجسم و الجسماني لا يخلو عن حزازة و ركاكة، فهذا المسلك هو المطابق للعقل و النقل، كما عرفت بيانه مفصلاً، لكن لصاحب الأسفار(1) عليه اعتراضاً عجيباً، قال: و إن كان الأول منها - أي الفاعل بالقصد - مضطراً في اختياره؛ لأنّ اختياره حادث فيه بعد ما لم يكن، و لكل حادث محدث، فيكون اختياره عن سبب مقتضٍ و علة موجبة، فإمّا أن يكون ذلك السبب هو، أو غيره، فإن كان غيره فثبت المدّعى، و إن كان هو نفسه: فإمّا أن يكون سببيتها لاختياره باختياره، أو لا، فعلى الأول يعود الكلام و ينجرّ إلى القول بالتسلسل في الاختياريات إلى غير النهاية. و على الثاني يكون وجود الاختيار فيه لا بالاختيار، فيكون مضطراً و محمولاً (مجبولاً خ) على ذلك الاختيار من غيره، فينتهي إلى الأسباب الخارجة عنه، و ينتهي بالآخرة إلى الاختيار الأزلي الذي أوجب الكلّ على ما هو عليه بمحض الاختيار من غير داع و زائد و لا قصد مستأنف و غرض عارض. انتهى كلامه.
و قد سبقه إلى ذلك الفارابي في الفصّ السادس و الخمسين من فصوصه، لكنّه غير صحيح؛ إذ للاختيار معنيان:
الأول: إمكان الفعل و الترك، أي للفاعل أن يفعل، و له أن يترك.
الثاني: الترجيح و إيثار أحد الطرفين - الفعل و الترك - على الآخر، فإن أراد به المعنى الأول فنقول: إنّه أزلي ليس بحادث، فإنّ قدرته تعالى عين ذاته، و الاختيار بهذا المعنى لازم قدرته على ما مرّ بحثه في الجزء الأول مفصّلاً، فثبوت الاختيار - بهذا المعنى - له تعالى ليس باختيار منه، بل هو ضروري له، و لكن لا يستلزم اضطراره في أفعاله كما لا يخفى على عاقل. و إن أراد به المعنى الثاني فنقول: إنّه حادث، و مرجّحه بمعنى السبب الفاعلي هو الله تعالى، و بمعنى العلة الغائية هي المصالح أو المفاسد الراجعة إلى مخلوقاته، فهو مع قدرته و تمكّنه من الفعل و الترك يرجح ما هو الأصلح بمحض عدله و حكمته، من غير أن تؤثّر المصالح المذكورة في تمكّنه تعالى، و إنّما هي علة فاعلية الفاعل في خروج فعله عن اللغوية و العيثية، و إلا فله تعذيب الأنبياء و تعظيم الكفرة و الأشقياء.
ص: 172
و بالجملة: حدوث الاختيار بهذا المعنى هو عبارة أخرى عن حدوث فعله، و هذا ممّا لا شك فيه لأحدٍ، و أمّا حديث لزوم التسلسل فقد مرّ انحلاله بأوضح وجه في مبحث إرادته تعالى في الجزء الأول. و الإنصاف أنّ هذه الشبهة سخيفة جداً. هذا، و قد عرفت في مبحث القدرة أنّ الواجب على أصول الفلسفة فاعل مضطرّ، و علّة موجبة - بفتح الجيم - بحيث لا يقبله الإنكار.
المسألة الرابعة: قد انجلى أنّ الغرض من أفعاله ليس هو ذاته المقدسة، بل ما يرجع إلى مخلوقه من المنافع كما يحكم به العقل. و الآن نرجع إلى النقل في بيان تفصيل هذا الغرض و تعيين مصداقه، و الكلام يقع في مقامين:
المقام الأول: في تعيين الغرض من خلقة الإنسان الذي فضّله الله على كثير من خلقه، المستفاد من الأدلة أنّ العلة من خلقه أمور:
الأول: الرحمة، قال الله تعالى: إِلاّٰ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ (1).
و ظاهر أنّ مرجع الإشارة هو الرحمة.
و في صحيح أبي عبيدة الحذّاء(2) قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الاستطاعة... قلت: قوله: إِلاّٰ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ؟ قال: «هم شيعتنا، و لرحمته خلقهم، و هو قوله: وَ لِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ...» إلى آخره.
الثاني: العبادة، قال الله تعالى: وَ مٰا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاّٰ لِيَعْبُدُونِ (3).
و قال الصادق (ع) كما في روايتي جميل(4): «خلقهم للعبادة».
و تدل عليها أيضاً رواية حبيب السجستاني، عنه (ع)(5)، و رواية محمد بن أبي عمير عن الكاظم(6) (ع).
الثالث: المعرفة، و يدل عليها الحديث القدسي المعروف: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لأعرف».
و رواية سلمة بن عطاء(7) عن الصادق (ع) قال: «خرج الحسين بن عليّ (عليهم السلام) على أصحابه،
ص: 173
فقال: أيّها الناس، إنّ الله جلّ ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فاذا عرفوه عبدوه... إلى آخره.
الرابع: الأمر و النهي و التكليف بالطاعة، دلّت عليه رواية عمارة، قال: سألت الصادق جعفر بن محمد (عليهم السلام) فقلت له: لم خلق الله الخلق؟ فقال: «إنّ الله تبارك و تعالى لم يخلق خلقه عبثاً، و لم يتركهم سدى، بل خلقهم لإظهاره قدرته، و يكلّفهم طاعته، فيستوجبوا بذلك رضوانه، و ما خلقهم ليجلب منهم منفعة، و لا ليدفع بهم مضرّة، بل خلقهم لينفعهم و يوصلهم إلى نعيم الأبد».
و رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله عزّ و جلّ: وَ مٰا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاّٰ لِيَعْبُدُونِ؟ قال: «خلقهم ليأمرهم بالعبادة»، قال: و سألته عن قوله عزّ و جلّ: وَ لاٰ يَزٰالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاّٰ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ؟ قال: «خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فيرحمهم»(1).
و رواية عليّ بن إبراهيم(2)... قال: «خلقتهم للأمر و النهي و التكليف، و ليست خلقة جبران يعبدوه، و لكن خلقة اختيار ليختبرهم بالأمر و النهي، و من يطع الله و من يعصي».
الخامس: إظهار قدرته و حكمته و إنفاذ علمه، يدل عليه خبر عمارة المتقدم، و خبر هشام بن الحكم(3) أنّه سأل الزنديق أبا عبد الله (ع): لأيّ علّة خلق الخلق و هو غير محتاج إليهم و لا مضطرّ إلى خلقهم و لا يليق به العبث؟ قال: «خلقهم لإظهار حكمته و إنفاذ علمه و إمضاء تدبيره».
السادس: النبي الأعظم و أوصياؤه المكرمون سلام الله عليه و عليهم أجمعين، و يدل عليه ما في نهج البلاغة: «نحن صنايع الله، و الناس بعد صنايع لنا «صنايعنا».
و ما دلّ على أن الأرض لا تبقى بغير الإمام، و إلاّ لساخت أو ماجت بأهلها، و هي كثيرة(4). و ما في رواية المفضل الطويلة(5) عن الصادق (ع): «و لولا هم - أي النبي و بنته الصديقة و الأئمة (ع) - ما خلقتكما»، يعني آدم و حواء. و مثلها رواية أخرى.
ص: 174
و ما في رواية محمد بن الحرب الهلالي أمير المدينة، عن الصادق(1) (ع) من قوله حاكياً عن قول الله تعالى: «و لولا هما - أي النبي و أمير المؤمنين (عليهم السلام) - ما خلقت خلقي».
و ما عن ابن عباس(2): لمّا أراد الله أن يخلق محمداً (ص) قال لملائكته: «... فلولاه - أي النبي الأكرم - ما زخرفت الجنان، و لا سعّرت النيران...» إلى آخره.
و ما في رواية عبد السلام بن صالح الهروي الواردة في قصّة آدم (ع) من قوله تعالى(3): «و لو لا هم - أي الخمسة الطيّبة - ما خلقتك، و لا خلقت الجنة و النار، و لا السماء و الأرض...» إلى آخره.
و عن الحمويني في فرائد السمطين (كما في عبقات الأنوار(4) بإسناده عن أبي هريرة، عن النبي (ص): «... قال - آدم -: فمن هؤلاء الخمسة الذين أراهم في هيئتي و صورتي؟ قال: هؤلاء خمسة من ولدك، لولا هم ما خلقتك و لولاهم ما خلقت الجنة و النار و لا العرش و لا الكرسي و لا السماء و الأرض، و لا الملائكة، و لا الانس و لا الجنّ... آليت بعزتي أنّه لا يأتيني أحد بمثقال حبّة من خردل من بغض أحدهم إلا أدخلته ناري و لا أبالي...». و الروايات فيه كثيرة منتشرة.
إذا تقرر ذلك فأعلم: أنّه لا منافاة بين هذه الآيات و الروايات أصلاً. بيان ذلك:
أنّ الغرض الأصلي من خلقة الإنسان - و إن شئت فاذكر الجنّ أيضاً معه - هو الرحمة الرحيمية، سواء فسّرناها بتكامل النفس بالملكات الحميدة، أو بالثوب الأخروي، كما دلت عليها الآية الأولى، و صحيحة أبي عبيدة الحذّاء و غيرها، و هذه الرحمة حيث لم يمكن إيصالها إليها من دون معرفة الله تعالى و إقرارهم بوجوده و صفاته، و من دون عبادته، و الامتثال لأوامره و مناهيه، كلّفهم الله و شرع لهم معالم الزلفى.
و على الجملة: تلك الرحمة موقوفة على أمرين طوليّين:
أولهما: جعل التكليف من الله تعالى و إيصاله إلى الناس، و هذا ممّا لا بد من فعله على الله تعالى؛ لئلاّ يلزم اللغو في إيجاد الإنسان، أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمٰا خَلَقْنٰاكُمْ عَبَثاً، أَ يَحْسَبُ اَلْإِنْسٰانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً، و قد فعله الله تعالى.
ص: 175
ثانيهما: إتيان المكلّف ما أمره به باختياره لا بجبر من الله، و إلا لبطل التكليف و ما يترتب عليه من الرحمة المذكورة، و هذا خلف، و لذا تتخلّف العبادة عن التكليف خارجاً، و إلا كان التخلّف مستحيلاً؛ لأن الله هو القاهر الغالب على أمره.
ثم اعلم: أنّ المراد بالعبادة الموقوف عليها الرحمة هو الإيمان و الأعمال معاً، فإنّ المعرفة أفضل أنحاء العبادة، فلا حاجة إدخالها في سلسلة الغايات إلى دليل خاصّ، على أن الحديث القدسي المتقدم مجهول سنداً، بل ذكر المحدّث الفيض بأنّه من مجعولات الصوفية(1)، و ما اشتهر من تفسير «ليعبدون» ب - «ليعرفون» بلا مدرك، فلم يبق إلا رواية سلمة بن عطاء المتقدمة، و هي من حيث السند ضعيفة إلى الغاية، و الصحيح ما ذكرنا.
فإن قلت: بناءً على هذا تكون المعرفة و العمل في مرتبة واحدة، مع أنّه لا شك في تقدمها عليه.
قلت: تقدمها عليه خارجاً لا ينافي تقارنهما لحاظاً و غرضاً، بل بعض مراتب المعرفة متأخر عن العمل و مترتب عليه، كما يشهد له الاعتبار و الآثار، و يدل عليه قوله تعالى: وَ اُعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ اَلْيَقِينُ بناءً على أنّ المراد باليقين هو بعض مراتب المعرفة دون الموت، لكنّ هذه المرتبة منها خارجة عن سلسلة الغايات، بل الغاية هي المعرفة بمقدار خاص نبيّنه إن شاء الله في مباحث المعاد، وهي التي قلنا: إنّها ملحوظة مستقلة، لا آلة إلى العمل و إن كانت شرطاً لصحته و قبوله، فافهم.
ثم إنّ إيصال التكليف إلى المكلفين و حملهم على الرشاد و السداد حيث كان وظيفة النبي و الإمام فصارا من العلل الغائبة لخلقة الإنس و الجنّ؛ إذ لو لا هما لما وصل التكليف إليهم و إن لم يقدروا على العبادة فلم يتيسر لهم التكامل و الرحمة الرحيمية، فتكون خلقتهم لغواً، و هذا خلف، و هذا معنى أنّه لو لا هما لما خلق الخلق.
و قد ورد عن الأئمة (عليهم السلام): «لولا نا ما عبد الله، و لولانا ما عرف الله(2)، و «إنّ الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام»(3). و الروايات في ذلك كثيرة، و يؤيده: ما روته العامة عن النبي الأكرم (ص)
ص: 176
«إنّ أهل بيتي أمان لأمّتي»(1).
فالمتحصل: أنّ مدخلية الأكرم و الأئمة (عليهم السلام) إنّما هي في العلة الغائية من الناحية التشريعية فقط، دون العلة الفاعلية، و لو بإذن الله حتى على نحو غير الاستقلال، على ما سندرسه في مسائل المقصد السابع - و هو مبحث الإمامة - إن شاء الله.
و أمّا الغرض الخامس فهو بظاهره يؤيده القول الثالث فلا بد من توجيهه؛ لما سبق من بطلان القول المذكور.
و يمكن أن يقال: إنّ المراد بإظهاره الحكمة و إمضاء التدبير هو إيصال الرحمة إلى المكلّفين، و الأمر - بعد ضعف الخبرين المذكورين - سهل.
المقام الثاني: في تعيين الغرض من خلقة سائر الأشياء، فنقول: أمّا ما في الأرض فخلق لأجل الإنسان، لقوله تعالى: خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً، و كذا بناء السماء و المطر، لقوله تعالى: اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اَلْأَرْضَ فِرٰاشاً وَ اَلسَّمٰاءَ بِنٰاءً وَ أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ اَلثَّمَرٰاتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلاٰ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدٰاداً.
و أمّا الأشياء بأسرها فالغرض من إيجادها غير معلوم لنا. نعم، في الحديث القدسي: «يا إنسان، خلقت الأشياء لأجلك، و خلقتك لأجلي»، لكنه مع كونه خبراً واحداً لا سند له فلا عبرة به. و كأن بعض الناس أرادوا أن يخبروا عنالله كذباً باسم الحديث القدسي. و لا بدّ للمحقّقين من عدم قبول الأحاديث المسمّاة بالقدسية، إلا بسند صحيح عن النبي الأكرم (ص) أو أوصيائه حتى لا يكونوا من المغترين على الله، و كثير من الكتّاب و المبلغين لا علم لهم بالرجال و وثاقة الرواة.
و في رواية ابن عباس عن أمير المؤمنين (ع)، عن قول الله عز و جل لنبيه (ص): «و عزتي و جلالي لولاك ما خلقت الأفلاك»(2). و في حديث الكساء المعروف و زيارة الجامعة و بعض
ص: 177
الروايات المتقدمة في المقام الأول و غيرها شواهد على علّية النبي و آله (عليهم السلام) للأشياء و مدخليتهم في العلة الغائية، و الله العالم.
المسألة الخامسة: في دفع ما يورد على هذه القاعدة، و هو أمور:
الأول: أنّ الغاية من خلق الإنسان هي الرحمة الموقوف على المعرفة و العبادة كما سبق، فالذين لا يمكنهم تحصيل المعرفة و العبادة كالمجانين و القاصرين و الأطفال، أو لا يجب عليهم تحصيلهما كالمراهق يلزم أن لا غرض لله من خلقتهم، فتكون لغواً، تعالى عن ذلك.
و جوابه: أنّ الغرض المذكور نوعي لا شخصي، فالمخلوق له نوع الإنسان و مجموعة، لإتمام أفراده(1) و الذي لا يصح تكليفه، أو لم يكلّف شرعاً و إن صح عقلاً، له غرض آخر لا نعلمه.
أو نقول: إنّ الغرض منهم أيضاً هو الرحمة الموقوفة على العبادة و التكليف، لكنّ تكليفهم في الآخرة، لا في الدنيا، كما نصّت عليه و الروايات: منها صحيحة زرارة(2)، قال الباقر (ع) فيها: «إنّه إذا كان يوم القيامة أتي بالأطفال، و الشيخ الكبير الذي قد أدرك السن «النبي خ» و لم يعقل من الكبر و الخرف، و الذي مات في الفترة بين النسبين، و المجنون، و الأبله الذي لا يعقل، فكل واحد يحتج على الله عز و جل، فيبعث الله تعالى إليهم ملكاً من الملائكة و يؤجّج ناراً، فيقول: إنّ ربكم يأمركم أن تثبوا فيها، فمن و ثب فيها كانت عليه برداً و سلاماً، و من عصاه سيق إلى النار».
أقول: في رواية أخرى لزرارة زيد «الأصم و الأبكم».
و أمّا ما عن جمع من المتكلمين من إنكار التكليف في القيامة بحجة أنّ الآخرة دار الجزاء و المكافاة لا دار التكليف فهو خطأ؛ لأنّ الجزاء في الجنة و النار، و هذا التكليف في المواقف السابقة عليهما، و للبحث صلة تمرّ عليك في بعض القواعد الآتية إن شاء الله.
الثاني: قد تقرر أنّ الغرض الأقصى هو الرحمة الرحيمية، و حيث إنّها لا تيتسّر من دون العبادة فكلّف الله الناس بها.
لكن يرد عليه: أنّها غير موقوفة على العبادة، فإنّ العبد بأعماله لا يستحق ثواباً على الله تعالى، كما سيأتي بحثه في محله إن شاء الله، و لو سلّمناه نقول بكفاية الإيمان الصحيح لحصول الرحمة المذكورة به من دون انضمام الأعمال الجوارحية معه، كما تدل عليه قطعية العفو، و الشفاعة، و قبول التوبة في حق العصاة، و من ترك وظائفه الفرعية، قال الله تعالى: إِنَّ اَللّٰهَ
ص: 178
لاٰ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشٰاءُ، وقال: إِنَّ اَللّٰهَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ جَمِيعاً، و قال: مَنْ ذَا اَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّٰ بِإِذْنِهِ، و قال: وَ هُوَ اَلَّذِي يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ.
أقول: عدم الاستحقاق للثواب على الأعمال الصالحة إنّما هو بنظر العقل فقط، و أمّا من جهة الشرع فاستحقاقه عليها ضروري، على أنّ المراد بالرحمة ليس هو الثواب، بل تكامل المكلفين، كما سيأتي بحثه، و هذا لا بد في حصوله من وساطة أعمال العبد الاختيارية، و لا يمكن من دونها، كما لا يخفى، فالإشكال الأول ساقط.
ثم إنّ الإيمان و إن يستأهل العبد به للدخول في الجنة و الخلود فيها من جهة العفو أو التوبة أو الشفاعة إلا أنّه لا يبلغ في المرتبة و الكمال بمن أتى بالعبادات على وجهها، كما لا يخفى على الناظر في قواعد العدلية، فلا مجال للإشكال الثاني أيضاً، فإنّ الرحمة الرحيمية في حقّ العامل أكمل منها في حقّ التائب و المعفوّ عنه و المشفّع له، فافهم.
روي عن مولانا أمير المؤمنين (ع) كما عن الاحتجاج(1): «إنّ الله تبارك و تعالى لمّا خلق خلقه أراد يكونوا على آداب رفيعة، و أخلاق شريفة، فعلم أنّهم لم يكونوا كذلك إلا بأن يعرّفهم مالهم و ما عليهم، و التعريف لا يكون إلاّ بالأمر و النهي، و الأمر و النهي لا يجتمعان إلا بالوعد و الوعيد، و الوعد لا يكون إلا بالترغيب، و الوعيد لا يكون إلا بالترهيب، و الترغيب لا يكون إلا بما تشتهيه أنفسهم و تلذّه أعينهم، و الترهيب لا يكون إلا بضدّ ذلك...» إلى آخره.
و مع الغضّ عن الجميع نقول: إنّ التوقف المذكور في المقام تعبّدي لا عقلي.
الثالث: أنّ توسّط النبي و أوصيائه (ص) في إيصال التكليف إنّما هو بالنسبة إلى هذه الأمّة دون غيرها، فكيف صاروا علّة غائية لجميع الخلق أو جميع الناس؟ هذا من ناحية، و من ناحية أخرى: أنّ جميع الأنبياء (عليهم السلام) واسطة في التكليف، فما معنى التخصيص؟
أقول: و جوابه أولاً: أنّ أمة النبي الخاتم (ص) لعلهم أكثر عدداً و أطول زماناً من بقية الأمم، بحيث لولا هذه الأمة لمّا كانت عبادة تلك الأمم - لقلّتها من كل جهة - مقصودة و علة غائية للإيجاد، و حيث إن النبي الخاتم و أوصياءه (ص) علل غائية لهذه الأمة - كما مرّ - فصاروا عللاً
ص: 179
غائية لجميع الأمم، و لعلّ هذه هو السرّ في أخذ الاعتراف بنبوه نبينا و ولاية أوصيائه من الأنبياء الماضين (عليهم السلام)، كما في بعض الأخبار.
و ثانياً: أنّه لو لا عبادة محمد و آله (ص) لم تكن عبادة غيرهم بمثابة تصير مستوجبة للرحمة المذكورة المقتضية لخلقه المكلفين؛ و ذلك لكمال عباداتهم (ص) كمّاً و كيفاً، كما تدل عليه الروايات، و لعلّ هذا هو السرّ في اشتراط قبول ولايتهم في قبول الأعمال من الناس، كما يمرّ عليك دليله في موطنه المناسب له إن شاء الله.
و أمّا الروايات المذكورة غير المعتبرة سنداً، فهي كثيرة و إليك بعضها:
رواية ابن يزيد الجعفي عن الصادق (ع)... و قلت...: أين كنتم قبل أن يخلق الله سماءً مبنية و أرضاً مدحية أو ظلمة أو نوراً؟ قال: «كنا أشباح نور حول العرش نسبّح الله قبل أن يخلق آدم (ع) بخمسة عشر ألف عام...» إلى آخره.
و رواية أبي ذرّ، قال: سمعت رسول الله (ص) و هو يقول: «خلقت أنا و علي بن أبي طالب من نور واحد، نسبّح الله يمنة العرش قبل أن خلق آدم بألفي عام...» إلى آخره(1).
و في بعض الروايات: «قبل... بأربع مئة ألف سنة» و «أربع و عشرين ألف سنة». و الجمع بين الروايات لرفع اختلافها بحث آخر، لكنّ الغرض هو إثبات كثرة عباداتهم في تلك العوالم، بل و في هذا العالم، لأنّ عبادة الأعلم الأعرف أكمل من عبادة غيره، و لا شك أنّ نبيّنا و أوصياؤه أعلم من غيرهم حتى الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين، كما ستعرف دليله في مبحثه إن شاء الله.
و ثالثاً: أنّ النبي (ص) كما هو رسول إلى أمته كذلك روحه الطاهرة مرسلة إلى أرواح الأنبياء، فهو واسطة بين الله و تمام خلقه، و الدليل عليه: خبر المفضل(2)، قال: قال لي أبو عبد الله (ع): «يا مفضل، أما علمت أنّ الله تبارك و تعالى بعث رسول الله - و هو روح - إلى الأنبياء - و هم أرواح - قبل الخلق بألفي عام؟»، قلت: بلى، قال: «أما علمت أنّه دعاهم إلى توحيد الله و طاعته واتّباع أمره و وعدهم الجنة على ذلك...» إلى آخره. و هذا الوجه مجرّد احتمال لضعف الخبر المذكور سنداً.
و لعله المراد بقوله (ص) كما اشتهر: «كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين».
رابعاً: أنّ ذكر أسمائهم من باب المثال، و المراد الواقعي أنّه لو لا الأنبياء و الأوصياء لما خلق الله الخلق، لكنّه احتمال محض، بل تصحيحه غير ممكن بالقياس إلى الروايات الدالة على أنّ الرسول الخاتم و خلفاء (عليهم السلام) علل غائية، فلاحظ و الله العالم.
ص: 180
الرابع: لم لا يكفي علمه أزلاً بطاعة المطيعين و معصية العاصين في إيصال الرحمة و النقمة؟
أقول: إن كان المراد بالرحمة هو تكامل المكلف في صفاته النفسانية بمزاولة الأفعال الاختيارية فعدم كفاية علمه تعالى بالطاعة و المعصية لإيصالها واضح. و إن كان المراد بها هو الثواب و العقاب فجوابه: أنّ فعلية الثواب و العقاب مترتبة على فعلية القرب و البعد من الله تعالى، و هي تابعة لفعلية الشقاوة و السعادة المتوقفة على فعلية الإطاعة و المعصية المتفرعة على فعلية الأمر و النهي، فتدبّر.
الخامس: أنّ الثواب يمكن بتوسّط الأعمال اليسيرة دون مثل هذه التكاليف الشاقّة؛ إذ ليس ثواب على قدر المشقة و عوضاً مساوياً لها، ألا ترى أنّ في التلفّظ بكلمة «الشهادة» من الثواب ما ليس في كثير من العبادات الشاقة؟ و ما يروى من أنّ أفضل الأعمال أحمزها - أي أشقّها - فذلك عند التساوي في المصالح، فلا ينافي أن يكون الأخفّ أكثر ثواباً إذا كان أكثر مصلحة(1).
أقول: و هذا التلفيق عجيب، الملفّق سلّم تبعية الثواب للأكثر مصلحة، و مع ذلك يدّعي إمكان الثواب الكثير بتوسّط الأعمال اليسيرة! و هل له دليل على أنّ كل عملٍ سهل أكثر مصلحة من كل عمل شاقّ!؟
لا يقال: الثواب و العقاب إنّما يدوران مدار الانقياد و التجرّي فقط دون ترك المصالح و ارتكاب المفاسد الواقعيتين، كما حقق في أصول الفقه.
فإنّه يقال: نعم، لكن للانقياد والتجرّي مراتب قوة و ضعفاً يتفاوت الثواب و العقاب بلحاظها قلة و كثرة، و لا ريب أنّ أهمية المصلحة أو المفسدة ممّا يوجب مزيد عناية الآمر والناهي و اهتمامه للبعث أو الزجر، و من البديهي أنّ هذا الاهتمام يقوّي مرتبة التجرّي و الانقياد فيتفاوت الجزاء أيضاً، فافهم فإنّه دقيق.
السادس: تكليف الكفّار، و الإشكال فيه من جهتين:
الأولى: أنّه لا غرض له تعالى فيه؛ لأنّ الغرض المتصور هو كونه وسيلة و ذريعة إلى الرحمة(2)، و المفروض أنّ الله تبارك و تعالى يعلم أزلاً بعدم ترتبها عليه، و إن كان بسوء اختيار المكلف نفسه.
ص: 181
الثانية: أنّه ضرر على الكافر فإنّه يستوجب دخوله النار و لو بتوسط اختياره.
و جوابه: أنّ عدم ترتب الغاية بسوء اختيار المكلف شيء، و تعلّل فعله بها شيء آخر.
فإنّا نقول: الغرض من التكليف هو جعل المكلف في معرض تحصيل الرحمة و تمكّنه من اكتسابها، و هذا الغرض مترتب على التكليف و لا يمكن انفكاكه عنه، فعدم استفادة المكلف منه و إلقاء نفسه في التهلكة - بمحض اختياره - لا يضرّ بتشريع التكليف.
و حق الجواب و أحسنه: أنّ التكليف ذو مصلحة مهمة يستوجب تكامل النفوس و راحة البال، و الخلود في دار النعيم، كما هو واضح، و الله سبحانه يعلم أزلاً أنّ كثيراً من المكلفين يستوفونها بامتثالهم تلك التكاليف، و كثير منهم لا يستوفونها؛ لتمرّدهم عن الطاعة اختياراً، قال الله تعالى: فَرِيقاً هَدىٰ وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ اَلضَّلاٰلَةُ (1).
هذا من ناحية، و من ناحية أخرى أنّ التفكيك في التكليف و اختصاصه بالمؤمنين و المتّقين غير ممكن، فإنّ الله سبحانه و تعالى إذا قال: «إنّ من يقبل التكليف و يريد الإيمان و العمل الصالح فهو مكلف، و أمّا من لا يريده و لا يقبله فلا اكلّفه». يسقط التكليف و التشريع عن النفوذ رأسا، إذ لا يقلده إلا الأوحدي من الناس - إن وجد - فبهذا القول قد فوّت التكامل و الثواب على كثير ممن كانوا يؤمنون في فرض كون التكليف عاماً شاملاً، و هذا واضح إن شاء الله، فافهم و اغتنم.
السادس: خلق الكافر، فإنّ الغاية المقررة من إيجاد الإنسان - و هي الرحمة - لا تترتب عليه، و هذا معلوم لله تعالى أزلاً، و ما ذكرناه من الجواب المتقدم لا يجري هنا؛ لإمكان التفكيك في الخلق و التكوين.
و أجيب عنه(2): بأنّ تفاوت الماهيات الجنسية و النوعية و الصنفية و الشخصية في أنفسها و لوازمها بنفس ذواتها، لا بجعل جاعل و تأثير مؤثّر، فمنهم شقي و منهم سعيد بنفس ذاته و ما هويته، و حيث كانت الماهيات موجودة في العلوّ الأزلي و طلب بلسان حال استعدادها الدخول في دار الوجود، و كان الواهب الجواد فيّاضاً بذاته غنياً بنفسه، فيجب عليه إفاضة الوجود، و يمتنع عليه الإمساك عن الجود، و حيث الجود بمقدار قبول القابل و على طبق حال السائل كانت الإفاضة عدلاً و صواباً؛ إذ الشيء لا ينافي مقتضاء، فإفاضة الوجود على الماهيات كائنة ما كانت إفاضة على ما يلائم الشيء، حيث إنّ الشيء يلائم ذاته، و ذاتياته و لوازمه و قياسه بإجابة السفيه قياس باطل، إذ السفيه ربما يطلب ما ينافي ذاته، فإجابته خلاف الحكمة، و بخلاف إجابة الماهيات فإنّه لا اقتضاء وراء الذات و الذاتيات، فالاعتراض إن كان بالإضافة إلى مرتبة
ص: 182
الذات و الماهية فهو باطل بأنّ الشقي شقي في حدّ ذاته، و السعيد سعيد كذلك... و الذاتي لا يعلّل إلا بنفس ذاته، و إن كان بالإضافة إلى الوجود فهو فاسد؛ لما عرفت من أنّ إفاضة الوجود على وفق قبول القوابل عدل و صواب.
أقول: هذا ملخّص الجواب مع حذف مقدماته، و هو كما ترى لا يمكن الركون إليه بوجه.
فالصحيح أن يقال: إنّ الإنسان ما أوتي من العلم إلا قليلاً، إنّ الله سبحانه هو الأعلم بفعله و غرضه، فنحن و إن لا نعلم الغرض من إيحاده الكافر غير أنّا نعلم أنّه حكيم لا يفعل القبيح، و أنّه عادل لا عبث في أمره. ثمّ إن هذا الاشكال يجري في حقّ غير المكلين كالأطفال و المجانيين و... قد مرّ الجواب عنه سابقاً.
السابع: العقاب و العذاب، إذ لا داعي له بعد استحالة التشفّي عليه تعالى، و عدم تعقّل افتقاره إليه، فهذا ضرر محض للعبد لا يرجع نفعه إلى أحد، و لا سيما الخلود في النار.
و أجيب عنه أولاً: بأنّ التعذيب من باب التخويف و الإيفاء بالوعيد الواجبين في الحكمة الإلهية فإنّ إخلاف الميعاد منافٍ للحكمة، و موجب لعدم ارتداع النفوس من التوعيد و التخويف على ترك التكاليف المستلزم لوقوع المكلف في المفسدة أو ترك المصلحة.
أقول: و فيه نظر: أمّا أولاً فلأجل أنّ التخويف المستلزم لدخول المكلف في النار الموقدة التي تطّلع على الأفئدة أبداً أو مؤقّتاً من ترك تكامل النفس بامتثال التكاليف الشرعية غير معقول، ألا ترى أنّ أحداً من العقلاء لا يحسن أن يقول قائل لمن هو دونه: اشرب هذا الماء البارد لئلاّ تبقى عطشاناً و إن لم تشرب أقصّ لسانك؟
و ثانياً: أنّ خلاف الوعيد في القيامة تفضلاً على حال العبد ليس بقبيح.
و أجيب عنه ثانياً: بأنّ مصلحة التخويف العام إنّما هي لأجل حفظ النظام الذي لا أتمّ منه نظام.
أقول: و هذا أحسن من الجواب الأول؛ إذ علة التخويف المذكور ليست مجرد حفظ العبد عن الوقوع في المفسدة - و إن كان من الفوائد أحياناً - حتى يقال بأنّه لا يقاوم مفسدة الوقوع في العذاب الدائم، بل حفظ النظام الذي لا يزاحمه شيء أبداً، ثم قال هذا المجيب: و من هنا أتّضح سرّ التكليف و التخويف مع القطع بعد التأثير، حيث إنّ المقدمة و إن كان شأنها إمكان التوصّل بها، لكنّ إيجادها مع القطع بعدم الموصلية لغو جزماً و إن لم يسقط عن المقدمية، إلا أنّه بعد ما عرفت أنّ الداعي الحقيقي هو حفظ النظام و هو مترتب على عموم التخويف و الإلزام فلا مجال للإشكال.
أقول: و فيه: أنّ جعل الجزاء المذكور - و هو الخلود في النار كما في حقّ الكفّار و هم أكثرو
ص: 183
أفراد هذا النوع، أو المكث مؤقتاً كما في حقّ غيرهم - لحفظ النظام الاجتماعي المؤقت ممّا لا يقبله عاقل كما تقدم، على أنّ إنفاذه في القيامة ممّا لا داعي إليه؛ لانقضاء النظام المذكور بفناء الدنيا و حلول الآخرة. هذا، مع أنّ حفظ النظام الاجتماعي غير موقوف على هذا المقدار من العذاب الشديد، بل يكفيه ما هو أقلّ منه و أخفّ بمراتب، كما يشاهد في أنظمة الدول الكافرة الحاضرة، فتبصّر. و أمّا سرّ التكليف العام مع القطع بعدم التأثير فقد مرّ منّا جوابه.
و أجيب ثالثاً: بأنّ جعل التخويف في العاجلة و إجراءه في الآجلة ليس له غرض سوى ذاته تعالى، فإنّه تعالى غاية الغايات.
و بكلمةٍ أوضح بياناً: معروفية ذاته بتمام أسمائه هي الغاية لجميع أفعاله التي هي أنواع تجلّياته و ظهوراته، فظهور اسم الهادي و المرشد و الدليل هو المقتضي لجعل الأحكام، و تأكيد الدعوة بحكمته و عنايته هو المقتضي لجعل العقاب، و كونه عادلاً و شديد العقاب هو المقتضي لإجراء العقاب، ذكره بعض أعاظم العلماء. و قيل: إنّه مذهب جماعة من الصوفية.
أقول: قد عرفت تحتّم تبعية أفعاله للغرض، و أمّا هذا المسلك فسوف نفنّده في القاعدة الآتية إن شاء الله.
و رابعاً: بأنّ المخالفة و العصيان يقتضي استحقاق العقاب عقلاً، إذ هي هتك لحرمة المولى، و خروج معه عن رسوم العبودية و مقتضيات الرقّية، و هو ظلم خصوصاً على مولى الموالي، فالعقل هو المخوف على المخالفة، و اختيار العقاب فيما لا مانع منه من توبة أو شفاعة مثلاً ممّا تقضية الحكمة الإلهية.
أقول: لا شك أنّ مخالفة المولى ممّا يوجب استحقاق العقاب - في الجملة - عقلاً، لكنّ الكلام في إنفاذه يوم القيامة من قبل الغني الرحيم، فإنّ العفو في غير موارد حقوق الناس أولى بلا ريب، فما هو الموجب لإجرائه و إنفاذه؟ و الحال أن كونه عادلاً و شديد العقاب، لا يسلب اختياره.
ثم إنّ هنا وجوهاً أخر ذكرها المحدّث الحرّ العاملي (رحمه الله) في رسالته المؤلّفة لذلك، لكنّها بأسرها غير قابلة للاعتماد عليها(1).
و أمّا الخلود فقد ورد سرّه في رواية أبي هاشم(2)، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الخلود في الجنة و النار؟ فقال: «إنّما خلد أهل النار في النار لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبداً، و إنّما خلد أهل الجنة في الجنة لأنّ الجنة نيّاتهم كانت في الدنيا لو بقوا أن يطيعوا الله أبداً
ص: 184
ما بقوا، فبالنيات تخلّد هؤلاء و هؤلاء»، ثم لا قوله تعالى: قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىٰ شٰاكِلَتِهِ قال: «على نبيّته».
أقول: لكنّ حرمة نية الحرام ممّا اختلف فيه الأنظار لاختلاف الآيات و الأخبار، و تحرير المسألة في محلّها. و الرواية المذكورة غير معتبرة سنداً، و مع ذلك لا تدفع الاشكال أيضاً.
و يمكن أن يقال: إنّ استعظام الخلود إنّما هو لأجل الرقّة و العاطفة الكائنتين فينا، فلا ربط له بالواقع و حقيقة الحال. هذا كلّه إذا لم نقل بتجسم الأعمال، و إلا فإشكال العقاب ساقط من رأس، فإنّه لا معاقب خارجي هنا، بل تلك الآلام إنما هي أعمالكم ترد عليكم(1)، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فالفاعل لا يرى غير عمله الذي عمله، وَ مٰا ظَلَمَهُمُ اَللّٰهُ وَ لٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، و سيأتي الكلام حول هذا البحث في القاعدة الآتية إن شاء الله.
هذا، و لكنّ الصحيح أن يقال: إنّ العقل البشري ضعيف الإدراك، ناقص الاستعداد، محدود السلطان، فلا إحاطة له بدقائق الأمور الممكنة الجلية فضلاً عن أسرار أفعال الواجب الخفية، فلا بد من الاقتصار على الإذعان الإجمالي، و أنّه لا يفعل إلا لغرض حسن من مصلحة أو ترك مفسدة، كما مرّ برهانه سابقاً، و الجهل به في مورد لا يضرّ بأصل الكبرى، كما لا يخفى.
ص: 185
لا شك في أنّ الممكنات بأسرها منتهية إلى الواجب القديم و لو بوسائط، و في أنّ الأجسام و الأعراض - سوى الأفعال الاختيارية - صادرة عنه تعالى ابتداءً، كما عليه المتكلمون قاطبة، و إنّما المهمّ هو معرفة كيفية الأفعال الصادرة عن بعض الممكنات بالاختيار و الإرادة و استنادها إلى الواجب الوجود، فإنّها أمر عجيب و سرّ غريب قد تبلد فيه الأفهام و تزلّ الاقدام، و قلّ من أصاب الحق و فاز بالمرام! فإنّ البرهان قائم - قياماً قطعياً أو ضرورياً - على أنّه لا موجود إلا و يجب فيه تأثر الواجب، و العيان حاكم بأنّ الأفعال الاختيارية صادرة بإرادة الفاعل و محض قصده، و البرهان أيضاً يساعده كما سيأتي، و الجمع بين الأمرين أوجب بلبلةً في علمي الكلام و الفلسفة، بل المسألة - كما قيل نشأت منذ نشأة الفلاسفة الأغر يقيّين قبل الإسلام.
و ممّا يوجب مزيد الاهتمام بهذه المسألة أنّها ليست من البحوث العلمية فقط، بل لها ارتباط قوي و تأثير مستقيم في النظام الاجتماعي و الناموس الأخلاقي، فإنّ القول بالجبر و سلب الاختياري عن الإنسان - مثلاً - يبرئ المجرم من المسؤولية أمام المجتمع، و لا يرى لسعيه نحو التكامل النفسي و المادي أثراً أبداً، فإنّ التدبير محكوم عليه للتقدير، و الإنسان عنده كالسكّين في يد القصاب، فهذا القول يبرّز جميع الجنايات بلا شرط و قيد.
فلا بد للعاقل من تحقيق المقام و اتّباع الحق، فإنّ الحقّ أن يتّبع، و ها نحن نفصل لك المسألة في طيّ مقالات بعون الله و تسديده:
قالت المفوّضة: إنّ الله أوجد العباد، و أقدرهم على تلك الأفعال، و فوّض إليهم الاختيار، فهم مستقلون بإيجاد تلك الأفعال على وفق قدرتهم و إرادتهم. و قالوا: إنّ الله تعالى أراد منهم الإيمان و الطاعة، و كره منهم الكفر و المعصية. و قالوا: و على ضوء ذلك تتّضح أمور: 1 - صحة التكليف و الوعد و الوعيد. 2 - استحقاق الثواب و العقاب. 3 - تنزيه الله عن إيجاد القبائح
ص: 186
و الشرور من أنواع الكفر و المعاصي و المساوئ، إذ الجبر لا يجامع مع شيء من هذه الأمور كما لا يخفى، فكل واحد من هذه الوجوه الثلاثة دليل قطعي و كاشف إنّي من اختيار العبد.
هذا، مع أنّ الضرورة قائمة على تحقق الاختيار و استناد أفعالنا إلينا، و تأثير إرادتنا فيها، أترى أنّ نزولنا من السطح على الدراجة مع سقوطنا منه قهراً على حدّ سواء، أو أنّ حركة اليد المرتعشة مع حركة يد الكاتب لا تفرقان؟ هكذا نقل عن المفوّضة، و هم أكثر المعتزلة أو جميعهم كما يظهر للمراجع إلى كتب هذا الفن.
أقول: ما ذكروه من الوجوه الثلاثة و دعوى الضرورة من الأمور القطعية الواضحة التي لا يمكن لعاقل أن يتوقف في صحتها، بل هي ضروري الإذعان، و من يجحده فإنّما يجحده باللسان، لكن نتيجتها ليست استقلال العبد في أفعاله كما تخيّلوه، و إنّما هي تبطل الجبر وحده، و لا دلالة لها - و لو دلالة ضعيفة - على استغناء العبد عن خالقه في حركاته و سكناته، و ستعرف أنّ الحق المطابق للعقل و النقل هو الأمر بين الأمرين، لا الجبر و لا التفويض.
هذا من ناحية استدلالهم، و أمّا من ناحية الدعوى نفسها فهي مزيّفة بوجهين:
الأول: افتقار الممكن في جميع شؤونه إلى الواجب بقاءً كما في حدوثه، و قد مرّ برهانه القطعي في بيان خواص الممكن في الجزء الأول، و هذا المذهب يستلزم استغناءه عن الواجب بقاءً في صفاته و أفعاله فلا ريب في فساده.
الثاني: بطلان مذهب المجوس و رداءته باتفاق من المسلمين؛ و ذلك لأنّ القول باستقلال المكلف و غيره بأفعاله أردأ و أشنع من قول المجوس، فإنّهم قالوا بمبدأين فقط: (يزدان، و أهرمن)، و هؤلاء قالوا بمبادئ كثيرة حسب تعدد أفراد الإنسان و الحيوان و الجنّ و غيرهم، بل لا شبهة أنّ هذا المذهب - أي جعل أفراد الناس و غيرهم خالقين لأفعالهم و مستقلين بآثارهم - أقبح من مذهب من جعل الأصنام أو الكواكب شفعاء عند الله.
تنبيه:
هذا كله على تقدير إرادتهم من استقلال الإنسان - مثلاً - بأفعاله هو عدم احتياجه فيها إلى الواجب، و أمّا إذا زعموا عدم قدرة الله تعالى على أفعالهم فالخطب أفضح و أقبح، بل لعلّ بطلانه حينئذٍ يكون ضرورياً في دين الإسلام، فإنّ أفعال الإنسان ممكنة، و الله قادر على كل ممكن، و المظنون بدواً أنّهم نفوا الحاجة إلى الواجب، لا المقدورية له، فإنّ نفي الاحتياج يكفي لإثبات مذهبهم في هذا المقام، و لا حاجة إلى إنكار قدرة الله على أفعالنا، و إنّي - لحدّ الآن - لم أفز على عبارة اعتزاليّ دلت على إنكارها، لكنّ الظاهر من جملة من كلمات الباحثين أنّهم - أي المعتزلة - ينكرون كون الأفعال المذكورة مقدورة لله تعالى.
ص: 187
ففي الفصول: أنّ أكثر المعتزلة قالوا: إذا شاوا فعلوا، سواء شاء الله أو شاء عدمه و لو مشيئة جازمة!
و في شرح المنظومة(1) غرّر في عموم قدرته تعالى لكلّ شيء. خلافاً للثنوية و المعتزلة، و كذا في غيرهما.
أقول: و هذا منهم عجيب، و يمكن أن يكون مرادهم من نفي القدرة هي القدرة المؤثّرة ليرجع إلى نفي الحاجة، كما يظهر من عبارة الشهيد القاضي (رحمه الله) في إحقاق الحق(2)، قال: أمّا أولاً فلأنّ شمول قدرته تعالى لجميع المقدورات لم يثبت عند المعتزلة، فإنّهم يخصصون خلق الأجسام بقدرة الله تعالى، و أفعال العباد بقدرتهم... إلى آخره. فالجميع مقدور له تعالى، إلا أنّ قدر دته لم تؤثّر في خلق الأفعال عندهم. لكن في شرح المواقف(3): لا تكون القدرة عندهم - أي المعتزلة - إلا مؤثّرة، و لذا نقل عنهم القول بامتناع كون مقدور بين القادرين للتمانع، و يظهر من أخبارنا أيضاً أنّ التفويض إنكار لقدرته تعالى، و سيأتي سردها، و الله العالم.
و كيفما كان أنّ التفويض المذكور باطل قطعاً عقلاً و نقلاً، لا أعلم أحداً من الإمامية قال به، بل استفاضت أن تواترت الأخبار من الأئمة (عليهم السلام) في بطلانه، كما سيأتي ذكرها:
قال الصادق (ع)(4): «لعن الله المعتزلة أرادت أن توحّد فألحدت، و رامت أن ترفع التشبيه فأثبتت».
و عن الفقه الرضوي(5) عن العالم (ع): «مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله عز و جل بعدله فأخرجوه من قدرته و سلطانه».
و كلتا الروايتين مرسلتان، فما في بعض الكتب من نسبة متابعة الإمامية للمعتزلة في التفويض و استقلال الفاعلية ناشٍ عن طغيان التعصب.
نقل عن جهم بن صفوان و أتباعه: أن لا اختيار و اقتدار للإنسان بوجه، و لا مؤثر في الوجود
ص: 188
إلا الله، فأفعال الإنسان و غيره عندهم كحركة السكين في يد القصاب، أو كحركة القلم في يد الكاتب!
و قال ابو الحسن الأشعري و مقلّدوه: إنّ أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها و ليس لقدرتتهم تأثير فيها، بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة و اختياراً، فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارناً لهما - أي للقدرة و الاختيار الكائنين في العبد - فيكون فعل العبد مخلوقاً لله تعالى إبداعاً و إحداثاً و مكسوباً للعبد(1).
أقول: امتيازه عن القول الأول بامرين:
الأول: تحقق القدرة و الاختيار في العبد المقارن لهما الفعل، لكن بلا تأثير لهما فيه.
الثاني: كون العبد كاسباً لفعله و إن لم يكن الفعل مستنداً إلى إرادته و اختياره، لكن الحقّ رجوع هذا القول إلى الأول، و كونهما شيئاً واحداً، فالمجبّرة هم الجهمية و الأشاعرة، فإنّ الأمرين المذكورين ممّا لا محصل له، و لا معنى معقول تحته، بل هو مجرد لقلقة لسان لا غير.
إذ نقول لهم: إذا لم يكن للقدرة و الاختيار تأثير و كانت أفعالنا صادرة عن إرادة الله تعالى فقط فما الدليل على وجود هذه القدرة و الاختيار؟ و لمن خلقهما الله في العبد؟ هل للسخرية و الاستهزاء، فالله بريء عن القبيح، أم للإنفاذ و تدبير الشؤون؟ فأنتم تمنعون تأثيرهما في فعل العبد.
فإن قيل: إنّهما ضروريان في الإنسان. نقول: نعم، لكنّ استناد الفعل إليهما أيضاً ضروري وجداني، فقد سقط مذهبكم!
و أمّا الأمر الثاني - أعني الكسب - فلهم فيه اضطراب عجيب و تقلقل غريب، و كل ما أمعنت فيه النظر تجده أقرب شيء إلى الكلام النفساني من حيث الغموض و الإبهام! يقولون بأفهواهم ما لا تدركه قلوبهم و لا تتصوره عقولهم.
يقول الجرجاني في شرح المواقف في تفسير الكسب عن قيل سيده و قائده الأشعري: و المراد بكسبه (أي العبد) إيّاه (أي الفعل): مقارنته لقدرته و إرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير و مدخل في وجوده سوى كونه محلاً له.
أقول: ليس فيه زيادة على التصريح بجبر العبد في فعله و سلب اختياره. ثم لمّا جاء الباقلاني و لا حظ كسب شيخه الأشعري على حالة الانحلال و الاضمحلال حاول أن يستصلح فساده - و هل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟ - فقال(2): تتعلق قدرة الله بأصل الفعل و قدرة العبد
ص: 189
بصفته، أعني بكونه طاعة و معصية، إلى غير ذلك من الأوصاف التي لا توصف بها أفعاله تعالى، كما في لطم اليتيم تأديباً أو إيذاءً، فإنّ ذات اللطم واقعة بقدرة الله و تأثيره، و كونه طاعة على الأول، و معصية على الثاني بقدرة العبد و تأثيره.
أقول: و جوابه ظاهر، فإنّ هذه الصفة أمر اعتباري ينتزع من موافقة العمل للأمر الشرعي أو نهيه، و لا معنى لتعلق قدرة العبد به، و لو سلّمنا أنّها موجودة يبطل مذهبهم، إذ ثبت مورد استند موجود خارجي إلى اختيار العبد و قدرته مع أنّهم ينكرونه على المعتزلة!
و أيضاً نقول لهم: إذا جوّزتم استناد هذا الموجود المسمّى بالكسب إلى العبد فلم لا تجوّزون استناد أصل الفعل قدرته و إرادته؟ حيث لا فرق بينهما أصلاً، فهل هو إلا تحكّم بارد؟ فقضاوة هذا القاضي الباقلاني أيضاً لم تكسب للكسب نفعاً كما اعترف بعض الأشعريين أيضاً.
و من هنا أراح بعضهم نفسه فقال: إنّ هذا الكسب غير معقول و لا معلوم، مع أنّه صادر عن العبد، و لعلّ هذا هو مراد الغزالي أيضاً من قوله المحكي: إنّ الأفعال مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعاً، و بقدرة العبد على وجه آخر من التعلق! يعبّر عنه بالاكتساب.
نعم، للفضل بن روزبهان كلام آخر حول هذا الكسب، و حسب أنّه أتى بما يرتضيه المنصف و ينقاد لصحته المتعسّف! و إليك عبارته(1): يفهم من كلام الشيخ أنّه فسّر كسب العبد للفعل بمقارنة الفعل لقدرته و إرادته تارةً، و فسّره بكون العبد محلاً للفعل أخرى، و تحقيقه: أنّ الله خلق في العبد إرادة يرجح بها الأشياء، و قدرة يصح بها الفعل و الترك، و من أنكر هذا فقد أنكر أجلى الضروريات عند حدوث الفعل، و هاتان الصفتان موجودتان في العبد، حادثتان عند حدوث الفعل، فإذا تهيّأ العبد بقبول هاتين الصفتين لإيجاد الفعل و ذلك الفعل ممكن و الممكن إذا تعلقت به القدرة و الإرادة و حصل الترجيح فهو يوجد لا محالة بقدم (بتقدم ظ) الإرادة القديمة الدائمة الإلهية و القدرة القديمة، فأوجد الله بهما الفعل لكونهما أتمّ من الإرادة و القدرة الحادثة... فلمّا أوجد الله تعالى الفعل، و كان قبل الإيجاد تهيّأت صفة اختيار العبد إلى إيجاد ذلك الفعل، و لكن سبقت القدرة الإلهية فأحدثته، فبقي للفعل نسبتان: نسبة إلى العبد و هي أنّ الفعل كان مقارناً لتهيئة الإرادة و الاختيار نحو تحصيل الفعل و حصول الفعل عقيب تهيّؤه، فعبّر الشيخ عن هذه النسبة بالكسب... و نسبة إلى الله تعالى و هي أنّه كان مخلوق الله تعالى موجوداً منه... و هذا معنى كون الفعل مخلوقاً لله تعالى مكسوباً للعبد... إلى آخره.
ص: 190
أقول: و قد سبقه غيره إلى هذا البيان، و ليس في كلامه شيء جديد سوى التطويل، و ضعفه ظاهر من وجوه، و إليك توضيحه: قوله: (إرادة يرجّح بها الأشياء) باطل؛ إذ لا ترجيح لإرادة العبد عندهم، و لعلّه أراد بالترجيح مجرد الميل النفسي، فينتقض دليلهم به إن كان الميل المذكور عمل النفس اختياراً.
أو يلغو كلامه إذا كان من فعل الله سبحانه، فإنّ حاله حال الفعل الخارجي في كونه خارجاً عن اختيار العبد و مستنداً إلى إرادة الله تعالى.
قوله: من أنكر هذا فقد أنكر أجلى الضروريات.
أقول: نعم، و من أنكر استناد الفعل إلى القدرة و الإرادة المذكورتين فقد كابر أيضاً وجدانه و أنكر أوضح الواضحات.
قوله: «حادثتان عند حدوث الفعل» يزيّف أولاً: بأنّهما متقدمتان على الفعل بالضرورة.
و ثانياً: بأنّه ما فائدة خلقهما عند حدوث الفعل الصادر عن الله تعالى؟ ثم ما الدليل على إثباتهما؟ فهل هو إلا تخرص.
قوله: «فإذا تهيّأ العبد بقبول هاتين الصفتين لإيجاد الفعل» فساده واضح.
أمّا أولاً فلأنّ هذا التهيّؤ إن كان من فعل العبد فقد انتقضت أدلتهم، و هدم مذهبهم. و إن كان من فعل الخالق فما فائدة هذا التطويل و التسويل؟ فإنّه جبر على جبر!
و ثانياً: أنّ تهيّؤ العبد بهما لإيجاد الفعل غير معقول، إلا مع تحققهما قبل الفعل و تقدمها عليه، فهذا يناقض قولهم بحدوث القدرة حين حدوث الفعل و إنكار سبقها عليه، و هو ظاهر.
قوله: «بتقدم الإرادة القديمة» هذا ناش من حسبان تنافي إرادة الله و إرادة العبد، و ستعرف عدم التنافي بينهما، و هو معنى الأمر بين الأمرين.
قوله: «تهيّأت صفة اختيار العبد» قد عرفت بطلان أساسه بوضوح.
قوله: «نسبة إلى العبد» لا فائدة تترتب على هذه النسبة، و هذا كما إذا أراد أحد قتل زيد مثلاً، لكنّ ثالثاً قتله، فإنّ فاعل القتل و المسؤول عنه هذا الثالث، لا ذاك المريد بلاشك لأحد من العقلاء في ذلك، و مجرد المحلّية في المقام دون المثال غير مؤثر قطعاً، و إلا لإستحقّ اليد المرتعشة العقاب إذا قتل أحداً لأجل ارتعاشها، و هو ظاهر الفساد، فافهم جيداً.
فتحصّل: أنّ قول الأشاعرة نفس قول الجهمية، فكلا الفريقين من المجبّرة الغالية، لكنّ الأشعرية تفرّدت بأمر غير معقول آخر، و هو الكسب الذي لم يعرفوا معناه!
الجبر و صحة التكليف و استحقاق الجزاء:
لا ريب أنّ الاضطرار و الجبر يبطلان الحسن و القبح و استحقاق العقاب و الثواب، بل صحة
ص: 191
التكليف و الوعد و الوعيد، فإنّ ذلك كلّه إنّما يتمشّى على الأفعال الاختيارية، لكنّ المجبرة تقول(1): المدح و الذم باعتبار المحلّية، لا باعتبار الفاعلية حتى يشترط فيهما الاستقلال! و ذلك كما يمدح الشيء و يذم بحسنه و قبحه و سلامته من الآفة و عاهته، فإنّ ذلك باعتبار أنّه محلّ لها، لا مؤثر فيها. و أمّا الثواب و العقاب المترتبات على الأفعال الاختيارية فكسائر العاديات المترتبة على أسبابها بطريق العادة من غير لزوم عقلي و اتجاه سؤال، و كما لا يصحّ عندنا أن يقال: لم خلق الله الاحتراق عقيب النار؟ و لم لم يحصل ابتداءاً أو عقيب مماسّة الماء؟ فكذا هاهنا لا يصحّ أن يقال: لم أثاب عقيب أفعال مخصوصة، و عاقب عقيب أفعال أخرى، و لم يفعلهما ابتداءً؟ أو لم يعكس فيهما؟ و أمّا التكليف و التأديب و البعثة و الدعوة فإنّها قد تكون دواعي للعبد إلى الفعل و اختياره فيخلق الله الفعل عقيبها عادة، و باعتبار ذلك الاختيار المترتب على الدواعي يصير الفعل طاعة و معصية، و يصير علامة للثواب و العقاب، لا سبباً موجباً لاستحقاقهما.
أقول: كل ذلك يشبه الهذيان، فإنّ المدح و الذم إنّما يتعلقان بالأفعال الاختيارية، فيستحق الإنسان المدح بأفعاله الحسنة و الذم بأعماله السيئة، و لا معنى لأن يستحق الذم أو المدح بأمور خارجة عن اختياره. نعم، لا بأس باتصاف شيء بالحسن و القبح في غير الأمور الاختيارية، بمعنى اشتماله على الكمال و النقص أو ما يوافق الطبع و ينافره أو غيرهما كما مرّ في أوائل هذا المقصد، و أمّا قولهم في العقاب و الثواب فهو أقبح و أشنع، فإنّ معناه أنّ عادة الله جارية على عقاب عباده العاجزين بلا جهة! و هل هذا إلاّ ظلم بحت ينفيه العقل و القرآن عن الله تعالى، و توهّم أنّ الممكن ملك له و للمالك كيف ما شاء من التصرف و لا قبح؟ قد أبطلناه سابقاً بأوضح وجه.
و بالجملة: العقل و القرآن يناديان بأنّ العقاب إنّما هو جزاء أعمالهم، لا من جريان عادة الله تعالى الله عمّا يقول الظالمون علواً كبيراً.
و أمّا ما ذكروه في التكليف فضعفه ظاهر؛ لأنّ الدواعي أيضاً عندهم من فعله تعالى و لا اختيار للعبد، بل و اختياره - مع كونه غير مؤثر - أيضاً من خلقه تعالى، فلا يتصور للتكليف فائدة.
و خلاصة القول و لبّه: إنّ القول بالجبر مخالف للعقل في إدراكاته الأولية و أنظاره البدئية و الدين في أصل أساسه و آثاره الثابتة اللازمة.
ص: 192
الأول: من ناحية القدرة، و تقريرها: أنّ فعل العبد ممكن في نفسه، و كلّ ممكن مقدور لله. ففعل العبد مقدور له، و لا شيء ممّا هو مقدور لله بواقع بقدرة العبد؛ لامتناع اجتماع قدرتين مؤثّرتين على مقدور واحد، فأفعال العباد واقعة بقدرة الله و حده.
أقول: القياس الأول قوي جداً، لكن القياس الثاني فاسد قطعاً، فإنّ القدرة عند المتكلمين هي صحة الفعل و الترك كما مرّ بحثها في الجزء الأول، فلا مانع من اجتماع ألف قدرة على مقدور واحد، بل هو واقع خارجاً، و لا يستند الأثر إلى القدرة، و إلا لزم اجتماع النقيضين، فإنّ القدرة بالنسبة إلى الفعل و تركه سواء، و كلا طرفي الفعل مقدور، فلا بد من وقوعهما معاً، و للزم لغوية الإرادة أيضاً، فهذه الشبهة سخيفة جداً. و توصيف القدرة بالمؤثرة إنّما يصحّ بأخذ الإرادة معها، فهو نوع من المغالطة و أمّا البحث من جهة عموم إرادته فسيأتي تفصيله قريباً. نعم، يمكن أن تقرّر الشبهة من جهة قدرته تعالى على أصول الفلاسفة، إلا أنّها فاسدة عندنا و عند البحريين.
الثانية: من ناحية علم الفاعل بفعله، قالوا: لو كان العبد موجداً لأفعاله بالاختيار لوجب أن يعلم تفاصيلها، و اللازم باطل، فكذا الملزوم.
بيان الملازمة: أنّ الأزيد و الأنقص ممّا أتى به ممكن منه، فوقوع ذلك المعين منه دون الأزيد و الأنقص لأجل القصد إليه بخصوصه، و الاختيار المتعلق به وحده مشروط بالعلم به، كما تشهد به البديهة، فتفاصيل الأفعال الصادرة عنه باختياره لا بد أن تكون مقصودة معلومة له. و أمّا بطلان اللازم فلأنّ النائم و الساهي قد يفعلان باختيارهما، كما إذا انقلب النائم من جنب إلى جنب و لا يشعر بكمية ذلك الفعل و كيفية.
أقول: و فساده واضح، فإنّ الساهي و النائم - كما ذكرناه في مبحث علمه تعالى - ليسا بمختارين، ضرورة عدم صدور فعلهما عن إرادة، فالاستدلال باطل. و الحق أنّه لا يحب العلم التفصيلي بالفعل الاختياري، بل يكفيه العلم الإجمالي الارتكازي.
قال ابن سينا في محكيّ الشفاء(1): فتأمل حال الصناعة، فإنّ الصناعة لا يشك في أنّها لغاية، و اذا صارت ملكة لم يحتج في استعمالها إلى الروية، و صارت بحيث إذا حضرت الروية تعذّرت و تبلّد الماهر فيها عن النفاذ فيما يزاوله، كم يكتب أو يضرب بالعود فإنه إذا أخذ يروي في اختيار حرف حرف، أو نغمة نغمة و أراد أن يقف على عددها تبلّد و تعطّل، و إنّما يستمر على
ص: 193
نهج واحد فيما يفعله بلا روية في كلّ واحد واحد... إلى آخر ما أوضح المقام ايضاحاً تاماً، فلاحظ.
ثم إنّ هذا الوجه لو تمّ لأبطل الكسب أيضاً، فإنّ تعلق الاختيار بشيء و التهيّؤ لإيجاده لا يكون إلا بالعلم.
ثم نزيد و نقول: إنّ هذا البيان أقوى دليل على الاختيار، فإنّ الفعل الجبري غير موقوف على العلم به كما اعترفوا به أيضاً، و من البديهي أنّ جملة من أفعالنا موقوفة على العلم و لو إجمالاً، فيثبت أنّها تصدر عنّا بإرادتنا و اختيارنا، فافهم.
الثالثة: من ناحية المرجح، و بيانه: أنّ العبد لو كان موجداً لفعله باختياره فلا بد أن يتمكن من فعله و تركه، و إلا لم يكن مختاراً، و لا بد أيضاً من أن يتوقف ترجيح فعله على تركه على مرجّح؛ إذ لو لم يتوقف عليه كان صدور الفعل عنه مع جواز طرفيه و تساويهما اتفاقياً، لا اختيارياً، و يلزم أيضاً أن لا يحتاج وقوع أحد الجائزين إلى سبب فينسد باب إثبات الصانع، و ذلك المرجح لا يكون من اختيار العبد، و إلا لزم التسلسل في المرجحات، و يكون الفعل عند ذلك المرجح واجب الصدور، و إلا لم يكن المرجح المذكور تمام المرجح؛ لأنّه إذا لم يجب منه الفعل حينئذٍ جاز أن يوجد معه الفعل تارة، و يعدم أخرى مع وجود ذلك المرجح فيهما، فتخصيص أحد الوقتين بوجوده يحتاج إلى مرجح؛ لما عرفت، فلا يكون ما فرضناه مرجحاً، مرجحاً تاماً، هذا خلف، و إذا كان الفعل «مع المرجح الذي ليس من العبد» واجباً عنه يكون اضطرارياً.
أقول: هذا الوجه ممّا زيّفه جملة من المجبّرة أنفسهم، و سلّموا ما أجاب العدلية عنه، فلا عبرة به، غير أنّ توضيح بطلانه موقوف على ذكر مقدمات تنفعكّ في غير المقام أيضاً.
فنقول: إنّ ما يتوقف عليه الفعل الاختياري أمور:
1 - الالتفات إلى الفعل و تصوره.
2 - اعتقاد النفع فيه، علماً أو ظنّاً أو احتماله.
3 - الشوارق إليه.
4 - القصد إليه(1).
و حينما تحققت هذه المقدمات يترتب عليها حركة العضلات، و هذه الحركة إذا نسبت إلى الفاعل إيجاد، و اذا لو حظت إلى المفعول وجود.
ص: 194
إذا تقرر هذا فاعلم أنّ المراد بالداعي في الاصطلاح هو المقدمة الثانية، أعني بها اعتقاد النفع، و هو في الواجب علمه بالمصلحة التي ذكرنا أنّها الغرض من فعله فيما مضى، فالمخصّص و المرجّح لأفعاله تعالى هو علمه المتعلق بالأصلح، و النفع المسمّى عندهم بالداعي، و هو غير مسبوق بالتصور و التردّد، و لا ملحوق بالشوق و القصد؛ لاستحالة هذه الصفات على الواجب المجرد.
ثمّ إنّ الصحيح: أنّ معنى الإرادة فينا هو القصد، كما يتبادر منها، و لذا لا يقال لمن أراد شيئاً: إنّه لم يقصده، و لا لمن قصده: إنّه لم يرده.
و أنت إذا أمعنت النظر في موارد استعمالاتها تجد صدق ما قلناه بوضوح، و للباحثين في تفسيرها اختلاف عجيب، فإنّ أقوالهم حوله - مع كون الإرادة وجدانية - متشتّتة جداً.
فعن أكثر المعتزلة - و هو الظاهر من المحقق الطوسي (قدس سره) - أنّها الاعتقاد بالنفع. و عن بعضهم: أنّها ميل يتبع اعتقاد النفع، و هو الشوق المفسّر يتوقان النفس إلى تحصيل شيء. و عن آخر: أنّها الشوق المتأكّد المؤدّي إلى حصول المراد، إلى غير ذلك من الكلمات.
و حق القول: إنّه لا مشاحّة في الاصطلاح و التسمية، فلكل أحد أن يطلق لفظ «الإرادة» على كل ما يريد، و لكن لو أرادوا من الإرادة ما يترتب عليه الفعل خارجاً كترتب المعلول على علّته التامة فشيء ممّا ذكروه غير تام. أمّا الاعتقاد بالنفع فتخلّف الفعل عنه ظاهر لا ستر عليه؛ إذ كثيراً ما نعتقد النفع، و لا نفعل و ما اعتذر به المحقق اللاهيجي في شوارقه غير متين، فلاحظ.
و أمّا الشوق فمطلقه مثل الاعتقاد بالنفع كما لا يخفى، و أمّا مرتبته الشديدة التي تؤدي إلى المراد فنقول: إنّ فرض تأديته إلى المراد بلا توسّط القصد فهو ممنوع وجداناً، و إن ثبتت في مورد فالفعل فيه يكون اضطرارياً لا اختيارياً، فلا ربط له بمحل البحث و الكلام، و إن فرض تأديته مع توسّط القصد فهو صحيح كما قلنا فيرجع إلى المختار.
و قال في الأسفار ردّاً على التعريف الأخير: و فيه: أنّه قد يوجد الفعل بدون الشوق المتأكد، كما في الأفعال العادية من تحريك الأعضاء و فرقعة الأصابع، و كثير من الأفعال العبثية و الجزافية، و كما في تناول الأدوية البشعة و غيرها. و قد يتحقق الشوق المتأكد و لا يوجد الفعل؛ لعدم الإرادة، كما في المحرمات للرجل المتّقي الكثير الشهوة. انتهى كلامه.
ثمّ إنّ المقدمة الأولى - و هي التصور - قهرية في الأغلب، كما هي محسوسة، و ربما يكون رفعه اختيارياً، كما إذا نام أصرف ذهنه إلى شيء آخر.
و أمّا المقدمة الثانية - أعني الاعتقاد بالنفع أو الضرر - فهي ربّما تترتب على الأولى، و ربما لا تترتب، بل يبقى الشخص متحيّراً شاكّاً، و حيث إنّ استمرار التصور - و هو العلة للاعتقاد
ص: 195
المذكور - كان اختيارياً فكذا الاعتقاد المذكور، و ربما يزول بالتدبّر حول ما يترتب على هذا النفع من عتاب العقلاء و عقاب الله تعالى، فتأمل. و قد يكون حصوله قهرياً اضطرارياً.
و أمّا المقدمة الثالثة - أي الشوق - فترتّبها على اعتقاد النفع و عدمه على اعتقاد الضرر قهري؛ فإنّ الإنسان مفطور على حبّ ما يلائمه و بغض ما ينافره.
نعم، ربما يمكن إزالته كما قلنا في المقدمة الثانية، و أمّا المقدمة الرابعة فهي اختيارية أبداً، فإنّ الشوق مهما بلغ في تأكّده لا يضطرّ النفس إلى ارتكاب ما تشتقاق إليه إلا نادراً، فحيئذٍ يكون الفعل اضطرارياً لا اختيارياً.
و بالجملة: القصد (المعبّر عنه في لسان بعض الأكابر بالاختيار) فعل النفس لها أن تقصد، و لها لا تقصد، و لا علّية للشوق في تحصيله، كما عرفت وجهه مفصّلاً في بحث الإرادة في الجزء الأوّل. و أمّا حركة العضلات فهي تترتب على القصد المذكور ما لم يمنع عن الترتيب مانع أقوى، فلا تتخلّف عنه، و هذا الذي ذكرنا هو الموافق للوجدان، كما يدركه كل من ترك العصبية و المكابرة و رجع إلى الحق و سبيله.
اشكال و دفع:
قالوا: الفعل الاختياري ما يستند إلى الإرادة، فلا بد أن تكون الإرادة نفسها و مقدمتها غير اختيارية، و إلا لزم مسبوقية كلّ إرادة أو مقدمة منها بإرادة سابقة، فتسلسل الإرادات، و هو محال.
أقول: هذه المعضلة قد استصعبها الباحثون، عندي منحلّة بوجهين:
الأول: أنّ الإرادة لو لم تكن اختيارية - مع أنّها اختيارية وجداناً كما عرفت - لكانت الأفعال المرادية أيضاً غير اختيارية؛ لعدم تخلّف المعلول عن العلة، و حيث إنّ الاختيار في أفعالنا متحقق قطعاً بل مشهود وجداناً فتكون الإرادة أيضاً اختيارية، و هذا جواب إجمالي.
الثاني: أنّ تفسير الفعل الاختياري بمسبوقيته بالإرادة كلام مشهوري لا دليل عليه، بل الاختياري ما تمكن الفاعل من إيجاده و تركه، و له أن يفعل، و أن لا يفعل، و عليه فلا إشكال في المقام؛ إذ التدبر و التفكر و القصد كالأفعال الاختيارية الجوارحية بيد الفاعل فعلاً و تركاً بالوجدان، و أمّا نفس هذا التمكن و الاختيار (أي فله ان يفعل و له الا يفعل) فهو غير اختياري، بل شيء قهري أوجده الله تعالى في العبد بمحض إرادته و حكمته، فأين التسلسل أو الاضطرار؟!
و بكلمة أوضح بياناً: إنّ هاهنا أمورا ثلاثة: 1 - الأفعال الجوارحية. 2 - الأفعال الجوانحية التي تقع مقدمات للإرادة. 3 - القصد نفسه.
أمّا الأول فهو مستند إلى الإرادة - أعني القصد - و إلا يكن اضطرارياً.
ص: 196
و أمّا الثاني فما هو منه قهري الحصول فهو غير مرتبط بالقصد، و أمّا ما هو اختياري منه حدوثاً أو بقاءً فهو
يستند إلى الإرادة.
فإن قلت: إذا كانت أجزاء الإرادة إرادية يلزم الدور أو التسلسل؟
قلت: اللزم المذكور ممنوع، فإنّ التصور و التفكر في إطعام زيد - مثلاً - مقدمة للإرادة التي تتعلق - بعد تحققها - بالإطعام المذكور، و لكنّه معلول للقصد المتعقل بنفسه، و هذا القصد مسبوق بالتصور و اعتقاد النفع و الشوق الارتكازية.
بيان ذلك: أنّ الإنسان مفطور على حبّ ذاته، و مجبول على حفظ كيانه، و هذا ضروري، و يتولّد من هذا الحبّ لزوم دفع الضرر و جلب المنفعة، فالإنسان بحسب ارتكازه الفطري متوجّه نحو تحصيل سعادته و تكامله، و حيث إنّ حصول السعادة و دفع المشقّة لا يتيسّران إلا بالتفكر و التدبر حول الأشياء و تمييز صالحها من فاسدها فهو يعتقد - اعتقاداً فطرياً - أنّ التفكر حسن فقهراً يشتاق إليه ثم يقصده، فالقصد المذكور و إن كان اختيارياً - كما يأتي - لكنّ مقدماته غير اختيارية منتهية إلى خلق الواجب الحكيم، فلا يلزم التسلسل و الدور
و على الجملة: إطعام زيد مستند إلى الإرادة و هي القصد، و الإرادة موقوفة على مقدماتها و هي تصور الإطعام و اعتقاد نفعه و الشوق إليه، و هذا التصور و التفكر - في غير موارد اضطراره - أيضاً اختياري إرادي مستند إلى الإرادة المتعلقة به، و هذه الإرادة مسبوقة بمقدماتها الارتكازية القهرية، و حيث إنّها لا توجب الإرادة بل مقتضية إيّاها - كما يأتي - لا يخرج التدبر و التفكر المذكور عن الاختيار.
و أمّا الثالث فهو كما عرفت أيضاً اختياري، و ليس الشوق علّة موجبة له، بل للنفس القصد و عدمه، و الشوق المذكور مرجح له و ليس بموجب، فالقصد - أي الإرادة - و إن كان اختيارياً - أي للنفس تمكن من وجوده و عدمه - لكنّه ليس إرادياً، و إلا لتسلسلت الإرادات، و لا دليل على أنّ كل ما لم يكن مستنداً إلى الإرادة - و لو كان نفس الإرادة - كان اضطرارياً غير اختياري؛ لما عرفت من أنّ الاختياري ما كان الفاعل متمكناً من فعله و تركه.
فتحصّل: أنّ جميع الأفعال الجوانحية و الجوارحية الاختيارية إرادية مسبوقة بالقصد، و أمّا القصد نفسه فهو لا يستند إلى قصد و إرادة أخرى و إن كان اختيارياً، بل هو فعل النفس.
و ممّا ذكرنا كله ظهر أنّ القاعدة القائلة: «إنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد» صحيحة حتى في الأفعال الاختيارية؛ إذ بعد تحقق القصد تتحق حركة العضلات قهراً، و إنّما الخارج عنها القصد نفسه؛ لما عرفت من قضاء الوجدان على عدم إيجابه بالشوق و إن كان بالغا في التأكد غايته.
ثمّ إنّ الواجب الوجود حيث لا يتصور في حقّه القصد - كما مرّ في مبحث الإرادة - لا يعقل
ص: 197
جريان القاعدة المذكورة في أفعاله، فإنّ علمه بالمصلحة كاعتقادنا بالنفع و شوقنا إليه في عدم إيجاب الفعل و القصد، فكما أنّ اعتقادنا و اشتياقنا لا يوجبان قصدنا كذلك علمه تعالى بالأصلح لا يوجب فعله، و هذا ظاهر، و لا يخفى تحقق الاختيار له تعالى حينئذٍ في مترتبة من المراتب، و هذا بخلاف جريانها في أفعال الممكن، فإنّها و إن و جبت بعد القصد لكنّ القصد نفسه اختياري حدوثاً و بقاءً.
هذا خلاصة كلامنا في تحقيق هذا المقام، و نوصي القارئ الكريم بالتأمل حوله، و لا ينكره بما يبدو له في أول النظر، ليزلّ عن صراط الحق كما زلّ عنه أقوام، و الله الموفق.
و إذا علمت ذلك فقد ظهر لك بطلان الشبهة الثالثة المذكورة، فإن قولهم: «و ذلك المرجح لا يكون من اختيار العبد، و إلا لزم التسلسل في المرجحات» باطل الأساس، إذا أريد بالمرجح الداعي أو الشوق - كما هو ظاهر جماعة منهم حيث يقولون: إنّ الدليل إلزامي للمعتزلة القائلة بامتناع الترجيح بلا مرجح - فقد دريت دراية كاملة عدم ترتب الفعل عليه. و إن أريد به الأعمّ منه و من الإرادة - كما هو ظاهر القوشجي بل صريحه - فقد عرفت عدم لزوم الدول و التسلسل من القول باختيارية الإرادة، و القصد أتمّ عرفان.
ثم إنّ الشبهة المذكورة تنقض بأفعال الله سبحانه و تعالى و لجريانها فيها حرفياً، مع أنّ الخصم لا يظهر الالتزام بإيجابه تعالى، فيكون الدليل فاسداً.
و أمّا دفع هذا النقض بإبداء الفرق بين إرادة الواجب و الممكن، حيث إنّ الثانية حادثة منتهية إلى إرادة يخلقها الله بلا اختيار من العبد دفعاً للتسلسل في الإرادات، و الثانية قديمة غير مفتقرة إلى إرادة أخرى كما عن الرازي، فهو ضعيف؛ لأنّ عدم استقلال العبد في إيجاد إرادته و استقلال الرب في إرادته غير مربوط بمسألة الاختيار و الاضطرار؛ إذ يقال: هل الواجب مع إرادته القديمة يمكنه الفعل و الترك أم لا؟... إلى آخر الشبهة، و أمّا الحديث التسلسل فقد عرفت بطلانه، و على ضوء ذلك يسقط ما ذكره العضدي في مواقفه دفاعاً عن النقض المذكور، فلاحظ.
فظهر أنّ هذه الشبهات الواهية لا تقاوم الوجدان في حكمه باستناد أفعالنا إلى إرادتنا، و القرآن في تشريعه و تكليفه و بيان ثوابه و عقابه و وعده و وعيده.
نعم، قالوا(1): إنّ هذا الذي ذكر إن لزمنا من القول بالجبر فهو لازم لكم أيضاً لوجوه:
1 - من جهة علمه تعالى، لأنّ ما علم الله عدمه من أفعاله العبد فهو ممتنع الصدور عن العبد، و إلا جاز انقلاب العلم جهلاً، و ما علم الله وجوده فهو واجب الصدور عن العبد، و إلا لجاز ذلك
ص: 198
الانقلاب، و لا مخرج عنهما لفعل العبد، و أنّه يبطل الاختيار، إذ لا قدرة على الواجب و الممتنع، فما لزمنا من بطلان التكليف و لواحقه في مسألة خلق الأفعال لزمكم في مسألة علم الله تعالى بالأشياء. قال الرازي: و لو اجتمع جملة العقلاء لم يقدروا على أن يوردوا على هذا الوجه حرفاً.
أقول: لكنّ هذا المسكين المغرور ما شعر أنه لو اجتمع الجنّ و الإنس على تصحيحه لما قدروا عليه، فإنّ العلم تابع للمعلوم في تعلقه، فالعبد حيث يكون فاعلاً باختياره فعلاً خاصاً فيما لا يزال تعلق علمه تعالى به، دون العكس، و هذا كما نقول: طلعت الشمس فعلمناه، و لا نقول: علمنا طلوع الشمس فطلعت، و هذا واضح.
ثم نزيد و نقول إنّ الله تعالى كما علم أزلاً صدور الفعل منّا كذلك علم صدوره باختيارنا و إرادتنا، و علم تمكننا من تركه، و علم أنّ ترجيحنا جانب وجوده بمحض اختيارنا، فلو فرض صدوره عنّا بالجبر للزم انقلاب علمه تعالى جهلاً، و هو محال.
نعم، ربما تقرّر الشبهة من جهة أنّ علمه فعلي، و العلم الفعلي مؤثّر، و المفروض أنّ كل ممكن معلوم لله تعالى.
و هذا التقرير أحسن من التقرير المتقدم، لكنّنا أبطلنا أساس العلم الفعلي كما مرّ في الجزء الأوّل، و على تقدير تسليمه فنقول: إنّه كما علم فعلنا علم تمكننا منه أيضاً فلا يبطل اختيارنا، كيف و لو كان علمه الأزلي منافياً لاختيار العبد لكان منافياً لاختياره تعالى أيضاً، و هذا ممّا لا يلتزم به الأشاعرة جهراً، و إن كان إيجابه تعالى لازماً على قواعدهم قطعاً، كما ذكرنا سابقاً، و قد اعترف به الجرجاني أيضاً. و أمّا ما لفّقه ابن روزبهان في منع هذا النقض(1) فجدّ موهون؛ فلذا تركنا ايراده.
2 - من جهة إرادته تعالى، فإنّ ما أراد الهل وجوده فهو واقع قطعاً، و ما أراد الله عدمه فهو غير واقع قطعاً، فلا قدرة لغيره تعالى، و هذا معنى ما اشتهر بينهم تبعاً للصوفية من أنّه لا مؤثر في الوجود إلا الله.
أقول: و الأولى تبديل الجملة الثانية: بأنّ ما لم يرد الله وجوده غير واقع؛ لئلاّ يقال: إنّه تعالى ما أراد وجوده و لا أراد عدمه، و قد تقدم أنّ عدم العلة علة لعدم المعلول. لكنّه يزيّف بأنّه مصادرة محضة! فإنّه مبنيّ على تعلق إرادته تعالى بكلّ شيء، و هو هنا اول الكلام.
و على الجملة: لا شك في أنّ ما يتعلق به إرادة الله التكوينية يقع لا محالة، و يستحيل تخلّف
ص: 199
المراد عنها، لكنّ الشأن في تعلق إرادته بالأفعال الاختيارية فهذا التلفيق لا ينفعهم.
و إن شئت فقل: إنّ هذه الشبهة ظاهرة التناقض؛ إذ مع فرض كون الأفعال أفعالاً اختيارية للإنسان أو غيره كيف تتعلّق بها إرادة الله تعالى؟ فإنّ الفعل حينئذٍ فعل الله تعالى، لا فعل غيره، فهذه الشبهة نظير أن يقال: هل يمكن طلوع الشمس في الليل؟ و هل يمكن النهار بلا طلوع الشمس؟ و هل يمكن أن يخلق الله ابن زيد من غير زيد؟! و أمثالها، فقولهم: «لا مؤثر في الوجود إلا الله» كذب محض، و حقّ القول: إنّه لا حول و لا قوة إلا بالله، و لا موجود إلا و الحق مؤثر فيه، كما سيأتي في تفسير الأمر بين الأمرين إن شاء الله.
3 - من جهة الداعي، فإنّ الفعل عند استواء الداعي إلى الفعل و الترك ممتنع، ضرورة تناقض الرجحان للاستواء، و عند رجحان أحدهما يجب الراجح و يمتنع المرجوح.
أقول: و هو منقوض بأفعاله تعالى أولاً، و مزيّف بأنّ الوجوب الناشئ من الاختيار لا ينافي الاختيار ثانياً.
و اعلم أنّ الرازي افتتن و اغترّ بهذا الوجه، فكرّره في مواضع من تفسيره، و زعم أنّه يعارض جميع أدلة الاختيار! و نحن نقول له: ما ذا تعنى بالداعي و المرجح؟ فإن أردت به الإرادة، فقد أثبتنا أنّها اختيارية، و إن أردت الشوق أو الاعتقاد بالنفع، فقد قررنا أنّ الفعل غير مترتب عليه بلا توسط الإرادة!! لعن الله التعصّب و التكبّر فإنّهما يدخلان صاحبهما مواقع الهلكة.
4 - من ناحية التكليف بالمعرفة، قالوا: التكليف واقع بمعرفة الله تعالى، فإن كان في حال حصول المعرفة فهو تكليف بتحصيل الحاصل.
و إن كان في حال عدمها فغير العارف بالمكلف (بالكسر) و صفاته المحتاج إليها في صحة التكليف منه غافل عن التكليف، و تكليف الغافل تكليف بالمحال.
أقول: و ضعفه بيّن بعد التوجه إلى ما ذكرنا في مبحث وجوب النظر و المعرفة في أول الكتاب.
و لهم وجوه واهية أخرى تركناها مخافة ملالة القارئين الكرام؛ و كون إبطالها من توضيح الواضحات.
فالجبر كالتفويض أمر فاسد يجب على العاقل اجتنابه، بل هو أفحش من التفويض بالنسبة إلى الإحساس الوجداني و النظام الاجتماعي. نعم، التفويض أقبح منه بالنسبة إلى سلطان ربّ العالمين، فالأول إفراط، و الثاني تفريط.
الأول ينافي رحمة الحكيم العادل، و الثاني شوكة القادر الفعّال، و الأول تضييع للخلق، و الثاني توهين للحقّ، فلا إلى الجبر و لا إلى التفويض، أيها العاقل الرشيد، بل إلى الأمر بين
ص: 200
الأمرين الذي نبع من عين حكمة آل محمد (ص) الصافية و ذاق حلاوة شرب مائها الإمامية(1).
ثم إنّه يجدر بنا أن نذكر شطراً من الروايات الواردة عنهم تيمّناً بها في الكتاب، و خاتمة لهذه المقالة، و مقدمة للمقالة الآتية:
1 - صحيحة يونس، عن غير واحد، عن أبي جعفر و أبي عبد الله، قال: «إنّ الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه عن الذنوب ثم يعذّبهم عليها، و الله أعزّ من أن يريد أمراً فلا يكون»، قال: فسئلا: هل بين الجبر و القدر منزلة ثالثة؟ «قالا: نعم، أوسع ممّا بين السماء و الأرض!».
أقول: اختصاص الجبر بالذنوب لوضوح بطلان لازمه، و إلا فهو باطل مطلقاً، ثم إنّ ظاهر الرواية أنّ القدرية ينكرون قدرته تعالى على الأفعال الاختيارية، و قد سبق الإشارة إليه.
2 - رواية هشام بن سالم، عن الصادق (ع) قال: «الله أكرم من أن يكلّف الناس ما لا يطيقون، و الله أعزّ من أن يكون في سلطانه ما لا يريد».
3 - رواية الوشاء، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته فقلت: الله فوض الأمر إلى العباد؟ قال: «الله أعزّ من ذلك»، قلت: فجبرهم على المعاصي؟ قال: «الله أعدل و أحكم من ذلك»، قال: ثم قال: «قال الله: يابن آدم، أنا أولى بحسناتك منك، و أنت أولى بسيئاتك منّي، عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك».
4 - رواية أبي طالب القمي، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال: «لا»، قال: قلت: ففوض إليهم الأمر؟ قال: «لا»، قال: قلت: فماذا؟ قال: «لطف من ربك بين ذلك».
5 - رواية صالح، عن بعض أصحابه، عن الصادق (ع) قال: سئل عن الجبر و القدر؟ فقال: «لا جبر و لا قدر، و لكن منزلة بينهما، فيها الحق التي بينهما، لا يعلمها إلا العالم، أو من علّمها إيّاه العالم».
6 - صحيحة يونس، عن عدة، عنه (ع) قال: قال له رجل: جعلت فداك، أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال: «الله أعدل من أن يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم عليها»، فقال له: جعلت فداك، ففوض الله إلى العباد؟ قال: فقال: «لو فرض إليهم لم يحصرهم بالأمر و النهي»، فقال له: جعلت فداك، فبينهما منزله؟ قال: «نعم، أوسع ما بين السماء و الأرض».
7 - رواية محمد بن يحيى، عمّن حدثه عنه (ع) قال: «لا جبر و لا تفويض، و لكن أمر بين أمرين...» إلى آخره.
ص: 201
8 - رواية حفص بن قرط، عنه (ع)(1) قال: «قال رسول الله (ص): من زعم أنّ الله يأمر بالسوء و الفحشاء فقد كذب على الله، و من زعم أنّ الخير و الشر بغير مشيّة الله فقد أخرج الله من سلطانه. و من زعم أنّ المعاصي بغير قوة الله فقد كذب على الله، و من كذب على الله أخله النار».
9 - رواية مهزم(2)، قال: قال أبو عبد الله (ع): «... فاسألني»، قلت: أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال: «الله أقهر لهم من ذلك»، قال: قلت: ففوض إليهم؟ قال: «الله أقدر عليهم من ذلك»، قال: قلت: فأيّ شيء هذا أصلحك الله؟ قال: فقلب يده مرتين أو ثلاثاً، ثم قال: «لو أجبتك فيه لكفرت!».
10 - صحيحة هشام و غيره(3)، قالوا: قال أبو عبد الله الصادق (ع): إنّا لا نقول جبراً و لا تفويضاً».
11 - رواية حريز، عنه (ع)(4) قال: «الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل زعم أنّ الله عز و جل أجبر الناس على المعاصي، فهذا قد ظلم الله عز و جل في حكمه، و هو كافر. و رجل يزعم أنّ الأمر مفوض إليهم، فهذا وهن الله في سلطانه، فهو كافر. و رجل يقول: إنّ الله عز و جل كلّف العباد ما يطيقون و لم يكلّفهم ما لا يطيقون، فإذا أحسن حمد الله، و إذا أساء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ».
إلى غير ذلك من الروايات، فلاحظ الجزء الخامس من البحار، و سيأتي بعض ما يرتبط بهذه الروايات.
لا ريب أنّ الممكنات محتاجة إلى الله سبحانه بقاءً، كما تحتاج إليه حدوثاً، فإنّ الماهية الممكنة لا تقتضي الوجود و لا العدم، و إنّما يلحقها أحدهما من علة خارجة عن ذاتها، فهو يتبع هذه العلة دون تلك الماهية، و قد سلف بحثه في الجزء الأول مفصّلاً.
فنقول: لا شك أنّ النفس الإنسانية - مثلاً - مخلوقة لله تعالِى، و محتاجة في بقائها إلى إفاضة الحق عليها، فبطريق أولى هي مفتقرة إليه تعالى في أفعالها و إبراز آثارها و تمكنها منها،
ص: 202
فالواجب الوجود هو الذي يبقي النفس و يعطيها القوة و المكنة و الاقدار على إيجادها الأفعال، بل الشوق الذي هو من مرجحات إرادتها و قصدها نحو الفعل مخلوق لله تعالى بلا مدخلية لاختيار النفس، بل هي مجبولة و مفطورة على اشتياق ما يلائمها و التنفّر عمّا يزاحمها، و إنّما للنفس - بإذن الله و إقداره و تمكينه - هو الاختيار في قصدها نحو الفعل و عدم قصدها نحوه، فلها أن تفعل، و لها أن لا تفعل، و لكن إذا فعلت فعلت بقوة الله التي أعطاها.
و على الجملة: الإنسان في أفعاله - سواء كانت صالحة كالصلاة و الإحسان، أو سيئة كالزنا و الظلم و قتل ولي - محتاج إلى ربه في وجوده و في علمه، بأن يفيض عليه آناً فآناً بحيث لو أمسك فيضه لحظة لعدم و فنى، و لم يكن شيئاً مذكوراً! و للعبد القصد و إعمال هذه القدرة، فلا جبر و لا تفويض، بل أمر بين الأمرين.
أما عدم الجبر فلأنّ العبد مختار، له أن يفعل، و له أن لا يفعل، و هذه صفة أعطاها الله الإنسان حتى يصح تكليفه بما يقتضي تكامله النفسي و ارتقائه المعنوي. فالقصد يصدر عن النفس بتمكين من الله من غير صيرورته واجباً بالوجوب السابق، كما دريت وجهه سابقاً، و عليه فقد ظهر فائدة التكليف و الوعد و الوعيد و التربية و استحقاق الجزاء عند الله تعالى و عند الناس في نظامهم الاجتماعي.
و أمّا عدم التفويض فلأنّ العبد محتاج إلى إمداده و إفاضته تعالى في وجوده و إبراز أفعاله في كلّ آن، بحيث لو لا تمكينه لما قدر على شيء أبداً، و قد عرفت في الجزء الأول أن إرادته تعالى هي إحداثه و إعمال قدرته و إفاضته - و ما شئت فعبر - فيثبت أنّ جميع الأشياء بإرادته تعالى، حتى الأفعال الاختيارية للإنسان وَ مٰا تَشٰاؤُنَ إِلاّٰ أَنْ يَشٰاءَ اَللّٰهُ لكن لا بمعنى أنّ الله يوجد عمل زيد - مثلاً - كما يوجد سواد لونه حتى يكون زيد مسلوب الاختيار، بل بمعنى أنه تعالى يفيض عليه لأن يعمل باختياره، و هذا هو الأمر بين الأمرين.
و يصح لنا حينئذٍ أن نقول في مقام تنزيه الحق و عدله و حكمته: سبحان من تنزّه عن الفحشاء، و أن نقول في مقام عظمته و قدرته و جبروته و سلطنته: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء، كما نطقت به الروايات المتقدمة أيضاً.
وهم و إزاحة:
بعد ما عرفت أنّ القصد قائم بالنفس قياماً صدورياً، و أنّه صادر عنها بلا واسطة شيء أصلاً، و أنّ قاعدة «ما لم يجب لم يوجد» غير جارية فيه وجداناً، و أنّ الفعل و إن كان مترتباً عليه قهراً،
ص: 203
لكن القصد نفسه حيث يكون اختيارياً فلا ينافي الترتب المذكور اختيارية الفعل، و أن إرادة الله تعالى هو إحداثه و إفاضته التابعة لعلمه بالمصلحة على نحو لا ينافي اختياره. تدري أنّ الوجوه الأربعة من الإيراد المذكور في كلام بعض الأعيان من أهل المعقول(1) غير واردة على المختار، بل هي ساقطة من رأس. كما أن ما ذكره الفارابي في الفصّ السادس و الخمسين من فصوصه من الإشكال على اختيار الممكن، أيضاً ساقط بعد الإحاطة بما ذكرنا، و قد تقدم بعض الكلام عليه في القاعدة السابقة، حيث ذكر مثله صاحب الأسفار فزيّفناه، فلا نطيل المقام بذكر الوجوه المشار إليها و ردّها تفصيلاً، مغموم إرادته تعالى بشمولها الأفعال الإنسان - مثلاً - مقرونة بهذا المعنى - أي إفاضة القوّة و القدرة في كلّ لحظة - مقرونة باختياره - أي له أن يستعمل هذه القدرة المفاضة، و له ألاّ يستعملها، لا يستلزم الجبر بوجه، فافهم المقال تصب الحق. و الله الهادي.
قال الحكيم الشيرازي في مبحث عموم إرادة الله تعالى: و ذهبت طائفة أخرى و هم الحكماء و خواص أصحابنا الإمامية (رحمه الله) إلى أنّ الأشياء في قبول الوجود من المبدأ المتعالي متفاوتة، فبعضها لا يقبل الوجود إلاّ بعدوجود الآخر، كالعرض الذي لا يمكن وجوده إلا بعد وجود الجوهر، فقدرته تعالى على غاية الكمال يفيض الوجود على الممكنات على ترتيب و نظام بحسب قابليتها المتفاوتة بحسب الإمكانات، فبعضها صادرة عنه تعالى بلا سبب، و بعضها بسبب واحد أو أسباب كثيرة، فلا يدخل مثل ذلك في الوجود إلا بعد سبق أمور هي أسباب وجوده، و هو مسبّب الأسباب من غير سبب، و ليس ذلك لنقصان في القدرة، بل لنقصان في القابلية و كيف يتوهّم النقصان و الاحتياج مع أنّ السبب المتوسط أيضاً صادر عنه... إلى آخره.
قال السبزواري في حاشيته: و حاصل هذه الطريقة: أنّ الله تعالى يوجد القدرة و الإرادة في العبد، ثم هاتان القدرة و الإرادة توجبان وجود المقدور، فالله تعالى فاعل بعيد، و العبد فاعل قريب في هذه الطريقه... والفرق بينها و بين طريقة المعتزلة ظاهر؛ لأنّ المعلول لا يحتاج إلى العلة في البقاء عند المعتزلة، بخلافه عند المحقق و غيره - انتهى - أي المحقق الطوسي الذي هو كالأصل في إبراز هذا القول في شرح رسالة العلم، و قد أوضح هذه الطريقة اللاهيجي في «گوهر
ص: 204
مراد» و «سرمايه إيمان» و المحدث الكاشاني في كتابه «الوافي»، و غيرهما في غيرها، و قال الأول: إنّه مذهب محقّقي علماء الإمامية و جمهور الحكماء.
و حيث إنّ تحقيق هذا القول منسوب إلى المحقق الطوسي (قدس سره) فلا بد من نقل كلامه(1)، قال: لا شك أنّ عند الأسباب يجب الفعل، و عند فقدانها يمتنع، فالذي ينظر إلى الاءسباب الأوّل و يعلم أنّه ليست بقدرة الفاعل و لا بارداته يحكم بالجبر. و هو غير صحيح مطلقاً؛ لأنّ السبب القريب للفعل و هو قدرته و إرادته، و الذي ينظر إلى السبب القريب يحكم بالاختيار. و هو أيضاً ليس بصحيح مطلقاً؛ لأنّ الفعل لم يحصل بأسباب كلها مقدورة و مرادة، و الحق ما قاله بعضهم: لا جبر و لا تفويض و لكن أمر بين أمرين... إلى آخره.
أقول: فالمتحصّل: أنّ أفعال العبد واقعة بإرادة و اختياره فلا يلزم الجبر، و لكنّ إرادته و قدرته موجودتان فيه بإرادة الله تعالى و مستندتان إليها فلا يلزم التفويض.
فإن قلت: إذا كانت إرادة العبد - و هي العلة التامة لفعله - موجودة بإيجاده تعالى فلا محالة يكون الفعل غير اختياري، و مجرد توسط الإرادة لا يثبت الاختيار.
قلت: الفعل الاختياري ما كان بإرادة الفاعل و اختياره، كما هو المفروض في هذا المذهب، لا أن تكون الإرادة بالإرادة و الاختيار بالاختيار، فإنه غير لازم في مفهوم الاختيار، كيف و لو كانت الإرادة أيضاً اختيارية لزم التسلسل؟ هكذا أجابوا.
أقول: و الحق أنّه لا فرق بينه و بين قول المجبّرة أصلاً، فإنّ علة الفعل التامة - و هي الإرادة - إذا كانت غير اختيارية للفاعل، بل كانت معلولة لأمور قهرية مستندة إلى إرادة الله تعالى الأزلية كان الفعل أيضاً غير اختياري لا محالة، إلا أنّ يصطلح أحد في إطلاق كلمة الاختيار على هذا المعنى و لا نزاع معه، غير أنّ كلامنا بحسب المعنى و نفس الأمر، لا بلحاظ اللفظ.
و أمّا حديث التسلسل في الإرادات فقد عرفت هدم بنيانه و قلع أساسه. و بعبارة واضحة: إذا كان الفعل معلولاً للإرادة - أي الشوق المؤكد - يكون حال الفعل المزبور حال الارتعاش الحاصل من الخوف؛ إذ كلّ من الخوف و الشوق صفة نفسانية و علة تامة للحركة في العضلات، فينبثق من الأول ارتعاش البدن و صفرة الوجه، و من الثاني الضرب و الأكل مثلاً، فكيف صار أحد الفعلين اختيارياً يتعلق به الحسن و الذم و التكليف و الجزاء، و الآخر قهرياً اضطرارياً لا يتعلق به شىء؟! و أنت إذا تأملت هذا الكلام تقطع بفساد هذا القول من دون حاجة إلى إطالة المقال.
ص: 205
و أمّا ما في «الأسفار» و «گوهر مراد» من نسبة هذا القول إلى جملة من علماء الإمامية فهي غير ظاهرة حتى من المحقق الطوسي (قدس سره) فإنّه قابل للحمل على ما اخترناه، فافهم جيداً.
قال العلامة المجلسي في مرآة العقول(1): إنّ هذا المذهب الذي نسبوه إلى الحكما من أنّ العلة القريبة للفعل الاختياري إنّما هو العبد و قدرته، لكن قدرته مخلوقة لله تعالى، و إرادته حاصلة بالعلل المترتبة منه تعالى، قول بعضهم، و قال جمّ غفير منهم: لا مؤثر في الوجود إلا الله، و موجد الأفعال هو الله سبحانه... إلى آخره.
تعقيب و تنقيد:
هذا القول - كقول الجهمية و الأشعرية - ينافي العقاب من الله الحكيم العادل على الجرائم، فلذا حاول أربابه تصحيح العقاب عليه، و ذكروا في بيانه وجهين:
الأول: ما ذكره المحقق الهروي في كفاية الأصول(2): أنّ حس المؤاخذة و العقوبة إنّما يكون من تبعة بعده بعده عن سيده... فكما أنّه - أي التجرّي - يوجب البعد عنه كذلك لا غرو في أن يوجب حسن العقوبة، فإنّه و إن لم يكن باختياره إلا أنّه بسوء سريرته و خبث باطنه، بحسب نقصانه و اقتضاء استعداده ذاتاً و إمكاناً...
و بالجلمة: تفاوت أفراد الإنسان في القرب منه - جل شأنه و عظمت كبريائه - و البعد عنه سبب لاختلافها في استحقاق الجنة و درجاتها، و النار و دركاتها، و موجب لتفاوتها في نيل الشفاعة و عدمها، و تفاوتها في ذلك بالآخرة يكون ذاتياً، و الذاتي لا يعلّل!
ثم قال: إن قلت: على هذا فلا فائدة في بعث الرسل و إنزال الكتب و الوعظ و الإنذار. قلت: ذلك لينتفع به من حسنت سريرته و طابت طينته؛ لتكمل به نفسه... و ليكون حجة على من ساءت سريرته و خبثت طينته. انتهى. و قد ذكر قريباً منه في موضعين آخرين من كتابه متناً و هامشاً.
أقول: العقاب على العمل المعلول لنقص الاستعداد الذاتي ظلم محض لا يقبله عقل أحد، و لا يصير التكليف و الوعد و الوعيد حجة على مثله، كما لا يصير حجة على الأربعة بانتزاع الزوجية عن نفسها! بل هو من اللغو المحض.
و أمّا حديث ذاتية السعادة و الشقاوة فسيأتي إبطاله إن شاء الله.
و بالجلمة: هذا الكلام بعد إثبات الحسن و القبح و إثبات عدل الله و حكمته لا يحتاج إلى
ص: 206
زيادة بحث عن بطلانه.
الثاني: ما ذكره جملة من الفلاسفة، بل نسب إلى جميعهم من الالتزام بتجسّم الأعمال، و أنّ المثوبة و العقوبة من تبعات الأفعال و لوازم الأعمال.
قال صاحب الأسفار(1) في مقام الجواب عن اعتراض معاقبة الله المكلفين على معاصيهم الصادرة بقضاء الله و قدره لا باختيارهم: و الجواب على مقتضى قواعد الحكماء: أنّ الله غني عن العالمين و طاعة المحسنين و معصية المسيئين، و إنّما الوارد على النفس بعد مفارقة الدنيا إنّما هو على تقصيرها و تلطيخ جوهرها بالكدورات المؤلمة و الظلمات الموذيه الموحشة؛ لا أنّ عقابها لمنتقم خارجي يعاقبها و يؤذيها... كما تتوهّم النفوس العامية... فإنّ العقوبات هنالك - أي في الآخرة - من لوازم أعمال و أفعال قبيحة و نتايج هيئات ردية و ملكات سيئة، فهي حمّالة لحطب نيرانها و معها وقود جحيمها، فإذا فارقت النفس البدن متلطّخة بالملكات المذمومة و الهيئات المرذولة و زال الحجاب البدني، و فيها مادة الشعلات الجحيمية و كبريت الحرقات الباطنة و النيران الكامنة فشاهدتها بعين اليقين و قد أحاطت بها سرادقها... كما قال الصادق (ع): إنّما هي أعمالكم ترد عليكم... إلى آخره(2).
أقول: هذا البحث أجنبي عن موضوع النزاع، فإنّه إنّما يدفع السؤال القائل بأنّ الله تعالى لم يعاقب العبد و لو كان مستحقاً للعقاب بارتكابه المعاصي فانه تعالى غنيّ عنه غير مفتقر إليه؟
وجه الدفع: أنّ العقاب مجسّم من عمله، لا أنّه وارد عليه من الله تعالى، و أمّا إثبات استحقاق العقاب فالبحث المذكور لا يثبته، و لا ينظر إليه أصلاً، و المفروض أنّ العقلاء يرون المتمرّدين مستحقين و مستأهلين للعقاب و العتاب، و مع فرض كون المكلف مجبوراً و مضطراً في أفعاله لا يستحق ثواباً و لا عقاباً فسقط هذا القول أيضاً.
إلا أن يقال(3): إنّا لا نقول بالعقاب من أجل حكم العقلاء بالاستحقاق حتى يرد علينا اعتراض انتهاء الفعل إلى ما لا بالاختيار.
بل نقول: بأنّ الفعل الناشئ عن هذا المقدار من الاختيار مادة لصورة أخروية، و التعبير بالاستحقاق بملاحظة أنّ المادة حيث كانت مستعدّة فهي مستحقة لإفاضة الصور من واهب الصور، و منه تعريف أنّ نسبة التعذيب و الإدخال في النار إليه تعالى بملاحظة أنّ إفاضة تلك
ص: 207
الصورة المؤلمة منه تعالى بتوسط ملائكة العذاب، فلا ينافي باللزوم مع ظهور الآيات و الروايات في العقوبة من معاقب خارجى.
و تحقيق الموضوع إنّما يتم بذكر أمرين:
الأمر الأول: في إثبات أصل هذه المسألة.
فنقول: استدلّوا عليه بالآيات و الروايات، مثل قوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، و قوله: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ اَلنّٰاسُ أَشْتٰاتاً لِيُرَوْا أَعْمٰالَهُمْ، و قوله: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مٰا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ مٰا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهٰا وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً(1)، و قوله: لاٰ تَعْتَذِرُوا اَلْيَوْمَ إِنَّمٰا تُجْزَوْنَ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، و قوله: ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مٰا كَسَبَتْ، و قوله: فَاتَّقُوا اَلنّٰارَ اَلَّتِي وَقُودُهَا اَلنّٰاسُ وَ اَلْحِجٰارَةُ، و قوله: مٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ اَلنّٰارَ، إلى غير ذلك.
قال بعض السادة المفسّرين من أهل المعقول(2): و لعمري لو لم يكن في كتاب الله آية إلا قوله: لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هٰذٰا فَكَشَفْنٰا عَنْكَ غِطٰاءَكَ فَبَصَرُكَ اَلْيَوْمَ حَدِيدٌ لكان فيه كفاية، إذا لغفلة لا تكون إلا عن معلوم حاضر، و كشف الغطاء لا يستقيم إلا عن مغطى موجود... إلى آخره.
و أمّا الروايات فهي أيضاً عدة منتشرة في مواضع شتّى نقل بعضها صاحب الأسفار في بعض فصول المعاد، و المتتبع يجدها في محالّها.
قال السبزواري(3): بل هو أمر ثابت بالبرهان، محقق عند أهل الكشف و العيان، مستفاد من أرباب الشرائع و الأديان. انتهى كلامه.
ص: 208
أقول: أمّا الاستفادة من الشرع فقد عرفتها، و أمّا تحقيقه بالكشف فلنقل قصص و حكايات عليه، لكنها ممّا لا يعتمد عليه في المسائل العلمية، و أمّا البرهان فما وقفت عليه بعد الفحص المقدور وجوه:
الأول: ما ذكره صاحب الأسفار في فصل نشر الصحائف و إبراز الكتب من فصول باب المعاد، قال: إنّ الملكات النفسانية تصير صوراً جوهرية و ذوات قائمة فعّالة في النفس(1) تنعيماً و تعذيباً، و لو لم يكن لتلك الملكات من الثبات و التجوهر ما يبقي أبد الآباد لم يكن لخلود أهل الجنة في الثواب و أهل النار في العقاب وجه أبداً، فإنّ منشأ الثواب و العذاب لو كان نفس العمل أو القول - و هما أمران زائلان - يلزم بقاء المعلول مع زوال العلة المقتضية، و ذلك غير صحيح.
الثاني: ما ذكره هو أيضاً في نفس المقام، من أن الفعل الجسماني الواقع في زمان متناهٍ كيف يصير منشأ للجزاء الواقع في أزمنة غير متناهية؟! و مثل هذه المجازاة غير لائق بالحكيم؛ سيما في جانب العذاب...
و لكن يخلد أهل الجنة في الجنة و أهل النار في النار بالثياب في النيات، و الرسوخ في الملكات.
الثالث: ما في بعض الحواشي(2) من أنّ الماهية الخارجية هي بعينها توجد في الذهن، كما قرّر في مبحث الوجود الذهني، و اختلاف الخارجي و الذهني في الآثار إنّما هو لأجل الوجود الخارجي و الذهني دون الماهية، فإنّها متحققة في المقامين بنفسها، و هكذا في الخيال و الحسّ و العقل، فإنّ الماهية الموجودة فيها ماهية واحدة، لكنّها تتجلى في كل موطن بصورة، و تسمّى في كل مقام باسم، فتتجسم في مقام، و تصير عرضاً في مقام آخر.
و أصل ذلك كله إمكان تفاوت آثار الشيء بحسب نشآت وجوده مع كونه هو هو بحسب ماهيته.
أقول: أمّا الوجه الأول فجوابه: أنّ القول أو العمل أو الاعتقاد بوصف كونه معصية علة عقلائية لاستحقاق العذاب و خلوده، و أمّا نفس العقاب فهو معلول لإرادة الله سبحانه و تعالى حدوثاً و بقاءً، فأين لزوم بقاء المعلول بلا علة؟
و أمّا الوجه الثاني فقد تقدم الكلام حوله مفصّلاً في القاعدة المتقدمة.
ثمّ إنّ المستدلّ غير معتقد بهذين الوجهين أيضاً كما يظهر من بيانه حول خلود الكفّار في
ص: 209
أسفاره و إنّما ذكرهما تفنّناً.
و أمّا الوجه الثالث فهو بعد لم يخرج عن ميدان الادّعاء، فهو مصادرة، كما لا يخفى.
و أمّا الآيات القرآنية فما اشتمل منها على رؤية الأعمال يوم القيامة غير مربوط بالمقام، فإنّ المدّعى أنّ الأعمال تتجسّم في القبر و القيامة بأشكال موجودات منعّمة و معذّبة، كالحور و الغلمان و الفواكه و السرور و غيرها، و كالحيّات و العقارب و النار و الزقّوم و أمثالها، فيلتذ بها الإنسان أو يتأذي بهما و مجرد رؤية العمل بتجسّمه لا يدل على أنّه الثواب نفسه أو العقاب، بل لعلّ تجسّمه لأجل تثبيت عمله عليه ليرى عيناً، فيكون أو كد في إقناعه أو سروره أو انفعاله، و لعلّ قوله تعالى: تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهٰا وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً ناظر إلى ذلك، أي من جهة انفعاله به، فتأمّل.
و أمّا العقاب و الثواب المحقّقان بالنار و دخول الجنة و نحوهما فهما موجودان مستقلاّن مبائنان للعمل، مستندان إلى إرادة الله تعالى جزاءً على عملهم، بل يمكن أن يقال: إنّ الرؤية لا تستلزم التجسّم أبداً؛ لما ينقل عن بعض الرياضيين ممّن قارب عصرنا من أنّ الأفعال و الحركات محفوظة في محالّها ممكنة الرؤية في حدّ نفسها، فلو قويت باصرة البشر أو حاز حاسّة سادسة لرآها بعينها، فإن شرائط الرؤية في الأرض و بعض المجرّات الأخرى، لعلّها تختلفه. فتأمل.
و بالجلمة: لو لم نقل: إنّ المستفاد من هذه الآيات الكريمة حسب متفاهم العرف العام - و هم المخاطبون بالخطابات القرآنية - هو رؤية جزاء العمل، لما دلت على مقصودهم، أيضاً، كما عرفت، و منه يظهر الحال في قوله تعالى: لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هٰذٰا، فإنّه لا يدل على كون العمل عقابا، و لا على تجسّم العمل، و العمدة قوله: إِنَّمٰا تُجْزَوْنَ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، لكن قوله تعالى: جَزٰاءً بِمٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ ينافيه، فلا يبقى مجال للاعتماد على ظهوره.
ثم إن هنا وجهين - آخرين يدلان على نفي عموم التجسّم المذكور.
الأول: ما في كثير من الآيات من استناد الثواب و العقاب إلى الله تعالى، و إنّه هو المثيب و المعاقب، و أمّا ما سبق من بعضهم من أنّ الاستناد المذكور إنّما هو لأجل إفاضة الصورة فهو خلاف متفاهم العرف، إلا أن يقال أن استثنا شيء إلى الله تعالى - و هو الله - البعيدة، و إلى غيره
ص: 210
- و هو علّة قريبة، غير ضائرة أن ثبت تجسّم العمل.
الثاني: وجود الجنة و النار فعلاً و قبل هذا، بل قبل وجود المكلفين، كما يستفاد من جملة من الآيات و الروايات، و سيأتي تفصيله في المقصد الثامن إن شاء الله.
وجه الدلالة: أنّ النشأة الآخرة بعد لم تبرز حتى تتجسّم الأعمال فيها، بل لم يوجد أعمال جميع المكلفين في هذه النشأة أيضاً، فكيف وجدت الجنة و جهنم فعلاً مع أنّهما مجسّم الأعمال الصالحة و الطالحة؟
ثم إنّ هذه الدعوى إن تمّت لتمّت في خصوص العقاب الأخروي(1)، و أمّا العقاب الدنيوي كما في الحدود فلا مسرح لها، كما لا يخفى، و لا أدري ما هو الوجه عندهم لاستحقاق قتل القاتل بقتل المقتول، مع أنّ القاتل المجبور لا ذنب له؟!
و لعمري إنّ حديث التجسم بنحو العموم بحيث تكون الجنة و النار و ما فيهما مجسّمة أعمالنا من مادة أخرى مخلوقة لله تعالى مقطوع البطلان بلحاظ دلالة القرآن.
نعم، لا مانع من الالتزام به في الجملة من جهة قوله تعالى: وَ وَجَدُوا مٰا عَمِلُوا حٰاضِراً وَ لاٰ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً، و بشهادة قوله: وَ لاٰ يَظْلِمُ. و من جهة الروايات إن صحت سندا.
الأمر الثاني: في تصحيح العقاب به على تقدير تماميته، فنقول: العمل الصادر من العبد إمّا علة تامة لإفاضة الصورة من قبل الله تعالى، بحيث لا يمكن التخلف عنه، أم لا، بل الإفاضة باختيار الواجب و إرادته، و على كلا التقديرين فلحوق المجسّم المذكور بالعامل إمّا ضروري لا يمكن انفكاكه عنه، و إمّا ممكن و تابع لإرادة الله تعالى. هذه احتمالات أربعة، أحدها باطل قطعاً، و هو فرض أنّ العمل علة تامة لإفاضة الصورة، و كون لحوقها بالعامل ضرورياً.
وجه البطلان: أنّ الشفاعة و التوبة و العفو الإلهي ممّا يسقط الذنوب بلا إشكال، و الاحتمال المذكور لا يجامع سقوط الذنب على الفرض، فيكون باطلاً قطعاً. و أيضاً قد تقدم - في محلّه - أنّ الله فاعل مختار يمكنه الفعل و الترك، و المستفاد من الآيات الكثيرة أنّ العذاب و الثواب بإرادة الله و مشيئته. فبطلان هذا الاحتمال فليكن مفروغاً عنه. (فافهم).
و أمّا بقية الاحتمالات فكلّ منها ثبت بالدليل لا يمكن أن يندفع به إشكال العقاب؛ إذ يقال: إن صدور الفعل عن العبد ضروري قهري غير داخل تحت اختياره فكيف يعذّبه الله تعالى عليه، مع أنّه مختار و متمكن من دفعه عنه؟! و لا جواب عنه أبداً.
و ما تقدم من بعضهم من أنّ العمل مادة مستعدّة و مستحقة لإفاضة الصور، و الله واهب يهب
ص: 211
الصورة لها فهو ساقط جداً، ضرورة قبح الهبة المستلزمة لخلود أحد في العذاب و العقاب، فحديث تجسّم الأعمال لا ينفع المقام شيئاً(1).
قد عرفت منّا حقيقة الأمر بين الأمرين على وجه صحيح، لكنّ هنا أقوالاً و آراء أخرى ادّعى أصحابها أنّها الأمر بين الأمرين، مع أنّها ليست كذلك، و نحن نذكر جملة منها، فنقول:
منها: ما تقدم من مذهب الحكماء و المنسوب إلى كثير من الإمامية، و قد عرفت أنّه راجع إلى الجبر، و لا يرتبط بالأمر بين الأمرين، و أشرنا إلى أنّ نسبته إلى كثير من الإمامية غير ظاهرة.
و منها: ما ذكره صاحب الأسفار، و قال: إنّه مذهب أهل الله! و اختاره جملة من محقّقي الفلاسفة بعده، و حاصل هذا القول: إنّ الإيجاد يدور مدار الوجود في وحدة الانتساب و تعدده، و في الاستقلال و عدمه، و حيث إنّ المجعول بالذات - بحيث تكون حيثية ذاته حيثية المجعولية و الارتباط، لا أنّ هناك شيئاً له المجعولية و الربط - هو الوجود المنبسط على هياكل الماهيات، و المتحد مع مراتب الوجودات، و كان لهذا الوجود المذكور انتسابات إلى الفاعل بالوجوب، و هو بهذا الاعتبار فعله و صنعه تعالى، و إلى القابل بالإمكان، و هو بهذا الاعتبار وجود زيد و بكر مثلاً، فكان أثر هذا الوجود و إيجاده أيضاً صرف ربط و فقر؛ إذ الجاعل بالذات حيثية ذاته حيثية الجاعلية، فإن كانت ذاته مستقلة كانت حيثية الجاعلية مستقلة، و إن كانت عين الفقر كانت حيثية الجاعلية أيضاً كذلك؛ إذ لا تغاير بين الحيثيتين حقيقة.
فاتضح أنّه لا تفويض؛ إذ حيثية الأثر كحيثية مؤثّره عين الارتباط، و لا جبر؛ إذ الأثر كالمؤثر له انتسابات: نسبة إلى الرب حيث إنّه أثر فعله الحقيقي الإطلاقي، و نسبة إلى العبد حيث إنّه أثر وجوده الحقيقي، فالفعل فعل زيد حقيقة، و مع ذلك فهو فعل الله أيضاً بلا عناية.
نعم، لا بد أن ينسب إلى الله تعالى بما هو مطلق و بما هو يليق بساحة قدسه، و إلى العبد بما هو مقيّد و بما هو يلائمه من تجسّمه و إمكانه، هذا ملخّص ما قرره بعض الفحول من أرباب هذا القول(2).
أقول: لا مانع من كون نسبة الفعل إلى الربّ كنسبة إلى العبد على نحو ذكره، فإنّه يتمّ على
ص: 212
مسلكنا أيضاً، و أمّا مان في جملة من الروايات: «أنّ الله أولى من العبد بالحسنات، و العبد أولى منه بالسيئات»، بل في التنزيل: مٰا أَصٰابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اَللّٰهِ وَ مٰا أَصٰابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (1)، فالوجه فيه: أنّ الحسنة بإرشاد الله و هدايته و أمره، و السيئة من سوء اختيار العبد و اشتهاء نفسه، و الله تعالى نهى عنها و توعّد عليها، فالأولوية بهذا الاعتبار، و إلا فلا فرق بين الحسنات و السيئات من ناحية الإفاضة و التمكين و تمكّن العبد أصلاً، و في بعض تلك الروايات: «و بنعمتي أدّيت إليّ فرائضي، و بقدرتي قويت على معصيتي»، و هذا ظاهر، و لذا لم يفصل أحد بينهما.
لكنّ الذي يوجب رفض هذا القول هو عدم كفاية صحة الفعل إلى العبد لصحة التكليف و استحقاق الجزاء، بل و لما هو المشهود وجداناً و عياناً من اختيارنا، ما لم يقل: إنّ العبد متمكّن من الفعل و الترك على نحوٍ أسفلناه، و إلا فنسبة وجودنا و بعض صفاتنا إلينا أيضاً صحيحة بلا شائبة عناية، و مع ذلك هو خارج عن قدرتنا و إرادتنا.
و على الجملة: إن قالوا مع ذلك بتمكّن العبد من الترك و الفعل كما قلنا فقولهم هو الأمر بين الأمرين، و إن لم يقولوا - كما هو الظاهر - فهو جبر محض يبطله الوجدان قبل البرهان.
و منها: ما قيل من أنّ المراد من الأمر بين الأمرين كون بعض الأشياء باختيار العبد و هي الأفعال الاختيارية، و بعضها بغير اختياره، كالصحة و المرض و النوم و أشباهها.
أقول: و ضعفه ظاهر، فإنّ الأول تفويض محض، و الأمثلة في الشقّ الثاني قد تكون اختيارية، و قد تكون اضطرارية قهرية، على أن المفوضة أيضاً لم يدّعوا أنّها اختيارية دائماً.
و منها: ما ذكره الفاضل الطريحي في مجمع البحرين في مادة (القدر)، قال: و الذي يظهر من كثير من الأحاديث أنّ العبد ليس قادراً تاماً على طرفي فعله، كما هو مذهب المعتزلة، و إنّما قدرته التامة على الطرف الذي وقع منه فقط، و أمّا على الطرف الآخر فقدرته ناقصة، و السبب في ذلك - مع تساوي نسبة الأقدار و التمكين منه تعالى إلى طرفي الفعل - أمر يرجع إلى نفس العبد، و هو إرادة أحد الطرفين دون الآخر، لا من الله فيلزم الجبر... فالقدرة التامة للعبد على ما زعمه المعتزلة باطلة، و القول بعدم القدرة على شيء من الطرفين كما زعمه الأشعرية أظهر بطلاناً، و الحقّ ما بينهما هو القدرة التامة فيما يقع من العبد فعله، و الناقصة فيما لم يقع... إلى آخره.
أقول: فساده واضح، و عدم دلالة الأحاديث عليه لائح.
ص: 213
و منها: ما استظهره المجلسي من الأخبار المعتبرة، و تبعه عليه بعض السادة، قال بعد تفسيره الجبر و التفويض بمعناهما المعروف(1): و أمّا الأمر بين الأمرين فهو أنّ لهداياته و توفيقاته تعالى مدخلاً في أفعالهم، بحيث لا يصل إلى حدّ الإلجاء و الاضطرار، كما أنّ لخذلانه سبحانه مدخلاً في فعل المعاصي و ترك الطاعات، لكن لا بحيث ينتهى إلى حدّ لا يقدر معه على الفعل و الترك... إلى آخره.
أقول: كلامه بطوله ظاهر في أنّ المراد بالأمر بين الأمرين هو اللطف المصطلح، و هذا من مثله عجيب، إذ لا ربط بين المسألتين أصلاً، مع أنّ المباح لا هداية فيه و لا خذلان، فلازم كلامه تفويض الأفعال المباحة إلى العبد، مع أنّه مقطوع البطلان بلحاظ دلالة الروايات فضلاً عن حكم العقل باستحالته. نعم، إنّ بعض الروايات يدل على ما ذكره، لكنّ الأمر بين الأمرين الذي هو يقابل الجبر و القدر لا يتحد معه، فالحق في تفسيره ما ذكرنا.
ثم إنّ هنا أقوالاً أخرى تركنا ذكرها و بيان ما فيها مخافة التطويل، و اعتماداً على فهم القارئ بعد الإحاطة بما ذكرنا، و الله وليّ التوفيق و السداد، و عليه الاتّكال و الاعتماد.
الروايات الواردة حول الاستطاعة و إبطال الجبر و التفويض و إثبات المنزلة بينهما كثيرة ربّما تتجاوز المائة، و قد نقلها العلامة المجلسي (رحمه الله) في بحاره(2)، و الذي يظهر منها أنّ التفويض الباطل على معانٍ:
1 - غلبة إرادة العبد على إرادة الله تعالى، و وقوع الفعل حسب مشيئة العبد و إن كان مخالفاً لإرادة الله تعالى، يدل عليه جملة من الروايات.
2 - نفي تكليف العباد و رفع الحظر عنهم في أفعالهم، و لعلّ أكثر الأخبار الواردة في إبطال التفويض ناظر إلى هذا المعنى، كما يظهر لمن تدبّرها، و من هنا فسّؤ المفيد (قدس سره)(3) التفويض - بقول مطلق - بالقول برفع الحظر و الإباحة للعباد مع ما شاؤوا من الأعمال، و قال هذا القول الزنادقة و أصحاب الإباحات، و الواسطة بين هذين القولين: أنّ الله أقدر الخلق على أفعالهم و مكّنهم من أعمالهم، و حدّ لهم الحدود في ذلك... و نهاهم عن القبائح بالزجر و التخويف و الوعد و الوعيد...
ص: 214
فهذا هو الفصل بين الجبر و التفويض... انتهي.
3 - تفويض أمر الخلق و الرزق إلى حجج الله تعالى، و في بعض الروايات: أنّ القائل به مشرك.
4 - تفويض التشريع إلى العباد.
أقول: و في هذا القسم الأخير بحث سيمرّ بك في مبحث النبوة و الإمامة، و ستعرف أنّ النبيّ الخاتم (ص) قد فوّض إليه التشريع، فانتظر.
و على الجملة: أنّ التفويض بجميع معانيه المذكورة فاسد قطعاً، سوى ما وعدناك ببيانه فيما بعد، و أمّا التفويض بالمعنى الذي ذكرناه سابقاً من عدم احتياج العبد في أفعاله إلى الله تعالى «و إن كان العبد و أفعاله مقدورين لله تعالى» فلم نجد رواية صريحة على بطلانه، و لعلّه لم يكن دائراً بين الناس في تلك الأعصار، و الله أعلم.
و أمّا الجبر فلعلّ المستفاد من الأخبار المذكورة أنّ له معاني ثلاثة:
1 - ما ذكره هؤلاء الناس من عدم قدرة العبد على أفعاله و سلب الاختيار عنه، و لعلّه مدلول أكثر الأخبار.
2 - التكليف بما لا يطاق.
3 - الأمر بالمعاصي.
و الجميع واضح البطلان. إذا عرفت ذلك نذكر لك بعض الروايات:
1 - صحيحة الجعفري، عن الرضا (ع)(1) قال: ذكر عنده الجبر و التفويض، فقال: «ألا أعطيكم في هذا اصلاً لا تختلفون فيه، و لا يخاصمكم عليه أحد إلا كسر تموه؟»، قلنا: إن رأيت ذلك، فقال: «إنّ الله عز و جل لم يطع بإكراه، و لم يعص بغلبة، و لم يمهل العباد في ملكه، هو المالك لما ملكهم، و القادر على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادّاً و لا منها مانعاً، و إن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم و بين ذلك فعل، و إن لم يحل و فعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه»، ثم قال (ع): «من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه».
قوله (ع): «لم يطع بإكراه»، ردّ على المجبّرة مع الإيماء إلى دليله، فإنّ العبادة - على قولهم - واقعة بقدرة الله و إرادته، لا بإرادة العبد، و العبادة غير الاختيارية غير مطلوبة من المكلفين، إذ لو شاء الله تلك هدى الناس أجمعين، و لذا قال تعالى: لاٰ إِكْرٰاهَ فِي اَلدِّينِ، بناءً على أنّ المراد بالإكراه هو الجبر، كما في تفسير بعض الأعاظم من أساتيذنا الأصوليين.
ص: 215
قوله (ع): «و لم يعص بغلبة»، ردّ على المفوضة، و أنّ العباد ليسوا بغالبين على إرادة الله تعالى، بل ما صدر عن العباد من المعصية إنّما يصدر عنهم بإقدار من الله و تمكينه إيّاهم، و إلا فلا قدرة لهم، و يمكن لله تعالى منعهم عن العصيان و لو بعد إعطاء القوة و القدرة.
قوله (ع): «لم يمهل العباد في ملكه»، ناظر - بحسب الظاهر المستفاد من سائر الروايات - إلى بطلان القسم الثاني من التفويض، كما تقدم بيانه.
قوله (ع): «هو المالك لما ملكهم» من ألطف الكلام، و قد ورد ذلك عن أمير المؤمنين و الحسن الزكيّ (1) أيضاً، و كأنّه ناظر إلى بيان الأمر بين الأمرين، و أنّ القوة و المكنة التي أوجدها الله في العبد لم تخرج عن ملكه تعالى، بل هي بعد في ملكه و اختياره في كلّ آن و آن، و مفتقرة إليه تعالى في حدوثها و بقائها، كما فصّلناه تفصيلاً، فافهم و استقم.
قوله: «و القادر على ما أقدرهم عليه» تأكيد و تصريح على بطلان التفويض بمعناه الأول المتقدم.
قوله: «و ان ائتمروا بمعصيته»، و التعبير بالائتمار لعلّه للمشاكلة للائتمار بالطاعة، أو هو بمعنيّ الهمّ أو الفعل من غير مشاورة، كما عن النهاية و القاموس.
2 - صحيحة البزنطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(2) (ع): قال: «لا يكون العبد فاعلاً و لا متحركاً إلا و استطاعة مع من الله عز و جل» إلى آخره.
و إذا انضمّ إليها افتقار الممكن إلى الواجب حدوثا و بقاءً كانت ظاهرة في المراد.
3 - رواية عليّ بن يقطين، عن أبي إبراهيم (ع)(3)... فقال أمير المؤمنين (ع): «إن زعمت أنّ بالله تستطيع فليس إليك (لك) من الأمر شيء، و إن زعمت أنّك مع الله تستطيع فقد زعمت أنّك شريك معه في ملكه، و إن زعمت أنّك من دون الله تستطيع فقد ادّعيت الربوبية من دون الله... إلى آخره.
فانظر إلى كلامه (ع) كيف أثبت الاستطاعة للعبد مع نفي الاستقلال عن العبد، و الروايات في الباب كثيرة، و الله الهادي.
ص: 216
استدلّ المجبّرة و المفوّضة القدرية بجملة كثيرة من الآيات المباركة القرآنية على إثبات الجبر و التفويض، حتى تمسّكوا بآية واحدة لتصحيحهما، و لهم كلمات عجيبة غريبة في مقام النقض و الإبرام و الدفع و الإيراد، كما يفهمها من لا حظ تفسير الرازي الجبري.
و اعلم أنّه لا دلالة للقرآن - و لو ضعيفة - على التفويض أصلاً، بل الآيات الشريفة تبطله، مثل قوله تعالى: وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ، و قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلنّٰاسُ أَنْتُمُ اَلْفُقَرٰاءُ إِلَى اَللّٰهِ، و غيرهما.
و أمّا الآيات الدالة على الاختيار و إسناد الأفعال إلى العباد، أو على ما يتوقف على الاختيار كالآيات الدالة على التكليف و الوعد و الوعيد و أمثالها فلا مساس لها بالتفويض؛ لعدم الملازمة بينهما، بل هنا أمر آخر - و هو الأمر بين الأمرين - يحقق الاختيار، و لا يستلزم التفويض، فهذه الآيات الكريمة و إن تبطل بالجبر لكنّها لا تثبت التفويض؛ لإمكان نظارتها إلى الأمر بين الأمرين.
و أمّا الآيات الدالة على بطلان الجبر فكثيرة جداً، بل القرآن من أوّله إلى آخره - سوى بعض آياته - يدلّ على الاختيار و بطلان الجبر و الاضطرار، فقولنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم(1)، و بسم الله الرحمن الرحيم، لا يتمّ إلا على القول بالاختيار؛ إذ لا معنى للاستعاذة عن فعل الله تعالى بالله؛ و ذلك لأنّ إغواء الشيطان بناءً على مذهب المجبّرة من فعل الله و خلقه فكيف يعوذ العبد منه؟! و أين معنى الرحمة و هو يعذب عباده على ما يخلق فيهم بمحض إرادته النافذة؟! و كذا لا يصحّ قولنا:... من شرّ الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فإنّ حال الخنّاس في وسواسه كحال السكّين في قطعه رأس أحد! و إنّما الفاعل هو الله تعالى، بل الصحيح أن يدّعى حينئذٍ هكذا: أعوذ من شرّ الله تعالى الذي يوسوس... إلى آخره! (نعوذ بالله من هذا القول). بل عرفت أنّ أساس التشريع و أصل إنزال الكتب و إرسال الرسل مبنيّان على الاختيار و عدم الاضطرار، و معه لا يحسن أن نذكر الآيات الدالة على الاختيار و بطلان الجبر كما ذكرها الأصحاب و بوّبوها أبواباً، و إنّما المهمّ أن نتعرض للآيات التي تخيّلها المجبّرة - الجهمية و الأشعرية - دلالتها على الجبر، و أن نبيّن وجه خبطهم و غلطهم، و في ذلك فوائد مهمة.
ص: 217
و الذي يهمّ في المقام تعرضه هو ثلاث طوائف من الآيات، فنقول:
الطائفة الأولى: ما دل على أنّ الله خلق كل شيء، كقوله تعالى: اَللّٰهُ خٰالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ هُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْ ءٍ وَكِيلٌ (1)، و قوله: وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ ءٍ... خٰالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ فَاعْبُدُوهُ (2)، و قوله: أَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكٰاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشٰابَهَ اَلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اَللّٰهُ خٰالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ إلى غير ذلك.
و امّا قوله تعالى: أَ تَعْبُدُونَ مٰا تَنْحِتُونَ وَ اَللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مٰا تَعْمَلُونَ، فالظاهر بقرينة الصدر أنّ كلمة «ما» موصولة، لا مصدرية، فهو أجنبي عن المقام، إذ معنى الآية حينئذٍ: أنّ الله خلقكم و الأحجار التي تنحتونها، و قد اعترف الرازي في تفسيره أيضاً بذلك، فلاحظ.
و على الجملة: هذه الآيات تدلّ على أنّ الأشياء - و منها أفعال العباد الاختيارية - مخلوقة لله تعالى، و هذا هو معنى الجبر الذي يدّعيه المجبّرة.
و الجواب عنها: أولاً: أنّ الخلق بمعنى التقدير، كما قيل في قوله تعالى: خَلَقَ اَلْمَوْتَ وَ اَلْحَيٰاةَ، و على هذا فالآيات المذكورة أجنبية عن المقام، فإنّ تقدير الأشياء أزلاً لا ينافي الاختيار، كما يأتي إن شاء الله.
و ثانياً: أنّ عموم هذه الآيات غير ثابت حتى عند الأشاعرة، فإنّهم يخصّمونه بغير صفاته الثمانية القديمة القائمة بذاته تعالى، الصادر عنه بنحو الإيجاب و الاضطرار دون الخلق و الاختيار، كما صرّح به إمامهم الرازي.
قال في تفسير سورة الأنعام: و جواب أصحابنا: أنّا نخصّص هذا العموم بالدلائل الدالة على كونه تعالى عالماً بالعلم... إلى آخره، فإذن يصح لغير الجبري أن يخصّصه بالأدلة الدالة على اختيار العبد.
و ثالثاً: أنّه لا عموم لها ليشمل الأفعال الاختيارية من الأول لكي نحتاج في خروجها عنه إلى مخصّص؛ و ذلك لأنّ المخصّص إذا كان متصلاً لا ينعقد للعام ظهور في عمومه من الأول، إلا في غير ما شمله المخصّص، فإذا قلنا: أكرم كل عالم عادل، كان الموضوع من الأول هو العالم المتصف بالعدالة، لا مطلق العالم، و هذا واضح، و قد تقرر في أصول الفقه أنّ المخصّص كما
ص: 218
يكون لفظياً كذلك يكون عقلياً، كما أنّ كلّاً منهما قد يكون متصلاً و قد يكون منفصلاً.
و المراد بالمتصل العقلي: وضوح حكم شيء عند العقل بحيث لو ألقي عام أو مطلق شامل له بحسب وضع اللغة، مخالف له في الحكم لم يكن للّفظ ظهور بالنسبة إليه، و لم يدل عليه بحسب ما هو المتعارف بين العقلاء في باب الإفادة و الاستفادة من الخطابات، بل العام المذكور ينصرف إلى غيره، فإذا قيل: أطعم كل أحد، و خذ كل شيء لا يشمل لفظاً الأحد و الشيء الواجب الوجود و الأموات و السحاب و الهواء و الشمس و القمر، و غير ذلك من الأمور الظاهرة عند العقل في أنّها لا تقبل الأخذ والإطعام، و هذا الظهور العقلي يضيّق دلالة اللفظ من الأول، فلا تتم إلا في غير الأمور المذكورة، و المقام كذلك، فإنّ استناد أفعالنا الاختيارية إلى إرادتنا و تأثير قدرتنا و لو في الجملة ضروري فلا ينعقد للآيات الشريفة ظهور بالنسبة إليها من الأول، فافهم جيداً. گ
و رابعاً: أنّه تعالى قال عن أفعاله: اَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ ءٍ خَلَقَهُ. و من الظاهر أنّ المعاصي و الآثام و قتل الأنبياء و الأولياء لا حسن فيها، بل فيها القبح كل القبح، فلا بد من الالتزام بمدخلية العبد في إيجادها حتى تتوجّه المعايب المذكورة إليه، لا إلى الله الحكيم العليم. و أيضاً أنّه تعالى قد مدح نفسه في تلك الآيات بعموم الخلقة مع انتفائه بخلق القبائح التي لا يرضى بها هو تعالى أيضاً.
و خامساً: أنّها معارضة بقوله تعالى: فَتَبٰارَكَ اَللّٰهُ أَحْسَنُ اَلْخٰالِقِينَ، فقد أخبر بوجود خالقين غيره.
و للرازي في تفسيره هذه الآية اضطراب عجيب، و كلام غريب، و لم يستطع هدم دلالتها أصلاً.
و بقوله تعالى حاكياً عن السامري: لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوٰارٌ، و بقوله حاكياً عن عيسى (ع) أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ اَلطِّينِ كَهَيْئَةِ اَلطَّيْرِ، و وجه الجمع خروج الأفعال الاختيارية عن خلقة الله تعالى التامة المستقلة.
و سادساً و هو الأقوى من مقام الجواب: أنّ تلك الآيات إنّما تنافي مذهب التفويض، لا ما عليه أهل الحق من الأمر بين الأمرين، فإنّ الأفعال صادرة عن فاعليها بما يفيض الله عليهم من إبقاء وجودهم و إعطاء القوة لهم في كلّ آن، و ليس للعبد إلا إبراز تلك القوة، فكما يصح استناد
ص: 219
الأفعال إليهم كذلك يصح استنادها إلى الله تعالى على نحو يليق بعزّ جلاله، فافهم.
و إن شئت فقل: استناد فعل أو شيء إلى العلتين قد يكون عرضياً و قد يكون طولياً و على الأوّل يتمّ تخيّل الأشعري و على الثاني يتمّ ما هو الحق من الأمر بين الأمرين، و قد وقع الماديون و طوايف من المسلمين منهم الأشاعرة في الاشتباه بين القسمين فانحرفوا عن الحق.
الطائفة الثانية: ما دل على أنّ أفعالنا و مشيئتنا بمشيئته تعالى، مثل قوله تعالى: وَ لاٰ تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً إِلاّٰ أَنْ يَشٰاءَ اَللّٰهُ و قوله: كَلاّٰ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شٰاءَ ذَكَرَهُ وَ مٰا يَذْكُرُونَ إِلاّٰ أَنْ يَشٰاءَ اَللّٰهُ و قوله: إِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شٰاءَ اِتَّخَذَ إِلىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً وَ مٰا تَشٰاؤُنَ إِلاّٰ أَنْ يَشٰاءَ اَللّٰهُ و قوله:... لِمَنْ شٰاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَ مٰا تَشٰاؤُنَ إِلاّٰ أَنْ يَشٰاءَ اَللّٰهُ رَبُّ اَلْعٰالَمِينَ و قوله: قُلْ لاٰ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَ لاٰ ضَرًّا إِلاّٰ مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ.
أقول: أمّا الآية الأولى ففيها إضمار القول، و تقديرها: إلا أن تقول: إن شاء الله، و لمّا حذف القول نقل إن شاء الله إلى لفظ الاستقبال، كما حكي عن الأخفش و غيره، أو المعنى، إلا أن يشاء الله أن يأذن لك في ذلك القول، أي ليس لك أن تخبر عن نفسك أنّي فاعل لشيء إلا إذا أذن الله لك في الإخبار، كما ذ كره الرازي. أو أنّ قوله: «إلا أن يشاء الله» مقول القول و من تتمة المنهيّ عنه، أي لا تقل: إنّي أفعل فعلاً غير محتاج فيه إلى الله إلا أن يمنع الله منه، فإنّ هذا تفويض باطل، كما ذكره بعض أساتذتنا الأعلام في مجلس درسه.
و على جميع الوجوه تكون الآية أجنبية عن مسألة الجبر، إلا أنّ الاحتمال الثالث خلاف ظاهر الآية، كما لا يخفى.
و أمّا الآية الأخيرة فيمكن حملها على غير الأفعال الاختيارية.
و أمّا بقية الآيات فأجيب عنها بوجوه، أقربها وجهان:
الأول: حمل المشيئة المذكورة فيها على المشيئة الإلجائية، و لا شك أنّ الله تعالى إذا أراد شيئاً يقول له: كن فيكون؛ لاستحالة تخلّف المعلول عن علّته التامة.
الثاني: أنّ المعنى: إلا أن يشاء الله أن يلطف بكم في الاستقامة و التذكّر و التخاذ الطريق، كما يقتضيه سياق الآيات و نظمها.
ص: 220
أقول: قد تقدم في الجزء الأول: أنّ للإرادة معنيين.
1 - الإيجاد و الإفاضة.
2 - ذكر الأشياء في اللوح.
و مرّ أيضاً أنّ جميع الأشياء قد ذكرت في اللوح، و تعلّق المشيئة بهذا المعنى بعموم الأشياء ممّا لا ربط له بالجبر أصلاً، بل حاله حال علمه بها في أنّه كاشف، لا سبب كما مرّ، لكنّ حمل المشيئة المذكورة في الآيات على هذا المعنى خلاف الظاهر.
و الحقّ أن يقال: إنّ إرادة الله تعلّقت بكل شيء حتى بالأفعال الاختيارية من دون أن يستلزم الجبر! إذ الواجب يفيض على الممكن في بقاء وجوده و صدور أفعاله آناً فآناً، سواء في حال صلواته أم في حال زناه، كما بيّناه سابقاً، و إرادته ليست إلا إفاضته، كما قرّرناها في الجزء الأول، فثبت أنّ الجميع مراد له، و الكلّ من عند الله تعالى. لكنّها مرادة له بالإرادة التكوينية؛ لأنّ الله تعالى أراد وقوع ما يختاره العبد في الخارج، و هذا بعد الإحاطة بما مضى واضح بحمد الله تعالى.
فمذهب الإمامية غير موقوف على تأويل الآيات الكريمة و هدم ظواهرها كما يتوقف عليها بناء الجبر و القدر، بل القائل بالأمر بين الأمرين يرى توافق الآيات في هذا الباب، و هذا من ألطف الأمور و أعجب الرموز، فتبصّر و كن على بصيرة من موقفك.
و في رواية الفضيل، عن الصادق (ع)(1): «شاء و أراد، و لم يحبّ و لم يرض...» إلى آخره.
و أمّا تعلق إرادته تعالى بأفعالنا على نحو تعلّقها بأفعاله فهو واضح الفساد، فإنّه من محض التناقض و صرف التهافت، كما قرّرناه في المقالة الثالثة، فلاحظ.
ثم إنّ في بعض الروايات(2): «إنّ الله جعل قلوب الأئمة مورداً لإرادته، فإذا شاء الله شيئاً شاؤوا، و هو قوله: وَ مٰا تَشٰاؤُنَ إِلاّٰ أَنْ يَشٰاءَ اَللّٰهُ رَبُّ اَلْعٰالَمِينَ.
أقول: و هذا مقام عالٍ لا يتيسر لأحد غيرهم سلام الله عليهم، و هو اختيار محض في صورة الاضطرار، و لعلّه المراد بقول حافظ:
در پس آئينه طوطي صفتم داشته اند *** آنچه استاد ازل گفت بگو، آن گويم
الطائفة الثالثة: ما دل على أنّه تعالى يضلّ من يشاء و يهدي من يشاء، و هذا القسم أكثر من
ص: 221
ثلاثين آية، و ظاهر آنّ من يضلل الله فلا هادي له، و لن تجد له ولياً مرشداً.
أقول: الإشكال فيها من جهتين:
الأولى: قبح إضلال الناس عن صراط الحقّ، و لو فرضنا عدم العقاب و الجزاء.
الثانية: لزوم الجبر منها كما عرفت، لكنّ الأول ساقط، فإنّ القبيح إضلال الغير ابتداءً، و أمّا انتقاماً و جزاءً على تمرّده و عصيانه فلا قبح فيه، كالعقاب و العذاب، و هذا واضح، و المستفاد من القرآن أنّ إضلاله تعالى إنّما هو للمتمرّدين، لا غير، و إليك بعض ما يدل عليه: كَذٰلِكَ يُضِلُّ اَللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتٰابٌ، وَ يُضِلُّ اَللّٰهُ اَلظّٰالِمِينَ، يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَ مٰا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ اَلْفٰاسِقِينَ اَلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اَللّٰهِ...، كَذٰلِكَ يُضِلُّ اَللّٰهُ اَلْكٰافِرِينَ، كَيْفَ يَهْدِي اَللّٰهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمٰانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ اَلرَّسُولَ حَقٌّ وَ جٰاءَهُمُ اَلْبَيِّنٰاتُ وَ اَللّٰهُ لاٰ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظّٰالِمِينَ، اَللّٰهُ وَلِيُّ اَلَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ اَلظُّلُمٰاتِ إِلَى اَلنُّورِ.
و هذه الآيات كما ترى ناطقة باختصاص الإضلال بمن هو مسرف مرتاب ظالم كافر في مترتبة متقدمة، و إنّما يلحقه الإضلال جزاءً بعمله، و كذا الهداية للمؤمنين، كما يأتي.
و أمّا الإيراد الثاني فجوابه: أنّ هذا الإضلال لا يستلزم الجبر و الاضطرار، و توضيحه موقوف على بسط الكلام في الجملة.
فنقول: قال الرازي(1): فاعلم ان معنى الإضلال عن الدين في اللغة هو الدعاء إلى ترك الدين و تقبيحه في عينه، و هذا هو الإضلال الذي أضافه الله تعالى إلى إبليس، فقال: إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، و قال: وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ قٰالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنٰا أَرِنَا اَلَّذَيْنِ أَضَلاّٰنٰا مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ نَجْعَلْهُمٰا تَحْتَ أَقْدٰامِنٰا....
و أيضاً أضاف الله تعالى هذا الإضلال إلى فرعون، فقال: وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ مٰا
ص: 222
هَدىٰ
و أعلم أنّ الأمّة مجمعة على أنّ الإضلال بهذا المعنى لا يجوز على الله تعالى؛ لأنّه ما دعا إلى الكفر و ما رغّب فيه، بل نهى عنه و زجر و توعّد بالعقاب عليه، و إذا كان المعنى الأصلي للإضلال في اللغة ليس إلا هذا، و هذا المعنى منفيّ بالإجماع، ثبت انعقاد الإجماع على أنّه لا يجوز إجراء هذا اللفظ على ظاهره، و عند هذا افتقر أهل الجبر و القدر إلى التأويل، أمّا أهل الجبر فقد حملوه على أنّه تعالى خلق الضلال و الكفر فيهم و صدّهم عن الإيمان و حال بينهم و بينه... إلى آخره.
أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم و إفك مبين! تكاد السماوات يتفطّرن من قوله، يقول: إنّه تعالى ما دعا إلى ترك الدين! ثم يقول: إنّه تعالى خلق في المكلفين ترك الدين!! يقول: ذم الله إبليس و فرعون على إضلالهما الناس و دعائهما إيّاهم إلى ترك الدين! لكنّه يخلقه فيهم، و هو حسن محض! هكذا في سنة هذا القوم، نقول لهم: هذا الذي أضلّه الله و خلق فيه الضلالة على زعمكم هل هو قادر على عمل الطاعات، أو لا؟ و الأول يبطل مذهبكم، و الثاني ينفي تكليفه؛ لأن الله يقول: لاٰ يُكَلِّفُ اَللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا، و إنّي لا أظنّ بهؤلاء أن يلتزموا بسقوط التكليف عن الكفّار و الظالمين و المسرفين، فهذا يستكشف أنّ في وسعهم عمل الخير، و هم غير مجبورين، كما هو محسوس أيضاً، فيعلم من ذلك - علماً قطعياً - أنّ معنى الإضلال المنسوب إليه تعالى ليس بمعنى خلق ترك الدين، كما أنّه ليس بمعنى الأمر بترك الدين و الترغيب عنه و دعائه الناس إلى المعصية.
و قال بعض السادة المعاصرين(1): لا يخفى أنّ جميع ما ذكر من هذه الوجوه (أي الوجوه السبعة التي ذكرها السيد المرتضى و المجلسي - رحمهما الله - في توجيه قوله تعالى: أَنَّ اَللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ، إنّما هو للفرار من نسبة فعل القبيح إليه تعالى، فإن الحيلة و المكر و الأمر بالمعصية، و بالجملة كلّ ما هو إضلال بوجه قبيح من الحكيم فلا ينسب إليه تعالى، إلا أنّ ظاهر الكتاب أنّ جميع ذلك منه تعالى فيما نسب إليه من قبيل المجازات على المعاصي، قال تعالى: وَ مٰا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ اَلْفٰاسِقِينَ، و قال: فَلَمّٰا زٰاغُوا أَزٰاغَ اَللّٰهُ
ص: 223
قُلُوبَهُمْ. و لا يقبح الإضلال و كل ما يرجع إليه إذا كان بعنوان المجازات، كما لا يخفى. انتهى.
أقول: إن أراد بالإضلال الدعاء و التكليف بترك الدين كما يدلّ عليه قوله: «و الأمر بالمعصية» فهو مقطوع البطلان، فإنّ الله لم يرسل رسولاً و لم ينزّل كتاباً إلى الكفّار يدعوهم إلى الكفر و الفسق، بل دعا لناس بأسرهم إلى الإيمان و الطاعة في جميع حالاتهم، و قال في كتابه: إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يَأْمُرُ بِالْفَحْشٰاءِ، و قد مرّ نقل إجماع الأمّة على بطلانه. و إن أراد به خلق الضلالة فيهم بحيث لا يقدرون على إزالتها و سلوك الطريقة الحقة كما يقول به الجبرية، فهذا مع كونه خلاف الحسّ يبطل تكليفهم، كما قرّرنا وجهه.
لا يقال: الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
فإنّا نقول: نعم، لكنّه عقاباً لا تكليفاً على القول الصحيح، و تفصيله في أصول الفقه.
و مما يدل على بطلانه قوله تعالى: بَلْ طَبَعَ اَللّٰهُ عَلَيْهٰا بِكُفْرِهِمْ فَلاٰ يُؤْمِنُونَ إِلاّٰ قَلِيلاً، فأخبر عن إيمان من طبع على قلبه و عدم عجزه عنه، و إن أراد به خلقها على نحوٍ غير منافٍ لاختياره، كما إذا كانت الضلالة المخلوقة المذكورة مقتضية للمعاصي، لا علة تامة، فهذا لا محذور فيه، لكن استفادة ذلك من القرآن على نحو يعتمد عليه في جميع الموارد مشكلة.
فالأولى أن يحمل الإضلال المذكور في الآيات المشار إليها على أحد الوجهين:
الوجه الأول أنّ بعض أفعاله يكون سبباً لأنّ يتصف الناس - بسوء اختيارهم - بالضلالة، فإنّه تعالى كلّف الناس بالإيمان و العمل الصالح، فتمرّد عن قبوله جماعة فضلوا عن الطريق القويم، كما امتثله قوم فاهتدوا و صاروا من السعداء، فلو لا تكليفه تعالى لمّا تبرّزت ضلالة الأولين و لا اهتداء الآخرين، و هذا واضح، فضلالة الضالّين و إن كانت تابعة لمحض اختيارهم و إرادتهم، لكنّ الذي تتحق به الضلالة هو تكليف الله تعالى، فكأنّه هو الموجب لضلالتهم؛ فلذا أسندها إلى نفسه، و قال: يُضِلُّ اَللّٰهُ اَلْكٰافِرِينَ، و مثل هذا الإسناد و النسبة شائع في العرف، و كفاك فيه قول خليل الرحمن (ع) كما في القرآن: رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ اَلنّٰاسِ، و قوله تعالى حاكياً عن نوح (ع): وَ لاٰ يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْراً وَ قَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً، إذ من
ص: 224
الضروري أنّ الأصنام الجامدة لا إضلال لها بوجه، غير أنّها حيث صارت مرجحة لإرادتهم عبادتهنّ و ترك طاعة الله تعالى نسب الإضلال إليها.
و يقول شيخ الأنبياء - على نبينا و آله و عليه الصلاة و السلام -: و لم يزدهم دعائي إلا فرارا. و من المعلوم أنّه دعاهم إلى القرار دون الفرار، يقول الله تعالى: كِتٰابٌ أَنْزَلْنٰاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ اَلنّٰاسَ مِنَ اَلظُّلُمٰاتِ إِلَى اَلنُّورِ، و يقول: هُدىً لِلنّٰاسِ، ثم يقول: وَ لَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيٰاناً وَ كُفْراً، و يقول: وَ إِذٰا مٰا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زٰادَتْهُ هٰذِهِ إِيمٰاناً، فَأَمَّا اَلَّذِينَ آمَنُوا فَزٰادَتْهُمْ إِيمٰاناً وَ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَ أَمَّا اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزٰادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ.
و من الظاهر أنّ القرآن نزل لهداية الناس و سعادتهم، لا لإضلالهم و إغوائهم، فنسب الطغيان و الكفر و زيادة الرجس إليه من جهة ما ذكرنا لك، ألا ترى إلى الآية الأخيرة تبيّن أنّ سورة واحدة تزيد المؤمنين إيماناً و الكافرين رجساً، و هذا كالنصّ فيما قلنا، و أنت إذا تنبّهت لذلك تعلم أنّ المراد من الإضلال المنسوب إليه تعالى في جملة من الآيات ذلك، و عليه فلا محذور فيه أصلاً.
فإنّ الضلال يستند إلى إرادة الضالّ و اختياره، لا إلى إرادة الله تعالى، و من هذه الجملة قوله تعالى: وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلاّٰ بِلِسٰانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اَللّٰهُ مَنْ يَشٰاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشٰاءُ، و قوله: يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَ مٰا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ اَلْفٰاسِقِينَ، و قوله تعالى: إِنْ هِيَ إِلاّٰ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهٰا مَنْ تَشٰاءُ وَ تَهْدِي مَنْ تَشٰاءُ. إلى غير ذلك من الآيات.
ثم إنّ لبعض المعتسفين(1) إيراداً على هذا الوجه من جهة إنزال المتشابهات القرآنية، لكنّه يندفع بأدنى توجّه إلى ما قرّرنا، فلذا تركنا نقله و نقده.
الوجه الثاني من الوجهين اللذين يمكن أن يحمل عليهما الضلالة: هو التخلية بين العبد و ما
ص: 225
يرتكبه، و منع الألطاف الخاصة في حقه. توضيح ذلك: أنّه لا ريب أنّ الله تعالى هدى الناس عامة، و إن لم تصل إلى بعضهم، و هو الجاهل القاصر المعذور، قال الله تعالى: اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ هُدىً لِلنّٰاسِ وَ بَيِّنٰاتٍ، و قال: إِنّٰا هَدَيْنٰاهُ اَلسَّبِيلَ إِمّٰا شٰاكِراً وَ إِمّٰا كَفُوراً، و قال: وَ أَمّٰا ثَمُودُ فَهَدَيْنٰاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا اَلْعَمىٰ عَلَى اَلْهُدىٰ، و قال: إِنَّ اَلَّذِينَ اِرْتَدُّوا عَلىٰ أَدْبٰارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُمُ اَلْهُدَى اَلشَّيْطٰانُ سَوَّلَ لَهُمْ، و قال: وَ هَدَيْنٰاهُ اَلنَّجْدَيْنِ، و قال: كِتٰابٌ أَنْزَلْنٰاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ اَلنّٰاسَ مِنَ اَلظُّلُمٰاتِ إِلَى اَلنُّورِ.
إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. و معنى هذه الهداية هو إراءة الطريق و بيان ما به السعادة و الشقاوة، هذه - أي هداية الناس بهذا المعنى - فلتكن مفروغاً عنها، كما أنّه لا شك في عدم هدايته الناس بمعنى إيصالهم إلى المطلوب، و لذا قال: وَ لَوْ شٰاءَ لَهَدٰاكُمْ أَجْمَعِينَ، و قال: وَ لَوْ شِئْنٰا لَآتَيْنٰا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰاهٰا، فإنّ الهداية الحاصلة بالمشيئة الإلجائية غير مطلوبة لله تعالى، فلذا لم يردها، فافهم.
فالهداية بمرتبة منها متحققة ضرورة، و بمرتبة منها غير واقعة قطعاً، و بين هاتين المرتبتين مراتب عديدة أخرى نسمّيها بالألطاف الخاصة، و عدمها بالتخلية، أي تخلية الله سبحانه العبد مع نفسه.
و الدليل على ثبوت هذه المراتب: آيات من القرآن المجيد، فمنها قوله تعالى: إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنٰاهُمْ هُدىً، و منها قوله: وَ اَلَّذِينَ اِهْتَدَوْا زٰادَهُمْ هُدىً وَ آتٰاهُمْ تَقْوٰاهُمْ، و منها قوله: وَ يَزِيدُ اَللّٰهُ اَلَّذِينَ اِهْتَدَوْا هُدىً، و منها قوله: وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ
ص: 226
قَلْبَهُ، و منها قوله: اِهْدِنَا اَلصِّرٰاطَ اَلْمُسْتَقِيمَ، و منها قوله: يُثَبِّتُ اَللّٰهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ اَلثّٰابِتِ فِي اَلْحَيٰاةِ اَلدُّنْيٰا وَ فِي اَلْآخِرَةِ وَ يُضِلُّ اَللّٰهُ اَلظّٰالِمِينَ، و منها قوله: وَ اَلَّذِينَ جٰاهَدُوا فِينٰا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنٰا وَ إِنَّ اَللّٰهَ لَمَعَ اَلْمُحْسِنِينَ. إلى غير ذلك من الآيات.
هذه المراتب كلها مختصة بالمؤمنين، و لا حظّ منها لغيرهم، كما يظهر من هذه الآيات و غيرها، مثل قوله: وَ اَللّٰهُ لاٰ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْفٰاسِقِينَ و قوله: وَ اَللّٰهُ لاٰ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظّٰالِمِينَ، و قوله: وَ اَللّٰهُ لاٰ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْكٰافِرِينَ.
و هذه الهداية هي الرحمة الرحيمية التي تقدم اختصاصها بالمؤمنين في الجزء الأول، و كلّ ما قرب العبد من ربّه كان نصيبه أوفر منها.
فتحصّل: أنّ الهداية هي الألطاف المذكورة، و تركها و تخلية العبد و عمله هو الإضلال، و أنت إذا أحطت بما ذكرنا خبراً تعلم أنّ جملةً كثيرةً من الآيات المتضمنة لنسبة الإضلال إليه تعالى ظاهرة في هذا المعنى، و لا محذور فيه أصلاً، فإنّ العبد بعد ما تمرّد عن امتثال أوامر الله و نواهيه، و صار في مقام العصيان لا يستحق مزيد العناية بألطاف مانعة (منعاً غير تام) عن الضلالة و الشقاوة، فيخلّي الله بينه و بين ما يريد فيضلّه.
و الظاهر أن إضلاله تعالى - في معظم تلك الآيات الكريمة - بهذا المعنى، كما يتضح لمن لاحظها و تدبّر فيها، و إليك ذكر بعضها، كقوله تعالى: مَنْ يُضْلِلِ اَللّٰهُ فَلاٰ هٰادِيَ لَهُ * وَ يَذَرُهُمْ فِي طُغْيٰانِهِمْ يَعْمَهُونَ. و ذيل الآية و هو قوله: وَ يَذَرُهُمْ... أقوى شاهد على مرادنا، و كقوله: وَ يَقُولُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ، قُلْ إِنَّ اَللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشٰاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنٰابَ فيكون الذي أضلّه الله غير من أناب إليه.
ثم إنّ الإضلال ربّما جاء بمعنى الإهلاك، و عليه حمل قوله تعالى: فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمٰالَهُمْ،
ص: 227
و عليه حمل المحقق الطوسي (قدس سره) جميع الآيات الدالة على نسبة الإضلال إليه تعالى في التجريد و العلامة في شرحه صريحاً.
و ربّما استعمل بمعنى العذاب، و عليه حمل قوله تعالى: إِنَّ اَلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلاٰلٍ وَ سُعُرٍ * يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي اَلنّٰارِ... إلى آخره.
و في رسالة الإمام الهادي (ع)(1) في قوله تعالى يُضِلُّ مَنْ يَشٰاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشٰاءُ...: فإخبار عن قدرته، أي أنّه قادر على هداية من يشاء و ضلال من يشاء... إلى آخره.
أقول: و هذا أيضاً وجه وجيه يمكن أن يفسّر به بعض الآيات إذا ناسبه السياق، و بعد ذلك كلّه لا أظنّ بك - إن كنت من أهل الدراية و التفكّر - أن تبقى متردّداً في مفهوم الآيات الدالة على نسبة الهداية و الضلالة إلى الله تعالى، فافهم و استقم و لا تكن من الجاهلين، هذا مختصر القول في جملةٍ من الآيات القرآنية.
قد يتوهّم أنّ تعلّق قدر الله و قضائه بجميع الأشياء التي منها أفعال العباد الاختيارية يبطل تمكنهم، و يوجب اضطرارهم إلى ما يفعلون، و هو و هم فاسد، فإنّا حققنا لك معن القدر و القضاء في الجزء الأول، و ذكرنا: أنّ المراد بالأول هو ذكر تحديد الأشياء بجميع حدودها و أطرافها في اللوح المحفوظ، و بالثاني: هو ذكر حكمها الفصل النافذ المستتبع للإيجاد - و لو من غير جهة الدعاء و الصدقة في الجملة - تكوينياً كان - أي الحكم المذكور - أم تشريعياً، قال الله تعالى: إِذٰا قَضىٰ أَمْراً فَإِنَّمٰا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.
و على ضوء ذلك فنقول: إنّ الأفعال العباد الاختيارية جهتين: جهة صدورها عن فاعليها، و هي جهة تكوينية. و جهة لحاظها إلى الأحكام الشرعية، و هي جهة اعتبارية تشريعية، فمن جهتها الأولى ذكر في اللوح مثلاً: أنّ فلاناً يفعل باختياره و إرادته عملاً كذا، ساعة كذا، بكم و كيف كذا باختياره، و لا بد من أنّه يفعل كذلك. و من جهتها الثانية ذكر فيه: أنّه حرام، و له كذا مقدار من العقاب، أو واجب، و له كذا مقدار من الثواب، أو مباح أو مندوب أو مكروه، فأين
ص: 228
استلزام تعلقهما بالأفعال، الجبر و الاضطرار؟
و على الجملة: حال القدر و القضاء حال علمه تعالى بالأشياء، فكما أنّ تعلّقه بها لا تأثير له فيها، بل هو تابع للواقع على ما مرّ، فكذا تعلقهما غير مؤثر بطريق أولى، كما لا يخفى.
قال الرضا (ع) كما في آخر رواية العيون(1): «نعم، ما من فعل يفعله العباد من خير و شرّ إلاّ و لله فيه قضاء»، قلت: فما معنى هذا القضاء؟ قال: «الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب و العقاب في الدنيا و الآخرة».
أقول: هذا ناظر إلى الجهة الثانية المذكورة.
و قال الإمام الصادق (ع) كما في آخر رواية زرارة(2): «كذلك الشرّ من أنفسكم، و إن جرى به قدره تعالى».
أقول: هذا ناظر إلى الجهة الأولى.
و في رواية ابن أذينة، عنه (ع) قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في القضاء و القدر؟ قال: «أقول: إنّ الله إذا جمع العباد يوم القيامة سألهم عمّا عهد إليهم، و لم يسألهم عمّا قضى عليهم»(3).
أقول: أي قضاءً متعلقاً بالأمور غير الاختيارية، كالمرض و الفقر و نحوهما.
و في الطرائف(4): روي أنّ الحجّاج بن يوسف كتب إلى الحسن البصري و إلى عمرو بن عبيد، و إلى واصل بن عطاء، و إلى عامر الشعبي أن يذكروا ما عندهم و ما وصل إليهم في القضاء و القدر، فكتب إليه الحسن البصري: أنّ أحسن ما انتهى إليّ ما سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) أنّه قال: «أتظنّ أنّ الذي نهاك دهاك(5)؟ و إنّما دهاك أسفلك و أعلاك! و الله بريء من ذاك».
و كتب إليه عمرو بن عبيد: أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع): «لو كان الزور (الوزر) في الأصل محتوماً كان المزور في القصاص مظلوماً.
و كتب إليه واصل بن عطاء: أحسن ما سمعت في القضاء و القدر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع): «أيدلّك على الطريريال و يأخذ عليك المضيق؟
و في رواية: «من وسّع عليك الطريق لم يأخذ عليك المضيق».
ص: 229
و كتب إليه الشعبي: أحسن ما سمعت في القضاء و القدر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع): «كلّ ما استغفرت الله منه فهو منك، و كلّ ما حمدت الله فهو منه».
فلمّا وصلت كتبهم إلى الحجاج و وقف عليها قال: أخذوها من عين صافية.
أقول: هذه الكلمات الشريفة كلّها ناظرة إلى أنّ القدر و القضاء لا ينافيان الاختيار، كما أوضحناه لك. و هنا رواية أخرى مشهورة دالة أيضاً على أنّهما لا ينافيان الاختيار، نقلت عن أمير المؤمنين (ع) في جواب رجل سأله عن مسيره إلى صفّين أنه بقضاء من الله و قدره، أم لا؟ تركناها لاشتهارها، فلاحظ.
تذييل حول الرضا بالقضاء:
قال العلامة الحلّي(1) قدّس الله نفسه الزكية: اتفقت الإمامية و المعتزلة و غيرهم من الأشاعرة و جميع طوائف الإسلام على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى و قدره، ثم إنّ الأشاعرة قالوا قولاً لزمهم خرق الإجماع و النصوص الدالة على وجوب الرضا بالقضاء، و هو: أنّ الله تعالى يفعل القبائح بأسرها، و لا مؤثر في الوجود غير الله تعالى... فتكون القبائح من قضاء الله تعالى على العبد و قدره، و الرضا بالقبيح حرام بالإجماع، فيجب أن لا يرضى بالقبيح، و لو كان من قضاء الله تعالى لزم إبطال إحدى المقدمتين، و هي: إمّا عدم وجوب الرضا بقضائه تعالى و قدره، أو وجوب الرضا بالقبيح، و كلاهما خلاف الإجماع.
أمّا على قول الإمامية من أنّ الله منزّه عن الفعل القبيح و الفواحش، و أنّه لا يفعل إلا ما هو حكمة و عدل و صواب، و لا شك في وجوب الرضا بهذه الأشياء لا جرم كان الرضا بقضائه و قدره على قواعد الإمامية و المعتزلة واجباً، و لا يلزم منه خرق الإجماع في ترك الرضا بقضاء الله، و لا في الرضا بالقبائح. انتهى كلامه رفع مقامه.
قلت: موت الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) و حلول المصاعب و البلايا بهم أيضاً ممّا تعلق به القضاء، مع أنّ الرضا به غير حسن؛ لأنّه مستلزم لانقطاع الخيرات و انفتاح السيئات، بل ربّما يكون فسقاً أو كفراً، و كذا الشرور النازلة بالإنسان من الأمراض و الفقر و موت الأحبّة و نحوها أيضاً من أفعاله تعالى و مقضيّ بها، مع أنّ الإنسان بطبعه متنفّر منها و لا يرضى بها أصلا، فكيف يعقل إيجاب الرضا بها عليه؟! بل ورد فيه الشرع أيضاً الأمر بإزالتها بالتداوي و الكسب و الدعاء و نحوها، فالإشكال لا يختصّ بالمجبّرة، بل يعمّ غيرها أيضاً. نعم، وروده عليهم أقوى.
و بالجملة: لا بد للجمع بين الرضا بالقضاء و هذه الأمور من حيلة يدفع بها التنافي،
ص: 230
و للباحثين فيه مسالك:
1 - أنّ الكفر مقتضّي، لاقضاء؛ لأنّه متعلق القضاء فلا يكون نفس القضاء، فنحن نرضى بالقضاء لا بالمقضيّ، نقله في الأسفار(1) عن الغزالي و غيره كالإمام الرازي،
و قال: و استصوبه جماعة من الصوفية، كصاحب العوارف المولى الرومي، ثم قال: و زيّف هذا الجواب جماعة من البارعين في العلم، منهم المحقق الطوسي في نقد المحصّل، حيث قال: و جوابه بأنّ الكفر ليس نفس القضاء، و إنّما هو المقضيّ ليس بشيء، فإنّ قول القائل: رضيت بقضاء الله، لا يعني به رضاه بصفة من صفات الله، إنّما يريد به رضاه بما يقتضي تلك الصفة، و هو المقضى. انتهى كلامه.
و قال العضدي و الجرجاني(2): قلنا: الواجب هو الرضا بالقضاء، لا بالمقضي، و الكفر، مقضي لاقضاء، و الحاصل: أنّ الإنكار المتوجه نحو الكفر إنّما هو بالنظر إلى المحلّية، لا إلى الفاعلية، يعني أنّ للكفر نسبةً إلى الله تعالى باعتباره فاعليته له و إيجاده اياه، و نسبة أخرى إلى العبد باعتبار محلّيته له و اتصافه به، و إنكاره باعتبار النسبة الثانية، و الفرق بينهما ظاهر؛ لأنّه ليس يلزم من وجوب الرضا بشيء باعتبار صدوره عن فاعله وجوب الرضا به باعتبار وقوعه صفة لشيء آخر؛ إذ لو صحّ ذلك لوجب الرضا بموت الأنبيا (ع)، و هو باطل إجماعاً، هذا كلامهما.
و لكنّه لا يرجع إلى معني صحيح، فإنّ القضاء تعلق بوصول الكفر - مثلاً - من الله تعالى إلى العبد، و كون العبد محلّاً له، كما هو قضية عموم تعلقه، و عليه فيعود الإشكال على أنّ السر في لزوم رضا العبد بقضائه تعالى أو حسنه هو تسليم العبد لله تعالى في أفعاله و عدم الاعتراض عليه، و اعتقاد أنّ ما يصل إليه من ربه أصله له، و كل ذلك ناظر إلى جهة المحلّية أيضاً، دون الفاعلية فقط، و هذا هو المستفاد من الأدلة أيضاً، و لعلّ هذا هو مراد المحقق الطوسي في كلامه المتقدم.
ثم إنّ صاحب الأسفار رام إصلاح القول المذكور، و كون الرضا بالقضاء لا يستلزم الرضا بالمقتضي - و هو الكفر - و لم يرتض ما أفاده المحقق الطوسي (قدس سره)، و حيث إنّ ما ذكره غير صحيح - كما يظهر للمتطّلع على أصولنا - تركنا نقله و نقده لئلّا يطول المقام بلا طائل، و الله الهادي.
2 - ما عن شرح الكشّاف من أنّ الرضا بالكفر إنّما يكون كفراً إذا كان مع الاستحسان له، و عدم الاستقباح، بخلاف الرضا به مع استقباحه قصداً إلى زيادة عذابه، كما قال الله تعالى:
ص: 231
رَبَّنَا اِطْمِسْ عَلىٰ أَمْوٰالِهِمْ وَ اُشْدُدْ عَلىٰ قُلُوبِهِمْ فَلاٰ يُؤْمِنُوا حَتّٰى يَرَوُا اَلْعَذٰابَ اَلْأَلِيمَ.
أقول: ظاهره أنّ الرضا بالكفر من جهة زيادة عقاب الكافر، و هذا أجنبي عن المقام المبحوث فيه عن تعلق الرضا بالكفر، من حيث إنّه تعلق به القضاء، لا من حيثية أخرى، فالإشكال باقٍ على حاله.
3 - ما ذكره الحكيم الشيرازي في رسالة «القضاء و القدر»(1) بعد إنكاره الجواب الأول، قال: بل الحقّ في الجواب أن يفرّق بين القضاء بالذات و بالعرض، و المأمور به هو الرضا بما يوجبه القضاء بالذات، هو الخيرات كلّها و المنهيّ عنه هو الرضا بما يلزم من القضاء على سبيل العرض، و هي الشرور اللازمة للخيرات الكثيرة، و هذه أيضاً إذا لم تعتبر من هذه الحيثية، بل قصد إليها بالذات و بالقياس إلى هذا الشخص الجزئي الموصوف به.
و أمّا إذا اعتبر كونها متضمّنه للمصالح و الحكم الكلّية بالقياس إلى النظام الكلّي فلا شرّ أصلاً؛ لأنّ هذا الترتيب من لوازم الوجود و الإيجاد... إلى آخره. و قد سبقه إلى هذا الجواب أستاذه السيّد المحقق الداماد، كما نقل كلامه في أسفاره، قال...: بل إنّما تعلق به - أي بالكفر - القضاء بالعرض، فكان مقضيّاً من حيث هو لازم للخيرات الكثيرة، لا من حيث هو كفر، فإذن إنّما يجب الرضا به من تلك الحيثية لا من حيث هو كفر، و إنّما الكفر الرضا بالكفر بما هو كفر، لا بما هو لازم خيرات كثيرة لنظام الوجود. انتهى.
و لعلّ هذا قول جمهور الفلاسفة، لكنّه غير تام أيضاً، أمّا في المصائب فلأجل صحة تعلق الرضا بها من حيث صدورها من الله تعالى من دون اعتبارها لازمة للخيرات الكثيرة. و أمّا في المعاصي فلأنّ القول المذكور مبنيّ على أنّها من فعل الله تعالى. و أمّا بناءً على أنّها من قبل العبد - و لو بنحو مرّ تحقيقه - فهي ليست متعلقة لقضائه تعالى حتى يتكلف بما ذكروه، بل المقضيّ - بمعنى المفاض و الصادر عن الله تعالى - هو التمكين من الكفر، و الرضا به لا محذور فيه بلا حاجة إلى هذه التكلّفات، و أمّا القضاء بمعنى الكتابة فهو متعلق بأفعاله تعالى و أفعالنا جميعاً، و الرضا به غير معارض بشيء أصلاً، فإنّ حال الكتابة حال علمه تعالى بلا فرق.
و مع الغضّ عن الجميع نقول: إنّا كلّما نتأمّل أنّ الكفر المبغوض المستلزم للخلود المنشأ لجميع المعاصي و الخبائث كيف يكون لازماً للخيرات الكثيرة؟ و ما هي تلك الخيرات؟ و ما هي صلة الكفر بها؟ و كيف لا ينفكّ عنها حتى وقع مورد القضاء بالعرض؟ لا نجد تقريباً معقولاً له، بل يزيد اعتقادنا بخرافته، مع أنّا ذكرنا في مباحث معالجة إسناد الشرور في الجزء الأول بطلان هذا
ص: 232
اللزوم كلّياً، فلاحظ.
4 - ما يخطر بالبال من أنّ الرضا يتعلق بالشيء بوصف كونه مقضياً، و من حيث إنّه متعلقٍ للقضاء، و أمّا بلحاظ نفسه فقط فلا ملزم للرضا به، بل قد يكون مرضياً، و قد يكون مبغوضاً و منفوراً إمّا طبعاً و إمّا شرعاً و إمّا طبعاً و شرعاً.
توضيح ذلك: أنّ ما يقال له الشر قسمان:
الأول: ما يوجب سخط الربّ من الكفر و الفسق.
الثاني: ما ينافي طبائعنا و إن كان ذا مصلحة واقعاً.
أمّا القسم الأول فهو ليس من أفعال الله تعالى، بل من سوء اختيار المكلفين و أفعالهم على تفصيل دريته. نعم، إنّ الله تعالى مكّن العبد و أعطاه القدرة و الاختيار ليكفر أو يؤمن، و هذا هو المقتضي، و لا مانع من لزوم الرضا بمثله أصلاً.
و بعبارة واضحة: أنّ الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ: أنّ زيداً يكفر باختياره و إرادته و بقوتي و تمكينى إياه من ذلك، ثم نقول: نحن نرضى بهذه الكتابة و بتمكين الله تعالى المكلف من الكفر و الفسق و الإيمان و الطاعة، و وجه هذا التمكين أيضاً واضح؛ إذ لو لاه لبطل التكليف و التشريع، فإنّ الاضطرار مانع عن الأمر و النهي بالضرورة، و نقبّح ترجيح المأمور الكفر و الفسق، فالمعصية من جهة تمكين العاصي عنها مرضية، و من جهة وجودها بإرادته مستنكرة.
ثم إنّ من الظاهر عدم جريان هذا الوجوب على مسلك الأشعري و من ينجرّ قوله إلى الجبر، فإنّ الكفر صادر بإرادة الله تعالى وحده، و لا تأثير لغيرها، فالمجبّرة في داء عياء لا ينجع فيه دواء أبداً، فافهمه جيداً.
و أما القسم الثاني فأمره ظاهر؛ لأنّ المصائب و البلايا بما أنها مقضية و واصلة من الله تعالى إلى العبد مرضية لا محالة، و بما أنها مصيبة و بلية منفورة، و من هذا القبيل وفاة الأنبياء (عليهم السلام) فإنّها من حيث كونها مقضية مرضية، و من حيث إنّها موجبة لقطع الخيرات منفورة، و قطع الخير المذكور مرضي من حيث إنه مقضي، و منفور من حيث إنّه نقص لنا، و هكذا، و من هنا ظهر أنّ الدعاء و المعالجة و الحيلة لا تنافي الرضا بالقضاء، كما لا يخفى، و قول المحقق الطوسي المحكي في الأسفار: «إنّ الرضا بالكفر من حيث هو قضاء الله طاعة، و لا من هذه الحيثية كفر. إن رجع إلى ما ذكرنا فهو، و إلا فليس بصحيح.
تتمة:
قد ثبت أنّ الرضا المتعلق بكل شيء لا ينافي لزوم استنكار العصيان و حسن التأثر من موت الصلحاء و المؤمنين و تنفر البلايا طبعاً. و الآن نقول: لا شكّ في فضل هذا الرضا و حسنه،
ص: 233
و لكنّه هل هو واجب على المكلفين، أو لا؟ و الدليل على وجوبه أمور:
1 - اجماع العدلية بل جميع المسلمين - كما تقدم عن العلامة (قدس سره)، بل يظهر من جملة الكلمات - أنّ الوجوب المزبور من المسلّمات الواضحة، لكن كونه إجماعاً تعبّدياً غير ثابت؛ لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه الآتية، مع أنّه قد تقدم في أوائل الجزء الأول ما في حجّية الإجماع المحصّل فضلاً عن مثل هذا الإجماع المنقول.
2 - إنّ الرضا المذكور من لوازم الإيمان، و كيف يكون الشخص مؤمناً بالله تعالى و لا يرضى بحكمه و فعله و قضائه، و لا سيما على رأي أهل الحق من تبعية أفعاله للمصالح و المفاسد؟!
أقول: هذا بيان متين، لكنّه لا يثبت الوجوب؛ لعدم الدليل على وجوب الرضا بكل ما هو من لوازم الإيمان و أوصاف المؤمن الكامل.
3 - الحديث القدسي(1)، قال الله تعالى: «من لم يرض بضائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ رباً سوائي».
أقول: ضعف سنده يمنع عن الكلام في دلالته على المراد.
4 - الروايات الواردة من أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، و هي كثيرة جداً، و قد عقد لها ثقة الإسلام الكليني (رحمه الله) في الكافي(2) باباً، و المحدث الجليل الحرّ العاملي (رحمه الله) في الوسائل(3)، و لا يمكن نقلها و النظر في دلالتها تفصيلاً، فإنّه يطول بنا المقام.
و مجمل الكلام: أنّها - مع تواترها معنى - لا تدلّ على مرامهم؛ لوجهين:
الأول: أنّها أخصّ من المدّعى المذكور؛ لاختصاص دلالتها على ترغيب الناس في الرضا بقضاء الله المتعلّق بهم، و المقضي عليهم ليرضوا بما قضى الله فيهم، و لا دلالة لها على لزوم الرضا بمطلق قضاء الله و إن لم يرتبط به بوجه.
الثاني: عدم دلالتها على الوجوب الشرعي، كما يشهد له ما فيها من القرائن.
و بالجلمة: حاله حال الصبر و نحوه من الصفات النفسانية الأخلاقية الموجبة لتكميل المؤمن و رقيّ درجته و علوّ شأنه(4) في أنّها فضيلة و كمال، و يرجّح تحصيلها شرعاً و عقلاً، لكنّها
ص: 234
غير واجب وجوباً شرعياً، فارجع و لا حظ، و نحن نتبرّك بنقل روايتين منها:
1 - رواية أبي حمزة الثمالي(1)، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: «العبد بين ثلاث: بلاء و قضاء و نعمة فعلية للبلاء من الله الصبر فريضة، و عليه للقضاء من الله التسليم فريضة، و عليه للنعمة من الله الشكر فريضة».
أقول: إن سلّمنا أنّ التسليم هو الرضا، و أنّ عدم وجوب الصبر لا يمنع عن الأخذ بظاهر الرواية لطرحنا الرواية بضعف سندها، فإنّ عمر بن مصعب (و في الرجال عمرو بن مصعب) الواقع في سندها مهمل، و عبد الرحمن بن حماد (بناءً على نسخة الوسائل و المطبوعة حديثاً)
مجهول، و أمّا بناءً على نسختها المطبوعة قديماً من كون حماد مروياً لعبد الرحمن لا أباه فهو مشترك بين الثقة و غيره.
2 - رواية الحسين بن خالد، عن الرضا (ع)، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب (ع) قال: «سمعت رسول الله (ص) يقول: قال الله جلّ جلاله: من لم يرض بقضائي و لم يؤمن بقدري فليلتمس إلهاً غيري، و قال رسول الله (ص): في كلّ قضاء الله خيرة للمؤمن.
أقول: إنّ صحّ استفادة الحكم المولوي و عدم استظهار الحكم الإرشادي منها فلا نقبله؛ لضعف سندها.
و خلاصة الكلام: إن أريد بالرضا بقضاء الله هو عدم إنكار حكم الله تعالى، و عدم ما يوجب سخطه فلا شك في وجوبه و لزومه، بل ربّما يوجب ارتداد الرادّ المنكر. و إن أريد به ظاهره فلا دليل عليه على التحقيق.
ثم إنّ الظاهر من جماعة من الفقهاء في مسألة جواز البكاء على الميت هو لزوم الرضا بقضاء الله أيضاً، كما يظهر من عبارة السيد اليزدي (رحمه الله) في «العروة الوثقى» و من علّق عليها من الأعلام الأماجد، ولكن يمكن أن يكون مرادهم ما ذكرنا من إظهار ما يوجب سخط الربّ، أو حسبان وقوع حكمه تعالى في غير مورده (العياذ الله)، و الشاهد عليه: أنا سألنا بعض الأعاظم(2) ممّن علّقوا على الكتاب المذكور عن دليلهم على هذا الوجوب المذكور في كلام الماتن، فقال: المراد وجوب الاجتناب ممّا يسخط الربّ، لا الرضا بالقضاء، فافهم جيداً.
ص: 235
قد ثبت ممّا تقدم - ثبوتاً قطعياً و ضرورياً - أنّ الإنسان مختار في أفعاله و تروكه, فله أن يفعل كلّ ما يشاء, و له أن يترك كل ما لم يشاء, لكّن هنا شيئاً آخر لا يمكن إنكاره, و هو اختلاف أفراد الإنسان في ميولهم و طلباتهم.
فيميل بعضهم إلى الخير من بدو أمره و بداءة عمره - و إن تمكّن من الانصراف عنه إلى الشرّ - و يتّعظ بوعظ و جيز, و يتأثر بوعيد قليل, و يهوى بعضهم الشرّ و الفساد من أول رشده و عنفوان شبابه (مع القدرة على فعل الخير و ترك الشرّ), و لا ينفعل - في الأغلب - بنصح ناصح, و لا من عتاب لائم, و لا من تخويف عقاب أصلاً.
و ربما يتفق أنّ مثل هذين الشخصين من أب و أمّ واحد, تربَّيا عند معلم واحد, و عاشا في محيط واحد, و الاختلاف بينهما موجود متحقق, فيتجه السؤال إلى لُمّية هذا الاختلاف؟ و هذا مقام دقيق و موقف عميق, اضطرابت فيه الأنظار, و تبلّدت فيه الأفكار, و زلّت فيه الأقدام إلّا من عصمه الله بلطفه.
و إليك ما فزت عليه من الأقوال لحلّ هذا الاعتضال, و عليك بالتدبّر و التثبّت التام:
الأول: ما ذكره المحقق الهروي(1): قلت: العقاب إنّما يتبع الكفر و العصيان التابعين للاختيار الناشئ عن مقدماته الناشئة عن شقاوتهما الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما, فإنّ السعيد سعيد في بطن أمّه و الشقي شقي في بطن أمّه, و الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة, كما في الخبر. و الذاتي لا يعلّل, فانقطع سؤال: أنّه لِمَ جُعل السعيد سعيداً و الشقي شقياً؟ فإنّ السعيد سعيد في نفسه, و الشقي شقي كذلك, و إنّما أوجد هما الله. قلم اين جا رسيد سر بشكست. انتهى كلامه.
أقول: الاختيار لا يجامع ذاتية الشقاوة و السعادة, و عليه فاستتباع الكفر و العصيان للعقاب ممنوع, بل هي - أي ذاتية الشقاوة - تبطل حسن تكليف الشقي المضطرّ إلى ارتكاب الفعل, في حين أنّهما لا توجب انقطاع السؤال أيضاً, فإنّ الجعل التركيبي و إن لم يتعقل في الذاتيات إلّا أنّ الجعل البسيط غير ضروري.
فنقول: لِمَ خلق الله الشقي مع أنّ شقاوته الموجبة لدخوله النار ذاتية, و من البديهي قبح مثل هذا الإيجاد, و معه لا يُصغى إلى ما قيل في حسن خلقته فإنّه يناسب حال القصّاصين, و قد مرّ
ص: 236
بعض الكلام فيه في المباحث السابقة.
ثم إنّ ذاتية الشقاوة و السعادة أمر خيالي بحت لا واقع له أصلاً؛ إذ إن أريد بالذاتي ذاتي في باب الكلّيات ففساده أوضح من أن يخفى على عاقل, ضرورة أنّهما ليستا بجنس الإنسان, و لا بفصل له, مع أنّه يستلزم اختلاف السعيد و الشقي في الماهية و الحقيقة, كاختلاف الإنسان و البقر, و اختلاف الحيوان و النبات, و هو كما ترى.
و أن أريد به الذاتي في باب البرهان كإمكان الماهيات و زوجية الأربعة و نحوهما فيزيَّف بلزوم تساوي تمام الأفراد في السعادة أو الشقاوة, فإنّ حكم الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز واحد قطعاً, مع أنّ الواقع خلافه, فمنهم سعيد و منهم شقي, على أنّه يوجب استحالة سلب السعادة عن السعيد و الشقاوة عن الشقي, و الحال أنّ المحسوس خلافه, إذ الشقي العنود قد يصبح سعيداً رشيداً, و السعيد الصالح شقياً ضالّاً, و هذا الانقلاب يبطل ذاتية السعادة و الشقاوة بجميع معانيها, كما لا يخفى.
و على الجملة: تأثير التربية و توقّع الإصلاح و الإفساد و حسن التكليف و الجزاء عند العقلاء أدلة محكمة على أن الشقاوة و السعادة غير لازمبين للإنسان, فما ذكره هذا القائل بتمامه مختلّ الأساس و لا طائل تحته.
ثم نرجع و نُضيف: أنّا لا نعقل للسعادة و الشقاوة معنى غير ما يتحصل من الأفعال الصالحة و السيئة و يستنتج منها, فهما معلولتان للأفعال دون العكس, و إلّا لدار. نعم, لا غروة في استناد بعض الأفعال إليهما بعد تحققهما ببعض أفعال أخر منها.
بحث روائي:
في رواية أبي بصير - كما عن التوحيد(1) - عن أبي عبدالله (ع) في قول الله عزّ و جلّ: قٰالُوا رَبَّنٰا غَلَبَتْ عَلَيْنٰا شِقْوَتُنٰا؟ قال: بأعمالهم شقوا.
أقول: هذا نصّ فيما قلنا آنفاً من ترتب السعادة و الشقاوة على الأفعال دون العكس, فتبطل به ذاتية الشقاوة و السعادة من رأس.
و في حسنة منصور بن حازم أو صحيحته(2), عن أبي عبدالله (ع) قال: إنّ الله خلق السعادة و الشقاوة قبل أن يخلق خلقه, فمن خلقة الله سعيداً لم يبغضه أبداً, و إن عمل شرّاً أبغض عمله و لم
ص: 237
يبغضه. و إن كان شقياً لم يحبه أبداً, و إن عمل صالحاً أحب عمله و أبغضه لِما يصير إليه, فإذا أحبّ الله شياً لم يبغضه أبداً و إذا أبغض شيئاً لم يحبه أبداً.
أقول: لابد من حملها على غير ظاهرها على كلّ حال, و الأولى ردّ علمها إلى قائلها.
و في صحيحة معاوية بن وهب(1) قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: «إنّ ممّا أوحى الله ألى موسى (ع) و أنزل عليه في التوراة: إنّي أنا الله لا إله إلّا أنا خلقت الخلق, و خلقت الخير و أجريته على يدي من أحب, فطوبى لمن أجريته على يديه, و أنا الله إله إلّا أنا خلقت خلق, و خلقت الشرّ و إجريته على يدي من أريده, فويل لمن أجريته على يديه». و مثلها غيرها.
أقول: المحبوب الذي يجري الخير على يديه هو العبد الصالح, و المراد من الذي يُجرى الشرّ على يدي هو العبد المتمرّد, كما يدلّ عليه ما وراه في قرب الإسناد(2), عن ابن عيسى, عن البزنطي قال: سمعت الرضا (ع) يقول: «جفّ القلم بحقيقة الكتاب من الله بالسعادة لمن آمن و اتقى, و الشقاوة من الله تبارك و تعالى لمن كذّب و عصى»
و لا منافاة بين نسبة إجراء الخير و الشرّ إليه تعالى و بين استنادهما إلى العبد نفسه, كما هو ظاهر لمن علم معنى الأمر بين الأمين, أو معنى الإجراء هو منح اللطف الخفي للمطيعين و منعه عن العاصين، و على كلا التقديرين لا إشكال في مدلول الرواية. ثم الظاهر أنّ قوله: «و أجريته على يدي من...» عطف تفسير لقوله: «خلقت الخير» و قوله: «خلقت الشر».
و في صحيحة الكناني(3)، عن الصادق (ع) قال: «قال رسول الله (ص): الشقي من شقي في بطن أمّه...» إلى آخره.
أقول: ظاهرها المنافاة مع المختار، لكنّ الأمر ليس كذلك، كما يدل عليه رواية ابن أبي عمير(4)، قال: سألت أباالحسن موسى بن جعفر (ع) عن معنى قول رسول الله (ص): «الشقي من شقي في بطن أمه، و السعيد من سعد في بطن أمه»؟ فقال: «الشقي من علم الله (علمه الله) و هو في بطن أمه أنّه سيعمل أعمال الأشقياء و السعيد من علم الله (علمه الله) و هو في بطن أمه أنّه سيعمل أعمال السعداء» قلت له: فما معنى قوله (ص): «اعملوا فكلّ ميسّر لما خلق له»، فقال: «إنّ الله عزّ و جلّ خلق الجنّ و الإنس ليعبدوه، و لم يخلقهم ليعصوه، و ذلك قوله عزّ و جلّ: وَ مٰا خَلَقْتُ
ص: 238
اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاّٰ لِيَعْبُدُونِ فيسّر كلاً لما خلق له، فالويل لمن استحبّ العمى على الهدى».
أقول: و هذه الرواية نعمت المفسّرة للرواية المتقدمة و ما شابهها في المضمون، مثل ما دل على أنّ الملكين يكتبان على من في رحم أمّه أنّه شقي أو سعيد، و انطلاقاً منه يظهر الحال في بقية الروايات، أو يسهل الكلام فيها، فلاحظ، و الله الهادي.
القول الثاني من الأقوال المذكورة في حلّ ذلك الاعتضال: ما ذكره الحكيم المحدّث الكاشاني في «الوافي»(1)، قال: السرّ في تفاوت النفوس في الخير و الشرّ و اختلافها في السعادة و الشقاوة هو اختلاف الاستعدادات و تنوّع الحقائق، فإن المواد السفلية بحسب الخلقة و الماهية متباينة في اللطافة و الكفافة، و أمزجتها مختلفة في القرب و البعد من الاعتدال الحقيقي، و الأرواح الإنسية التي بإزائها مختلفة بحسب الفطرة الأولى في الصفاء و الكدورة و القوة و الضعف، مترتبة في درجات القرب و البعد من الله تعالى؛ لما تقرّر و تحقّق أنّ بإزاء كل مادة ما يناسبها من الصور، فأجود الكمالات لأتمّ الاستعدادات، و أخسّها لأنقصها، كما أشير إليه بقوله (ع): «الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام».
فلا يمكن لشيء من المخلوقات أن يظهر في الوجود ذاتاً و صفةً و فعلاً إلا بقدر خصوصية قابلية و استعداده الذاتي. هذا كلامه.
و لعلّه إليه يرجع كلام المحقق الهروي في المجلد الثاني من «كفاية الأصول»، حيث قال: فإنّه - يعني التجرّي - و إن لم يكن باختياره إلاّ أنّه بسوء سريرته و خبث باطنه بحسب نقصانه و اقتضاء استعداده ذاتاً و إمكاناً، و إذا انتهى الأمر إليه يرتفع الإشكال و ينقطع السؤال ب - «لم»، فإنّ الذاتيات ضرورية الثبوت للذات، و بذلك أيضاً ينقطع السؤال عن أنّه: لم اختار العاصي و الكافر الكفر و العصيان، و المطيع المؤمن الإطاعة و الإيمان؟ فإنّه يساوق السؤال عن أنّ الحمار لم يكون ناهقاً و الإنسان لم يكون ناطقاً؟
و بالجملة: تفاوت أفراد الإنسان في القرب منه جلّ شأنه و عظمت كبريائه، و البعد عنه سبب لاختلافها في استحقاق الجنة و درجاته و النار و دركاتها، و موجب لتفاوتها في نيل الشفاعة و عدمها، و تفاوتها في ذلك بالأخرة يكون ذاتياً، و الذاتي لا يعلّل... إلى آخره.
و الظاهر أنّ ما ذكره اللاهيجي في «گوهر مراد»(2) أيضاً موافق لكلام الكاشاني، قال: اگر گويند: سبب چيست كه بيم عقاب در بعضى مردم سبب انزجار از قبيح شود، و در بعضى نشود
ص: 239
گوئيم: سببش اختلاف استعداد نفوس باشد كه ناشى از اختلاف استعداد امزجه كه معدّ فيضان نفوسند شود.
و بالأخره منتهى شود به قضاى الهى كه مقتضى اختلاف استعدادات است به جهت نظام خير، و شريتى كه از اين اختلاف لازم آيد، بغايت قليل باشد نظر به نظام كل، و بالعرض خير كثير بود. انتهى كلامه.
أقول: أمّا ما قرره الفيض في «لوافي» ففيه: أنّ الاستعدادات المختلفة المذكورة لا تكون عللاً تامة لصدور الأفعال من أفراد الإنسان، لأنّه الجبر الباطل بالأدلة المتقدمة، و لا سيّما بما ذكرناه في أول هذه المقالة، و منه يظهر فساد ما ذكره المحقق اللاهيجي و صاحب الكفاية أيضاً، كما لا يخفى.
نعم، ظاهر كلام اللاهيجي أنّ اختلاف الاستعدادات ليس ذاتياً غير مجعول كما هوظاهر «لوافي» و صريح «الكفاية»، بل هو بقضاء الله تعالى لأجل نظام الخير، و ستعرف أنّ الحق كون الاستعداد مقتضياً للميل الى العمل المناسب له لا سبباً تاماً، و أنّ الاستعداد المذكور مجعول لله تعالى، و ليس بذاتي.
القول الثالث: ما في «الوافي» أيضاً، قال عقيب كلامه الماضي: و وجه آخر(1)، و هو: أنّه قد ثبت أنّ الله عزّ و جلّ صفات و أسماء متقابلةً هي من أوصاف الكمال و نعوت الجلال، و لها مظاهر متباينه، بها يظهر أثر تلك الأسماء، فكلّ من الأسماء يوجب تعلق إرادته سبحانه و قدرته إلى إيجاد مخلوق يدل عليه من حيث اتصافه بتلك الصفة، فلذلك اقتضت رحمة الله جلّ و عزّ إيجاد المخلوقات كلّها لتكون مظاهر لأسمائه الحسنى و مجالي لصفاته العليا.
مثلاً لمّا كان قهاراً أوجد المظاهر القهرية لا يترتب عليها إلا أثر القهر من الجحيم و ساكنيه و الزقوم و متناوليه، و لمّا كان عفوّاً أوجد مجالي للعفو و الغفران، يظهر فيها آثار رحمته، و قس على هذا فالملائكة و من ضاهاهم من الأخبار و أهل الجنة مظاهر للّطف، و الشياطين و من والاهم من الأشرار و أهل النار مظاهر القهر، و منها تظهر السعادة و الشقاوة، فمنهم شقي و سعيد.
فظهر أن لا وجه لإسناد الظلم و القبائح إلى الله سبحانه؛ لأنّ هذا الترتيب و التمييز من وقوع فريق في طريق اللطف و آخر في طريق القهر من ضروريات الوجود و الإيحاد، و من مقتضيات الحكمة و العدالة، و من هما قال بعض العلماء: ليت شعري لم لا ينسب الظلم إلى الملك المجازي
ص: 240
حيث يجعل بعض من تحت تصرفة وزيراً قريباً و بعضهم كنّاساً بعيداً(1)؛ لأنّ كلاًّ منهما من ضروريات مملكته، و ينسب الظلم إلى الله تعالى في تخصيص كلّ من عبيده بما خصّص، مع أنّ كلاّ منهما ضروري في مقامه؟! انتهى كلامه.
أقول: صفاته تعالى على قسمين: صفات ذاتية أزلية، و صفات فعلية حادثة.
و الأولى عين ذاته، مصداقاً على ما مرّ بحثه مفصّلاً، و هي - على ما دريت في الجزء الأول - ليست إلا الوجود و العلم و القدرة، و أمّا غيرها فراجعة إليها لا محالة، فهي أصول أوصافه الكمالية. و من الظاهر جداً أنّ نسبتها متساوية إلى جميع الممكنات، فإنّ العلم شأنه الانكشاف، و القدرة شأنها صحة الفعل و الترك، و أما الوجود فحاله واضح.
و إن شئت فقل: إنّ قرب ممكنٍ إلى الواجب المجرد دون ممكن ترجّح بلا مرجّح، و هو محال بلا ريب.
و أما الثانية فهي ممكنة زائدة على ذاته كالإيجاد و الخلق و الرزق و الهداية و الرحمة و الإماتة و الإحسان و اللطف و الغضب و نظائرها. و من المعلوم أنّ الله تعالى لا يتصف و لا يسمّى بمشتقات هذه المبادئ قبل تحققها، فلا يقال: إنّه خالق رحيم لطيف هادٍ مضلّ قبل صدور الخلقة و الرحمة و اللطف و الهداية و الضلالة عنه تعالى التابعة لمناطاتها الواقعية.
و لا بد أن يكون هناك مؤمن ليلطف به و يهديه، و كافر ليضلّه، على ما مرّ تفصيله. نعم، الإيجاد غير موقوف على وجود الموجود، بل الامر بالعكس، و هو واضح.
فانقدح ممّا ذكرنا أنّ أسماءه تعالى لا تصلح لمبدئية الأشياء، و الأشياء لا تكون لوازم أسمائئه و صفاته، فإنّ صفاته الذاتية متساوية إلى جميع الممكنات، و لا يعقل اختصاصها بشيء دون شيء، و صفاته الفعلية غير متحققة أزلاً و قبل تحقق مبادئها الحادثة الموقوف على عللها و أسبابها، فليس أنّه: أحسن و هدى و لطف لكونه لطيفاً هادياً محسناً، و لا أنّه: غضب و قهر و أضلّ لكونه قهّاراً مضلّاً، بل إنّما صار لطيفاً هادياً و قاهراً و مضلّاً لأنّه هدى و أضلّ و قهر و لطف، فافهمه حتى تفهم أنّ الجواب المذكور منهدم الأساس، على أنّ العقاب و العتاب على المعاصي حينئذٍ يكون ظلماً بحتاً، فيخلّ بعدله و حكمته تعالى الله عنه، و ما ذكره من كون ذلك عدل و حكمة واضح الفساد، فلا يليق بالجواب، و أمّا ما نقله من المثال فهو أجنبي عن المقال، كما لا يخفى على أرباب الكمال، و الإنصاف أنّ هذا القول المنسوب إلى الصوفية باطل جداً لا معنى محصّل تحته أصلاً.
ص: 241
هذه الوجوه التي ذكرت في سرّ اختلاف الناس في ميولهم و أعمالهم غير صحيحة في نفسها، فلا يمكن الاعتماد عليها، بل المعتمد عليه في سرّه هو اختلاف طينة الناس حسب ما اقتضته الحكمة البالغة الإلهية، و حيث إنّ المسألة من المعضلات، و لم يعطها الباحثون حقّها نظراً و تحليلاً و لعلّ بعض ما تقدّم في الأقوال يرجع إلى هذا البحث إلى حدما، فينبغي أن نرخي عنان القلم لتحقيقها و تنقيحها بما لا ينافي وضع هذا الكتاب في ضمن فصول:
فاعلم أنّ جملةً من الروايات تنطق: أنّ الأئمة و شيعتهم خلقوا من طينة علّيّين(1)، و أعداءهم من سجّين(2). و جملة منها تنطق: أنّ الأولين من أرض طيبة و ماء عذب أو من الماء العذب فقط، و الآخرين من أرض خبيثة و سبخة و ماء ملح أجاج أو من الماء المذكور فقط(3)، أو من طينة خبال وحماً مسنون(4).
و جملة منها: أنّ طينة الأولين من الجنة(5) و في عين في الفردوس(6)، و طينة الآخرين من النار(7).
و لا منافاة بين هذه الروايات؛ لأنّ ملاحظة مجموعها تعطي أنّ علّيين و الأرض الطيبة هما الجنة، فتكون خلقة الأولين من تراب الجنة و ماء العين العذب. و إنّ سجين و الأرض الخبيثة هما جهنم، فتكون خلقة الآخرين من تراب جهنم و الماء المالح الأجاج.
و أمّا الفرق بين الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) و بين شيعتهم فهو: أنّهم خلقوا من صفوة تلك الطينة و أعلاها، و قد صرّح في بعض الروايات: أنّهم خلقوا من أعلى علّيين، و خلق متابعوهم من أسفلها، و لا أقلّ قلوب الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) خلقت من أعلى علّيين، و إن خلقت أبدانهم من دونه، كما في جملة من الروايات المشار إليها.
ص: 242
و فرق ثانٍ بينهما، و هو: أنّ طينة الأنبياء و الأئمة (ع) لم تخلط بشيء، بخلاف طينة شيعتهم فإنّها خلطت بطينة أعدائهم، فليست هي بخالصة، كما في الروايات أيضاً.
و أمّا الفرق بين أكابر الأشقياء و أتباعهم فبأخذ طينة الأولين من أعلى سجين، و أخذ طينة أتباعهم من أسفله.
و إليك بعض الروايات تبرّكاً و تيمّناً:
فمنها: رواية أبي بصير(1)، عن الباقر (ع) قال: «إنّا و شيعتنا خلقنا من طينة علّيين، و خلق عدونا من طينة خبال من حمأٍ مسنون».
قيل: الخبال أصله الفساد و الهلاك، و الحمأ: الطين الأسود المنتن، و المسنون: المنتن.
و منها: صحيحة ربعي بن عبد الله، عمّن ذكره، عن السجاد (ع) قال: «إنّ الله عزّ و جلّ خلق النبيّين من طينة علّيين قلوبهم و أبدانهم، و خلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة(2)، و خلق أبدانهم من دون ذلك، و خلق الكافرين من طينة سجيل (سجين) قلوبهم و أبدانهم، فخلط بين الطينتين؛ فمن هذا يلد المؤمن الكافر، و يلد الكافر المؤمن، و من هاهنا يصيب المؤمن السيّئة، و يصيب الكافر الحسنة، فقلوب المؤمنين تحنّ إلى ما خلقوا منه، و قلوب الكافرين تحنّ إلى ما خلقوا منه».
هذا تقرير مسألة الطينة و تفسيرها بلحاظ دلالة السنّة، و القرآن أيضاً يؤيدها و يشعر بها في الجملة، كقوله: وَ اَللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرٰابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ...، وَ مٰا يَسْتَوِي اَلْبَحْرٰانِ هٰذٰا عَذْبٌ فُرٰاتٌ سٰائِغٌ شَرٰابُهُ وَ هٰذٰا مِلْحٌ أُجٰاجٌ (3)... إلى آخره. و قوله تعالى: هُوَ اَلَّذِي مَرَجَ اَلْبَحْرَيْنِ هٰذٰا عَذْبٌ فُرٰاتٌ وَ هٰذٰا مِلْحٌ أُجٰاجٌ وَ جَعَلَ بَيْنَهُمٰا بَرْزَخاً وَ حِجْراً مَحْجُوراً * وَ هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ مِنَ اَلْمٰاءِ بَشَراً(4)... إلى آخره. و قوله تعالى: هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهٰاتِكُمْ (5)، و قوله تعالى: كَلاّٰ إِنَّ كِتٰابَ اَلْأَبْرٰارِ لَفِي عِلِّيِّينَ * وَ مٰا أَدْرٰاكَ مٰا عِلِّيُّونَ كِتٰابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ اَلْمُقَرَّبُونَ كَلاّٰ إِنَّ كِتٰابَ اَلفُجّٰارِ لَفِي سِجِّينٍ * وَ مٰا
ص: 243
أَدْرٰاكَ مٰا سِجِّينٌ كِتٰابٌ مَرْقُومٌ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (1)، و قوله تعالى: هُوَ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ، و قوله: وَ بَدَأَ خَلْقَ اَلْإِنْسٰانِ مِنْ طِينٍ، و قوله: مِنْهٰا خَلَقْنٰاكُمْ وَ فِيهٰا نُعِيدُكُمْ وَ مِنْهٰا نُخْرِجُكُمْ تٰارَةً أُخْرىٰ.
فنقول و بالله الاعتصام:
السؤال الأول: ظاهر قوله تعالى: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسٰانَ مِنْ صَلْصٰالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (2) أنّ الحمأ طينة الجميع، و ظاهر بعض الروايات المتقدمة(3) أنّ المخلوق من الحمأ المذكور هم الكفار.
و جوابه: أنّ الحمأ له مراتب و لو من جهة الماء العذب و الماء الأجاج، و عليه فترتفع المنافاة؛ و إذ الكافر و من شابههم من خبال الحمأ و فاسده كما في بعض تلك الروايات.
و إن شئت فقل: خلقة الإنسان من الحمأ المسنون لا تنافي كون الحمأ مأخوذاً من الجنة و النار، أو من أرض طيبه و من أرض خبيثة. نعم، يظهر من بعض الروايات(4) وحدة الطينة للجميع، لكن لا بد من حملها على الأخبار الدالة على تعدّدها حمل المجمل على المبيّن.
السؤال الثاني: المخلوق من الطين هو أبونا آدم (ع)، و أمّا غيره من ذريته فمخلوقون من ماء دافق و يخرج من بين الصلب و الترائب، قال الله تعالى: اَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ اَلْإِنْسٰانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاٰلَةٍ مِنْ مٰاءٍ مَهِينٍ، فما معنى هذه الروايات الدالة على ثبوت الطينة لجميع أفراد الناس المقتضية لاختلافهم في أعمالهم؟
قلت: لا مانع من وجود أجزاء الطين في المنيّ فيختلف بها حال الإنسان في آرائه و أفعاله. و في بعض تلك الروايات، عن الباقر (ع)(5): «أخبرني أبي، عن جدي، عن رسول الله (ص) أنّه
ص: 244
قال: إنّ الله ملكاً رأسه تحت العرش و قدماه في تخوم الأرض السابعة السفلى، بين يديه راحة أحدكم، فإذا أراد الله عزّ و جلّ أن يخلق خلقاً على ولاية علي بن أبي طالب (ع) أمر ذلك الملك فأخذ من تلك الطينة، فرمى بها في النطفة حتى تصير إلى الرحم منها يخلق، و هي الميثاق».
السؤال الثالث: ذكرنا أنّ المراد بالعلّيين هو الجنة، و بالسجين هو جهنم، مع أنّ ظاهر القرآن كونهما من جنس الكتاب.
وحله: أنّه يمكن تقدير كلمة في الآيتين الشريفتين، أي فيه كتاب مرقوم، أو نقول باشتراك لفظ «العليين» و «السجين» - لفظاً أو معنى - للكتاب و للجنة و جهنم، و لعلّه أقرب.
السؤال الرابع: ظاهر قوله تعالى: وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ أنّ ذريّة بني آدم بأجمعهم آمنوا، و هذا هو المستفاد من جملة من الروايات(1)، بل بعضها يدل على أنّ جميع بني آدم أقروا الله بالطاعة و الربوبية، و للرسل بالطاعة، لكن ظاهر جملة من الروايات بل صريحها(2): أنّ الناس اختلفوا، فمنهم من آمن، و منهم من كفر و أنكر، فكيف التوفيق؟
قلت: تحمل الطائفة الأولى على مجرد الإقرار، سواء كان عن اعتقاد، أم لا، و الثانية على الإقرار المطابق للاعتقاد الحقيقي، فلا منافاة بينهما، و يدل على هذا الجمع عدّة من الروايات:
منها: رواية ابن مسكان(3)، عن أبى عبد الله (ع) في قوله: وَ إِذْ أَخَذَ... قلت: معاينة كان هذا؟ قال: «نعم...، فمنهم من أقرّ بلسانه في الذرّ و لم يؤمن بقلبه، فقال الله: فَمٰا كٰانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمٰا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ.
أقول: لعلّ اللسان و القلب كناية عن الطوع و الكره؛ لبعد كون الذرّ جسماً ذا أعضاء. فتأمّل.
و منها: رواية عبدالله بن سنان، عنه (ع) «... فقال لهم: أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قال أصحاب اليمين: بلى طوعاً، و قال أصحاب الشمال: بلى كرهاً»(4).
ص: 245
و منها: رواية أبي بصير، عنه (ع) «... قالوا بلى، و أسرّ بعضهم خلاف ما أظهر...»(1).
و يدل على هذا الجمع: ما رواه السيوطي في محكّي الدرّ المنثور أيضاً، فراجع و لا حظ.
فما في مرسلة العياشي، عن أبي بصير(2)، عن الصادق (ع) في قول الله تعالى: أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ، قلت: قالوا بألسنتهم؟ قال: «نعم، و قالوا بقلوبهم». لا بد من تخصيصه بالمؤمنين إن صحّ صدورها عنه (ع).
السؤال الخامس: إذا كان المؤمنون من طينة علّييّن و الماء العذب، و الكفّار من طينة سجّين و الماء المالح، فما هو السرّ في تفاوت الأولين في أعمالهم الصالحة و السيئة، و في اختلاف الآخرين في درجات الكفر و الفسق؟
أقول: و جوابه: أنّ مراتب الطينة متفاوتة بحسب تفاوتها في القرب و البعد عن الدرجة العليا، كما يظهر من بعض تلك الروايات، و لعلّ مقدار الخليط منهما أيضاً مختلف؛ فلذا تجد ذلك التفاوت و الاختلاف.
السؤال السادس: المستفاد من بعض تلك الأخبار أنّ الطينة الطيّبة مصيرها إلى الجنة، كما أنّ الطينة الخبيثة مصيرها إلى النار، مع أنّ الأمر ربّما ينعكس، كما إذا أنكر شيعيّ يحبّ الأئمة (عليهم السلام) ضرورياً من ضروريات الدين أو المذهب مع علمه بكونه ضروياً، إذ لا شك حينئذٍ في كفره و دخوله النار، مع أنّ طينته طيّبة لحبّه الأئمة (عليهم السلام) و بغضه أعدائهم، كما أنّ بعض الكفّار أو أشباههم ربّما يصير مؤمناً صالحاً فيدخل الجنة؟
قلت: الجواب: هو تخصيص تلك الأخبار بغير هذه الصورة، جمعاً بين الأدلة.
السؤال السابع: صريح كثير من تلك الأخبار أنّ الله سبحانه خلط الطينتين و الماءين العذب و المالح، و إنّما الخالص طينة الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام)، و عليه فكيف يصحّ القول بأنّ المؤمن من طينة العلّيين، و الكافر من طينة السجّين؟!
قلت: المؤمن طينته الطيبة و ماؤه العذب أكثر من طينته الخبيثة و مائه المالح، و الكافر بالعكس، و لعلّه واضح.
فنقول: إنّها - على كثرتها - تنقسم بلحاظ مدلولها إلى أقسام ثلاثة:
ص: 246
1 - ما يدل على منشأ الإيمان و الطاعة هو الطينة الطيبة، و منشأ الكفر و العصيان هو الطينة الخبيثة، و هذا القسم يتجاوز عن عشرين رواية(1)، سيأتي مزيد توضيح له.
2 - ما يدل على أن اختصاص طينة العلّيين ببعض و طينة السجين بآخرين إنّما هو بسبب علمه تعالى بكفر الثاني، و عصيانه في دار التكليف، و إيمان الأول و طاعته فيما باختيارهما، و ليس هو إلا رواية واحدة عند التدقيق(2).
3 - ما لا يدل على الوجهين، بل هو قابل للحمل على كلّ منهما، و هذا كالقسم الأول في العدد(3)، و حيث إنّ الطائفة الثانية لا تقاوم الطائفة الأولى لقلّتها عدداً فلا محالة تطرح أو تحمل على محمل آخر، فحينئذٍ يتعين حمل الطائفة الثالثة على الأولى حمل المجمل على المبيّن، و يتخلّص من مجموعهما أنّ للطينة مدخلية في الأفعال و الآراء. نعم، مفاد الطائفة الأولى من الروايات المذكورة مختلف، ففي بعضها(4): أنّ الطينة تقتضي الهوى و الحنان إلى ما أخذت عنه، و لذا تحنّ قلوب المؤمنين إلى أئمتهم (عليهم السلام)، و قلوب المخالفين إلى أكابرهم، و في بعضها: أنّها السبب للطاعة و المعصية في الفروع(5)، بل المستفاد من بعضها: أنّها المؤثرة في الأصول و الفروع(6)، و في بعضها: أنّها الموجبة للصفات الأخلاقية و النفسية(7).
ثم إنّه يمكن تأييد هذه الطائفة بطوائف أخرى من الروايات، مثل بعض ما دل على السعادة و الشقاوة و الخير و الشر(8)، و ما دل على أنّ دخول الناس في الولاية و قبولهم الإمامة من قبل الله تعالى، و لا أثر لاختيارهم في ذلك(9)، و هذا كثير. و ما دل على أنّ المعرفة من الله تعالى، و لا صنع
ص: 247
فيها للناس(1)، و ما روي من «أنّ الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام».
نقول: لا شك أن العقل الصريح و النقل الصحيح بل الحسّ و الوجدان تحكم حكماً بتّياً جزمياً يقيناً أنّ الإنسان مختار في حركاته و سكناته، و إرادته مؤثرة في أفعاله و آثاره، و الجبر في حقه من أوضح السفسطات، و عليه فيشكل الأمر في مدلول تلك الروايات المشار إليها، و لذا اختلفت فيها الآراء و تشتّت الأنظار.
و قد ذكر العلامة المجلسي (قدس سره) في «البحار»(2) و «مرآة العقول» في أوائل مجلدها الثاني بعد اعترافه و تصريحه: بأنّها من متشابهات الأخبار و معضلات الآثار، من أصحابنا وجوهاً في ذلك:
الأول: حملها على التقية لموافقتها لروايات العامة، و لما ذهبت إليه الأشاعرة و هم جلّهم، و لمخالفتها ظاهراً لما مرّ من أخبار الاختيار و الاستطاعة.
أقول: لم يبيّن المراد من روايات العامة، و أنّها ما هي؟ و كيفما كان هذا الوجه بديهي البطلان واضح الفساد؛ إذ روايات الباب صريحة في مذمّة المخالفين، و أنّ خلقتهم و خلقة سلفهم من السجين، فلا يعقل حملها على التقية، و إن توافق مضامينها مذهب المجبّرة من حيث النتيجة، لكنها أين من الحمل على التقية؟! و ما ذكرنا فليكن قطعياً بل ضرورياً.
الثاني: أنّ الأخبار المذكورة كناية عن علمه تعالي بما هم إليه صائرون، فإنّه تعالى لمّا خلقهم مع علمه بأحوالهم فكأنّه خلقهم من طينات مختلفة.
أقول: و هذا القول ربما يلحق بالقول الأول من حيث وضوح الفساد؛ إذ ملاحظة روايات الباب توجب القطع ببطلانه، و أنّه غير مراد من تلك الأخبار.
الثالث: ما ذهب إليه الأخباريون، و هو: أنّا نؤمن بها مجملاً، و نعترف بالجهل عن حقيقة معناها، و أنّها من أيّ جهة صدرت؟ و نردّ علمه إلى الأئمة (عليهم السلام).
أقول: هذا هو المستفاد من بعض الأصوليين المعاصرين، و من المجلسي في بحاره أيضاً. لكنّ صحة هذا الوجه و سقمه مبنيّ على عدم إمكان الجمع بين روايات الباب و القواعد العقلية و النقلية و إمكانه، فعلى الثاني لا يبقى موضوع لهذا القول، و على الأول لابد من اختياره؛ إذ
ص: 248
لا يمكن طرحها و رفضها بتاتاً؛ لأنّها كثيرة.
الرابع: أنّه لمّا كلّف الله تعالى الأرواح أولاً في الذرّ و أخذ ميثاقهم فاختاروا الخير و الشرّ باختيارهم في ذلك الوقت، فتفرّع اختلاف الطينة على ما اختاروا باختيارهم، كما دل عليه بعض الأخبار السابقة، فلا فساد في ذلك.
أقول: و يزيّف أولاً م بما عرفت من الطائفة الأولى الدالة على مدخلية الطينة في إتيان الأفعال دون العكس.
و ثانياً: بأنّا لم نجد ما دل على تقدم عالم الذرّ على موضوع الطينة و اختلافها إلا رواية جابر(1) قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول في هذه الآية: وَ أَنْ لَوِ اِسْتَقٰامُوا عَلَى اَلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنٰاهُمْ مٰاءً غَدَقاً: يعني من جرى فيه شيء من شرك الشيطان على الطريقة، يعني على الولاية في الأصل عند الأظلّة حين أخذ الله ميثاق بني آدم، لَأَسْقَيْنٰاهُمْ مٰاءً غَدَقاً يعني لكنّا وضعنا أظلّتهم في الماء الفرات، بناءً على دلالتها على أنّ منشأ اختلاف الطينة و الماء هو قبول التكليف و عدمه في عالم الأظلّة.
أقول: مع أنّها ضعيفة سنداً لأجل القاسم بن سليمان، معارضة بجملة روايات أخر دالة على تقدم الطينة على عالم الذرّ(2).
نعم، لو قلنا: إنّ عالم الأظلّة غير عالم الذرّ فهذه الروايات لا تعارضها، و إنّما تعارضها رواية عبد الله الجعفي و عقبة(3)، عن أبي جعفر (ع) قال: «إنّ الله خلق الخلق فخلق من أحبّ ممّا أحبّ، و كان ما أحبّ أن خلقه من طينة الجنة، و خلق من أبغض ممّا أبغض و كان ما أبغض أن خلقه من طينة النار، ثم بعثهم في الظلال... ثم بعث منهم النبيين فدعوهم إلى الاقرار بالله...» إلى آخره.
هذا، مضافاً إلى أنّ الاعتبار العقلي أيضاً يقتضي تقدم الطينة على عالم الذرّ، فإنّ خروج ذرية بين آدم - كما في الآية - أو ذرية آدم جميعاً - كما في بعض الروايات - إنّما يعقل إذا كانوا متكوّنين و موجودين، و هذ لا يصح إلا بالطينة، فالآية الكريمة - و هي قوله تعالى: و إذا أخرج ربك... إلى آخره، و الروايات الواردة حول عالم الذرّ في أنفسها شاهدة على تقدم موضوع
ص: 249
الطينة على عالم الذرّ، فهذا القول أيضاً ساقط.
الخامس: أنّ هذه الروايات كناية عن اختلاف استعدادهم و قابلياتهم، و هذا أمر بيّن لا يمكن إنكاره، فإنّه لا شبهة في أنّ النبي (ص) و أبا جهل ليسا في درجة واحدة من الاستعداد و القابلية، و هذا لا يستلزم سقوط التكليف، فإنّ الله تعالى كلّف النبي (ص) حسب ما أعطاه من الاستعداد لتحصيل الكمالات، و كلّف أبا جهل ما أعطاه من ذلك، و لم يكلّفه ما ليس في وسعه، و لم يجبره على شيء من الشر و الفساد.
أقول: إنّ الروايات صريحة في اختلاف الطينة الموجب لتفاوت الاستعدادات، لا أنها كناية عنه. هذا أولاً.
و ثانياً: أنّ استعداد أبي جهل - مثلاً - للرذيلة أكثر من استعداده للكمالات، كما عرفته ممّا سبق، فيلزم من هذا القول لزوم تكليفه بالرذائل، فافهم.
و ثالثاً: أنّ اختلاف الثواب كثرةً و قلّةً حسب اختلاف الاستعداد شدة و ضعفا و إن كان أمراً معقولاً بل له شاهد من الأخبار، إلا أنّ اختلاف التكليف بحسبه غير صحيح، فإنّ الناس أمام التكليف الشرعي سواء. نعم، للنبي الأكرم (ص) وظائف خاصة لا تعمّ غيره، و لعلّها من قبيل وجوب الحجّ على المستطيع دون الفقير، فالتكليف عام للجميع على حدّ واحد، فتبصّر.
و أصل الإشكال الوارد على المقام: أنّ مقتضى تلك الروايات استناد الطاعات و المعاصي إلى الطينة غير المكتسبة للعبد، بل بإبداع من الله تعالى و إيجاده، و هو لا يجامع حسن العقاب و استحقاق الثواب، و هذا القول - إن تمّ - لا يدفع الإشكال المذكور.
السادس: ردّ الأخبار المذكورة إذا لم يمكن تأويلها بحيث توافق الآية الكريمة، و هي قوله تعالى: فِطْرَتَ اَللّٰهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنّٰاسَ عَلَيْهٰا، و الضروري من مذهب الإمامية ذكره بعضهم في حواشي «الوافي».
أقول: الأخبار متواترة إجمالاً أو معنى لا يمكن ردّها، بل لا بد من التوقف أو التأويل إلى ما ينافي الضرورة المذهبية، و أمّا الآية الكريمة فليست ناصّة على خلاف الروايات المذكورة، فيمكن الجمع بينهما، و سيأتي بحثه.
السابع: ما اعتمده أكثر الأصحاب و عوّلوا عليه في هذا الباب، كما نقله بعض الفضلاء السادة(1)، و هو: أنّ ذلك منزّل على العلم الإلهي، فإنّه تعالى لمّا خلق الأرواح قابلة للخير و الشرّ و قادرة على فعلها، و علم أن بعضها يعود إلى الخير المحض و هو الإيمان، و بعضها يعود إلى الشرّ
ص: 250
المحض و هو الكفر باختيارهما، عاملها هذه المعاملة كالخلق من الطينة الطيبة أو الخبيثة، فحيث على الله من زيد أنّه يختار الخير و الإيمان البتّة و لو لم يخلق من طينة طيبة خلقه منها، و لمّا علم من عمرو أنه يختار الشر و الكفر البتّة خلقه من طينة خبيثة... - إلى أن قال السيد الناقل المذكور: - و هذا معنى جيد ينطبق عليه أكثر أخبار الباب، و يستنبط من أخبارهم (عليهم السلام) كما أشير إليه بقوله (ع) حكاية عنه تعالى: «أنا المطلّع على قلوب عبادي، لا أحيف و لا أظلم و لا ألزم أحداً إلا ما عرفته منه قبل أن أخلقه. و يستفاد ذلك من أخبار أخر ذكرها يفضي إلى التطويل.
أقول: مغايرة هذا القول للقول الثاني و الرابع واضحة لا تخفى على الباحث, و الإنصاف: أنّ هذا القول أحسن و أقرب من جميع الأقوال المتقدمة, و به يجمع بين هذه الأخبار و ما تقتضيه القواعد العقلية و الأدلة الشرعية الأخر من اختيار العباد التام في أفعالهم, كما عرفتها في الأمر بين الأمرين, بيد أنّ القول المذكور في نفسه غير تام أيضاً؛ لما عرفت من أنّ الذي يصلح دليلاً له هو رواية جابر المتقدمة التي إن تمّت دلالتها عليه تسقط من ناحية السند, فيصبح القول المذكور بلا دليل, بل قد عرفت أنّ الروايات الكثيرة المذكودة في البحار تدلّ على مدخلية الطينة في الأعمال, كما أنّ ما أخرجه ثقة الإسلام الكليني في الكافي (أول الجزء الثاني من أصوله في هذا الباب) أيضاً يدل عليها, فلا حظ.
و أمّا ما أشار إليه السيد المذكور من قوله تعلى في الحديث: «و لا ألزم أحداً إلّا ما عرفته منه قبل أن خلقه» فهو و إن كان موجوداً في البحار لكنّه غير مذكور في «الوافي», فتكون الجملة المذكورة غير ثابتة من الإمام (ع), و على فرض تسليمها فمعناها: و لا ألزم أحداً إلّا ما عرفتته منه من الطينة الخبيثة أو الطيبة, لا من تمرّد المكلف و عصيانه مع قطع النظر عن الطينة, و لابد من تفسيرها بذلك لتلتئم الجملة المذكورة مع ما قبلها من جملات الرواية.
و أضف إلى ذلك: أنّ هذه الرواية - و هي رواية الليثي التي رواها الصدوق (قدس سره) في آخر كتابه «علل الشرائع» و الكاشاني عن بعض مشايخه في «الوافي» بطولها ناصّة على بطلان هذا القول, فالاستدلال بجملة منها له عجيب.
و الذي يسهّل الخطب أنّ الرواية لاشتمالها على بعض الأمور - مضافاً إلى ضعف سندها - مخالفة للأصول الدينية فضلاً عن قاعد العدلية, فلابد من طرحها.
الثامن: ما ذمره الفيض الكاشاني في «الوافي» و أول الروايات المذكورة إلى أمور غير ثابتة في نفسها, و على فرض صحتها فحمل الروايات عليها بلا شاهد, مع أنّ الإشكال المتقدم لا يدفع به فإنّه غير ناظر إليه, بل لعله يقوّيه, فلا نطوّل المقام بنقله و نقده.
ص: 251
و حيث هذه الأقول لم تفد لحلّ المشكلة شيئاً. فنقول: إنّ الطينة الطيبة مقتضية للإيمان و الأفعال الصالحة, و الطينة الخبيثة مقتضية للميل إلى الكفر و المعصية, على حسب اختلاف مراتب الطينتين المذمور تين شدّةً و ضعفاً, و ليستا علّتين تامّتين للطاعة و المعصية, ليلزم الجبر الباطل حسّاً و شرعاً, و ليقبح العقاب على تمرّد المكلفين.
و بالجملة: الطينة المذكورة و إن توجب الميل إلى ما تسانخه من العقائد و الأفعال, إلّا أنّ الميل المذكور قابل للزوال, و علي فرض ثبوته لا يستلزم التحرّك ألى العمل, بل يمكن حيلولة بعض الأمور بينهما, مثل: لحاظ أمر الله سبحانه, و خوف العقاب, و طمع الثواب, و نحو ذلك, و هذا التفاوت الحاصل في المكلّفين من قبل الله تعالى لا قبح فيه أبداً, كما ستعرف وجهه.
بحث أخلاقي في تأكيد المرام:
اختلفوا في جواز انتقال الأخلاق وعدمه على أقوال:
فذهب جماعة إلى أنّها طبيعية لا يمكن زوالها, كحرارة النار مثلاً.
و قالت طائفة أخرى - و هم الحكماء المتأخرون, و منهم المحقق الطوسي(1) -: إنّه لا شيء من الأخلاق بطبيعية و لا مخالفة للطبيعة, بل لكل شخص التخلّق بما يشاء بسهولة إن كان الخلق موافقا لمقتضى مزاجه, أو بصعوبة إن كان مخالفاً له, و قالوا: كلّ خلق عرض على أو جماعة علّته اختيارية, لكن تصيّره الممارسة و المداومة ملكة, و استدلّوا على مذهبهم بأنّ كل خلق قابل للتغيّر, و كل متغيّر ليس بطبيعي, فينتج: أنّ كل خلق لا يكون طبيعياً, أمّا الصغرى فبالضرورة, و وجوب التأديب و حسن الشرائع. و أمّا الكبرى فهي بيّنة؛ إذ كل أحد يعلم أنّ حرارة النار لا تنفكّ عنها, و ميل الماء إلى الأسفل لا يزول عنه أصلاً.
و فصّل قوم ثالث فقالوا: إنّ بعض الأخلاق طبيعية, و تعضها عادية ترسخ في النفس بالممارسة و المباشرة.
أقول: خير هذه الأقوال و أصحها أوسطها؛ لصحة دليله و متانة تقريبه.
و منه ظهر أنّ الأخلاق الموروثة من اختلاف مراتب الطينة ليست بطبيعية, بل يمكن إزالتها و لو بعد العمل بمقتضاها في برهة من الزمان.
ثم إنّ الأخلاق - حميدة كانت أو رذيلة - لا تكون عللاً تامة لصدور ما يناسبها من الأفعال, و لذا يرى أنّ صاحب ملكة العدالة قد يخرج عن خدّ الاعتدال لمانع, و المتخلّق بالفجور قد
ص: 252
يصلح كما هو المشهود خارجاً.
و هنا نزاع آخر بين الحكماء(1), فقال الرواقيون: إنّ الناس كلّهم خلقوا في بدو الفظرة على طبيعة الخير, و إنّما يتلوّثون بالشرور لمجاورة الأشرار و ممارسة الشهوات و عدم التأديب, فترسخ طبيعة الشرّ في أنفسهم.
و ذهب جمع ممّن سبقهم إلى الناس خُلقوا من الطينة السافلة و وسخ الطبائع, و الكدورات قد صرفت في مادتهم؛ و لذا ركّزت الشرّ فيهم, قبولهم للخيرات إنما هو من جهة التعليم و التأديب, و منهم من لا يصلح له لشدة شرّيّته, فالتأديب ينفع من ضعفت شرّيّته.
و قال جالينوس: إنّ بعض الناس فطر على طبع أهل الخير, و بعضهم على طبع أهل الشرّ, و البقية متوسّطة بينهما, قابلة للخير و الشرّ, و قال: إنّا نشاهد بالعيان أنّ طبائع بعض الناس - و هم قليلون - تقتضي الخير و لا ينتقلون منها بوجه, و طبائع بعضهم - و هم الكثيرون - تقتضي الشرّ و لا يقبلون الخير بوجه. و باقي الناس من المتوسّطين يصلحون بمجالسة الأخيار و يطلحون(2) بمخالطة الأشرار, ثم زيّف القولين الأولين بأنّ الناس لو كانوا كلّهم على طبيعة الخير أو الشرّ و كان انتقالهم إلى خلاف طبيعتهم بالتعلم و الممارسة, فلا محالة يكون ذلك إمّا من قبل أنفسهم؟ فيلزم أن يكون فيهم غير ما فزضناه أنّه مقتضى طبعهم أيضاً, و هذا خلف. و إمّا من قبل غيرهم, فلا يكون الناس على طبيعة واحدة, بل لعضهم على طبيعة الخير و بعضهم على طبيعة الشر, و هذا هو المطلوب.
و الحق: أنّ خلقة الناس مختلفة حسب اختلاف الطينة و درجاتها, على نحو تضمّنته الأخبار المتقدمة الذكر, غير أنّ هذه الطبائع لا تكون لازمة الثبوت و ممتنعة الانفكاك, و لا عللاً تامة للأفعال, فيمكن زوالها بالأفعال لها لأجل الإرشاد أو الإغواء, فهذه الأقوال غير متينة, فافهم جيداً.
1 - إنّ ظاهر بعض الأخبار المذكورة هو سببية الطينة التامة للأفعال, لا مجرد اقتضائها لها, بل المستفاد من بعضها أنّ مصير الطيبة إلى الجنة, و الخبيثة إلى النار, لا غير.
إقول: و حيث عرفت قطعية بطلان السببية التامة فلابد من تأويل هذا الظاهر إلى ما قرّرنا, و ممّا يدلّ على ذلك من نفس تلك الأخبار: هو ما تضمّن اختلاط الطينتين الخبيثة و الطيبة
ص: 253
و الماءين العذب و المالح, فهما مركوزتان في طبع كلّ شخص, فيكون له ميل إلى الى الأعمال الصالحة, و ميل إلى الأعمال السيئة, غير أنّ أحد الميلين أقوى من الآخر حسب أقوائية طينته, فأين الجبر والاضطرار؟!
و أمّا مصير الطينة إلى الجنة أو النار فهو محمول على مضيِّ حاملها على طبق مقتضاها, لا مطلقاً, كما يؤيده رواية جابر الجعفي الصحيحة(1), عن أبي جعفر, عن آبائه, عن أميرالمؤمنين (ع) ففيها: ثم اغترف غرفة أخرى من الماء المالح الأجاج فصلصلها في كفّه فجمدت, ثم قال لها: منك أخلق الجبّارين, و الفراعنة, و إخوان الشياطين..», قال: «و شرط في ذلك البداء فيهم, و لم يشترط في أصحاب اليمين البداء, ثم خلط الماءين»... إلى آخر.
رواها القمّي و العياشي و الصدوق قدّس الله أرواحهم, فاشتراط البداء دليل على أنّهم لو أطاعوا الله لصاروا إلى الجنة. نعم, يشكل الأمر في عدم اشتراطه في أصحاب اليمين, و لابد من توجيهه.
و مرسلة عمار, عن الصادق (ع)(2)...: «ثم قبض (الله) قبضة من كتف آدم الأيمن فَذَراها في صلب آدم, فقال: هؤلاء في الجنة و لا أبالي ثم قبض قبضة من كتف آدم الأيسر فذرأها في صلب آدم, فقال: هؤلاء في النار و لا أبالي, و لا أسال عمّا أفعل, ولي في هؤلاء البداء بعد, و في هؤلاء, و هؤلاء سيبتلون... إلى آخره.
2 - الالتزام باقتضاء الطينة للأخلاق و الأعمال, و إن كان أحسن من التباني على علّيتها لها إلّا أنّه أيضاً ينافي عدله تعالى؛ إذ كيف يحسن منه تعالى أن يجعل في الناس ما يقتضي المعاصي و الآثام.
قال قائل: إنّ هذه الأخبار و لو بمعنى أقربية الشخص إلى الكفر بسبب الطينة مستلزمة لتبعيض لطفه تعالى بالنسبة إلى العباد, و هو ظلم.
أقول: للإشكال ظاهر وجيه, غير أنّه ضعيف الأساس عند التدقيق؛ إذ نقول: أليس تقديره تعالى و لادة أحدٍ من أبوين كافرين مقتضٍ لكفره, أو تقديره سكونة شخص في بلدة خبيثة مقرباً له للفسق و الفجور؟! أهذا ظلم منه تعالى؟ أليس من المحسوس تفاوت أفراد الناس في قواهم العقلية و الكفرية و الشهوية و الغضبية, أليس هذا تبعيضاً للطفه؟! أهذا ظلم؟ و إن من شيء إلّا
ص: 254
عنده خزائنه, و ما ينزّله إلّا بقدر معلوم تقتضيه الحكمة البالغة.
نعم, يمكن أن تكون هذه المقرّبات و المبعّدات دخيلتان في زيادة الثواب و العقاب و قلتهما كما, أشرنا إليه فيما تقدم أيضاً, فتدبر جيداً.
3 - إنّ هذه الأخبار مخالفة لقوله تعالى: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اَللّٰهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنّٰاسَ عَلَيْهٰا لاٰ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اَللّٰهِ ذٰلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ الآية فإنّه يدل على أنّ الله فطر الناس جميعاً على الدين الحنيف(1), و خروج من خرج عنه لأمر طارئ, كالعوارض القسرية المخالفة لمقتضى الطبع, كما في الحديث المعروف: «كل مولود يولد على الفطرة, ثم إنّ أبويه يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه», و يؤيده قوله تعالى: وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ... قٰالُوا بَلىٰ شَهِدْنٰا الظاهر في أنّ ذرّية بني آدم آمنوا, سواء كفروا بعد ذلك أم آمنوا, ذكره بعضهم.
أقول: أمّا الآية الأخيرة فقد الكلام حولها, و ذكرنا: أنّ قول بني آدم أو ذرّيتهم أعمّ من الطوع و الكره, و أمّا الحديث فحاله حال الآية الأولى, لكنّ ذيلها غير موجود في رواياتنا على ما تتبّعت مظانّه(2). و أمّا الآية الأولى فيمكن أن يُجاب عن الاستدلال بها بما ذكره السيد المرتضى و الأمين الطبرسي(3) - طيّب الله نفسيهما - من أنّ كلمة «على» بمعنى كلمة «لام», فتقدير الآية: فِطْرَتَ اَللّٰهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنّٰاسَ عَلَيْهٰا وزان قوله: مٰا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاّٰ لِيَعْبُدُونِ, لكنّ الإنصاف أنّه خلاف الظاهر من لفظ الآية.
فالجواب التحقيقي: أنّ الطينة الخبيثة - كما دريت منّا - ليست علّة تامة للكفر و العصيان, و لا أنّ الفطرة على التوحيد و الدين سبباً مؤثراً في اختيار الإيمان و الإسلام كما يحسّ خارجاً,
ص: 255
فإذن لا تنافي بين كون شخص واحد مخلوقاً من طينة السجين, و كونه مفطوراً على التوحيد, و تدل على ذلك: صحيحة عبدالله بن سنان(1), عن الإمام الصادق (ع) قال: سألته عن قول الله عزّ و جلّ: فِطْرَتَ اَللّٰهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنّٰاسَ عَلَيْهٰا, ما تلك الفطرة؟ قال: «هي الإسلام, فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد, فقال: أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ و فيه المؤمن و الكافر».
و في البحار: «و فيهم المؤمن و الكافر», فالفطرة المذكورة لا تنافي الكفر كما يظهر من الرواية الشريفة, و يستفاد من الرواية أنّ الفطرة في عالم الذرّ المتأخر عن المسألة: الطينة, كما تقدم توضيحه سابقاً.
و الظاهر أنّ صحيحة زرارة(2) أيضاً تدلّ على ذلك, قال: قلت لأبي جعفر (ع): أصلحك الله, قول الله عزّ و جلّ في كتابه: فِطْرَتَ اَللّٰهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنّٰاسَ عَلَيْهٰا؟ قال: «فطرهم على التوحيد عند الميثاق على معرفة أنّه ربهم...» إلى آخر.
فإنّ الظاهر أنّ الميثاق - و لو بقرينة الصحيحة المتقدمة - هو عالم الذرّ, فيستفاد منها أنّ الله سبحانه خلق الناس أولاً بطينات مختلفة, ثم فطرهم - في عالم الذرّ - على التوحيد و الإسلام, ولا تمانع بين الأمرين, فافهم جيداً.
أنّ في خبرين من هذه الأخبار مسألة نقل الأعمال و وصول صالحات غير المؤمنين إلى المؤمنين, كوصول سيئات المؤمنين إلى غيرهم, و هما: رواية إبراهيم الليثي الطويلة, و رواية إسحاق القمّي عن الباقر (ع), و يظهر من بعض المعاصرين المفسّرين ارتضاؤه, لكنّهما مضافاً إلى ضعف سندهما مخالفتان لأصول المذهب, فلابد من طرحهما.
هذا مختصر القول في مسألة الطينة, و لم نفصّل الكلام فيه حذراً من ملالة القارئين الكرام, و باختتام هذه المسألة نختم مقالتنا في هذه القاعدة المبحوث فيها عن الجبر و التفويض و دحضهما, و الأمر بين الأمرين و دعمه.
نعم, هنا بحث آخر, و هو تقدم الاستطاعة على الفعل, خلافاً للأشعريّين و غيرهم ممن تهدمهم, و لكنّا أهملنا عنوانه؛ لوضوحه و جلائه, فلا معنى للاشتغال به, و الله الموفق.
ص: 256
اختلف المتكلّمون في أنّه هل يجب على الله تعالى ما هو الأصلح أو لا؟
فأتباع الأشعري - لإنكارهم الأحكام العقلية - نفوا هذا الوجوب, بل شدّدوا عليه النكير جداً(1). و أمّا المعتزلة فلهم أقوال(2):
فمنها: عدم وجوبه, و هو قول جماعة منهم.
و منها: وجوبه عليه تعالى, و هو قول البلخي و معتزلة ببغداد, و جماعة من المعتزلة البصريين.
و منها: أنّه يجب في حال دون حال, و هو قول بعضهم, و معناه: أن مقداراً من المصلحة إذا كانت خالية عن المفسدة و كان الزائد عليه مفسدة وجب على الله أن يفعل ذلك المقدار؛ لوجود الداعي و انتفاء الصارف, و إذا لم يكن في الزائد مفسدة إلى غير النهاية فإنه تعالى قد يفعل و قد لا يفعله؛ لأنّ مَن دعاه الداعي إلى الفعل و كان ذلك الداعي و حاصلاً في فعل ما يشقّ فإنّ ذلك يجري مجرى الصارف عنه, فيصير الداعي متردّداً بين الداعي و الصارف, فلا يجب الفعل و لا الترك.
مثلاً: أنّ من دعاه الداعي إلى دفع درهم إلى فقير بعينه و لم يكن له ضرر في دفعه فإنّه يدفعه إليه, فإن حضره من الفقراء جماعة يكون الدفع أليهم مساوياً للدفع إلى الأول, و يشقّ عليه الدفع إليهم للضرر, فهو قد يدفع الدرهم إلى الفقير منهم, و قد لا يدفعه, فإذا كان حصول الداعي فيما يشقّ يقتضي تجويز العدم فبحصوله فيما يستحيل وجوده أولى, و عليه حمل العلامة الحلي (رحمه الله) قول المحقق الطوسي (قدس سره) في تجريده: (و الأصلح قد يجب؛ لوجود الداعي و انتفاء الصارف).
أقول: و ستعرف أنّ هذا التفصيل لا يرجع ألى محصّل.
و أمّا عبارة المحقق الطوسي فلعلّها ناظرة إلى ما ذكره في شرح الإشارات (في النمط التاسع) من أنّ الأصلح بالقياس ألى الكلّ غير الأصلح بالقياس إلى البعض, و الأول واجب دون
ص: 257
الثاني(1). و فيه أيضاً بحث ستعرفه إن شاء الله.
هذا, و في بعض حواشي شرح عقائد النسفي للتفتازاني: أنّ معتزلة البصرة على وجوب الأصلح بالدين, و معتزلة بغداد على وجوبه بالدين و الدنيا.
هذا كلّه ما يرجع إلى آراء الأشاعرة و المعتزلة و المحقق الطوسي (قدس سره) من الإمامية, و أمّا نظرية بقية متكلّمي الإمامية فهي لم تحرز لي بعد. نعم, اختار الوجوب بعضهم, و نسبه المحقق اللاهيجي في بعض رسائله الفارسية إلى جمهور القائلين بالحسن و القبح العقلييّن, فيظهر منه أنّ القول بوجوب الأصلح عليه تعالى مذهب جميع الإمامية أو معظمهم؛ لأن الإمامية بأسرهم يقولون بالحسن و القبح المذكورين, لكن لا يمكن الاكتفاء بهذا المقدار في استناد القول المذكور إلى الإمامية, بل ذكر بغض الفضلاء(2): أنّ وجوب الأصلح في الدنيا ممّا اختلف فيه, و نسب القول بوجوبه إلى صاحب الياقوت من الشيعة فقط, ثم قال: و قال البصريون و الأشاعرة و جمهور علماء الشيعة: إلّا (هكذا) أنّه لا يجب. انتهى كلامه.
و هذا أيضاً غير معلوم, فموقف متكلّمي الإمامية في هذه المسألة لم يظهر عاجلاً. نعم, قال شيخنا الأقدم المفيد (قدس سره) في «أوائل المقالات»(3): أقول: إنّ الله تعالى لا يفعل بعباده - ما داموا مكلفين - إلّا أصلح الأشياء لهم في دينهم و دنياهم.
و كيفما كان فلابد من النظر إلى قضية البرهان العقلي, و أنّها ما هي؟ فإنّ الحقّ لا يعرف بالرجال, فتقول: استدل المثبتون على وجوبه بأنّ الأصلح و غير الأصلح و غير الأصلح متساويان بالقياس إلى قدرته, و القادر المحسن إلى غيره إذا تساوى شيئان بالقياس إليه وكان في أحدهما زيادة إحسان إلى غيره اختاره منهما البتّة, نقله المحقق الطوسي عن معتزلة بغداد(4), و لعلّ هذا يتحد معنيً بما في جملة من الكتب الكلامية من الاستدلال على الوجوب: بأن لله تعالى داعياً إلى إيجاده الأصلح, و ليس له صارف عنه فيجب ثبوته, إذ مع ثبوت القدة و وجود الداعي و انتفاء الصارف يجب الفعل, و بيان تحقيق الداعي: أنّه إنّه إحسان خالٍ عن جهات المفسدة, و بيان انتفاء الصارف أنّ المفاسد منتفية و لا مشقّة فيه.
و أورود عليه النفاة: بأنّ هذا يثبت وجوب الفعل عنه تعالى بمعنى اللزوم, عند تمام العلة
ص: 258
و المدّعى هو الوجوب عليه بمعنى استحقاق الذم على الترك, فأين هذا من ذاك(1)؟!
أقول: و هذا الإيراد واضح الفساد؛ إذ المراد بالداعي هو الأصلح نفسه، أعني به ما هو أتمّ مصلحة، و إتيانه غير لازم عنه تعالى، بل هو متمكن من فعله و تركه، بل هو لازم عليه؛ لأنّ إهمال الأصلح قبيح ينزّه عنه الله تعالى.
والأولى أن يقال: إنّ الأصلح ممّا يجب إتيانه على الله تعالى، فإنّه إذا دار الأمر بين إيجاد الأصلح و تركه، أو بينه و بين الصالح فاختيار الشقّ الثاني ترجيح المرجوح على الراجح، و هو ممنوع، فمتعلق إرادته تعالى دائماً هو الأصلح، و هو واجب عليه؛ لأنّ تركه قبيح منه تعالى.
و بعبارة واضحة: أنّ هذا البحث راجع إلى بحث حكمته تعالى، و لا فرق بينهما أصلاً؛ و ذلك لأنّ الحكمة: إمّا أن يراد بها تبعية فعله للمصلحة و العائدة، و أنّه لا يفعل إلا عن مصلحة، و هي ما تقدم في هذا الجزء في مسألة تعلّل أفعاله بالغرض. و إمّا أن يراد بها صدور الاشياء عنه على أكمل الأنحاء الممكنة، و هي مسألة أنّه تعالى حكيم، و قد مرّ تفصيلها في الجزء الأول، و مسألتنا هذه بعينها هي المسألة، فكما أنّا قلنا: إنّه تعالى حكيم، نقول: إنّه فاعل الأصلح لا محالة، و لا نظام ممكن أحسن من هذا النظام الحاضر، كما مرّ.
نعم، لو قلنا: إنّ المراد في هذا المقام هو البحث عن وجوب الأصلح بحال العبد، كما هو ظاهر جملة من الكلمات المتقدمة، بل هو مدلول دليلهم و هو المناسب لمباحث العدل، فتكون المسألة مورداً و مصداقاً لمبحث حكمته تعالى، لا أنّها راجعة إليه متحدة به، لكنّ البحث بهذا العنوان لغو بعد إثبات تلك الكبرى الكلّية، بل لا يمكن إثبات الحكم المذكور حينئذٍ؛ إذ الذي يفعله الله تبارك و تعالى هو الأصلح الواقعي، لا الأصلح بحال بعض، و إن صادم مصلحة أقوى راجعة إلى فرد آخر أو جمع آخرين فإنّ اختياره حينئذٍ قبيح، و على ضوء ذلك يبطل جميع الأقوال المفصّلة المتقدمة، كما لا يخفى.
ثم إنّ للنفاة اعتراضات على أصل المدّعى، و إليك بيانها مختصراً.
1 - إنّ الأصلح بحال الكافر المبتلى بالأسقام و الآفات أن لا يخلق أو يموت طفلاً، أو يسلب عقله عند البلوغ لئلاّ يستحق الخلود في النار.
أقول: و قد ظهر جوابه ممّا حرّرناه آنفاً، من أنّ المراد بالأصلح الواجب على الحكيم هو الأصلح بالنظر إلى الواقع و النظام، و إن شئت فقل: الأصلح غير المعارض بما هو الأقوى منه، و مصلحة عدم خلق الكافر ممّا لم يدلّ على كونها من هذا القبيل دليل.
ص: 259
2 - إنّه يلزم أن تكون إماتة الأنبياء و الأولياء المرشدين و تبقية إبليس و ذرّياته المضلّين إلى يوم الدين أصلح لعباده، و كفى بهذا فظاعة.
أقول: و قد اتضح جوابه من جواب الأول، فإنّ المعلوم أن تبقية الأنبياء و الأولياء إنّما تكون أصلح للمؤمنين القابلين لهداياتهم، و أنّ اماتة إبليس و ذرّيته أصلح للمتمرّدين و المغرورين بهم، و لكن لا طريق لنا أن نحرز عدم تزاحم هذه المصلحة بما هو أقوى منها، فلعلّ الأصلح في نفس الأمر هو إماتة الأنبياء و تبقية إبليس، فلا يتم النقض مع هذا الاحتمال، فالفظاعة إنّما جاءت من سوء فهم النفاة و عدم تعقّلهم حقيقة الحال.
3 - إنّه يلزم أن لا يبقى للتفضّل مجال، و لا يكون له خيرة في الإنعام و الإفضال، بل يكون ما يفعله تأدية للواجب، كردّ وديعةٍ أو دين لازم، فلا يستوجب على فعله شكراً، فيكون الدعاء لدفع البلاء و كشف البأساء و الضرّاء سؤالاً من الله تعالى أن يغير ما هو الواجب عليه.
أقول: وصف المحقق اللاهيجي هذا الوجه بأعظم شبهات هذا الباب، ثم أجاب عنه: بأنّ استحقاقه تعالى للشكر من أجل ابتداء الوجود و أصل الإيجاد، فإنّه تفضّل محض، فإنّ الواجب عليه تعالى إن أراد إتيان شيء هو أن يوجده على نحو أصلح، فالذي لا يستحق الشكر عليه هو إيجاد الشيء على نحو الأصلح، و أما إيجاد أصل هذا الشيء و إرادته فليس بواجب عليه، فيستحق بإعطائه الشكر على المتفضّل عليه.
و دليله: أنّ الذي يقبح عقلاً من العاقل أن يفعل فعلاً و هو يقدر على إيقاعه بوجه حسن فيفعله على غير هذا الوجه، لا أن يعلم فعلاً حسناً و لم يفعله.
لا يقال: إن ابتداء الوجود أيضاً مبنيّ على مصلحة، فيعتبر فيه أيضاً رعاية الأصلح فيكومن واجباً لا يجامع استحقاق الشكر.
فإنّه يقال: إنّ هذا ممنوع، بل وجوب الأصلح بعد ابتداء الوجود، فإنّ المستدعي للأصلحية غير متحقق قبل إرادة الإيجاد حتى يجب رعايته، بل تحقّقه بعد إرادة الإيجاد.
أقول: هذا التقرير منه عجيب، و لا أظنّ أن يوافقه أحد على هذا التفصيل، بل لا أظنّ أن يلتزم به هو نفسه في سائر المسائل، و فيما يترتب عليه من الآثار.
و على الجملة: لا شكّ في بطلان هذه النظرية، فإنّه كما يقبح عقلاً ترجيح الصالح أو الفاسد على الأصلح بعد إرادة أصل الفعل كذلك يقبح ترجيح ترك الأصلح على فعله، فيصبح الفعل الأصلح واجب الإتيان ابتداءً.
فالصحيح في جواب الشبهة: أنّ الوجوب المذكور لا ينافي استحقاق الشكر للفاعل، و لا وجوبه على المتفضّل عليه، كما يظهر من ملاحظة سنن العقلاء، ألا ترى أنّ من يحسن بالفقراء
ص: 260
لرقّة قلبية يعدّ مشكوراً عندهم، و الوالدين يربيان أولادهما لأجل المحبّة غير الاختيارية المودعة في قلبيهما حفظاً للنظام، و الأولاد ملزمون بشكرهما و تمجيدهما، و هكذا؟
و سرّ ذلك: أنّ استحقاق الشكر يتسبّب من الإحسان الصادر عن إرادة المحسن و رضاءه، و سواء كان تركه قبيحاً، أم لا، بل وجوب الأصلح يشمل جميع العقلاء أيضاً، و لا يخص الواجب الوجود وحده؛ لعموم دليله، فإذا أنعم زيد بدرهم على محتاج و كان الأصلح الإنعام بدينار فقد ارتكب القبيح واقعاً، و إن كان على المحتاج شكره؛ إذ ليس عدم إعطاء الدينار إيّاه ظلماً عليه، و لا منعاً من حقه، و إيتاء الدرهم له تفضّل محض عليه، كما هو واضح، و لعمري إنّ الشبهة المذكورة سخيفة جداً.
و أمّا فائدة الدعاء فظاهرة؛ إذ الدعاء ربّما يكون دخيلاً في الأسباب و العلل، مثلاً: الفقر أو المرض أصلح لزيد بطبع الحال، لكنّه إذا دعا الله لزواله يصير الغنى أو الصحة أصلح له لأجل دعائه؛ و لذا ورد: أنّ الدعاء يردّ القضاء، فالإيراد ناشئ عن عدم تعمّق في المسألة.
4 - إنّ مقدورات الله تعالى غير متناهية، فأيّ قدر يضبط في الأصلح فالمزيد عليه ممكن، فيلزم أن لا يمكن تأدية الله تعالى ما هو الواجب عليه، و فساده أظهر من أن يخفى.
أقول: و لعلّ هذا الوجه هو المستند للقول الثالث، كما يظهر من تقريره، لكنّه مزيّف صغرى و كبرى، أمّا صغرى فلأنّ عدم تناهي المقدورات لا يستلزم عدم تناهي الأصلح؛ إذ يمكن أن يكون مرتبة منها أصلح دون فوقها. و أمّا كبرى فلأنّ الوجوب المذكور - أي وجوب الأصلح - إنّما جاء من قبل قبح ترجيح المرجوح على الراجح كما عرفت، ومن الضروري عدم القبح في ترك المحال، فيتقصر على ما هو الممكن في الإيجاد، و هذا واضح.
نقل في المواقف و شرحها(1) حكاية زعماً أنّها تنحى بالقلع عن هذه القاعدة، و هي: أنّه قال الأشعري لأستاذه أبي عليّ الجبائي: ما تقول في ثلاثة إخوة عاش أحدهم في الطاعة، و أحدهم في المعصية، و مات أحدهم صغيراً؟ فقال: يثاب الأول بالجنة، و يعاقب الثاني بالنار، و الثالث لا يثاب و لا يعاقب، قال الأشعري: فإن قال الثالث: يا ربّ، لو عمّرتني فأصلح فأدخل الجنة كما دخلها أخي المؤمن؟ قال الجبائي: يقول الربّ: كنت أعلم أنّك لو عمّرت لفسقت و أفسدت فدخلت النار، قال: فيقول الثاني: يا ربّ، لم لم تمتني صغيراً لئلاّ أذنب فلا أدخل النار كما أمّت
ص: 261
أخي، فبهت الجبائي، فترك الأشعري مذهبه، و كان هذا أول ما خالف فيه الأشعري المعتزلة.
أقول: هذا هو مبلغهم من العلم، يبحثون عن مسألة بسيطة ثم إذا عجز المسؤول عن جوابها يخالفه السائل في تمام أقواله، و يجعل عجزه في مورد دليلاً على بطلان جميع مباينه! و قد وقع نظير هذا للحسن البصري و واصل بن عطاء، حيث قال الحسن: إنّ مرتكب الكبائر مؤمن فاسق! و قال واصل: إنّه لا مؤمن و لا كافر، فافترق منه و اعتزله، و حالهم عجيبة.
ثم إنّ الجواب عن هذه القصة قد انبثق ممّا تقدم، فإنّ الله تعالى إن قال في جواب الثالث: إنّ موتك في حال الصغر كان أصلح للنظام فأمّتك و إن كان تعميرك أصلح لك، لكنّ مصلحة الكلّ أولى بالرعاية من مصلحظ الجزء فلا يبقى له سؤال، ثم يقول له - كما دلت عليه الروايات الصحاح(1) -: إنّك لو تريد الجنة فالآن نختبرك و نكلّفك، فإن أطعتني أدخلك الجنة، و إلاّ فمصيرك إلى النار، ثم يؤجّج له ناراً فيؤمر بالدخول فيها، فإن دخل يدخل الجنة، و إن عصى فيدخل النار، فما ذركره الجبائي في جواب الثالث اختراع منه و تخرّص، فهذه القصة لا تخدش القاعدة الشريفة المذكورة، فافهم و استقم.
قال الصادق (ع) - كما في آخر رواية عبد الله الهاشمي المروية في التوحيد في الباب 61 -: «إنّ الله لا يفعل لعباده، إلا الأصلح لهم، و لا يظلم الناس شيئاً، و لكنّ الناس أنفسهم يظلمون».
و أعلم أنّ قانون العلّية سارٍ في عالم المادة، بل في عالم الممكنات؛ لا استثناء له أصلاً، و سلسلة العلل و تنتهى إلى علة العلل و هو الخالق المدبّر عزّ اسمه، بل قد جرت سنة الله على تأثير الأسباب العادية في مسبباتها، إلا في مورد المعجزات و خوارق العادات تقديماً لعلل مادية أو غير مادية قاهرة غير عاديته على أسباب عادية، تثبيتاً لمنصب النبوّات و الرسالات للأنبياء و الرسل عليهم السلام مثلاً، و كثير أما يشتبه غير الراسخين في العلم و يتوقعون تخصيصها في كلّ ما يحبون؛ و منها في مقامنا، فإن الصغير يميته الله على حسب قانون العليته الحاكم على الأشياء عن قبل مسبب الأسباب، و كأنّه المصداق الأكبر للنظام الأصلح كما عبّرنا به فافهم المقام.
ص: 262
اللطف عند المتكلّمين عبارة عمّا يقرّب العبد إلى الطاعة، و يبّعده عن المعصية، و لم يكن له حظّ في التمكين، كالقدرة و العلم و الآلة و نحوها، و لم يبلغ حدّ الإلجاء.
أقول: أمّا القيد الأول فوجهه واضح، فإنّ ما به تمكين المكلف من الفعل فهو ممّا لا شك في اعتباره في صحة التكليف عقلاً أو نقلاً، فإنّ الله لا يكلّف نفساً إلاّ وسعها، فإعطاء القدرة و بيان التكليف و نحوهما ليست من اللطف المبحوث عنه بشيء. و أمّا القيد الأخير فهوجه أيضاً ظاهر، ضرورة أنّ الذي يلجئ المكلف على الفعل و يحمله عليه قهراً ينافي روح التكليف القائم على اختيار المكلف و أفعاله الإرادية، ضرورة منافاة الجبر مع استحقاق الثواب و العقاب، بل مع استكمال النفس أيضاً.
هذا، و لكن يمكن أن يكون اعتبار القيدين في كلامهم مبنياً على الغلبة، و إلاّ فمن علم الله منه أنّ بقاءه يوجب صلاحه، و أنّه يتوب فيما بعد من معاصيه و يخلّص عمله لربه، يكون تعميره و ابقاؤه لطفاً له بلا شك، مع أن العمر ممكن له في عمله بحيث لو لاه لم يقدر عليه، و كذا من علم الله أن حدوث المرض الشديد الفلاني يوجب عجزه عن ارتكاب معصية كذائية هذا اليوم، فأمرضه فإنّه لطف بلا ريب، مع أنّه بالغ حدّ الإلجاء، فلاحظ.
و كيفما كان فهل اللطف بهذا المعنى واجب على الله تعالى، أو لا؟ فيه خلاف بينهم، ذهب الأشاعرة بناءً على إنكارهم الحسن و القبح العقليّين إلى عدم وجوبه عليه تعالى، و لا كلام لنا معهم بعد ما عرفت من ضرورة الحكم المذكور، و ذهب الإمامية و المعتزلة إلى وجوبه، كما صرّح به جماعة من أصحابنا. بل نسبه اللاهيجي إلى جميع القائلين بالحسن و القبح العقليين. نعم، ربّما يظهر من جماعة قليلة من أصحابنا التردّد فيه أو في عمومه، لكنّني لم أفز على وجه هذا التردّد في كلامهم.
و هذه القاعدة لها ثمرات مهمة نافعة في جملة من المسائل، و الدليل على صحتها على ما ذكره المثبتون وجوه:
1 - ما هو المشهور - و هو العمدة - من أنّ اللطف مما يتوقف عليه غرض المكلّف - بالكسر -
ص: 263
من المكلّف المأمور، و كل ما يتوقف عليه الغرض فهو واجب، فينتج أنّ اللطف واجب على المكلّف الأمر. أمّا الصغرى فلأن الغرض من التكليف هو امتثال أوامر الله و الانتهاء عن نواهيه، و هما موقوفان على كل ما يقرّب العبد إليهما و يبعده عن تركهما. و أمّا الكبرى فلأنّ المريد من غيره فعلاً من الأفعال إذا علم أنّ ذلك الغير لا يفعل الفعل المراد إلا بنوع ملاطفة و تأدّب من المريد معه، و لم يفعل التأدّب المذكور لذمّه العقلاء؛ لأنّه ناقض لغرضه.
مثلاً: من دعا غيره إلى طعام و هو يعلم أنّ المدعوّ لا يجيبه إلاّ أن يستعمل معه نوعاً من التلطف و التأدب، فإذا لم يفعله الداعي كان ناقضاً لغرضه، و هكذا الشارع الأقدس فإذا علم أنّ المكلف لا يطيع إلا بلطف لا بد له أن يفعله، و إلا فلو كلّفه بدونه لكان ناقضاً لهدفه و هادماً لمطلوبه، و هو قبيح بلا ريب.
و إن شئت فقل: ترك اللطف نقض للغرض، و نقض الغرض قبيح، فترك اللطف قبيح. ثم قل: لو كان ترك اللطف قبحياً لكان فعله واجباً بلا شك، لكنّ تركه قبيح، فينتج أنّ فعله واجب.
هذا، و لكنّ هذا الدليل عندي غير قابل للاعتماد في إثبات مثل هذه المسألة العظيمة، فإنّه مزيّف بوجهين:
الأول: أنّه لو تم لتمّ في خصوص من يعلم الله امتثاله للتكليف المتوجه إليه بعد فعل اللطف، و أمّا في حق من يمتثل التكليف و يطيع الله و لو من غير اللطف المذكور، أو في حق من لا يمتثل أمره و نهيه تعالى و إن فعل من ألطاف كما قال الله تعالى في حقهم: وَ لَوْ أَنَّنٰا نَزَّلْنٰا إِلَيْهِمُ اَلْمَلاٰئِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ اَلْمَوْتىٰ وَ حَشَرْنٰا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْ ءٍ قُبُلاً مٰا كٰانُوا لِيُؤْمِنُوا، فلا يتم أصلاً و وجهه أيضاً ظاهر غير مستور.
الثاني: أنّ الغرض من التكليف هو استكمال نفوس المكلفين و انتظام أمور معاشهم و معادهم، و هذا الاستكمال لا يحصل إلاّ بكون المكلف مختاراً غير مجبور على أحد طرفي المأمور به، فالذي تحتاج إليه حجية التكليف و به يحصل غرض المولى هو تمكين المكلّف - بالكسر - و إعلامه المكلّف - بالفتح - ليتمكن من الامتثال، و لا يعتبر أزيد من ذلك شيء أصلاً، فلو لم يفعل المكلف لطفاً بالمأمور و ترك الامتثال كان عاصياً مستحقاً للعقاب، و لم يمكن الأمر ناقضاً لغرضه و هادماً لهدفه، فإنّ غرضه لم يتعلّق بفعل الطاعة عن المكلّف كيفما اتفق، و إلا لوقع الفعل جبراً و بلا إرادة المأمور، بل الغرض هو إتيان المأمور ما أمر به من اختياره، و هذا النحو من الغرض لا يتوقف على فعل اللطف المذكور لحصوله بمحض تمكن العبد، فالمقدمة
ص: 264
القائلة في هذا الاستدلال: اللطف مما يتوقف عليه غرض المكلف، و أنّ تركه نقض للغرض غير واضح الوجه، فيكون الدليل المذكور - رغم كونه موروثاً عن أكابر الفنّ - ساقطاً لا يعتدّ به.
2 - ما في «كفاية الموحّدين» من تحقق الداعي و وجود القدرة و انتفاء الصارف، و مع اجتماع هذه المقدمات المذكورة يجب اللطف؛ لامتناع تخلّف المعلول عن علّته التامة.
و فيه: أنّ فرض تحقق الداعي مصادرة؛ إذ لا طريق له إلى لزوم تعلق إرادته تعالى باللطف إلا بعد إثبات وجوب اللطف المذكور، فيدور.
3 - ما فيها أيضاً و في «شمع اليقين» من أنّ فعل الأصلح واجب عليه تعالى، و اللطف أصلح إلى العبد فيكون واجباً. لكنّ القول بكون اللطف أصلح تخرّص و رجم بالغيب؛ إذ الواقع غير مكشوف لنا لندّعي أقوائية مصلحة اللطف ممّا يزاحمها، فلعلّ هنا مزاحماً و لعلّه أقوى منها، و العجب ما في الكفاية من تمامية هذين الوجهين حتى على مذهب من ينكر الحسن و القبح العقليين، و ضعفه ظاهر.
4 - قوله تعالى: اَللّٰهُ لَطِيفٌ بِعِبٰادِهِ هكذا قيل. و فيه: أنّ اللطف في الآية الشريفة لو كان بمعناه المصطلح و سلّمناه لمّا نسلم دلالة الآية على وجوبه قطعاً.
5 - قوله تعالى: وَ لَوْ نَزَّلْنٰا عَلَيْكَ كِتٰاباً فِي قِرْطٰاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقٰالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هٰذٰا إِلاّٰ سِحْرٌ مُبِينٌ (1).
قال القاضي - كما في تفسير الرازي في ذيل الآية الشريفة -: دلت هذه الآية على وجوب اللطف؛ لأنّه تعالى بيّن أنّه إنّما لا ينزل هذا الكتاب من حيث أنّه لو أنزله لقالوا هذا القول، و لا يجوز أن يخبر بذلك إلا لعموم، و إنّهم لو قبلوا و آمنوا به لأنزله لا محالة. و فيه: أنّ دلالة الآية على إنزال الكتاب المذكور في صورة قبولهم غير ثابتة، و لو ثبتت لما دلت على الوجوب؛ إذ وقوع الشيء لا يستلزم وجوبه، و هذا ظاهر.
قال المحقق الطوسي في تجريده: و يقبح منه تعالى التعذيب مع منعه - أي اللطف - دون ذمّه. و قال العلامة في شرحه(2): المكلّف إذا منع المكلّف عن اللطف قبح منه عقابه؛ لأنّه بمنزلة الأمر بالمعصية و الملجيء إليها، كما قال الله تعالى: وَ لَوْ أَنّٰا أَهْلَكْنٰاهُمْ بِعَذٰابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقٰالُوا
ص: 265
رَبَّنٰا لَوْ لاٰ أَرْسَلْتَ إِلَيْنٰا رَسُولاً فأخبر أنّه لو منعهم اللطف في بعثة الرسل لكان لهم أن يسألوا بهذا السؤال، و لا يكون لهم هذا السؤال، إلا مع قبح إهلاكهم من دون البعثة، و لا يقبح ذمّه؛ لأنّ الذمّ حق مستحقّ على القبيح غير مختصٍّ بالمكلّف، بخلاف العقاب المستحقّ للمكلّف؛ و لذا لو بعث الإنسان غيره على فعل القبيح ففعله لم يسقط حق الباعث من الذم، كما أنّ لإبليس ذم أهل النار و إن كان هو الباعث على المعاصي. انتهى كلامه.
بل هذا - أي قبح العقاب من دون لطف - هو الذي نقله الفاضل التوني - كما في «مطارح الأنظار» - عن الأصحاب و المعتزلة.
لكنّه عندي ضعيف جداً؛ لأنّ منع اللطف لا يكون بمنزلة الأمر بالمعصية قطعاً، و الآتية الشريفة أجنبية عن محلّ الكلام بالكلية، فإن العقاب من دون البيان و إرسال الرسول قبيح ضرورة، و ليس بشيء من اللطف؛ لما مرّ من أنّه بعد البيان و التكليف، و منه انبثق بطلان الفرق و التفكيك بين استحقاق الذم و العقاب.
و صفوة القول: إنّه لا دليل على وجوب اللطف و تحتّمه على الله الحكيم أصلاً، و إنّ مجرّد اختيار العبد و تمكنه من المكلف به يصحح تنجز التكليف و استحقاق العقاب في فرض المخالفة، من دون اشتراطه بمنح اللطف أصلاً. نعم، لو أدخلنا الوعيد بالعقاب في اللطف فلا شك في قبح العقاب في جميع الموارد، أي حتى في ما يكون العقل حاكماً فيه بالذم فقط دون العقاب على ما مرّ تفصيله في حديث الملازمة بين الحكم العقلي و الشرعي؛ و ذلك لأنّ العقاب حينئذٍ بلا بيان. نعم، يحسن العقاب المذكور في الموارد التي يحكم العقل به أيضاً زائداً على الذم، و لعلّه مراد القوم.
ثم إنّه يمكن أن يستدل على بطلان وجوب اللطف بجملة من الآيات الشريفة الدالة على اختصاص ألطافه تعالى الخاصة بطبقة خاصة، و على خذلان طائفة أخرى و منع هداياته و توفيقاته عنهم، و التخلية بينهم و بين ما يشتهون، كما مرّ تفصيلها في بعض مقالات قاعدة الأمر بين الأمرين، و بطلان الجبر و التفويض، فمثل قوله تعالى: وَ لاٰ يَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمٰا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمٰا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدٰادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ (1) و أشباهه يدلّ على نفي اللطف في حق الكافرين و المعاندين، بل على ثبوت ما يزيد به عقابهم!!
كما أنّ قوله تعالى: إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنٰاهُمْ هُدىً، و قوله: وَ اَلَّذِينَ اِهْتَدَوْا
ص: 266
زٰادَهُمْ هُدىً وَ آتٰاهُمْ تَقْوٰاهُمْ، و غيرهما تخصّص الهدايات الخاصة بالمؤمنين و المهتدين فتدبّر.
خاتمة:
قال شيخنا المفيد (رحمه الله) في «أوائل المقالات»: إنّ ما أوجبه أصحاب اللطف من اللطف إنّما وجب من جهة الجود و الكرم، لا من حيث ظنّوا العدل أوجبه، و أنّه لو لم يفعل لكن ظالماً.
و قال بعض من علق عليه: إنّ المعتزلة أوجبوه - أي اللطف - من جهة العدل...، و الإمامية إنّما أوجبوه من جهة الجود و الكرم، و أنّه تعالى لمّا كان متصفاً بهذين الصفتين اقتضى ذلك أن يجعل للمكلفين مادام هم على ذلك الحال أصلح الأشياء... إلى آخره.
ظاهر كلام الشيخ (رحمه الله) أنّه استدل على وجوب اللطف من جهة وجوب الأصلح، و إلاّ فلا دليل غيره على وجوب الجود و الكرم.
ثم إنّ ما استدل به المشهور من طريق نقض الغرض أيضاً ليس من جهة العدل، بل من لحاظ الحكمة، كما لا يخفى.
ص: 267
التكليف مأخوذ من الكلفة، و ينقسم إلى: العقلي و الشرعي، الأول كوجوب النظر و ردّ الوديعة و شكر المنعم و حرمة الظلم و الإيذاء، و لا إشكال في حسنه؛ لأنّ حكم العقل بإتيان شيء ليس إلا إدراك حسنه.
و الثاني كوجوب الصلاة، و حرمة الغناء مثلاً. و عرّفه - أي التكليف الشرعي - جماعة من المتكلّمين، منهم العلامة في شرح التجريد بأنّه: إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقّة بشرط الإعدام. و بقيد الابتداء خرج إرادة النبي و الإمام و السيد و الولد و غيرهم، فإنّ أمرهم بالصلاة - مثلاً - لا يسمّى تكليفاً؛ لسبق إرادة الله إيّاه من المصلّي. و قال: و المشقّة لا بد من اعتبارها ليتحقق المحدود، إذ التكليف مأخوذ من الكلفة.
و عن الجميع: أنّ التكليف عند المتكلّمين هو بعث من يجب... إلى آخره.
أقول: و هو ي - تحد مع الأول، بل عينه، و لكنّه مع صدقه على تكليف الموالي العرفية بغير ما أمر الله به، لا يمكن قبوله؛ لعدم المشقة في جملة من الأحكام الشرعية، كحرمة أكل القاذورات و غيرها مما تنفر طبائع المكلفين منها، و كحرمة الصوم في يوم العيد، و إتلاف الأموال بلا جهة، و إلقاء النفس في الهلكة، و كوجوب مقاربة الزوجة في أربعة أشهر، و أمثالها فليس المراد بالتكليف هو معناه اللغوي ليعتبر المشقة في مفهومه.
فالأقرب في تحديده ما ذكره بعض الأصوليين من أنّه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. نعم، لا بد من تعميم الفعل للفعل الجوانحي ليشمل التكاليف المتعلقة بالأصول الاعتقادية، كالمعاد الجسماني مثلاً، و من تبدل المكلفين بالعباد لئلاّ يلزم الدور، و من إضافة قيد «على سبيل الاقتضاء» ليخرج المباح منه، فإنّه ليس من التكليف بشيء.
و الصحيح أن نقول في تعريفه: إنّه ما اعتبره الله سبحانه أو رسوله الخاتم (ص) على ذمّه العباد من الأفعال و التروك، سواء كان على وجه الإلزام، أم لا. و إنّما ذكرنا النبي الأكرم (ص) أيضاً لثبوت التفويض عندنا على نحو يمرّ بك في مبحث النبوة في الجزء الثالث إن شاء الله.
ثم إنّ التكليف المذكور ممّا لا إشكال في حسنه إجمالاً؛ لأنّ الشارع قد فعله، و كل ما فعله
ص: 268
الشارع فهو حسن: إمّا كشفاً و إنّا كما عليه أهل الحق، و إمّا لمّاً و علّةً كما عليه منكروا الأحكام العقلية، و قد يعبّر عنه بالحكم العقلي بالمعنى الأعم، و إنّما الكلام في حسن التكليف المذكور تفصيلاً، و أنّ العقل هل يدرك حسنه مع قطع النظر عن فعل الشرع، أو لا يدركه؟ و يعبّر عنه في كلام بعضهم بالحكم العقلي بالمعنى الأخصّ. و يقع الكلام أيضاً في أنّه بعد حسنه هل يجب على الله الحكيم، أو لا؟
و قبل الدخول في هاتين الجهتين لا بد أولاً من تحقيق شروط التكليف، و المكلف به، و المكلف (بالفتح). و أمّا بيان ما يعتبر في المكلّف - بالكسر - فغير لازم، بعد ما مرّ من أنّ الله تعالى مستجمع لجميع الصفات الكمالية، و أنّه مالك الموجودات الممكنة. نعم، ما ذكره بعض المتكلمين من اعتبار علمه بقدر ما يستحق المكلّف - بالفتح - من الثواب و العقاب، و قدرته على إيصال المستحق حقه غير صحيح، بناءً على عدم حكومة العقل باستحقاق الممتثل للثواب، كما يأتي بحثه في مبحث المعاد. و أمّا العقاب فاستحقاقه للعاصي و إن كان ثابتاً عقلاً - و لو في الجملة - غير أنّ العلم بمقداره و القدرة على إيصاله غير معتبرين في صحة التكليف و حسنه و لزومه.
أمّا التكليف فيعتبر فيه:
أولاً: انتفاء المفسدة عنه، أو مفسدة غالبة على مصلحته، أو مصلحة المكلف به، و الظاهر أنّ تدريجية تشريع الأحكام الشرعية تتفرّع على هذا الأمر، فإنّ الصلاة - مثلاً - كانت ناهية عن الفحشاء و المنكر في أول البعثة أيضاً، غير الله تعالى لم يفرضها على الناس تسهيلاً عليهم، و ترغيباً لهم في قبول الإسلام؛ إذ لو أوجب العبادات كلها دفعة واحدة لم يتحمّلها كثير منهم و لرفضوها، و هو مفسدة عظيمة لهم لحرمانهم به من السعادة العظمى، بل دخولهم النار الكبرى.
و ثانياً: أن يصل في وقت يتمكن المكلف من إتيان العمل، و لا يكون وصوله بعد وقت العمل.
و ثالثاً: أن يكون ممكناً، ضرورة عدم تحقق التكليف المحال، كأن يأمر بشيء ثم ينهى عنه بعينه في زمان و حال واحد، و هذا ظاهر.
و إنّما الكلام في استحالة التكليف المذكور، فإنّ الأحكام الخمسة بأسرها أمور انتزاعية عقلية، و لا مانع من اعتبار الفعل و تركه على ذمة المكلف فينتزع العقل منه الوجوب و الحرمة، فإنّه بمكان من الإمكان. نعم، لا يتمكن المكلف من امتثالهما خارجاً؛ لاستحالة المكلف به،
ص: 269
أعني إيجاد شيء و عدمه في آن واحد، فهو من التكليف بالمحال، لا من التكليف المحال، و ليس للواجب جلّ و علا شوق و رضا و بغض و كراهة نفسية ليكون الأمر كاشفاً عن شوقه، و النهي حاكياً عن كراهته، فيمتنع؛ لعدم تعلق الحب و البغض بشيء واحد من حيثية واحدة، و لا تتعلق الإرادة و الكراهة التكوينيتان بالأحكام المذكورة لكي يقال بامتناع تعلقهما بشيء واحد؛ و ذلك لأنّ الأحكام اعتبارية محضة كما قلنا أولاً.
و التحقيق: أنّ ملاك الاستحالة هو تبعية أفعاله - تكوينية كانت أو تشريعية - للمصالح و المفاسد، فأمره بشيء يدل على وجود مصلحة خالصة أو غالبة فيه، و نهية يكشف عن مفسدة كذلك، و من الواضح امتناع اجتماع المصلحة و المفسدة كذلك في شيء واحد. و منه ينبثق أنّ التكليف المحال لا يعقل على مسلك من أنكر تبعية أفعاله للأغراض من منكري الحسن و القبح العقليين.
إلا أن يقال: إنّ اعتبار وجوب شيء مثلاً اعتباراً جدّياً لا صورياً ينافي اعتبار حرمته كذلك تنافياً واضحاً؛ و لا يمكن اجتماعهما أبداً، فتحقق التكليف المحال غير موقوف على مسلك العدلية، لكنّ المقام بعد محتاج إلى مزيد تأمل و تدبر.
و أمّا المكلّف به فيغتبر فيه:
أولاً: أن يكون في فعله مصلحة أو في تركه مفسدة، و إلا كان تعلق الحكم به ترجيحاً بلا مرجح، و تكليفه تعالى الناس به، لغو، تعالى عنه. نعم، في الأوامر و النواهي الامتحانية لا يعتبر ذلك، بل المعتبر فيها وجود المصلحة أو المفسدة في نفس الأمر أو النهي، و إن خلّي عنهما متعلق الأمر و النهي المذكورين.
و ثانياً: أن لا يكون بمحال، بل و لا غير مقدور حين الامتثال، فإنّه قبيح بلا خفاء، و الأشعريون حيث لا يلتزمون - لساناً - بالحسن و القبح العقليين يقولون(1): تكليف ما لا يطاق جائز عندنا! و يريدون به: ما لا يطاق عادة، مثل تكليف الأعمى نقط المصاحف، و الزمن المشي إلى أقاصي البلاد! بل عن شرح المقاصد: التكليف بالممتنع لذاته جائز، بل واقع عند كثير من المحققين! كتكليف أبي لهب بالإيمان بأنّه لا يؤمن، و نقله عن إمام الحرمين و الرازي أيضاً.
أقول: ظاهر الرازي في تفسيره الكبير في ذيل سورة أبي لهب: أنّ جواز التكليف بالممتنع الذاتي بل وقوعه مذهب جميع أهل السنّة!!
لكنّ سنّة الله تعالى على عدمه، كما قال في كتابه العزيز: لاٰ يُكَلِّفُ اَللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ
ص: 270
وُسْعَهٰا، و: لاٰ يُكَلِّفُ اَللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ مٰا آتٰاهٰا، و: يُرِيدُ اَللّٰهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لاٰ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ، و قوله: مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.
و عن النبي الأكرم (ص): «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة». فهذه الترّهات لا تستحق التفاتاً و جواباً.
ثم إنّ العلاّمة الحلي (قدس سره) ذكر شرطاً ثالثاً و نسبه إلى الإمامية، و هو: أن يكون الفعل ما يستحق به الثواب، و إلا لزم العبث و الظلم على الله تعالى.
أقول: و نسبة اعتبارها هذا الشرط إلى الإمامية لعلّها من جهة انطباق الكبرى عليه، و هي مسلّمة بين الإمامية، و لا يقول أحد منهم بجواز العبث و الظلم على الله الحكيم العادل. لكن تطبيقها على المقام عندي غير تام، فإنّ العبثية و الظلم يدفعان باشتمال الفعل على المصلحة، مع أنّ الثواب لا يدفع العبثية، كما سيأتي تحقيقه عن قريب إن شاء الله. نعم، لو فرضنا رجوع المصلحة إلى غير المكلف و قلنا بوجوب الثواب عقلاً على الله تعالى كان الشرط المذكور قوياً.
و أمّا الشخص المكلّف فيعتبر فيه أمور:
1 - الحياة.
2 - العقل.
3 - القدرة حين العمل لا وقت الخطاب، فيجوز خطاب المريض - مثلاً - بالصوم غداً إذا صح قبل طلوع الفجر، هذا إذا كان عدم القدرة لا من جهة المكلف، و أمّا إذا كان من قبله و بسوء اختياره، فهل هو أيضاً مانع عن صحة التكليف، أو لا؟ فيه بحث وخلاف، المسألة محرّرة - أتم تحرير - في أصول الفقه من كتب أصحابنا، و الأقوى سقوط التكليف به و إن استحق العقاب، فالامتناع بالاختيار ينافي الاختيار تكليفاً، و لا ينافيه عقاباً، و تمام الكلام في محلّه.
و اعلم أنّه يدخل في القدرة عدم السهو و النسيان، ضرورة أنّ الساهي و الناسي غي قادرين على ما نسي و سها، و ليس الذكر المقابل لهما شرطاً مستقلاّ في التكليف، و إلا كانا مانعين عن تنجز التكليف لا عن أصله؛ لئلاّ يلزم الدور، كما يأتي بحثه قريباً، مع أنّه لم يقل أحد - على ما أعلم - بذلك، بل قالوا: إنّهما مانعان عن أصل التكليف، و الأمر كما ذكروا؛ إذ لا دليل على اشتراط
ص: 271
ثبوت الأحكام بالذكر، فافهم.
ثم إنّ في المقام مباحث مهمة شريفة تركنا إيرادها اعتماداً على ما حرّره علماؤنا الفحول في فنّ أصول الفقه، و لا يستغني الأفاضل عن مراجعتها.
4 - العلم و اعتباره، كاعتبار بقية الشرائط المتقدمة واضح، ضرورة قبح تكليف الميّت، و المجنون، و العاجز، و الجاهل، نعم، العلم ليس كبقية الشروط دخيلاً في أصل التكليف، بل هو شرط لتنجّزه، فالجاهل و العالم من حيث تعلق الحكم و توجه التكليف إليهما سواء، إلا أنّ الجاهل - إذا كان جهله عن قصور - غير معاقب على مخالفة التكليف المذكور، لا أنّه غير مكلف أصلاً.
وإنّما قلنا ذلك لئلاّ يلزم الدور، فإن العلم بالحكم موقوف على ثبوت الحكم أولاً، توقف الحاكي على المحكيّ عنه، فلو توقف الحكم على العلم به لدار.
الجمهور من المسلمين على أن المصيب من المجتهدين المختلفين في العقليات - سواء كانت متعلقة بالعقائد الدينية، أم لا - واحد، و غيره مخطئ، و ادّعى عليه الإجماع بعضهم. و لا تكون آراء الجميع مطابقة للواقع؛ لأدائه إلى اجتماع النقيضين أو الضدين، و حقّية جميع الملل الفاسدة، و هذا واضح جداً، و قالوا أيضاً(1): إنّ النافي للإسلام مخطئ آثم كافر، اجتهد أم لا.
قال المحقق صاحب الفصول: و الأظهر أن يحتجّ على ذلك - أي على إثمه - بأنّا نرى أدلة المعارف الخمس بالوجدان و العيان واضحة جلية، بحيث لا يكاد يشتبه الحال فيها على منصف سلمت فطرته عن العناد و العصبية، و هو قضية الحكمة الإلهية الداعية إلى خلق هذا النوع، و تكليفهم بالوظائف الشرعية و النواميس الدينية، فإنّ ذلك لا يتمّ مع خفاء البرهان الموصل إلى الإيمان و الإذعان... و على هذا فالمخطئ مقصّر، لكنّه لا يكون آثماً إلا إذا تفطّن التقصير و لو بطريق التجويز و الاحتمال، كما هو الغالب، انتهى كلامه.
لكنّا ذكرنا في مدخل الكتاب: أنّ وجود الجاهل القاصر حسّي، و القارئ بمراجعته يعلم أنّ هذا الكلام ضعيف جداً، مع أنّ تعليق الإثم على أمر زائد على التقصير شيء عجيب، فالحق أنّ قولهم بعدم تصويب المختلفين بأجمعهم صواب، و باستحقاق الإثم لكل مخطئ و إنكار القاصر خطأ، فلاحظ.
ص: 272
و أمّا الفرعيات الشرعية فقالوا: إن كان عليهما دليل قاطع فالمصيب فيها واحد، و إن لم يكن عليها دليل قطعي فبعد استفراغ الوسع لا إثم عليه و إن أخطأ، بلا خلاف إلا من بعض العامة، و لكنّهم اختلفوا في التخطئة و التصويب.
فقيل (كما عن القاضي و الجبائي و جماعة من أهل الخلاف): لا حكم معيّن لله تعالى فيها، بل حكمه تعالى تابع لنظر المجتهد و ظنّه، فما أدّى إليه ظنّه فهو حكم الله تعالى في حقه و حق مقلّديه، فكل مجتهد مصيب!
و قيل: إنّ الله تعالى في كل مسألة حكماً معيناً، أصابه المجتهد أم أخطأه، و هذا هو مذهب الإمامية، كما عن العلامة و الشهيد الثاني (قدس سره).
قال صاحب القوانين(1): ثم القائلون بالتخطئة من العامة اختلفوا، فقال بعضهم: إنّ الله لم ينصب دليلاً على ذلك الحكم المعيّن، و هو بمنزلة الدفين فمن عثر عليه من باب الإنفاق فله أجران، و من لم يصب فله أجر واحد على اجتهاده.
و قال بعضهم: إنّه نصب عليه دليلاً، فقيل: إنّه قطعي، و قيل: إنّه ظنّي...
و القائلون بأنّه ظنّي اختلفوا، فقيل: إنّه لم يكلف بإصابة ذلك الدليل، لخفائه و غموضه... و قيل: إنّه مأمور بالطلب أولاً، فإن أخطأ و غلب على ظنّه شيء آخر انقلب التكليف و سقط عنه الإثم.
أقول: جميع هذه الأقوال بإطلاقها مزيّفة، و الحق أنّ الأحكام بأسرها مخزونة عند الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) من طريق النبي الأكرم (ص)، كما أشرنا إليه في القاعدة الثانية، فبعضها وصل إلى الناس و لم يخالفوا فيه فكان متفقاً عليه بينهم، و بعضها وصل و لكن لم يصبه الجميع، بل أخذه جماعة و أخطأه الآخرون، و هذا المختلف فيه ربّما يكون دليله قطعياً و ربّما ظنّياً، و المجتهد إنّما يكون مأموراً باستنباط الأحكام من أدلتها المعتبرة، لا بإصابة الواقع فإنّه خارج عن قدرته، فإذا استنبط الحكم من الأدلة فإن وافق الواقع فهو، و إلا فالحكم باق بحاله، المجتهد معذور، مأمور بالعمل بهذا الحكم الظاهري غير المنافي للحكم الواقعي المخالف له، كما قرّر وجهه في أصول الفقه تفصيلاً.
و أمّا الدليل على صحة ما ذهب إليه أصحابنا من التخطئة وجوه كما حرّروها في أصول الفقه: فمنها: إجماع أصحابنا الإمامية عليها.
و منها: سيرة الصحابة على تخطئة بعضهم البعض، و هي منقوله بالتواتر أو قريب منه.
ص: 273
و منها: تواتر الأخبار المروية عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) الدالة على أنّ الله في كلّ واقعةٍ حكماً، حتى الأرش على الخدش، و ما دلّ على البرائته في الشبهات البدوية و روايات الاحتياط، و أنّ الأحكام المذكورة مخزونة عند الإمام (ع).
و منها: قوله تعالى: مٰا فَرَّطْنٰا فِي اَلْكِتٰابِ مِنْ شَيْ ءٍ، و قوله: وَ لاٰ رَطْبٍ وَ لاٰ يٰابِسٍ إِلاّٰ فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ، و غيرهما من الآيات الدالة على ثبوت كلّ شيءٍ في الكتاب.
و منها: غير ذلك. و أمّا أدلة المصوّبة فهي ضعيفة جداً، و لا ينبغي أن نطوّل المقام بنقلها و نقدها، و قد زيّفها صاحب الفصول (قدس سره) تفصيلاً، فلاحظ.
أقول: العمدة عندي في بطلان التصويب و انقلاب الحكم الذي هو مختار بعض المخطئة العامة: هي الأخبار المتواترة المشار إليها، مضافاً إلى أنّ التصويب مستلزم للدور المحال كما قرّرناه أولاً.
فتحصّل من جميع ذلك: أنّ العلم ليس شرطاً في ثبوت الأحكام مطلقاً، عقلية كانت أم شرعية، قطعية كانت أم ظنّية، بل التكاليف ثابتة في حق العالم و الجاهل، و كلاهما مكلّف، غير أنّ الجاهل - إذا كان جهله عن قصور - لا عقاب له، سواء في العقائد و الفروع.
تنبيه:
قد ذكرنا في الجزء الأول: أنّ وجوب المعرفة شرعي، فهو يشمل العالم به و الجاهل، كما عرفته هنا، و لكن من غفل و لم يحتمل الضرر لا يجب عليه النظر في أدلة المعارف الاعتقادية واقعاً و ظاهراً، أنّ الحكم ثابت في حقّه واقعاً؛ و ذلك لأنّ موضوعه احتمال الضرر على ما مرّ تفصيله، و بانتفائه ينتفي الحكم المذكور قهراً، و ليس هذا من التصويب في شيء، كما لا يخفى.
5 - البلوغ، و اشتراطه في التكاليف الإلزامية الشرعية من الواجبات و المحرمات التعبدية ممّا لا خلاف فيه أصلاً، لحديث رفع القلم عن الصبي حتى احتلامه. و أمّا في الأحكام الوضعية و التكاليف المندوبة فقال الفقيه النبيل السيد اليزدي (قدس سره)(1): لا إشكال في ثبوت الأحكام الوضعية الغير الموقوفة على القصد و النية في حقه، كالضمان بالإتلاف و اليد و الجنابة و الحدث و النجاسة و الطهارة و نحو ذلك، و أمّا غير ذلك مما يعتبر فيه القصد فمقتضي القاعدة استحباب المستحبات العقلية عليه إذا أدركها عقله، بل لا يبعد أن يقال بوجوب واجباتها على الفرض
ص: 274
المذكور... و أمّا عباداته من الصلاة و الصوم و الحجّ و غيرها فالظاهر أنّها صحيحة شرعية كما عن المشهور.
بل يمكن أن يقال: إنّ خطابات المستحبات شاملة للصبي أيضاً، خصوصاً إذا كانت بطريق الوضع؛ إذ القدر المعلوم رفع قلم التكاليف الواجبة، و هذا لا ينافي ثبوت الاستحباب... و أمّا عقوده و إيقاعاته فالظاهر عدم نفوذها إذا صدرت عنه على وجه الاستقلال، أي بدون إذن الولي من غير إشكال و لا خلاف إلا في موارد...
أقول: العمدة في المقام هو: أنّ البلوغ هل يعتبر في وجوب النظر و المعرفة أو لا؟ فيه خلاف بينهم، و قد تقدم في كلام السيد المتقدم نفي البعد عن عدم اعتباره.
و حكي عن مجمع البرهان: أنّهم - المراهقين - إذا قدروا على الاستدلال و فهموا أدلة وجود الواجب و التوحيد و ما يتوقف عليه وجوب المعرفة و الإسلام يمكن أن يجب عليهم ذلك؛ لأنّ دليل وجوب المعرفة عقلي، و لا استثناء في الأدلة العقلية، فلا يبعد تكليفهم...
ثم حكي عن بعض العلماء التصريح: بأنّ الواجبات الأصولية العقلية تجب على الطفل قبل بلوغه دون الشرعية، و الظاهر أنّ ضابطة القدرة على الفهم و الاستدلال على وجه مقنع. انتهى.
قال المحقق القمّي في القوانين(1): بعض المتكلمين صرّح بعدم اشتراط البلوغ في التكليف بالمعارف... و عن الشيخ (رحمه الله): أنّ التكليف بالمعارف في الذكران هو بلوغ عشر سنين إذا كان عاقلاً.
أقول: و إلى عدم الاشتراط ذهب بعض من تأخر عنهم، قال(2): إذ الوجوب فيها من وجوب شكر المنعم، و هو عقلي لا توقف له بالبديهة على غير الفهم و الإدراك.
هذا، و لكن ذكر قدرة الفقهاء صاحب الجواهر - قدس الله نفسه الزكية -: أنّه كالاجتهاد في مقابلة المقطوع به نصّاً و فتوى من رفع القلم، و قال: و أمّا قبول إسلام علىّ (ع) فهو من خواصّه(3).
أقول: و هذا الكلام يدل على اشتراط صحة الإسلام بالبلوغ فضلاً عن وجوبه.
قال سيدنا الأستاذ الحكيم دام ظلّه(4): بل قيل بوجوبه عليه كوجوبه على البالغ، و حديث رفع القلم لا مجال له؛ لأنّ وجوب الإسلام عقلي أو فطري بمناط دفع الضرر المحتمل، و مثله لا
ص: 275
يرتفع بحديث رفع القلم؛ لاختصاصه بما يكون رفعه و وضعه بيد الشارع.
و فيه: أنّ احتمال الضرر الذي هو موضوع الحكم العقلي أو الفطري يرتفع بالحديث المذكور، و كذا الحال في بقية المعارف الدينية، سواء كان وجوبه عقلياً أو شرعياً فإنّه يمكن رفعه بحديث رفع القلم انتهى.
أقول: و يمكن أن يقال: إنّ ما أفاده - دام ظله - مبنيّ على أنّ المرفوع هو قلم المؤاخذة، كما استظهره شيخنا الأنصاري، و أمّا إذا قلنا: إنّه قلم الكلفة و الثقل و الإلزام و المشقّة ليكون مفاده نفي الواجبات و المحرمات فلا يتم؛ فإنّ التكاليف العقلية لا يكون وضعها بيد الشارع حتى يرفعها، فلا محالة يختصّ الحديث بالأحكام الشرعية المحضة.
و ممّا يدلّ على هذا الاحتمال أو يؤيده هو سياق بعض روايات الباب، فإنّ المرفوع عن المجنون و النائم هو التكليف، لا المؤاخذة فقطّ، فكذا في الصبيّ. و لا أقلّ من الشك في ذلك فلا يمكن الاعتماد عليه، و حينئذٍ لا يمكن رفع موضوع الحكم العقلي المذكور بمثله، كما ليس بسرّ.
و التحقيق في هذا المقام: أنّ صحة إسلام الصبيان و اعتبار عقائدهم الحقة ممّا لا شك في عدم اعتبار البلوغ فيها، بل المميّز إذا اعتقد بالله و صفاته و برسوله و وليه فهو مسلم مؤمن كبقية المؤمنين، و ذلك لأجل عموم الآيات و الروايات، فصحة إسلام أمير المؤمنين(1) ليست من خواصه و إن كانت من كماله و أمّا وجوب المعرفة فهو ليس عقلياً، بل هو شرعي، كما مرّ في مدخل الكتاب(2)، و قلنا هناك: إنّ الشارع أوجب تحصيلها على المكلفين.
و النظر و إن يجب عقلاً بملاك دفع الضرر المحتمل لكنّ وجوبه طريقي تابع لوجوب المعرفة عموماً و خصوصاً، فإذا فرضنا أنّ الشارع لم يرد من الناس معرفته قبل البلوغ و أمهلهم في تلك المدة لا يدرك العقل بتركها ضرراً ليدرك دفعه، فلا يجب النظر أيضاً.
و على الجملة: وجوب النظر معلول لوجوب دفع الضرر المحتمل الناشئ عن إيجاب الله تعالى معرفته على الناس، فإذا كان الإيجاب المذكور مختصاً بما بعد البلوغ لإطلاق حديث «رفع القلم» كان وجوب النظر أيضاً مختصاً به.
ص: 276
نعم، لو كان طالب المعرفة غافلاً عن هذه التوسعة أو ملتفتاً إليها، لكنّه لم يطمئن بصحتها؛ لعدم حجية مثل هذا الحديث في حق مثله، وجب عليه النظر بحكم فطرته.
فتحصّل: أنّ الموضوع للحكم الفطري - و هوالضرر المحتمل - تابع للحكم الشرعي في تحديده، إلا أنّ الحكم العقلي - هو وجوب شكر المنعم - لا يتبع الحكم الشرعي المذكور في حدوثه و بقائه، ضرورة عدم إمكان التخصيص في الأحكام العقلية، و لا شك أنّ ترك شكر المنعم قبيح و إن لم يطلبه المنعم من المنعم عليه. نعم، لونهاه عن شكر خاص لمبغوضيته عنده لقبح العقل إتيانه من المنعم عليه فإنّه إساءة لا إحسان و شكر للمنعم، و المفروض أنّ الشارع ما أبغض معرفته أصلاً، و إنّما لم يوجبها على غير البالغين. و العقل يلزم المميّژ الملتف على لزوم النظر إلى معرفة المنعم أداءً لشكر نعمائه، لكن لو ترك الشخص المذكور النظر عمداً يستحق الذم، و لا يستحق العقاب و الخلود، كما مرّ وجهه في أوائل الجزء الأول، و إنّما المصحّح للعقاب هو مخالفة الحكم الفطري دون العقلي.
هذا، و لكنّه لو تمّ لجرى في الفرعيات أيضاً و لا سيما بعد كون عبادات الصبي شرعية، و أنّه مكلف بالمستحبات، بل لازمه وجوب المستحبات على البالغين، فإنّ العبادة و امتثال أوامر المولى المنعم شكر له، و هو واجب على العبد المنعم عليه. هذا، مع أنّا ذكرنا فيما تقدم عدم استلزام وجوب الشكر لوجوب النظر، فافهم المقام.
و ممّا يدل على ما ذكرنا من عدم وجوب النظر و المعرفة على غير البالغ: الروايات الصحاح الدالة على تكليف الأطفال في القيامة الظاهرة في عدم تكليفهم في الدنيا، و سيأتي الكلام حولها في بعض قواعد هذا المقصد إن شاء الله.
فتحصّل من جميع ما مرّ: أنّ المكلف هو الحيّ العاقل القادر العالم البالغ.
و الشرط الأول عقلي فقط، و الأخير تعبّدي فقط، و ما توسّط بينهما عقلي و نقلي.
و الفاضل المقداد - في أوائل شرح الحادي عشر - خصّه بالإنسان، فعرّفه بأنّه هو الإنسان الحيّ البالغ العالم. لكنّه غير صحيح، فإنّ الجنّ أيضاً مكلفون، قال الله تعالى: وَ مٰا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاّٰ لِيَعْبُدُونِ و قال: وَ لَقَدْ ذَرَأْنٰا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ... إلى آخره، وقال تعالى حكاية عن لسانهم: وَ أَنّٰا مِنَّا اَلْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا اَلْقٰاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً * وَ أَمَّا اَلْقٰاسِطُونَ فَكٰانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً، و الآيات في ذلك كثيرة بل ربما قيل بأنّ لهم رسلاً من الله تعالى، مستدلاً بقوله تعالى: يٰا مَعْشَرَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ
ص: 277
مِنْكُمْ...(1).
أقول: و أجيب عنه بأنّ الرسل من الإنس، و قوله: مِنْكُمْ لا يدل على أزيد من أنّ الرسل من مجموع الجنّ و الإنس، و لا دلالة على أنّ الرسل من كل واحد من الإنس و الجنّ.
قلت: و فيه: أنّ الجانّ خلقوا قبل الإنس، قال الله تعالى: وَ اَلْجَانَّ خَلَقْنٰاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نٰارِ اَلسَّمُومِ، و هم أمّة و لكلّ أمّة رسول، و لا إنس في ذلك الوقت حتى يكون الرسول منهم، فافهم. على أن هذا الجواب مجرّد احتمال مخالف لظاهر الآية.
و عن أمير المؤمنين (ع)(2) في جواب من سأله عن أنّ الله هل بعث نبياً إلى الجنّ: «نعم، بعث إليهم نبياً يقال له: يوسف، فدعاهم إلى الله فقتلوه».
بل الظاهر أنّ الملائكة أيضاً مكلفون، و إن لم يشقّ عليهم وظائفهم، لقوله تعالى: لاٰ يَعْصُونَ اَللّٰهَ مٰا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مٰا يُؤْمَرُونَ.
و يمكن أن يستأنس من نفي نسبة العصيان إليهم أنّهم مختارون في أفعالهم, و كذا من قوله تعالى: وَ يَفْعَلُونَ مٰا يُؤْمَرُونَ.
قال: شيخنا المفيد (رحمه الله)(3): أقول: إنّ الملائكة مكلفون و موعودون و متوعّدون, قال الله تبارك و تعالى: وَ مَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلٰهٌ مِنْ دُونِهِ فَذٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ....
و أقول: إنّهم معصومون ممّا يوجب لهم العقاب بالنار. و على هذا القول جمهور الإمامية و سائر المعتزلة و أكثر المرجئة و جماعة من أصحاب الحديث, و قد أنكر قوم من الإمامية أن يكون الملائكة مكلّفين, و زعموا أنّهم إلى الأعمال مضطرّون, و وافقهم على ذلك جماعة من أصحاب الحديث. انتهى كلامه.
و قال العلامة المجلسي (قدس سره) في بحاره(4): و أمّا حشر الحيوانات فقد ذكره المتكلمون من
ص: 278
الخاصة و العامة على اختلاف منهم في كيفيته, و قال أيضاً: الأخبار الدالة على حشرها عموماً و خصوصاً و كون بعضها مما يكون في الجنة كثيرة انتهى.
لكنّ ذلك كلّه أعمّ من كونها مكلفة بتكاليف في الدنيا.
قال الطبرسي في المجمع عند قوله تعالى: وَ إِذَا اَلْوُحُوشُ حُشِرَتْ: أي جمعت حتى يقتصّ لبعضها من بعض, فيقتصّ للجماء من القرناء, يحشر الله سبحانه الوحوش ليوصل إليها ما تستحقه من الأعواض على الآلام التي نالتها في الدنيا, و ينتصف لبعضها من بعض, فإذا وصل إليها ما تستحقه من الأعواض, فمن قال: إنّ العوض دائم قال: تبقى منعمة إلى الأبد, و من قال باستحقاقها العوض منقطعاً, فقال بعضهم: يديمه الله بها تفضّلاً؛ لئلّا يدخل على المعوّض غَمّ بانقطاعه, و قال بعضهم: إذا فعل الله بها ما استحقّته من الأعواض جعلها تراباً.
و عن بعضهم: أنّ حشرها يوم القيامة للعوض و القصاص هو المشهور بين المتكلمين من الخاصة و العامة.
و قال الرازي في تفسير قوله تعالى: وَ إِذَا اَلْوُحُوشُ حُشِرَتْ: قال قتادة: يحشر كل شيء حتى الذباب للقصاص. و قالت المعتزلة: إنّ الله تعالى يحشر الحيوانات كلها في ذلك اليوم ليعوّضها على آلامها التي وصلت إليها في الدنيا بالموت و القتل و غير ذلك, فإذا عوّضت عن تلك الآلام فإن شاء الله أن يبقى بعضها في الجنة إذا كان مستحسناً فعل, و إن شاء أن يفنيه أفناه على ما جاء به الخبر, و أمّا أصحابنا فعندهم أنّه لا يجب على الله شيء بحكم الاستحقاق, و لكنّ الله يحشر الوحوش كلها فيتقصّ للخماء من القرناء, ثم يقال لها: مواتي, فتموت. انتهى.
قال أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان عند قوله تعالى: وَ مٰا مِنْ دَابَّةٍ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاٰ طٰائِرٍ يَطِيرُ بِجَنٰاحَيْهِ إِلاّٰ أُمَمٌ أَمْثٰالُكُمْ مٰا فَرَّطْنٰا فِي اَلْكِتٰابِ مِنْ شَيْ ءٍ ثُمَّ إِلىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (1).
و استدلت جماعة من أهل التناسخ بهذه الآية عن أنّ البهائم و الطيور مكلفة لقوله: أُمَمٌ أَمْثٰالُكُمْ, و هذا باطل؛ لأنّا قد بيّنا أنّها من أيّ وجه تكون أمثالنا... و كيف يصح تكليف البهائم و هي غير عاقلة, و التكليف لا يصح إلّا مع كمال العقل؟!
أقول: نفي الإدراك و التمييز المصحّح للتكليف عن الحيوانات غير واضح, بل الكتاب
ص: 279
و السنّة و العلم الحديث على خلافه. نعم, مجرد قوله تعالى: أُمَمٌ أَمْثٰالُكُمْ لايدل على تكليفها, لكّنه إذا انضمّ إليه قوله تعالى في سورة فاطر: وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاّٰ خَلاٰ فِيهٰا نَذِيرٌ, و قوله تعالى: وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ (1) ينبج إنّ لكل نوع من أنواع الحيوانات نذيراً فتكون مكلفة بتكاليف. و هذا ممّا لا دافع له إلّا دعوى انصراف لفظ «الأمة» في الآيتين إلى الناس, و يؤيد هذا الاستدلال: ما في المجمع(2) عن أبي هريرة أنّه قال: يحشر الله الخلق يوم القيامة البهائم و الدوابّ و الطير و كل شيء, فيبلغ من عدل الله يومئذٍ أن يأخذ للجماء من القرناء، ثم يقول: كوني تراباً فلذلك يقول الكافر: ياليتني كنت تراباً.
لكنّ السند ضعيف، و أبو هريرة هذا كذّاب مشهور، على أنّه لم يسند قوله إلى النبي الأكرم (ص).
و عن أبي ذرّ قال: بينا أنا عند رسول الله إذ انتطحت عنزان، فقال النبي (ص): «أتدرون فيما انتطحا؟»، فقالوا: لا ندري لكن الله يدري، و سيقضي بينهما.
و هذا أيضاً لإرساله ضعيف.
قال العلامة المجلسي (رحمه الله) في السماء و العالم من بحاره(3): و قد لاح من ظواهر كثير من الآيات و الأخبار أنّ لها - أي للحيوانات - شعوراً و معرفة، بل لهم تكاليف يعاقبون على ترك بعضها في الدنيا، و على ترك بعضها في الآخرة، لا على الدوام، بل في مدة يحصل فيها التقاصّ بين مظلومها و ظالمها... إلى آخره.
و عن الكافي: عن أمير المؤمنين (ع): أنّه (ع) عدّ من الذنب الذي لا يغفر نطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجماء.
فتحصّل من جميع ما تقدم: أنّ قوله تعالى: ثُمَّ إِلىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، و قوله: وَ إِذَا اَلْوُحُوشُ حُشِرَتْ يدلاّن على حشر الحيوانات، و الأول بصدره و بانضمام ما عرفت يدل على تكليفهم - لو لا دعوى الانصراف المذكور - فنفهم أنّ الحشر لأجل الجزاء و الانتقام.
ص: 280
ثم إنّ من المؤلفين من يدّعى بطلان تكليف الحيوانات بضرورة الشريعة و ظواهر الآيات و الروايات، لكنّه تعسّف محض.
و التحقيق أن تكليف الحيوانات حسب شعورهم و أجسامهم ممكن و لكننا لا نجزم به، و أما حشرها يوم القيامة فبعيد جداً، إذ أنواعها كثيرة جداً و قيل أن أنواع الحشرات بمفردها ثلاثمأة ألف.
و المراد من حشر الحيوانات في الآتية المتقدمة لعلّ جمع الحيوانات الموجودة على الأرض قبل قيام الساعة نعرض لا نعلمه، و ليست الآية المذكورة بظاهرة فيما يقولون. و الله العالم بأفعاله و أحكامه.
و الحاصل: أنّ قيد الإنسان في المكلف غير مطابق للواقع، و أنّ غير الإنسان أيضاً مكلف.
ثم إنّ هنا شرطاً آخر قيل باعتباره في أصل التكليف بالفرعيات زائداً على الشروط السابقة، و هو الإسلام، و أول من قال به - على ما أعلم - هو المحدث الحكيم الكاشاني (رحمه الله)، ثم اختاره المحدّث الجليل البحراني و أصرّ عليه، و استظهره من المحدّث الأمين الأسترآبادي أيضاً، لكنّ عبارته لا تساعد ذلك(1).
و عن الفاضل السبزواري في الذخيرة: أنّ تحقيق المقام من المشكلات.
أقول: لكنّ المنسوب إلى المشهور بل قيل: كاد أن يكون إجماعاً تكليف الكفّار بالفروع، و أنّ الإسلام ليس شرطاً لنفس التكليف، بل لصحة المكلف به في الجملة.
و أمّا العامة فعن بدائع الصنائع للكاشاني الحنفي(2): الكفّار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات عندنا... إلى آخره.
و عن المعني(3): اختلفوا في خطاب الكافر بفروع الإسلام في حال كفره، مع إجماعهم على أنّه لا يلزم قضاءها بعد إسلامه، حكي عن أحمد في هذا روايتان.
و عن أصول الفقه الخفري(4): اختلف الحنفية في هذه المسألة... و لم يقولوا بهذه الأقوال نقلاً عن أبي حنيفة؛ لأنّه لم يحفظ عنه فيها قول، و إنّما استخرجوها من فروع مذهبية(5).
هذا، و الذي يظهر من صاحب الحدائق (رحمه الله): أنّ القول بعدم تكليف الكفّار لم ينسب إلى أحد
ص: 281
من الخاصة و العامة، سوى أبي حنيفة و سوي الكاشاني و الأسترآبادي، و قد ذكرنا أنّ عبارة الأسترآبادي لا تدل على ذلك، فلا قائل به منّا إلاّ هو و الكاشاني (قدس سره).
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المحدّث البحراني المشار إليه (قدس سره) ذكر لإثبات مختاره وجوهاً(1):
1 - عدم الدليل على التكليف، و هو دليل العدم، كما هو مسلّم بينهم.
أقول: و يظهر ضعفه بما ستعرفه من الأدلة الدالة على التكليف.
2 - لزوم تكليف ما لا يطاق؛ إذ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تصوراً و تصديقاً عين تكليف ما لا يطاق.
أقول: إن تمّ لعمّ نفي تكليفه بالأصول أيضاً، فيكون الكفّار بأسرهم غير مكلفين بشيء، و هو كما ترى، بل لا قائل به من المسلمين.
و حلّه: أنّ كل كافر ليس بغافل و جاهل قاصر لكي لا يصح تكليفه و عقابه، بل أكثر ملتفتين إلى الديانة الإسلامية فروعاً و أصولاً، و مجرد الاحتمال و الشك كافٍ في صحة تكليفهم و عقابهم في فرض عدم الاعتناء، و ينتقض بالمسلمين الجاهلين بالشريعة الاسلامية، فهل يمكن أن يقول هذا القائل بسقوط التكليف عنهم، على أن الجهل كما مرّ ليس من شروط التكليف و إنّما هو شرط التنجز التكليف و استحقاق العقاب، إذا كان عن قصور.
3 - الأخبار الدالة على وجوب طلب العلم، كقولهم (عليهم السلام): «طلب العلم فريضة علم كل مسلم»، فإنّ موردها المسلم دون مجرد البالغ العاقل.
أقول: و فيه أولاً: ما ورد عن الصادق (ع): من أنّ طلب العلم فريضة في كل حال، و أنّه فريضة من فرائض الله»(2)، فتأمل.
و ثانياً: أنّ تخصيص المسلم للتشريف، أو لأجل أنّه المنتفع به دون الكافر، لا للتخصيص.
و على الجملة: غاية ما في الرواية عدم الدلالة على تكليف الكفار، لا الدلالة على عدمه.
4 - اختصاص الخطاب القرآني بالذين آمنوا، و ورود «أيّها الناس» في بعض - و هو الأقلّ - يحمل على المؤمنين حمل المطلق على المقيّد، و العامّ على الخاصّ، كما هو القاعدة المسلّمة بينهم.
أقول: و يظهر جوابه من بعض ما ذكرناه في سابقه، و أمّا ما ذكره من حمل الناس على
ص: 282
المؤمنين فهو غفلة منه (رحمه الله) عن قواعد أصول الفقه و شرائط التخصيص و التقييد.
5 - الأخبار الواردة في ذلك:
فمنها: ما في الاحتجاج عن أمير المؤمنين (ع): «فكان أول ما قيّدهم به الإقرار بالوحدانية و الربوبية و شهادة أن لا إله إلاّ الله، فلمّا أقرّوا بذلك تلاه بالإقرار لنبيه (ص) بالنبوة و الشهادة بالرسالة، فلما انقادوا لذلك فرض عليهم الصلاة، ثم الصوم، ثم الحج... إلى آخره».
أقول: الرواية مع ضعفها سنداً تدل على شرطية الإقرار بالله تعالى في وجوب الإقرار بالنبوة و الرسالة، و على شرطية وجوب الصلاة في وجوب الصوم و اعتباره في وجوب الحج، و هذا ممّا لا أعرف له قائلاً، و الظاهر أنّ الرواية ناظرة إلى تدريجية التشريع بالتكاليف الدينية، و لا ربط لها بمراد المستدل.
و منها: ما في تفسير القمّي من قول الإمام الصادق (ع) في تفسير قوله تعالى: وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ اَلَّذِينَ لاٰ يُؤْتُونَ اَلزَّكٰاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كٰافِرُونَ: «أترى أنّ الله عز و جل طلب من المشركين زكاة أموالهم و هم يشركون به، حيث يقول: وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ - الآية - و إنّما دعا الله العباد للإيمان به، فإذا آمنوا بالله و رسوله افترض عليهم الفرائض.
أقول: مثل هذه الرواية الضعيفة سنداً لا يهدم ظهور الآية المباركة أصلاً. فالرواية و إن رويت بطريقين(1) كما في تفسير البرهان مع تفاوت في متنها إلاّ أنّ كليهما ضعيف.
و منها: قول الباقر (ع) في تفسير قوله تعالى: أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ (2): «كيف يأمر الله بطاعتهم و يرخص في منازعتهم؟ إنّما قال ذلك للمأمورين الذين قيل لهم: أطيعوا لله و أطيعو الرسول».
أقول: هذه الرواية رويت - كما في تفسير البرهان - بسندين: أحدهما صحيح، و ثانيهما مجهول، و متن الرواية - بطريقيها - يغاير ما ضبطه المستدلّ، و المراجع إلى التفسير المذكور يدرك بأول نظرة أنّ الرواية أجنبية عن محلّ النزاع بالكلّية، و أنّ مساقها أمر آخر.
و منها: صحيحة زرارة(3)، قال: قلت لأبي جعفر (ع): أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال: «إنّ الله بعث محمداً (ص) إلى الناس أجمعين رسولاً و حجة لله على
ص: 283
خلقه في أرضه، فمن آمن بالله و بمحمد رسول الله و اتّبعه و صدّقه فإن معرفة الإمام منّا واجبة عليه، و من لم يؤمن بالله و برسوله و لم يتّبعه و لم يصدّقه و يعرف حقّهما فكيف تجب عليه معرفة الإمام و هو لم يؤمن بالله و رسوله و يعرف حقّهما...؟!» الحديث.
قال المستدل: و هو كما ترى صريح الدلالة على خلاف ما ذكروه، فإنّه متى لم تجب معرفة الإمام قبل الإيمان بالله و رسوله، فبطريق أولى معرفة سائر الفروع التي هي متلقّاه من الإمام (ع).
أقول: هذا هو العمدة في هذه المسألة، لكنّها أيضاً غير دالة على ما ذكره، فإنّ عدم وجوب معرفة الإمام لايستلزم عدم وجوب الفرعيات؛ لإمكان أخذ الأحكام منه من حيث كونه ثقة و مخبراً، لا من حيث كونه إماماً و خليفة عن الرسول (ص)، فالأولوية المذكورة في كلامه لا ترجع إلى محصّل.
بل أضف و أقول: إنّ الرواية صريحة الدلالة على بطلان الأولوية المذكورة؛ و ذلك لأنّ وجوب معرفة الإمام (ع) علّق في الرواية على معرفة الله تبارك و تعالى و معرفة رسوله الكريم و تصديقه و اتّباعه، و من الظاهر أنّه لا معنى لاتّباعه في غير العمل بشريعته و الامتثال لأوامره و نواهيه، فيكون تكليف الناس بالفروع مقدماً على تكليفهم بمعرفة الإمام، و هذا ما قلنا من صراحة دلالة الرواية على خلاف ما ادّعاه من صراحتها في مرامه! (فتأمّل).
ثم إنّ ظاهر الرواية عدم تقيّد التكليف بالفروع بشيء أصلاً، بل هو كوجوب معرفة النبي عامّ يشمل الناس جميعاً، فتدل الرواية على أنّ الكفار مكلفون بالفروع كما هو مكلفون بمعرفة الله تعالى و معرفة رسوله، فهي حجة للمشهور، لا للمستدل و من سبقه كالمحدث الكاشاني.
و الحاصل: أنّ مفاد الرواية هو عدم تكليف الكفار بمعرفة الإمام فقط، لا بالفروعات الشرعية كما هو محلّ الكلام و مورد النزاع، بل مفادها - كما عرفت - تكليفهم بها.
فإن قلت: نعم، لكنّك هل تقول به و تلتزم بعدم وجوب معرفة الإمام على الكفار؟ قلت: هذا الالتزام ممكن لا مانع منه عقلاً، غير أنّه بعيد جداً، بل لم أجد - عاجلاً - أحداً التزم به.
و وجه الاستبعاد: أنّ الناس مكلفون بالإسلام الذي بني على الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية، و قد صرح في الروايات أنّ الأخير أهمها، فإذا ثبت تكليف الكفار بالأربعة المذكورة فكيف لا يثبت تكليفهم بها؟!
و عندي أنّ احسن ما يمكن أن يحمل عليه الصحيحة هو نظارتها إلى مقام الإثبات؛ إذ من لم يؤمن بالله و رسوله و لم يتّبعه و يصدّقه في أقواله، و لا يمكن إثبات وجوب معرفة الإمام عليه، فإن الإمام خليفة الرسول و نصبه بتعيينه، فهو الذي يوجب معرفة وصيّه، فإذا كان الشخص لم يعرف النبي و لم يصدّقه فكيف يذعن بوجوب معرفة وصيّه؟!
ص: 284
على أن الأحكام الشريعة و الفروع الفقهية على أقسام منها ما هي غير متلقّاة من غير الإمام, بل هي متلقاة من القرآن المجيد و من السنة النبوية المواترة أو المسلّمة و من العقل و لا قائل بالتفصيل.
هذا كلّه حول اءدلة المحدث البحراني المذكور و بيان ضعفها و سقوطها.
و زبّما استدل بعضهم بأن الفروع لو كانت واجبة على الكافر: فإمّا أن يكون و جوبها عليه حال كفره, أو حال الإسلام, و كلاهما باطل, أمّا الأول فلا متناعها منه حال الكفر؛ لأنّها مشروطة بالقربة, و هي ممتنعة من الكافر, و أيضاً لا تصح منه حال الكفر إجماعاً.
و أمّا الثاني فلسقوطها عنه بالإسلام؛ لأنّ «الإسلام يجبّ ما قبله».
أقول: و فيه بحث, فإن إزالة الكفر للكافر ممكنة فلا يمتنع منه العبادة, على أنّه لايتم في المعاملات التي لا يعتبر فيها قصد القربة, فافهم.
و بالجملة: التكليف حال الكفر و حينه لا بشرطه و لحاظه, و الأول لا بأس به, و إنّما الممتنع الثاني. و أما حديث «جبّ الإسلام» فلا عموم فيه, فإنّ الكافز كما يكلف - مثلاً - بوجب الوفاء بعقوده حال الكفر كذلك يكلف به حال الإسلام.
و خلاصة القول: إنّ هذه النظرية و إن كانت لها صورة حسنة بملاحظة جملة من الآيات المتكفّلة لبيان عدّة من الفروعات, حيث إنّ الخطاب فيها إلى الذين آمنوا, لا إلى عموم الناس, لكنّها ضعيفة الأساس منهدمة النظام, فإنّ من لا حظ القرآن من أوله إلى آخره بدقّة يجد فيه أكثر من خمسين آية دالة على تكليف الكفار بالفروع, فلا يشك حينئذٍ في بطلان المقالة المذكورة, و نحن نذكر لك جملة من الآيات الشريفة, ثم نشير إلى بقيتها في الحاشية.
فمنها: قوله تعالى: يٰا بَنِي إِسْرٰائِيلَ اُذْكُرُوا نِعْمَتِيَ... وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ وَ اِرْكَعُوا مَعَ اَلرّٰاكِعِينَ (1).
و منها: قوله تعالى: وَ تَرىٰ كَثِيراً مِنْهُمْ أي من أهل الكتاب يُسٰارِعُونَ فِي اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوٰانِ وَ أَكْلِهِمُ اَلسُّحْتَ لَبِئْسَ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ (2), فتأمل.
و منها: قوله تعالى: لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ (3) و مثله كل آية متضمنة للتكليف و خوطب فيها الناس.
ص: 285
و منها: قوله: إِنّٰا جَعَلْنَا اَلشَّيٰاطِينَ أَوْلِيٰاءَ لِلَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ * وَ إِذٰا فَعَلُوا فٰاحِشَةً قٰالُوا وَجَدْنٰا عَلَيْهٰا آبٰاءَنٰا... قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ اُدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ (1).
و منها: قوله: يٰا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَ اِشْرَبُوا وَ لاٰ تُسْرِفُوا...
قُلْ إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ وَ اَلْإِثْمَ وَ اَلْبَغْيَ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ... وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اَللّٰهِ مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ... يٰا بَنِي آدَمَ إِمّٰا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيٰاتِي فَمَنِ اِتَّقىٰ وَ أَصْلَحَ فَلاٰ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاٰ هُمْ يَحْزَنُونَ (2) .
و منها: قوله: وَ لاٰ تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيٰاتِنٰا وَ اَلَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ تَعٰالَوْا أَتْلُ مٰا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاّٰ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَوْلاٰدَكُمْ مِنْ إِمْلاٰقٍ... وَ لاٰ تَقْرَبُوا اَلْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ وَ لاٰ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللّٰهُ إِلاّٰ بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصّٰاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَ لاٰ تَقْرَبُوا مٰالَ اَلْيَتِيمِ إِلاّٰ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا اَلْكَيْلَ وَ اَلْمِيزٰانَ بِالْقِسْطِ, لاٰ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا. وَ إِذٰا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ بِعَهْدِ اَللّٰهِ أَوْفُوا ذٰلِكُمْ وَصّٰاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ...(3).
و منها: قوله: وَ اَللّٰهُ لاٰ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتٰالٍ فَخُورٍ اَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ اَلنّٰاسَ بِالْبُخْلِ (4).
و منها: قوله: مٰا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قٰالُوا لَمْ نَكُ مِنَ اَلْمُصَلِّينَ وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ اَلْمِسْكِينَ (5).
ص: 286
و منها: قوله: وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ اَلَّذِينَ لاٰ يُؤْتُونَ اَلزَّكٰاةَ (1).
و ما ورد في تفسيره غير منافٍ لظاهره، مع أنّه ضعيف السند.
هذا بعض ما يدل على أنّ الكفار مكلفون بالفروع، و فيه غنىً و كفاية قطعية(2).
و يمكن أن يستدل أيضاً بقوله تعالى: إِنَّ اَلدِّينَ عِنْدَ اَللّٰهِ اَلْإِسْلاٰمُ، بضميمة ما ورد في الروايات المستفيضة من أنّ «الإسلام بني على خمس: الصلاة، و الزكاة و الحج، و الصوم، و الولاية»، فافهمه.
ثم إنّه حكي الإجماع على ذلك أيضاً من غير واحد(3)، لكنّا نعتمد عليه، بعد ما عرفت من دلالة الآيات البيّنات عليه كما أنّا لا نرى لزوماً لنقل الأخبار الدالة على ذلك، كما نقلها بعض العلماء السادة(4)، فإنّا أوضحنا المسألة من الكتاب العزيز بما لا مزيد عليه(5).
و في المسألة قول آخر، و هو: أنّ الكفّار مكلفون بالنواهي دون الأوامر، و هو و إن لم يكن مثل سابقه في ظهور البطلان لكنّه أيضاً قطعي الفساد، كما يظهر من الآيات المتقدمة.
المتحصّل ممّا تقدم: أنّ الإسلام ليس شرطاً لوجوب الأحكام الفرعية، بل هي ثابتة على
ص: 287
ذمّه جميع الناس، نعم، لا شك في أنّه شرط لصحة العبادات و دخول الجنة، و التقرب إلى الحق، كما هو ثابت بالضرورة الدينية، و لكن تخيّل بعض كتّاب العصر(1): أنّ الإسلام ليس شرطاً لدخول الجنة و قبول العمل، بل يكفيه مجرد الإيمان بالله تعالى، و كأنّه لا يرى للنبوة مدخلية في صحة التدين و السعادة الأخروية.
كما أنّ العامة لا ترى للإمامة دخلاً في أصول الدين، و استدل هذا القائل على ما تأدّى إليه نظره أو أدّاه إليه غرضه بجملة من الآيات القرآنية التي هي بين ما يدل على بطلانه، و بين ما لا يرتبط بمرامه.
و أحسن دلالة على مرامه ممّا ذكره قوله تعالى: إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اَلَّذِينَ هٰادُوا وَ اَلنَّصٰارىٰ وَ اَلصّٰابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ عَمِلَ صٰالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لاٰ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاٰ هُمْ يَحْزَنُونَ (2)، و قوله تعالى: مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ.
أقول: لكن لا أدري أنّ الذي حمله على هذا القول هو جهله، أو تجاهله؟ فحيث أنظر إلى استدلاله على مزعومه بقوله تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اَللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ أظنّ أنه جاهل؛ إذ الملتفت لا يستدل بما هو نصّ على بطلان قوله، و حين أنظر إلى مخالفة دعواه لضرورة الدين الإسلامي و أنّها محكومة بالبطلان عند نساء المسلمين و صبيانهم المميّزين، أظنّ أنّه متعمّد، فهو و إن ادّعى أنه مسلم مؤمن لكنّ كلماته تشهد على شيء آخر، و الله أعلم».
و على الجملة: هذه النظرية نظرية إلحادية مكذّبه للقرآن الكريم، بل لجميع الشرائع، و لا أظنّ أن يقبلها أحد من الملّيين؛ إذ كلّ متديّن يرى احقية دينه و بطلان ما يخالفه، و أمّا الدليل على بطلانه من القرآن فهو كثير، نذكر بعضها:
1 - قال الله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَتَّخِذُوا اَلْيَهُودَ وَ اَلنَّصٰارىٰ أَوْلِيٰاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ، وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظّٰالِمِينَ (3).
فلو كان أهل الكتاب على حقّ لمّا نهى الله عن تولّيهم.
2 - و قال: فإن آمنوا (أي أهل الكتاب اليهود و النصارى) بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا
ص: 288
وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمٰا هُمْ فِي شِقٰاقٍ. وجه الدلالة ظاهر.
3 - وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ اَلْإِسْلاٰمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي اَلْآخِرَةِ مِنَ اَلْخٰاسِرِينَ (1).
4 - إِنَّ اَلدِّينَ عِنْدَ اَللّٰهِ اَلْإِسْلاٰمُ وَ مَا اِخْتَلَفَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتٰابَ إِلاّٰ مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَهُمُ اَلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ.
أقول: هاتان الآيتان كافيتان - كفاية تامة قطعية - على المراد لمن كان مصدّقاً بالقرآن، فلا نحتاج إلى نقل آيات كثيرة دالة على المراد؛ على أنّ بطلان قوله ضروري في دين الإسلام.
و أمّا الآيتان اللتان استدل بهما فلو سلّم إطلاقهما و لم نقل: إنّ العمل الصالح ليس إلاّ امتثال الأحكام الإسلاهية التي من جملتها لزوم الاجتناب عن جميع الأديان الباطلة و المنسوخة، فنقيّده بالآيات التي أوردناها هنا و ما لم نورده منها، و هذا واضح جداً.
بل يمكن أن يقال: إنّ الأولى التي استدل بها تدل على كفر أهل الكتاب و عدم إيمانهم بناءً، على أنّ قوله تعالى: مَنْ آمَنَ ناظر إلى غير الذين آمنوا، و يؤيده قوله تعالى: وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْكِتٰابِ آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَكَفَّرْنٰا عَنْهُمْ سَيِّئٰاتِهِمْ وَ لَأَدْخَلْنٰاهُمْ جَنّٰاتِ اَلنَّعِيمِ.
فإنّه يدلّ، على أنّ أهل الكتاب ليسوا بمؤمنين، و لا يدخلون الجنة، بو قد فصّل الله بين المؤمنين و بينهم بقوله: إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اَلَّذِينَ هٰادُوا وَ اَلصّٰابِئِينَ وَ اَلنَّصٰارىٰ وَ اَلْمَجُوسَ وَ اَلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اَللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ إِنَّ اَللّٰهَ عَلىٰ كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ(2).
و على الجملة: أنّ الذي لم يقرّ بنبوة خاتم الأنبياء فهو كافر غير محبوب لله تعالى، فإن كان في ذلك مقصّراً فهو خالد في النار كائناً ما كان عمله و سيرته.
قد ثبت بما تقدم أنّ الإسلام ليس شرطاً في تعلّق الأحكام و التكليف، بل هو شرط صحة الأعمال على تفصيل تقرر في علم الفقه فغير المسلم مكلّف لكنّه لا يصحّ منه عمل فيى حال كفره بل يجب عليه الإيمان ليتمكن من العمل الصحيح، كما أنّ الصلاة واجبة على المحدث
ص: 289
لكنّها لا تصح منه، بل لا بد من تحصيل الطهارة ثم إتيان الصلاة، و هذا واضح.
و هل الإيمان - و نعنى به الإقرار بولاية الأئمة المعصومين (عليهم السلام) - مثل الإسلام، أم لا، بل هو شرط قبول الأعمال؟ فالمسلم غير المؤمن يصحّ منه عمله، و لا يجب عليه الإعادة و القضاء، و لا يستحقّ العقاب من هذه الناحية، و لكنّه لا يقبل منه و لا يثاب على عمله، بل هو آثم من أجل عدم اعتقاده بالإمامة.
لعلّ المشهور على الأول، و إلحاق الإيمان بالإسلام، و ذهب جماعة من الفقهاء إلى الثاني(1)، و أنّ الولاية لادخل لها في صحة الأعمال، و إنّما هي شرط لقبولها و ترتب الثواب عليها، و هذا هو ظاهر كلام الشهيد الأول (قدس سره) في كتاب الحجّ من اللمعة الدمشقية، و الذي وجدته في كلماتهم أنّ العمدة في إثبات القول الأول أمران:
1 - إجماع الإمامية على ذلك، ادّعاه صريحاً سيّدنا الأستاذ الحكيم - أدام الله ظلّه الشريف - في غير موضع من كتابه القيم الشهير «مستمسك العروة الوثقى».
و صاحب الجواهر (قدس سره) في محكيّ جواهره، و العلامة المجلسي (قدس سره) في بحاره قال في باب (أنّه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية) من المجلد السابع من البحار: و اعلم أنّ الإمامية أجمعوا على اشتراط صحة الأعمال و قبولها بالإيمان الذي من جملته الإقرار بولاية جميع الأئمة (عليهم السلام) و إمامتهم، و الأخبار الدالة عليه متواترة بين الخاصة و العامة. انتهى كلامه.
2 - الأخبار الواردة من الأئمة (عليهم السلام)، و قد عقد لها المجلسي (رحمه الله) باباً في المجلد السابع من بحاره، و المحدّث العالمي (رحمه الله) في أوائل وسائل الشيعة، و السيّد البروجردي (رحمه الله) في مقدمات جامع الأحاديث.
أقول: و هي متواترة قطعاً، كما ادّعاه العلامة المجلسي. لكنّ اعتبار الإجماع على تقدير عدم استناده إلى الروايات موقوف على حصول القطع منه برضا المعصوم، و هو غير حاصل لنا، و الروايات بمجموعها تدل على أنّ الثواب و قبول الأعمال و دخول الجنة مشروطة بالولاية و الإقرار بالإمامة، و ليس لها دلالة واضحة على اشتراط صحة العمل بها. نعم، ربما يظهر ذلك من بعضها، لكنّه بين ما هو ضعيف في سنده، و بين ما يمكن حمله على اشتراط قبول الأعمال بها.
نعم، ذكر سيدنا الاستاذ الخوئي - دام ظلّه العالي - في بعض دروسه الفقهية(2):
أنّ مقتضى إطلاق الروايات هو عدم القبول مطلقاً و من كل وجه، فتكون أعمال المخالفين
ص: 290
باطلة، لكن الاعتماد على ما أفاده مشكل.
و اعلم أنّ المستحبات لا أثر لصحتها بعد ردّها و عدم قبولها؛ إذ لا عقاب على تركها حتى يرتفع بصحتها، فما ينفع له هذا البحث هو الواجبات التعبدية فقط، و هي قلّما يمكن إتيانها منهم صحيحة من جهة إخلالهم بسائر أجزائها و شروطها التي تعتبر فيها واقعاً، فالبحث و إن كان له ثمرة لكنّها ليست بمهمّة غاية الأهميّة، و الله العالم.
ثم إنّ اشتراط الثواب بل الإيمان بمحبة أهل البيت (عليهم السلام) ممّا دل عليه جملة من روايات العامة أيضاً، و قد أخرج بعضها ابن حجر الجامد في صواعقه، فلاحظ.
و إذ فرغنا من الكلام في شروط التكليف فلنشرع في إثبات حسنه و وجوبه فللبحث مقامان:
المقام الأول: في بيان حسن التكليف، فنقول: أمّا حسنه إنّا و إجمالاً فمما لا شك فيه؛ لأنّ الله تعالى قد فعله، و كل ما يفعله تعالى فهو حسن، كما تقدم، و أمّا حسنه تفصيلاً فقد استدلّوا عليه بوجوه:
الأول: ما ذكره جماعة من المتكلمين، بل قيل: إنّه مذهب جميعهم، و هو: أنّ جهة حسن التكليف تعريض المكلف للثواب، فإنّ التكليف إن لم يكن لغرض كان عبثاً، و إن كان لغرض فإن كان عائداً إليه تعالى لزم المحال، كما سلف؛ و إن كان إلى غيره: فإن كان الضرر لزم الظلم، و إن كان النفع: فإن كان إلى غير المكلف كان قبيحاً، و إن كان إلى المكلف: فإن كان حصوله ممكناً بدون التكليف لزم العبث، و إن لم يكن: فإن كان النفع انتقض بتكليف من علم كفره، و إن كان التعريض المذكور فهو مطلوب.
و قالوا: إنّ الثواب منافع عظيمة خالصة دائمة واصلة مع التعظيم و المدح، و لا شك أنّ التعظيم إنّما يحسن لمستحقه، و لذا يقبح منّا تعظيم الأطفال والأراذل على حدّ تعظيم العلماء و الكبراء، فلا يحسن الابتداء به.
و معنى التعريض المذكور - كما قيل أيضاً -: إنّ المكلف (بالكسر) جعل المكلّف على الصفات التي تمكّنه الوصول إلى الثواب، و بعثه على ما به يصل إليه، و علم أنّه سيوصله إليه إذا فعل ما كلفه.
أقول: و عندي أنّ هذا الدليل مدخول من وجوه:
أمّا أولاً: فلعدم استقلال العقل باستحقاق العبد المطيع الثواب على طاعته، كما سيأتي بحثه في المعاد إن شاء الله تعالى، و نثبت أنّه تفضّل محض من الله المنّان. نعم، استحقاق العاصي الذمّ عقلي دائماً، بل العقاب أيضاً في غالب الموارد، كما أشرنا إليه في القاعدة الثالثة المقتدمة،
ص: 291
و على ضوء ذلك يضح هذا الوجه نقلياً لا عقلياً.
و أمّا ثانياً: فلأنّ الثواب - سواء كان استحقاقه للمطيع عقلياً أم نقلياً - لا يخرج فعله تعالى عن اللغوية، فإنّه شيء يترتب على امتثال العبد لما وظّفه الله، فهو في مرتبة المعاليل دون العلل، و الذي يصون الفعل من اللغوية و العبث ما تحقّق في مرتبة متقدمة على التكليف، و هي مرتبة العلل، و إلاّ لزم حسن التكليف بقتل الأنبياء و ارتكاب القبائح العقلية لترتب الثواب على امتثاله عقلاً أو شرعاً، مع أنّ قبح مثل هذا التكليف مما لا شك في ضرورته.
و ممّا يؤكّد بطلان هذا الوجه: أنّ الوجوب الصلاة دون الكذب حينئذٍ ترجيح بلا مرجح، فإنّ استحقاق الثواب متحقق على كل تقدير، و لذا يستحق المنقاد الثواب، و المتجرّي العقاب و إن كان الفعل في الأول قبيحاً و في الثاني صالحاً واقعاً.
و على الجملة: أنّ استحقاق الثواب و إن كان موجباً لحسن التكليف بالنسبة إلينا لكنّه لا يحسّنه بالنسبة إلى الحق، و هو فاعل التكليف.
و أمّا ثالثاً: فلأنّ قيد التعظيم في مفهوم الثواب - و إن ادّعوا عليه الضرورة في مسائل المعاد - أمر لا برهان عليه من العقل و النقل، فإنّ التعظيم المذكور إن كان نعمة فهي داخلة في المنافع، و يجوز الابتداء به من دون توسيط التكليف. و إن كان بمعناه المتعارف من الحركات المخصوصة و الآداب المرسومة فصدوره عن الله القديم المجرد ممتنع، و عن الملائكة ممكن، و نمنع قبح الابتداء به، و قد أمر الله تعالى ملائكته كلها أن يسجدوا لآدم (ع) ابتلاءً. و تمام الكلام في المقصد الثامن إن شاء الله، فهذا الدليل بما له من الاشتهار غير سديد عندي.
الثاني: ما ذكره المحقق اللاهيجي(1) من: أنّ التكليف الشرعي لطف في التكاليف العقلية، إذ المواظبة على العبادات الشرعية مقرّبة إلى العمل بالأحكام العقلية، كتحصيل المعرفة، و مراعاة الحقوق، و استعمال العدل، و اجتناب الجور بلا شبهة، و فيه: أنّ تحصيل المعرفة واجب شرعاً، و إنّما الواجب عقلاً هو وجوب النظر السابق على التكاليف الفرعية، و كذا مراعاة الحقوق و العدل و ترك الظلم، فإنّ الشرع أيضاً أمر بها. (فتأمّل)
هذا، مع أنّ الدليل أخصّ من المدّعى، فإنّه لا يثبت حسن جميع التكاليف التعبدية التي لا نعلم أسرارها و لا ارتباطها بالتكاليف العقلية. و هذا النقد يجري في استدلالنا أيضاً.
الثالث: ما ذكره هو أيضاً، و ملخّصه: أنّ للنفس الناطقة قوى مختلفة، أعظمها القوة العاقلة و القوة الشهوية، و الأولى لاستعداد تحصيل معرفة الله و استحقاق قرب الحق، و الثانية للمحافظة
ص: 292
على نظام البدن، و المنافاة بينهما ظاهرة، و لا يمكن رفعها إلا بالأمر والنهي الشرعيين ضبظاً للقوة الشهوية عن الإفراط و التفريط، و هذا الضبط لا يتيسّر للعقول وحدها، فلو لم يكلف الشارع لأضرّت الشهوية بالعاقلة، و منعت المكلف من بلوغه إلى كماله الحقيقي الذي هو الغرض من وجوده، و نقض الغرض قبيح، فكان التكليف واجباً على الله تعالى، فضلاً عن حسنه.
الرابع: ما هو الصحيح عندي، و هو: أنّ من المحسوس احتياج الإنسان في مسير حياته و نظام معاشه إلى أبناء نوعه، و ليس هو مثل سائر الحيوانات في عدم الافتقار إلى أمثاله، فالتعاضد و التعامل ممّا لا بد منه في استقامة عيشه، و هذا معنى كون الإنسان مدنياً بالطبع، فإنّ التمدّن عبارة عن الاجتماع المتسلسل المرتبط في شؤون الحياة. هذا من ناحية، و من ناحية أخرى: أنّه مجمع للقوى المختلفة كالعاقلة، و الشهوية، و الغضبية، و الوهمية، كما فصّل في علم الأخلاق. و إن شئت فقل إنّه واجد للقوى الروحية و المادّية، و مبتلى بالتمايلات المتنوعة العريضة و الطويلة.
و هذه القوى متصادمة بينها في الحقل الانفرادي، فضلاً عمّا إذا واجهت الآخرين في الميادين الاجتماعية بآرائهم المتشتّتة المتضادة التي شأن كل منها جرّ النار إلى قرصها، و مع هذه الحالة لا يمكن تمشّي التعاون المجري للنظام المدني على حد العدل و الإنصاف، ضرورة عجز العقل عن تعديل المشتهيات و تحديد القوى، فيلتمس ذلك وضع قانون ناظر إلى جهتين:
إحداهما: تحديد القوى النفسية في من الإفراط و التفريط، أو تحديد آثارها من الوصفين المذكورين على الأقل. و نعتبر عنه بالعدالة الأخلاقية.
ثانيتهما: تعديل نظام المعاملات و الارتباطات و العلاقات و تأسيسها على بناء عادل عام.
و يدخل في الأول: المعارف و الأخلاقيات والعبادات، على أن حسن الأوليتين ظاهر في نفسهما أيضاً، فإنّ التحلّي بهما كمال للنفس عند العقل.
و يدخل في الثاني المعاملات، فيكون التكليف الشرعي حسناً جداً، و لعلّ هذا التقرير هو مراد الحكماء في إثبات هذا الحكم، كما حكي عنهم في الكتب الكلامية. و إليه ينظر كلام اللاهيجي المتقدّم.
ثم إن هذا الحكم لا يتوقف على عدم إمكان تشريع الناس أنفسهم مثل هذه التكاليف الشرعية، ضرورة عدم توقف حسن الحسن على انحصار نوعه في فرده، نعم، يتوقف عليه وجوب التكليف المذكور على الشارع، فإنّه إذا أمكن للناس جعل مثل هذا القانون فلا يحكم العقل بوجوبه على الله تعالى، و لذا نحتاج لإثبات وجوبه عليه تعالى إلى بيان آخر.
فإن قلت: إذا كان التكليف لأجل تكميل الإنسان في حياته الانفرادية و نظامه الاجتماعي
ص: 293
فما هو السبب في عقابه؟
قلت: أمّا أولاً فلأنّ الوعيد بالعقاب يؤكد و ينفّذ التكليف، و يحمل الناس على الانقياد له. و أمّا ثانياً فلأنّ العقاب من لوازم العصيان و مخالفة أمر المولى، لا لأجل مدخليته في اكمال الإنسان، و لذا يختصّ بصورة العمد و الاختيار دون الجهل و الاضطرار.
و على الجملة: الثواب و العقاب بمراتبهما ليسا تابعين لمراتب المصلحة و المفسدة، بل هما تابعان لمراتب الانقياد و التجرّي على أحكام المولى الأمر.
نعم، مراتب التجرّي تختلف باختلاف مراتب الاهتمام المختلفة باختلاف مراتب المصلحة و المفسدة، و أمّا مراتب الانقياد فتختلف باختلاف مراتب المشقّة، فزيادة العقاب تدل على تأكد المصلحة الفائتة و المفسدة المرتكبة، و أمّا زيادة الثواب فلا تدل عليه. نعم، الوعد بزيادة الثواب يدل على مزيد الاهتمام الناشئ عن زيادة المصلحة، و لكن لا يبعد إلحاق الثواب بالعقاب في دلالة زيادته على تأكد الملاك و عدم تأثير المشقة فيه، فتدبر(1).
المقام الثاني: في التكليف على الله تعالى، و هو ممّا اتفق عليه العدلية كما في شرح «قواعد العقائد»(2)، بل عليه ضرورة الشرائع و الأديان و الإجماع المحقّق كما في «كفاية الموحّدين».
أقول: الإجماع ليس بدليل مستقل يعتمد عليه؛ لأنّ العدلية اتفقوا عليه من جهة قواعدهم العقلية، فلا بد من النظر فيها، و أمّا دعوى الضرورة فهي عجيبة، فإنّ الضرورة الدينية قائمة على صدور التكليف من الله عباده، لا على وجوب التكليف عليه كما هو ظاهر، فلا بد من النظر في أدلتهم، و قد استدلوا بوجوه:
1 - إنّ التكليف مشتمل على اللطف، و اللطف واجب عليه تعالى، ذكره العلامة في شرح قواعد العقائد.
أقول: إن أراد باللطف بيان الأحكام و المصالح و المفاسد فالدليل مصادرة، و إن أراد به ما يقرّب العبد إلى الطاعة و يبعّده عن المعصية ففيه منع الصغرى و الكبرى، أمّا الصغرى فلأن اللطف بهذا المعنى متأخر عن أصل التكليف و مسبوق به، و لا يعقل تحققه قبله، فكيف يحكم بلزوم التكليف لأجله؟ و قد تقدم تفصيله، و هو أيضاً قائل بذلك. و أمّا الكبرى فقد أسلفنا عدم تماميتها.
2 - إنّ التكليف لطف في الأحكام العقلية، و اللطف واجب، ذكره اللاهيجي.
ص: 294
أقول: الكبرى ممنوعة كما قلنا آنفاً، و أمّا الصغرى فإتمامها محتاج إلى ضمّ مقدمة أخرى قائلة بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد، و الى مقدمة قائلة بتأثير هذه الملاكات في الأحكام العقلية، و كلتا المقدمتين ثابتة. أمّا الأولى فقد مرّ بحثها في القاعدة الرابعة. و أمّا الثانية فيدل عليها قوله تعالى: إِنَّ اَلصَّلاٰةَ تَنْهىٰ عَنِ اَلْفَحْشٰاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ و غيره. بل عن المعتزلة: دعوى الضرورة عليها(1)، و لكن مع ذلك الصغرى أخص من المدّعى؛ إذ لطفية جميع الأحكام - حتى في باب المعاملات - للأحكام العقلية غير واضحة، كما أشرنا إليه سابقاً أيضاً.
3 - ما ذكره هو أيضاً من: أنّه لو لا التكليف للزم نقض الغرض، و هو قبيح.
و قد تقدم تقريبه في الوجه الثالث من الوجوه الدالة على حسن التكليف.
و جوابه: أنّ كون الغرض من خلق الإنسان هو الكمال الموقوف على التكاليف غير ثابت عقلاً.
4 - ما أفاده سيّدنا الأستاذ المحقق دام ظلّه، قال: تكليف عامة البشر واجب على الله سبحانه، و هذا الحكم قطعي قد ثبت بالبراهين الصحيحة و الأدلة العقلية الواضحة، فإنّهم محتاجون إلى التكليف في طريق تكاملهم و حصولهم على السعادة الكبرى و التجارة الرابحة، فإذا لم يكلفهم الله سبحانه: فإمّا أن يكون ذلك لعدم علمه بحاجتهم إلى التكليف، و هذا جهل يتنزّه عنه الحق تعالى.
و إمّا لأنّ الله أراد حجبهم عن الوصول إلى كمالاتهم، و هذا بخل يستحيل على الجواد المطلق.
و إمّا لأنّه أراد تكليفهم فلم يمكنه ذلك، و هو عجز يمتنع على القادر المطلق، فاذن لا بد من تكليف البشر(2).
أقول: قد مرّ في مبحث حكمته في الجزء الأول: أنّ الجود واجب عليه فلا يكون الدليل خطابياً. نعم، مفاد الدليل اختصاص وجوب التكليف بمن يسلك طريق التكامل بعد الإرادة، لا عمومه لمطلق البشر، إذ لا بخل في ترك هداية من لا يقبلها، كما لا يخفى.
هذا، و يرد عليه: أنّه - دام ظلّه العالي - إن أراد بالسعادة و التجارة الثواب و دخول الجنة فقد ذكرنا: أنّه لا يثبت حسن التكليف فضلاً عن وجوبه عليه تعالى.
و أن أراد به تكامل نفس المكلف و ارتقاءها المعنوي ففيه: أنّ إيجاب التكليف عليه تعالى
ص: 295
لأجله موقوف على كونه أصلح في نظام الكل، لا على كونه أصلح للمكلفين وحده، كما أشرنا إلى ذلك في القاعدة السادسة أيضاً و أنّى لنا إحراز ذلك؟ و عليه فلا سبيل لنا إلى الجزم بوجوب التكليف المزبور على الله سبحانه، فتأمل جيداً(1).
5 - ما ذكره جماعة من أصحابنا المتكلّمين من: أنّ الله تعالى جعل في الإنسان شهوةً إلى القبائح، و نفوراً عن الحسن، فلو لم يكلفه و لم يوعده المؤاخدة على الإخلال بالواجب و فعل القبيح لكل مغرياً بالقبيح، و لا شك في قبح الإغراء بالقبيح، فيكون التكليف واجباً، و هذا هو مراد المحقق الطوسي (قدس سره) من عبارته في التجريد: و واجب لزجره عن القبائح.
أقول: و هذا أمتن الوجوه و أحسنها، ألا ترى أنّه إذا فرض إلغاء الحكومات الفعلية المتعارفة، أو رفع قانون المؤاخذة و السجن من بين الناس لم يبق للسوق نظام من ساعة.
نعم، لقائلٍ أن يقول: إنّ العلم بقبح القبائح و إن لم يكن كالتكليف رادعاً عن تركها، لكنّه يكفي لمنع نسبة الإغراء إلى الله تعالى، فإنه تعالى كما جعل في العبد شهوة الى القبائح كذلك جعل فيه العقل و العلم بالقبائح، فارتكابه لها إنّما هو بسوء اختياره، و هذا واضح، إلاّ أن يقال بالعلم الإجمالي بقبائح أخرى غير ما نعلمه تفصيلاً، و الاجتناب عنها موقوف على التكليف الشرعي، كما قال تعالى: إِنَّ اَلصَّلاٰةَ تَنْهىٰ عَنِ اَلْفَحْشٰاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ، لكنّ لزوم البيان عليه في هذا الفرض إنّما هو بالنسبة إلى من يمتثل التكليف بعد وصول البيان؛ إذ لا قبح في ترك إرشاد من لا يسترشد بالإرشاد، كما لا يخفي.
و الإنصاف: أنّ جميع هذه الوجوه لا يفيد الجزم بوجوب التكليف عليه تعالى، فلم يقبح منه لو لم يكلف عباده بشيء. نعم، ما حكم به العقل يحكم به بالشرع لا محالة، كما مرّ وجهه مفصّلاً(2) أضف إلى ذلك. و أقول: إنّ التأمل في وضع التشريع يعطي عدم وجوبه على الله تعالى، و إلاّ لزم إخلاله تعالى بفعل الواجب و هو باطل عقلاً و اتفاقاً.
بيان الملازمة: أنّ إيصال الأحكام إلى الناس تمّ على نحو المتعارف و الأنبياء الكرام
ص: 296
- صلّى الله على خاتمهم و آله و عليهم - بلغوا ما أنزل إليهم حسب الأسباب العادية و السيرة المعمولة، و لذا لم يصل إلى من كانوا بعيدين عنهم في المسافة من أهل عصرهم فضلاً عمّن أتوا بعدهم بأزمنة، و لم يكن نبيّ من الأنبياء قد جال في الأرض برحبها و بلغ شريعته إلى جميع سكانها. و هذا خاتمهم - نبينا الأعظم (ص) - قد أتى بدين جامع عامّ للإنس و الجنّ إلى يوم القيامة، و مع ذلك لم يتعدّ في إيصاله إلى الناس من الحدود المتعارفة، و لم يستفد فيه من الأسباب فوق العادة ليوصل نداءه إلى جميع الموجودين في زمانه، بل قضى نحبه الشريف، و في الأرض من لم يسمع بشريعته و دينه، و كذا الحال في أوصيائه الكرام (عليهم السلام).
و على الجملة: لا ريب في وجود إناس كثيرين جاهلين بالديانة جهلاً عن قصور في كل دورة و كورة، جهلاً بالمعارف و الأصول الاعتقادية، فضلاً عن الأحكام الفرعية، فلو كان بيان الأحكام واجباً على الله تعالى لوجب عليه إيصالها إلى جميع العباد الواجدين لشرائط التكليف؛ لئلاّ يلزم الإخلال بالواجب، و حيث إنّ الأمر ليس كذلك كما نعلم خارجاً فنفهم أنّ التكليف ليس عليه بواجب.
و أيضاً أنّ العارف باستنباط الأحكام الفرعية في زمان الغيبة يدري أنّ ما يحصله الفقهاء المجتهدون بجهدهم ليس إلا الأحكام الظاهرية التي ربّما وافق الواقع و ربّما تخالفه، فتقع أفعالهم و أفعال مقلّديهم باطلة غير متضمنة للمصالح الواقعية، و إن كانت هي في ظاهر الشرع محكومة بالصحة، و يثابون عليها لأجل الانقياد، فلو كان التكليف عليه تعالى واجباً لأوصل الأحكام الواقعية إلى الناس ليستكملوا بالمصالح الواقعية.
و في صحيحة هشام(1)، عن الصادق (ع) أنّه سئل عمّن مات في الفترة و عمّن لم يدرك الحنث و المعتوه؟ فقال: «يحتجّ الله عليهم، يرفع لهم ناراً فيقول لهم: ادخلوها...» إلى آخره.
و في صحيح أخرى له عنه (ع): «ثلاثة يحتجّ عليهم: الأبكم، و الطفل، و من مات في الفترة، فيرتفع لهم نار فيقال لهم: ادخلوها...» إلى آخره.
و في رواية زرارة(2)، عن الباقر (ع) قال: «إذا كان يوم القيامة احتجّ الله عزّ و جلّ على خمسة: على الطفل، و الذي مات بين النبيين، و الذي أدرك النبي و هو لا يعقل، و الأبله، و المجنون الذي لا يعقل، و الأصمّ و الأبكم، فكل واحد منهم يحتجّ على الله عز و جلّ، قال: فيبعث الله إليهم رسولاً، فيؤجّج لهم ناراً، فيقول لهم: ربكم يأمركم أن تثبوا فيها، فمن وثب فيها كانت عليه برداً و سلاماً، و من عصى سيق إلى النار».
ص: 297
و في رواية أخرى له، عن الصادق (ع) أنّه قال: «حقيق على ألله أن يدخل الضلّال الجنة»، فقال زرارة: كيف ذلك جعلت فداك؟ قال: «يموت الناطق و لا ينطق الصامت، فيموت المرء بينهما فيدخله الله الجنة»(1).
أقول: فيفهم من هذه الروايات أن هؤلاء الطوائف لم يتمّ عليهم الحجة في الدنيا فيكلفون في الآخرة. و أمّا ما عن جماعة من المتكلمين (كما في توحيد الصدوق) من إنكار التكليف في الآخرة زاعمين أنّه لا يجوز أن يكون في دار الجزاء تكليف. فهو واضح السقوط، إذ التكليف المذكور في ميدان الحساب، لا في الجنة أو النار، و لا دليل على نفي مثل هذا التكليف هناك من العقل و النقل، فطرح الروايات أو تأويلها لأجل ذلك، كما صرح به بعض الأصحاب خارج عن منهاج الصواب.
استدل المحقق الطوسي (قدس سره) في تجريده على انقطاع التكليف بعد الإجماع بأن إيصال الثواب إلى المكلف غير ممكن في صورة استمرار التكليف المستلزم للمشقة؛ لاستدعاء الثواب الخلوص عن المشقة، و لا يمكن الجمع بينهما.
أقول: لا شك في انقطاع هذه التكاليف الفعلية بالموت عقلاً، و أمّا أنّه لا تكليف بعده على وجه عام، فهذا لا دليل عليه من العقل و النقل، بل قد عرفت دلالة الروايات على تحققه في الآخرة لبعض الأشخاص.
و أمّا ما أفاده من تنافي التكليف للثواب ففيه: أنّ الكلفة و المشقة غي معتبرة في صدق التكليف الشرعي، كما أسلفنا بحثه سابقاً، فيمكن أن يكون أهل الجنة مكلفين ببعض الأذكار مثلاً، و يزيد بامتثاله درجاتهم، و هذا الاحتمال لا دافع له.
قال شيخنا الأقدم المفيد (قدس سره) في أوائل المقالات(2): أقول: إنّ أهل الآخرة صنفان: فصنف منهم في الجنة، و هم فيها مأمورون بما يؤثرون، و يخفّ على طباعهم، و يميلون إليه و لا يثقل عليهم من شكر المنعم سبحانه و تعظيمه و حمده على تفضّله عليهم و إحسانه إليهم، و ما أشبه ذلك من الأفعال.
و ليس الأمر لهم بما وصفناه إذا كانت الحال فيه ما ذكرناه تكليفاً؛ لأنّ التكليف إنّما هو إلزام ما يثقل على الطباع، و يلحق بفعله المشاقّ، و الصنف الآخر في النار، و هم من العذاب و كلفه
ص: 298
و مشاقّه و آلامه على ما لا يحصى من أضعافه التكليف للأعمال، و ليس يتعرّون من الأمر و النهي بعقولهم حسب ما شرحناه، ثم نسبه إلى جمهور المتكلّمين من أهل بغداد أيضاً، و نقل الخلاف فيه عن البصريّين منهم. و نقل الطبرسي في مجمع البيان في تفسير سورة الرعد: أنّ النجّار و جماعة قالوا بتكليف أهل الآخرة.
و انطلاقاً من جميع ما تقدم منّا يتضح أنّ التكليف ليس بواجب على الله تعالى عقلاً.
و الصحيح أن يقال: إنّ الغاية من خلق الإنسان - مثلاً - هي الرحمة الرحيمية الموقوفة على التكليف شرعاً، كما فصّلناها في القاعدة الرابعة، و عليه يجب عليه تعالى تكليفهم لئلاّ يلزم نقض الغرض القبيح عقلاً، و أمّا عدم وصوله للجاهل القاصر و غيره فلا محذور فيه؛ لجواز التخصيص في الأدلة النقلية.
فوجوب التكليف ليس من العقليات الصرفة كما قالوه، بل من غير المستقلة، ضرورة عدم حكم العقل بقبح ترك التكليف إذا لم يخبر الشرع عن كونه غاية و غرضاً من إيجاد الانسان و وسيلة إلى الرحمة الرحيمية.
و يدل على وجوبه أيضاً قوله تعالى: وَ عَلَى اَللّٰهِ قَصْدُ اَلسَّبِيلِ (1)، فإنّ كلمة «على» ظاهرة في الوجوب، كما في قوله: لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ (2). و كذا يدل عليه قوله تعالى: إِنَّ عَلَيْنٰا لَلْهُدىٰ و هاتان الآيتان شاهدتان على بطلان مقالة من ينكر الوجوب على الله تعالى، فافهم.
و أمّا قوله تعالى: قٰالَ اِهْبِطٰا مِنْهٰا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمّٰا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً... إلى آخره، فهو و إن كان ظاهراً في عدم لزوم بيان الهدى لمكان كلمة «إن» الشرطية، لكنّه لا مجال للاعتماد على الظهور المذكور بعد ما عرفت، فيمكن حمله على إرادة إبهام الأمر للمخاطب، لا على عدم لزوم التكليف واقعاً.
ص: 299
من المشاهد تحقق الآلام خارجاً و عدم استنادها - بمجموعها - إلى اختيار المتألم، بل جملة منها واصلة من الله تعالى قهراً وفقا لقانون العلّية، و حيث إنّ إيلامه تعالى ينافي - بظاهره - حكمته و عدله الثابتين بما سبق حاولوا أن يبحثوا عن أسبابه و موجباته ليتضح به عدم المنافاة، و تتنزّه أفعال الحق تعالى عن اللغوب و العبث و الجور.
فهذه القاعدة ذات أصالة في مباحث العدل على حذو بقية قواعد هذا المقصد، لا أنّها تابعة للقاعدة السابعة و مرتبطة بمسألة اللطف، كما ذكر العلامة الحلي (قدس سره) و تبعه القوشجي و غيره في شرح التجريد، و مهما يكن فالبحث يقع فيها من جهات:
أنّ الذي يخرج الإيلام عن الظلم و يوجب اتصافه بالحسن أحد أمور على سبيل منع الخلوّ:
1 - كون المتألّم مستحقاً له بأن ارتكب جريمة و قبيحاً، و كان الإيلام انتقاماً منه و عقاباً له، و هذا ممّا لا شك في عدم قبحه عند العقلاء.
و ما قيل من منع كون إيلامه تعالى عقاباً للعاصي بحجة أنّ المعاقب لا يجب عليه الرضا بالعقاب، و المتألّم يجب عليه الرضا بألمه الواصل من الله تعالى فلا بد أن يكون العقاب في ظرف لا تكليف فيه و هو الآخرة.
ضعيف؛ لحكم العقل بحرمة الإنكار على فعله تعالى في جميع الأوقات و لو في جهنم، فلا مانع من كون الإيلام عقاباً للمكلف، و القرآن الكريم ناصّ بذلك في جملة آياته الشريفة كما يأتي.
2 - ترتب نفع كثير على الإيلام المذكور، أو دفع ضرر كذلك، فإن الإيلام حينئذٍ يصبح حسنا عند العقلاء، كما يشاهد في معالجة المرضى و تأديب الأطفال، بل و الكبار المنحرفين، و اختيار الأسفار لتحصيل العلم أو الربح أو غيره، بل المتخلّف عن هذه السيرة يعدّ عندهم سفيهاً.
ص: 300
3 - الدفاع، فإنّ قتل من قصد قتل شخص بلا جهة مبرّرة حسن لا قبح فيه، فضلاً عن جرحه و إيلامه، بل هو واجب بمناط وجوب دفع الضرر فطرة.
4 - جريان سنّة الله تعالى و سريان عادته، فإن سنّته لا تقبل التبديل و التحويل، فإذا وقع صبّي في النار أو ألقاه ظالم فالله تعالى و إن كان قادراً على حفظه، لكنّه يخلّي بينه و بين النار لتحرقه و يحرق قلب كل من يحب الصبي المظلوم! فإنّه تعالى أجرى عادته على تأثير الأسباب في المسبّبات مهما كان شكل الواقعة و شأن النتيجة.
ثم إنّ الأقسام الثلاثة المتقدمة مشتركة في حق الخالق و المخلوق، فإنّه كما يحسن لله تعالى أن يؤلم عبداً انتقاماً منه على جريرته، أو لأجل إيصال نفع أعظم من ألمه إليه أو دفع ضرر كذلك كأن يمرضه ليقعد في بيته، و لا يقتل في السوق فيما إذا علم الله أنّه لو دخل السوق لقتل، أو لأجل الدفاع عن عبد مظلوم، كذلك يحسن لزيد - مثلاً - أن يؤلم بكراً انتقاماً أو دفاعاً عن نفسه، أو لإيصال نفع كثير إليه، أو دفع ضرر عنه.
و لكنّ القسم الأخير مختصّ بالله تعالى، و لا يجري في حقنا؛ إذ لا شك في تقبيح من لا يخرج الصبي عن النار مع قدرته عليه، ضرورة وجوب حفظ النفس المحترمة عن الهلاك.
لا يقال: العقل كما يرى حسن حفظ الصبي - مثلاً - للمخلوق كذلك لله سبحانه، و لا معنى للتبعيض.
فإنّه يقال: نعم، لكن هناك مصلحة أهمّ من حياة الطفل المذكور مثلاً. فهو حكيم مطلق يراعي أهم المصلحتين في صورة التزاحم.
فالعقل و إن لم يحط بتلك المصلحة تفصيلاً لكنّه يذعن لها إجمالاً بعد ما اعترف بحكمة الله البالغة و عدالته الكاملة، على أنّه يمكن أن نكشف بعض السرّ من جريان عادته بتأثير الأسباب في المسبّبات، و هو: أنّ أهمّ الأمور عند الله تعالى رواج الديانة و الشريعة بين الناس؛ ليبلغوا أقصى سعاداتهم و كمالاتهم، و قد تقدم أنّ الإنسان الذي جعل لأجله ما في الأرض و بناء السماء خلق للرحمة الموقوفة على العبادة. هذا من جهة.
و من جهة أخرى أنّه لا ريب في أنّ العبادة و رواج الديانة لا يتحققان إلاّ بإرسال الرسل، و لا يمكن معرفة الرسل إلاّ بالمعجزات، كما سيأتي بحثه - إن شاء الله - فيما بعد، و ليست المعجزة إلاّ خرق العادات و بطلان تأثير الأسباب في المسبّبات العادية، أو تأثير أسباب خفية أقوى غير مألوفة للناس في المسبّبات، فلو أبطل الله تعالى تأثير النار لحفظ صبيّ، و تأثير الجوع و العطش لبقاء كبير، و تأثير الهدم والخرق و الغرق لصحة زيد و راحة بكر - مثلاً - في كل زمان و مكان، لأصبحت الأفعال الخارقة أموراً عادية لا تتوجه إليها الأنظار أبداً، بل يصير كل
ص: 301
شيء متعارفاً عادياً.
فحينما ادّعى نبيّ أنّه رسول من قبل الله تعالى و طولب بالدليل يفحم لا محالة؛ إذ لا طريق له إلى إثبات مدّعاه بعد ما تعارف و شاع بطلان قانون السببية و العلّية، فإنّ ما يأتي به من المعجزة يكون عند الناس أمراً غير مهم، و لا مختصاً بشأن النبي، فافهم المقام.
فالتحفّظ على الديانات و على إثبات صدق الرسل و على نظام الشرائع الذي هو أهم الأمور و أقوى المصالح، اقتضى جريان عادته تعالى بتأثير الأسباب في المسببات، و لو آل الأمر إلى قتل نبي و حرق و لي و هدم كعبة وخرق مصحف!!
لكن المعلوم أن ما ذكرنا فربّما لحكومته قانون العلية لا علة تامة له، و هي مجهولة عندنا.
أنّ الإيلام من المخلوق إن كان بأحد الوجوه الثلاثة الأولى فهو حسن، و إلا فهو جور قبيح. و أمّا الإيلام من الله تعالى فلا يكون إلا بأحد الوجوه الأربعة المذكورة، ضرورة عدم تعقّل الظلم من الحكيم العدل الرحيم.
فما عن الثنوية من تقبيح الآلام على الإطلاق حتى أسندوها إلى (أهرمن) و حسبان أنّه خالقها، و ما عن الدهرية من إسنادها إلى الطبيعة و إنكار الخالق الشاعر المختار، بتخيّل أنّ الشرّ لا يصدر عن الحكيم، و ما عن التناسخية و البكرية من حصر علة الإيلام بالوجه الأول - أعنى الاستحقاق - بدعوى أنّ النفوس البشرية إذا كانت في أبدانٍ قبل هذه الأبدان و فعلت ذنوباً استحقت الألم عليها، و ما عن الأشاعرة من البناء على حسن جميع الآلام الصادرة عنه تعالى، و إن لم تكن بأحد الوجوه المذكورة بتخيّل أن لا حكم للعقل في التحسين و التقبيح أبداً.
ضعيف جداً، فإن إيلامه إذا كان حسناً كما بيّناه فلا يبقى للقولين الأولين مجال، مضافاً إلى ما سبق في الجزء الأول من تزييفهما في نفسهما أيضاً.
و بطلان التناسخ يبطل القول الثالث، و أمّا القول الرابع فخرافة ظاهرة، و قد تقدم في مباحث قدرته تعالى في الجزء الأول ما يرتبط بالمقام، فلاحظ.
قال العلامة الحلي (قدس سره) في نهج الحق(1): ذهبت الإمامية إلى أنّ الألم الذي يفعله الله تعالى
ص: 302
بالعبد: إمّا أن يكون على وجه الانتقام و العقوبة... و لا عوض فيه، و إمّا أن يكون على وجه الابتداء، و إنّما يحسن فعله من الله تعالى بشرطين: أحدهما: أن يشتمل على مصلحة إمّا للمتألّم، أو لغيره، و هو نوع من اللطف؛ لأنّه لو لا ذلك لكان عبثاً، و الله تعالى منزّه عنه. الثاني: أن يكون في مقابلته عوض للمتألّم يزيد على الألم، بحيث لو عرض على المتألّم الألم و العوض اختار الألم، و إلا لزم الظلم و الجور من الله تعالى على عبده... إلى آخره.
أقول: الظاهر أنّ نسبة هذا الفرع إلى الإمامية باعتبار اتفاقهم على أصل الكبرى، و هي تنزّه أفعال الحق الحكيم من العبث و الظلم، و طبّقها هو (رحمه الله) على المقام باجتهادٍ منه، و إلاّ فاتفاقهم على خصوص الفرع المذكور بعيد جداً.
و الصحيح في المقام: التفصيل، و هو: أنّ المصلحة إن كانت راجعة إلى المتألّم نفسه فلا يستحقّ عوضاً على الله تعالى عقلاً، فالمصلحة المذكورة كما توجب زوال اللغوية و العبثية كذلك توجب بطلان الظلم أيضاً، بل تصيّر الإيلام تفضّلاً و إحساناً، كما إذا علم أنّه لو أمرض زيداً لترحم عليه فلان و لأعطاه مالاً يكفي مؤونة عمره مثلاً، أو لحبس في بيته و سلم من القتل اللازم عليه على تقدير دخول السوق، و من الضروري أنّ المرض المذكور محض تفضّل من الله تعالى عليه، و لا معنى لاستحقاقه العوض الآخر أيضاً، و هذا واضح.
و إن كانت المصلحة المذكورة راجعة إلى غير المتألّم فقط فلا شك في استحقاقه للعوض المذكور.
فاعتبار اجتماع الشرطين معاً في حق المتألّم كما هو ظاهر كلامه (قدس سره) غير متين، بل اللازم في إيلامه هو المصلحة دائماً، فإن عادت إلى المتألّم فلا حاجة إلى شيء آخر، و إن رجعت إلى غيره فلا بد له من عوض، فلا تجتمع المصلحة و العوض للمتألّم أبداً، و هذا هو الحق في المقام، و منه ينقدح فساد النزاع الواقع بين بعض أشياخ المعتزلة بكلا وجهيه، فلاحظ(1).
و أمّا الذي أفاده من كون المصلحة المزبوره لطفاً فهو الذي اختاره المحقق الطوسي - نوّر الله مرقده - في تجريده، و غيره في غيره، فقالوا: لا بد أن تكون المصلحة لطفاً، لكنّني لم أفهم وجهه؛ إذ مجرد المصلحة المذكورة يكفي لحسن الإيلام، و إن لم يكن مقرّباً إلى الطاعة و مبعداً عن المعصية، و ليس إفضاله منحصر بالجهات الأخروية دائماً، فالصحيح هو اعتبار مطلق المصلحة المتوقفة عن الإيلام المذكور في صيرورته حسناً و تفضّلاً، و أمّا إذا لم يكن للمصلحة المذكورة توقف فيقبح الإيلام، و إن أعطاه الله تلك المصلحة فإنّه و إن لم يكن ظلماً لكنّه عبث،
ص: 303
و العبث قبيح فلا يصدر عن الحكيم.
هل يكفي في حسن الإيلام اشتماله على اللطف فقط من دون عوض، أو لا، بل لا بد معه من العوض، كنفع أو دفع ضرر؟
فيه وجهان، بل قولان، إلى الثاني منهما ذهب جماعة منهم المحقق الطوسي (قدس سره).
دليل القول الأول: أن الإيلام إذا كان مقرّباً إلى الطاعة و مبعّداً عن المعصية لا يكون لغواً و لا ظلماً. أمّا الأول فواضح، و أمّا الثاني فلأنّ المكلف إذا امتثل التكليف لأجل اللطف المذكور يومن من النار و يثاب من قبل الله تعالى، فلا يكون الألم جوراً.
و دليل الثاني: أنّ الثواب أو دفع العقاب إنّما يترتب على الطاعة المفعولة بفعل اختياري، و لا ربط له بالألم حتى يعدّ له عوضاً.
و على الجملة اللطف مقرّب، لا أنّه محصّل للطاعة بحيث لو لم يأت بها المكلف يصبح الإيلام جوراً.
أقول: و يمكن التفصيل بين صورة ترتّب الطاعة على اللطف المذكور و بين صورة عدمه، فنقول بالقول الأول في الصورة الأولى، و بالقول الثاني في الصورة الثانية، فتأمّل.
إذا فرض المصلحة أو خصوص اللطف - على حدّ قولهم - في الألم و غير الألم فهل يحسن منه تعالى اختيار الإيلام مع العوض، أو لا، بل يتعين عليه اختيار اللذّة و غير الألم؟ فإنّ الألم إنّما يصير حسناً إذا لم يكن طريق إلى حصول المنفعة المترتبة عليه للمكلف، و مع فرض حصولها بطريق آخر كان الألم ضرراً و عبثاً، كما اختاره المحقق الطوسي (قدس سره) وغيره.
و ذهب بعضهم إلى الأول، و التخييؤ بين الإيلام مع العوض و بين اللذّة بلا عوض، و هذا هو الصحيح، فإنّ فرض المصلحة أو خصوص اللطف يرفع العبثية، و فرض العوض الكثير يمنع صدق الظلم بلا شك، فلا ضرر على المكلف.
أنّ الإيلام إذا كان بسبب الاستحقاق أو الدفاع أو جريان العادة فلا شك في عدم اشتراط رضا المتألّم به، و أمّا إذا كان لأجل دفع الضرر أو جلب النفع فهو مشروط برضا الشخص، فلا
ص: 304
يصح أنّ يؤلّم أحداً لينفعه أو يدفع عنه ضرراً.
فإن قلت: فما تقول في إيلامه تعالى لذلك، فإنه غير مسبوق بإذن المتألّمين.
قلت: قد أجيب عنه: بأنّ اعتبار الرضا إنّما يكون في النفع الذي يتفاوت فيه اختيار المتألّمين، و أمّا النفع البالغ إلى حدّ لا يجوز فيه اختلاف الاختيار فإنه يحسن الإيلام، و إن لم يحصل الرضا فعلاً و العوض المستحق عليه من الله تعالى كذلك.
هذا تمام الكلام في مبحث الآلام حسب ما يقتضيه الحسن و القبح العقلييان المعوّل عليهما عند العقلاء في النظام الاجتماعي، الممضييان للشارع المقدّس، و نختم البحث بذكر بعض الآيات و الروايات تتميماً للفائدة و تيّمناً للرسالة.
أمّا الكتاب فإليك بعض آياته الكريمة:
1 - وَ مٰا أَصٰابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمٰا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ(1).
2 - ظَهَرَ اَلْفَسٰادُ فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ بِمٰا كَسَبَتْ أَيْدِي اَلنّٰاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ اَلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.(2)
الآيتان تدلّان على أنّ الألم يصدر عنه لأجل الاستحقاق و الانتقام، و قوله تعالى: لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (3) علّة استعجال العذاب في الدنيا.
3 - وَ اِتَّقُوا فِتْنَةً لاٰ تُصِيبَنَّ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (4).
و لعلّ وصول الفتنة المذكورة إلى غير الظالمين من باب جريان العادة(5).
4 - وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ اَلْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنٰا تُرْجَعُونَ (6).
يمكن أن يكون الامتحان سبباً مستقلاًّ لحسن الإيلام و إن لم يذكره المتكلمون.
5 - فَانْتَقَمْنٰا مِنَ اَلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَ كٰانَ حَقًّا عَلَيْنٰا نَصْرُ اَلْمُؤْمِنِينَ (7).
ص: 305
يحتمل نظارته إلى السبب الثالث، و إليه ينظر قوله تعالى: وَ لَوْ لاٰ دَفْعُ اَللّٰهِ اَلنّٰاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ...(1).
و أمّا السنّة فإليك أيضاً نبذةً منها:
1 - رواية سماعة، عن الصادق (ع) قال(2): «إنّ العبد إذا كثرت ذنوبه و لم يجد ما يكفّرها به ابتلاه الله عزو جل بالحزن في الدنيا ليكفّرها به، فإن فعل ذلك به و إلاّ أسقم بدنه ليكفرها به، و إلاّ شدّد عليه عند موته ليكفرها به، فإن فعل ذلك به و إلاّ عذبه في قبره ليلقى الله عز و جل يوم يلقاه و ليس شيء يشهد عليه بشيء من ذنوبه».
تدلّ على سببيظ الانتقام للإيلام.
2 - رواية سفيان بن السمط، عنه (ع) قال(3): «إنّ الله إذا أراد بعبدٍ خيراً فأذنب، اتّعه بنقمة و يذكّره الاستغفار».
تدلّ على سببية النفع و دفع الضرر للنقمة.
3 - رواية ابن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن رسول الله (ص)(4): «لو لا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء: المرض، و الفقر، و الموت، و كلّهم فيه، و أنّه معهم لو ثاب».
و الظاهر أنّها مثل سابقتها في المفاد، مع زيادة دلالتها على إعطاء الثواب للمتألّم.
4 - ما عن أبي جعفر الجواد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (ع): المرض لا أجر فيه، و لكنّه لا يدع على العبد ذنباً إلا حطّه، و إنّما الأجر في القول باللسان و العمل بالجوارح...» إلى آخره(5)..
يدلّ على الإيلام الحاصل من المرض لأجل دفع الضرر دون جلب النفع. و يمكن رفع التنافي بينها و بين سابقتها بحمل الأجر على الاستحقاق الشرعي و الثواب على التفضل، و سيأتي وجه آخر للجمع بينهما.
5 - ما عن أمير المؤمنين (ع) أيضاً(6) في المرض يصيب الصبي؟ قال: «كفارة لوالديه».
6 - ما عن رسول الله (ص): «عجبت من المؤمن من وجزعه من السقم، و لو يعلم ما له من الثواب
ص: 306
لأحبّ أن لا يزال سقيماً حتى يلقى ربّه عزّ و جلّ (1)/
7 - رواية عبد الله بن سنان، عن أخيه محمد، عن جعفر بن محمد الصادق، عن آبائه (عليهم السلام)، عن عليّ (ع)(2): «أنّه عاد سلمان الفارسي... فقال له: يا سلمان، ما من أحد من شيعتنا يصيبه وجع إلا بذنب قد سبق منه، و ذلك الوجع تطهير له، قال سلمان: فليس لنا من ذلك أجر خلا التطهير؟ قال علي (ع): يا سلمان، لكم الأجر بالصبر عليه، و التضرّع إلى الله، و الدعاء بهما، تكتب لكم الحسنات، و ترفع لكم الدرجات، فأمّا الوجع خاصة فهو تطهير و كفّارة».
أقول: و هي تجمع بين الرواية الثالثة و الخامسة و بين الرابعة، و ترفع التنافي من بينهما، كما لا يخفى، فافهم جيداً.
ص: 307
العوض عندهم؛ نفع مستحقّ خالٍ عن التعظيم، و قالوا: إنّ قيد الاستحقاق يخرج المتفضّل به، و قيد الخلوّ عن التعظيم يخرج الثواب، فإنّه نفع مستحق مقترن بالتعظيم.
و استيفاء البحث عن أسبابه و أحكامه يقع ضمن فصول:
أنّ ما يوجب استحقاق العوض للعبد على الله الحكيم العادل أمور:
1 - إنزال الآلام على الإنسان، بل على مطلق الحساس على ما تقدم بحثه مفصّلاً.
2 - تفويت المنافع إذا كان لمصلحة غير راجعة إلى صاحبها؛ لعدم الفرق في لزوم العوض بين تفويت المنافع و إنزال الآلام، و لي في هذا الأمر بحث.
3 - إنزال الغموم إذا كان من قبله تعالى، لا بسوء اختيار العبد، كما هو المفروض في سابقه أيضاً. لكنّ الغمّ ألم، فيدخل هذا الأمر في الأمر الأول، لا أنّه بحياله كما زعم.
4 - إذن الله تعالى بإيلام حسّاس، سواء كان إذنه وجوبياً - كما في الهدي - أم ندبياً - كالضحايا - أم ترخيصاً كما في ذبح الحيوانات التي يؤكل لحمها و تذكية غيرها، فإنّ الإيلام و إن كان فعلاً مباشراً للإنسان - مثلاً - غير أنّ عوضه للذبيح المذكور على الله تعالى لمكان إذنه به. فتأمّل.
5 - تمكين غير العاقل، مثل سباع الوحش و سباع الطير و غيرهما من الحيوانات المؤذية، و للعلماء هنا أقوال أربعة:
أحدها: استحقاق العوض للمتألّم على الله تعالى مطلقاً، فإنّه تعالى مكّن الحيوان و جعل فيه ميلاً شديداً إلى الإيلام، و لم يجعل له عقلاً يميّز به حسن الألم من قبيحه، و لم يزجره بشيء من أسباب الزجر، مع إمكان ذلك كلّه، فلو لا تكلّفه تعالى بالعوض لقبح منه ذلك.
ثانيها: أنّ العوض على فاعل الألم، لقوله (ص): «إنّ الله ينتصف للجماء من القرناء».
ثالثها: أنّه لا عوض على أحد أصلاً، لقوله (ص): «جرح الجماء جبار».
ص: 308
رابعها: أنّ العوض عليه تعالى إذا كان الحيوان مضطرّاً إلى الإيلام، و على الحيوان إن لم يكن مضطرّاً إليه، فإنّ مجرد التمكين لا يقتضي انتقال العوض إلى الممكن، و إلاّ وجب عوض القتل على صانع السيف، بخلاف الإلجاء فإنّ الفعل يستند في الحقيقة إلى الملجئ.
أقول: الصحيح عندي: أنّ العوض على الله تعالى إذا فرضنا الحيوانات فاقدة للعقل و الشعور بين ما استدل للقول الأول، و على نفس الحيوان المؤلم إذا فرضناها شاعرة مدركة قبح الإيلام في غير صورة الاضطرار، فإنّ حال الحيوان حينئذٍ حال الإنسان العاقل العامد في إيلامه، حيث إنّ العوض عليه لا على الله تعالى. و قد أشرنا سابقاً أنّ في القرآن و السنّة و العلم الحديث مؤيّدات كثيرة لشعورها و إدراكها، غير أنّ مقداره و حدوده غير ثابتة، فالأقوال المذكورة غير تامة، و ما لفّقوه في بيانها فاسد، فإنّ الروايتين المذكورتين بعد تمامية دلالتهما تسقطان من ناحية ضعف السند. و تمكين غير الشاعر كالإلجاء دائماً، و صانع السيف مكّن العاقل الشاعر فلا يرجع عوض القتل إليه.
فإن قلت: معنى تعلق العوض بالحيوان المؤلم في فرض كونه عالماً هو انتقال ثوابه إلى المتألّم أو انتقال سيّئات المتألّم إليه، و هذا غير متأتّ في المقام؛ إذ لا دليل على دخول الحيوانات في النار، و لا على استحقاقها للثواب.
قلت: إذ سلّمنا عدم تكليفهم و انحصار العذاب بالنار لقلنا بأمر ثالث، و هو الانتقام، فينتقم المتألّم منه في ميدان الحساب ليتشقى قلبه، فتأمل. فإنّ ذلك بعيد، فلعلّ الله يعطى العوض بفضله.
و يلحق بالحيوان غير الشاعر: المجنون و الصبّي و نحوهما من غير المكلفين، فإنّ عوض الألم إذا لم يكن بسوء اختيار المتألّم إنّما هو على الله ربّ العالمين.
و فيه مقامان: المقام الأول: فيما إذا كان العوض على غير الله تعالى، و حينئذٍ يجب على الله تعالى الانتصاف من الظالم للمظلوم عقلاً و نقلاً، وفاقاً للمحقق الطوسي (قدس سره).
أمّا عقلاً فلأنّ الله تعالى مع كونه مدبّراً للنظام مكّن الظالم من الظلم على المظلوم، فلو لم ينتصف له لضاع حقّه، و هذا لا يلائم عدل الله سبحانه، فما ذهب إليه جمع من عدم وجوبه عقلاً ضعيف، و استدلالهم عليه عليل.
و أمّا نقلاً فلأنّ الله وعد بالاستيعاض من الظالم للمظلوم، و الوفاء بالوعد واجب عليه، و أنّه
ص: 309
لا يخلف الميعاد، و يدلّ عليه أيضاً - في الجملة - قوله تعالى: فَانْتَقَمْنٰا مِنَ اَلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَ كٰانَ حَقًّا عَلَيْنٰا نَصْرُ اَلْمُؤْمِنِينَ (1)، و كلمة «على» تفيد الوجوب.
قال العلامة في شرح التجريد: و لوصف المسلمين له تعالى بأنّه الطالب أي يطلب حق الغير من الغير.
قلت: إثبات أصل الانتصاف فضلاً عن وجوبه عليه تعالى بهذا الكلام مشكل، كما لا يخفى.
هل يجوز لله تعالى تمكين الظالم من الظلم إذا لم يكن له عوض في الحال يوازي ظلمه، أو لا يجوز؟
اختلفت العدلية في الجواب، فقيل: يجوز، و لو خروج الظالم من الدنيا و لا عوض له يعادل ظلمه يتفضّل الله عليه بالعوض المستحق عليه، و يدفعه إلى المظلوم.
و قيل: يجب تبقية الظالم حتى يحصل له العوض المستحق عليه للمظلوم، فوجود العوض في حال الظلم و إن لم يكن شرطاً لصحة التمكين إلا أنّه في تمام عمره معتبر فيها؛ و ذلك لأنّ الانتصاف واجب عليه تعالى، و التفضّل ليس بواجب، و تعليق الواجب بغير الواجب باطل.
و قال سيدنا المرتضى - أعلى الله مقامه - على ما نقله العلاّمة (رحمه الله) في شرح التجريد: إنّ التبقية أيضاً تفضّل، فلا يجوز تعليق الانتصاف بها، فيجب العوض في الحال، و هذا هو مختار المحقق الطوسي - قدس الله نفسه - أيضاً في تجريده.
أقول: و الصحيح هو: جواز التمكين، فإن حصل للظالم عوض فيما بعد فهو، و إلا يجب على الله تعالى أن يعوّض المظلوم؛ لأنّه الذي أقدر الظالم و ضعّف المظلوم و خلّى بينهما. و لا ملزم لدفع العوض إلى الظالم أولاً ثم إيصاله إلى المظلوم ثانياً، مع أنّ الظالم ربّما لا يستأهل التفضّل في الآخرة كما إذا كان قاتل نبي أو ولي.
و يحتمل سقوط العوض بتاتاً، فإنّ في تمكين الله المكلف الظالم مصلحة مهمة، و الظلم مستند إلى فاعله، عجزه عن العوض يوجب سقوطه، لا انتقاله إلى الله تعالى. لكنّ الحقّ ما قلنا، و الأقوال الثلاثة المذكورة كلّها غير متينة، كما يظهر بوجهه ممّا قلنا.
هذا، و لكنّ الكلام في صغرى هذه المسألة، فإنّ المؤلم إذا كان من المكلفين فهو متمكّن للاستيعاض منه دائماً و لو بانتقال سيئات المتألّم أو غمومه إليه، و إن كان من غيرهم فالعوض
ص: 310
على الله تعالى من أول الأمر بلا ريب، إلا أن يفرض المؤلم شاعراً غير مكلف كما أَشرنا إليه فيما سبق، فإيلامه مستند إلى نفسه، و لا عوض له ينتقل إلى المتألّم، و أحسن ما يصلح مورداً للمسألة هو قتلة المعصومين من الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) فإنّه لا ذنب لهم حتى ينتقل إليهم، و لا ثواب للقتلة المذكورين إلى المعصوم، و لو كان لما ساوى إيلامهم البتّة، و خلودهم في جهنم إنّما هو لأجل كفرهم و مخالفة أمر الله، فالتشفّي الحاصل منه لا يكون عوضاً، فافهم جيداً.
المقام الثاني: فيما إذا كان العوض عليه تعالى فيصحّ منه أن يوصله إلى المستحق في الدنيا أو في الآخرة، قل دخول الجنة أو بعده؛ لعدم خصوصية للزمان و المكان في ذلك.
لا يقال: إذا وصل العوض إلى المستحق في الجنة يحصل له الألم بانقطاعه، و الألم غير متحقّق في الجنة.
فإنّه يقال: حصول الألم بانقطاع العوض ممنوع، فإنّه متنعّم بما تشتهي نفسه و تلذّ عينه ألا ترى أنّ المتموّل الغنيّ لا يتألّم بانقطاع ما أهداه إليه صديقه أبداً، و هذا فليكن مفروغاً عنه، و منه ينبثق أنّ الالتزام بتفريق العوض على الأوقات بحيث لا يتعين له انتقطاعه ليتألّم به، أو باستمرار مثله دائماً تفضّلاً من الله عليه لئلاّ يتألّم، كما التزم بهما المحقق الطوسي (قدس سره) و غيره بلا ملزم، و مثلهما احتمال إن شاء الله إيّاه من الانقطاع، كما ذكره العلاّمة الحلّي (قدس سره).
فإن قلت: المستحق إذا كان من أهل النار إيصال عوضه إليه مستلزم لفرحه، و لا فرح في جهنم.
قلت أولاً: نمنع ذلك، بل يعوّضه الله قبل دخول النار، بل يظهر في بعض الروايات أنّ وصول أعواض الكافر إنّما هو قبل موته.
و ثانياً: نمنع لزوم فرحه، فإنّه في غمّ شديد و عذاب أليم لا يعقل معهما الفرح، و لا سيّما إذا لم يعلمه الله بذلك.
و ثالثاً: نمنع بطلان هذا المقدار من الفرح في جهنم.
و لعلّ أحداً يقول: إن إيصال العوض في النار لا معنى له إلا تخفيف عذاب المستحق في الجملة، و هو باطل، لقوله تعالى: لاٰ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ اَلْعَذٰابُ (1)، و قوله: لاٰ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَ هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (2).
لكنّ قوله غير محصّل و إن بنينا عليه سابقاً، فإنّ المقام من تشديد العذاب، لا من تخفيفه، فإنّا نقول: بأنّه يعذّب في أول دخوله النار عذاباً غير شديد، ثم إذا تمّ عوضه يشدّد عليه العذاب.
ص: 311
و لا نقول: إنّه يدخل جهنم ثم بعد حين من العذاب يخفّف عنه عوضاً له، و كم فرق بين الصورتين، و الآيتان المباركتان لا تدلاّن على نفي الصورة الأولى التي هي محلّ البحث، فافهم.
و هي أمور:
1 - لا يجب دوام العوض، لا في الدنيا و لا في العقبى؛ لعدم دلالة العقل على ذلك قطعاً، بل السيرة العقلائية قائمة على خلافه، فما عن بعض المعتزلة من وجوب دوامه في الجنة مستدلاّ بأمر ضعيف، باطل.
2 - لا يجب تعيّن العوض في شيء خاص، بل يصحّ بكلّ ما تحصل شهوة المستحق، و هو ظاهر. نعم، اعتبر التعيّن في الثواب، و سيأتي بحثه في باب المعاد في الجزء الرابع إن شاء الله.
3 - لا يجب إشعار صاحبه بإيصاله إليه، فإنّه منافع، أو دفع مضارّ يستريح به المستحق، و لا دخل للعلم فيه أصلاً، و أمّا الثواب فقيل بوجوب الإشعار عليه تعالى، و سيأتي بحثه في محلّه.
4 - يجب أن يكون العوض المستحق على الله تعالى زائداً على الألم زيادة تنتهى إلى حدّ الرضا من كلّ عاقل بذلك العوض مقابل ذلك الألم لو فعل به؛ لأنّه لو لا ذلك لزم الظلم، و أمّا مع مثل العوض المذكور فكأن الألم لم يثبت، و أمّا العوض المستحق على الغير فالواجب مساواته لما فعله الغير من الألم، أو فوت المنفعة، لأنّ الزائد على ما يستحق عليه ظلم على المؤلم المذكور. هكذا قالوا.
قلت: العوض إذا كان في مقابل الإيلام المسبّب من دفع الضرر و جلب النفع فلا بد من زيادته على الألم بمقدار لو عرض العوض و الألم على المتألم المذكور لرضي بالألم المزبور، و إلاّ قبح الإيلام، و أمّا إذا كان من جهة جريان العادة و نحوها فاعتبار الزيادة غير ظاهر؛ إذ المصلحة المذكورة تمنع العبثية، و العوض المساوي يمنع الظلم، فتدبر.
5 - يصحّ إسقاطه، خلافاً للمحقق الطوسي (قدس سره)؛ لأنّه حق المستحق، فله أن ينصرف عنه، و يصحّ نقله إلى غيره من المكلفين. و ربّما فصل بين العوض على الله تعالى و بين العوض على غيره، فقيل بجواز الإسقاط في الثاني إذا استحلّ الظالم من المظلوم، و بعدمه في الأول؛ لعدم انتفاع الواجب تعالى به فيكون عبثاً.
قلت: اشتراط الاستحلال ضعيف، بل يصحّ الإسقاط و لو ابتداءً، و عدم انتفاع الله سبحانه به لا يضرّ إذا كان للمسقط غرض عال فيه.
ص: 312
إنّ الله سبحانه بسابق فضله و قديم منه و إحسانه جعل العوض على نفسه زائداً على المقدار اللازم عقلاً بكثير. قال الله تعالى: وَ بَشِّرِ اَلصّٰابِرِينَ اَلَّذِينَ إِذٰا أَصٰابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قٰالُوا إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ * أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولٰئِكَ هُمُ اَلْمُهْتَدُونَ (1).
ففي صحيحة معروف بن خرّبوذ أو حسنة، عن أبي جعفر (ع) قال(2): «ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكر المصيبة و يصبر حين تفجؤه إلاّ غفر الله له ما تقدم من ذنبه، و كلّما ذكر مصيبة فاسترجع عند ذكره المصيبة غفر الله له كل ذنب اكتسبه فيما بينهما».
أقول: الروايات في المقام كثيرة جداً، و قد نقل جملة كثيرة منها المحدّث الحرّ العاملي (رحمه الله) في وسائله في أبواب الاحتضار و أبواب الدفن، و نحن ننقل هنا بعضها:
1 - صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: «قال رسول الله (ص): يقول الله عزّ و جلّ للملك الموكّل بالمؤمن إذا مرض: اكتب ما كنت تكتب له في صحّته، فإنّي أنا الذي صيّرته في حبالي.
و الروايات الناطقة بمثله كثيرة، و في بعضها: «و تساقطت ذنوبه كما تساقط ورق الشجر».
2 - صحيحة عبد الله بن المغيرة، عن أبي الصباح قال: قال أبو جعفر (ع): «سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة».
و مثلها غيرها، و في بعض الروايات: «و حمّى ثلاث ليالٍ تعدل عبادة سبعين سنة...» إلى آخره.
3 - رواية حماد و أنس، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبيّ (ص) لعليّ (ع) قال: «يا علي، أنين المؤمن تسبيح، و صياحه تهليل، و نومه على الفراش عبادة، و تقلّبه من جنب إلى جنب جهاد في سبيل الله، فإن عوفي مشى في الناس و ما عليه من ذنب».
4 - رواية الحسن بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام): «قال رسول الله (ص): من مرض يوماً و ليلة فلم يشك عوّاده بعثه الله يوم القيامة مع خليله إبراهيم خليل الرحمن حتى يجوز الصراط كالبرق اللامع.
5 - موثقة ابن بكير، عن أبي عبد الله (ع) قال: «ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنة، صبر أو لم يصبر».
ص: 313
6 - صحيحة إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السرّاج(1)، عن أبي عبد الله قال: «ولد يقدّمه الرجل أفضل من سبعين ولداً يخلّفهم بعده كلّهم قد ركبوا الخير (الخليل) و جاهدوا في سبيل الله».
و مثلها غيرها مضموناً، و في بعضها: «أفضل من سبعين ولداً يبقون بعده يدركون القائم» (ع).
7 - صحيحة أبي حمزة الثمالي، قال: قال أبو عبد الله (ع): «من ابتلى من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر ألف شهيد»(2).
8 - ما عن عليّ (ع) قال: «قال رسول الله (ص) - في حديث -: من صبر على المصيبة حتى يردّها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمئة درجة، ما بين درجة إلى درجة كما بين السماء و الأرض».
9 - رواية سليمان بن خالد: قال الصادق (ع): «إنّه ليكون للعبد منزلة عبد الله، فما ينالها إلا بإحدى خصلتين: إمّا بذهاب ماله، أو ببلية في جسده».
10 - رواية عبد الله بن يعفور، قال: شكوت إلى أبي عبد الله (ع) ما ألقى من الأوجاع و كان مسقاماً، فقال لي: «لو يعلم الناس (المؤمن خ) ماله من الأجر في المصائب لتمنّى أنّه قرض بالمقاريض».
ص: 314
و توضيح المرام فيها ببيان فوائد:
الرزق - كما في جملة من الكتب اللغوية -: ما ينتفع به الحيوان. و عرّفه بعض متكلّمي الأصحاب ب -: ما صحّ الانتفاع به و لم يكن لأحد منعه منه. و الظاهر أنّه مذهب جميع العدلية. و أمّا أتباع الأشعري فيعرّفونه ب -: كلّ ما ساقه الله إلى الحيّ فهو رزق له من الله، حلالاً كان أم حراماً إذ لا يقبح منه تعالى شيء.
أقول: فالنزاع في المحرّم حيث يعدّه هؤلاء القوم رزقاً، و العدلية لا تعدّه، و حيث إنّ الحكم بالحسن و القبح العقليين ضروري، فيكون كلام الأشاعرة باطلاً بالضرورة.
ثم إنّهم أوردوا على تعريف العدلية: بأنّه لو لم يكن الحرام رزقاً لم يكن المتغذّي طول عمره بالحرام مرزوقاً، و التالي باطل؛ لقوله تعالى: وَ مٰا مِنْ دَابَّةٍ فِي اَلْأَرْضِ إِلاّٰ عَلَى اَللّٰهِ رِزْقُهٰا(1).
و أجاب العدلية أولاً بالنقض: بما لو مات حيوان قبل أن يتناول شيئاً محلّلاً و لا محرّماً فإنّه غير مرزوق وجداناً.
أقول: و لعلّه لأجل هذا المحذور عدل بعضهم عن الاستدلال بالآية إلى الإجماع(2)، فيصحّ حينئذٍ أن يخصّص الإجماع بالمعمّر دون الحيّ ساعة مثلاً، لكنّ دعوى الاجماع في أمثال هذه المقامات إن دلّت على شيء فإنّما تدلّ على قصور المدّعي و عجزه عن البحث العلمي.
و ثانياً بالحلّ: بأنّ الرزق أعمّ من الغذاء، و لا أقلّ من انتفاعه بالهواء و الماء و نحوهما، فلا يوجد من لا ينتفع بالمحلّل أصلاً.
و قال شيخنا البهائي (قدس سره): إن المعتزلة لم يشترطوا الانتفاع بالفعل، بل تمكّنه، و من الظاهر أنّه
ص: 315
لا يوجد من لا يتمكن من الرزق الحلال طيلة حياته، فتدبّر.
و أمّا الدليل على صحة قول العدلية فهو: أنّ الرزق من الحرام قبيح، و لا القبيح لا يصدر عن الحكيم، و أن الله مدح من أنفق من رزقه بقوله: وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ (1). و من المعلوم أنّه على الإنفاق من الحرام، بل هو محرّم مذموم، كما قال تعالى: وَ لاٰ تَيَمَّمُوا اَلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (2). فيعلم أنّ الحرام ليس برزق.
أقول: هذا محصول بعض كلماتهم في المقام، و هنا وجوه أخرى استدلّ بها كلّ على صحة قوله.
و الحقّ الحريّ بالقبول أن يقال: إن كون الحرام رزقاً إمّا بمعنى تمكين الله تعالى الحي من التصرّف فيه و عدم منعه عنه تكويناً، و إمّا بمعنى تقديره و كتابة حدود التصرّف الحرام في اللوح المحفوظ، و إمّا بمعنى تحليله تشريعاً.
و إمّا بمعنى أنّه المؤثّر في تصرّف المنتفع بالحرام.
و إمّا بمعنى أنّه تعالى قدّر رزقه من الحرام و لم يجعل له سبيلاً إلى الحلال أصلاً، و لا احتمال سادس هنا.
فنقول للأشعرية: إن أردتم الوجه الأول فلا شكّ لأحد في صحته، بل هو محسوس.
و إن أردتم الوجه الثاني فهو أيضاً قطعيّ على ما تقدم في الجزء الأول من هذا الكتاب.
و إن أردتم الوجه الثالث فبطلانه قطعي، بل حسّي، كما سبق تفصيله في هذا الجزء.
و إن أردتم الوجه الرابع فهو مخالف للضرورة الدينية، فإنّ الله حرّم التصرف في المال الحرام، و لا يحتمل أن يتفوّه به مسلم.
و إن أردتم الوجه الخامس فهو أيضاً قطعيّ الفساد، فإنّه مع قبح هذا التقدير يستلزم حلّية المحرّم المذكور و سقوط المنع الشرعي عنه، ضرورة جواز أكل المحرّمات للمضطرّ شرعاً و عقلاً، و هذا خلف.
و على الجملة: الرزق رزقان: رزق تكويني، و هو كلّ ما يستمدّ به الحيوان أو غيره في بقائه و حفظ كيانه، سواء كان محلّلاً أم محرماً. و رزق تشريعي، و هو ما ينتفع به و لا يكون محرّماً و ممنوعاً شرعاً.
ص: 316
للرزق درجات: الدرجة الأولى: ما تتوقّف عليه الحياة، و يسمّى بسدّ الرمق.
الدرجة الثانية: ما يرتفع به المضيقة المانعة من حصول أثار الحيّ المطلوبة منه، كالعبادة من المكلف مثلاً، و الركوب، حمل الثقال من بعض الحيوان مثلاً.
الدرجة الثالثة: ما يحصل به اللذّة و الراحة، و له مراتب مختلفة.
أقول: لا يعتبر في الأول الحلّية، فيجوز أو يجب الارتزاق بأي مأكول عند الضرورة، و الثانية ليست من الحياة الدنيا، بل هي من الحياة الطيبة، و الثالثة محفوفة بالزهد و القناعة، و تفصيله في المباحث الاقتصادية مهم.
الجسم النامي له يكفي نفس وجوده لاستمراره و بقائه، بل لا بد من استمداده و تمتّعه بأشياء خارجة عن ذاته، كالهواء و الماء و الطعام و اللباس و المسكن و نحوها، فما دام يريد الله وجود الجسم المذكور فلا بد من إيصال هذه الأمور إليه؛ لئلّا يهلك فيلزم نقض الغرض القبيح.
فمن هنا انقدح أنّ الرزق بمرتبته الأولى و الثانية واجب عليه تعالى بحسب حكمته، و تعلّق إرادته النافذة ببقاء المرتزق المذكور؛ ضرورة أنّ حفظ المسبّب إنّما هو بوجود أسبابه، و يدلّ عليه - أي على الوجوب المذكور - أيضاً قوله تعالى: وَ مٰا مِنْ دَابَّةٍ فِي اَلْأَرْضِ إِلاّٰ عَلَى اَللّٰهِ رِزْقُهٰا(1).
و أمّا الزائد على هذه المرتبة فهو تفضّل منه سبحانه، يعطي حسب تفاعل الأسباب من يشاء: وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلاّٰ عِنْدَنٰا خَزٰائِنُهُ وَ مٰا نُنَزِّلُهُ إِلاّٰ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (2).
بعد ما ثبت أنّ الرزق واجب على الله تعالى مادام أراد بقاء المرتزق، يقع الكلام في أنّ وجوبه هل هو بنحو الإيصال إلى المرزوق بحيث لو لم يجهد في طريقه و قعد في بيته لوجب عليه تعالى أن يوصله إليه، أو لا، بل هو بنحو لا يستغني عن سعى القادر إليه؟ لم أفز عاجلاً بكلام أحدٍ تعرّض للمقام إلا بعض الأفاضل، و إليك نصّ كلامه(3):
ص: 317
ثم هل يشترط السعي في إيصال الرزق إلى العبد و وجوبه عليه تعالى، أو يجب عليه و إن جلس في بيته و ترك الطلب و السعي من رأسه. قال بعض بوجوب القدر الضروري، و هو ما يمسك به الحياة. و قال البعض: لا يجب إلا لمن ألقى عنان التوكّل إليه؛ لقوله تعالى: وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (1).
و قال بعض العلماء المحدّثين بعد نقل القولين: و الحق أنّ مثل هذا الإيصال غير واجب عليه سبحانه. نعم، ربّما تفضّل به، و لا مانع من التفضّل.
أقول: مقتضى جملةٍ من الآيات و الأخبار الماضية و الآتية: أن الله وعد أن يوصل الرزق المقدّر للعبد إليه و إن لم يطلبه و لم يأته، بل لو كان في حجرٍ لآتاه رزقه، كما نصّوا عليه - عليهم الصلاة و السلام - هنا، و تشهد له جملة من القصص السالفة و الآتية. و أمّا معرفة أنّه على وجه الوجوب عليه تعالى أو على وجه التفضّل منه فلا فائدة و لا حاجة لنا في معرفته، و تحقيقه في المقام.
و أمّا ما ورد في الأحاديث و التفاسير ممّا يخالف ظاهرها مثل... فهي محمولة على فضل طلب الرزق، أو توسعته، أو على انتظام أمور الدنيا، أو على عدم سدّ العبد على نفسه الطرق العادية لإيصاله تعالى رزقه إليه بسوء اختياره، أو على مراتب العباد في ذلك، و نحوها. انتهى ما أردنا نقله من كلامه.
أقول: المرتزق إمّا أن يمكنه السعي، أو لا، كالنبات و عجزة الحيوان، و الثاني يجب إيصال رزقه على التحكيم المدبر؛ ما دامت إرادته متعلّقة ببقائه، لما مرّ، و الأول: إمّا أن يتوقف رزقه على السعي، أو لا، كالهواء مثلاً.
و على الثاني لا معنى للسعي نحوه.
و على الأول: فإمّا أن يحصل بدونه اتفاقاً، كالأموال الحاصلة بالهدية و الهبة و اللقطة و الميراث و نحوها. و إمّا أن لا يحصل. فعلى الأول لا معنى أيضاً للسعي حتى بنحث عن تأثيره. و على الثاني فهل يشترط السعي نحوه أو لا؟ هذا هو محلّ البحث.
فإن فرضنا تعلق إرادة الله سبحانه على بقاء الحيوان على كل تقدير فلا ريب في عدم مدخلية السعي في وصول الرزق، و إلا فهو شرط فيه قطعاً. هذا في مقام الثبوت، و أمّا في مقام الإثبات فلا دليل معتمداً عليه على الشقّ الأول، و إليك بيان عمدة ما استدل الفاضل المتقدم عليه(2):
ص: 318
1 - ما روي من: «أنّ الرزق يأتيك أسرع من السيل، و يتعقّبك كما يتعقّبك الموت، فإنّ الرزق مقسوم، والحريص محروم».
2 - ما روي من: «أنّ الرزق بطلب العبد أشدّ من طلب أجله.
3 - ما عن الصادق (ع):... «فإنّ الرزق لا يسوقه حرص حريص، و لا يردّه كراهية كاره، و لو أنّ أحدكم فرّ من رزقه كما يفرّ من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت».
4 - ما عنه (ع)، كما في الكافي: «لو أنّ أحدكم هرب من رزقه لتبعه حتى يدركه، كما إن هرب من أجله تبعه حتى يدركه»، و قال (ع): «إنّ أرزاقكم تطلبكم كما تطلبكم آجالكم، فلن تفوتوا الأرزاق كما لم تفوتوا الآجال».
5 - ما عن النبي الأعظم (ص): «لو كان العبد في حجر فأتاه (لأتاه ظ) رزقه فأجملوا في الطلب». و في رواية، عن الصادق (ع): «لاقاه رزقه...» إلى آخره. و في الوافي عنه (ع): «لأتاه الله برزقه...» إلى آخره.
6 - ما عن الصادق (ع): «الرزق مقسوم على ضربين: أحدهما واصل إلى صاحبه و إن لم يطلبه، و الآخر معلّق بطلبه، فالذي قسّم الله للعبد على كلّ حال آتية، و إن لم يسع له...» إلى آخره.
7 - ما عن أمير المؤمنين (ع): «الرزق رزقان: رزق تطلبه، و رزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك... و اعلم أنّه لا يسبقك إلى رزقك طالب، و لن يغلبك عليه غالب، و لن يحتجب عنك ما قدّر لك...» إلى آخره.
أقول: و هناك آيات و روايات أخر تعارض هذه الروايات، و تدلّ على خلاف ما ذهب إليه الفاضل المذكور(1):
1 - قوله تعالى: هُوَ اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اَلْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنٰاكِبِهٰا وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ (2).
2 - و قوله تعالى: وَ اِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اَللّٰهِ (3).
و لا معنى للأمر بطلب الرزق إذا لم يكن سبباً له، و عليه فالروايات الكثيرة الأمرة بطلب الرزق كلّها تدلّ على خلاف قوله، و في بعضها: «إن رأيت الصفّين قد التقيا فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم». و في بعضها: «إن ظننت أو بلغك أنّ هذا الأمر (لعلّه (ع) يريد قيام القائم (ع) كائن
ص: 319
فلا تدعّن طلب الرزق...» إلى آخره.
3 - موثقة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله: رجل قال: لأقعدنّ في بيتي و لأصلّيّن و لأصومنّ و لأعبدنّ ربّي فأمّا رزقي فسيأتي! فقال أبو عبد الله (ع): «هذا أحد الثلاثة الّذين لا يستجاب لهم».
4 - روايته أيضاً عنه (ع) قال: «أرأيت لو أنّ رجلاً دخل بيته و أغلق بابه أكان يسقط عليه شيء من السماء»!
5 - ما عن أمير المؤمنين (ع): «أشخص يشخص لك الرزق».
و الشخوص: الخروج، كما في الوافي، و ظاهر الوسائل أنّه من الصادق (ع).
6 - ما عن الصادق (ع): «ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم... و رجل أمسك عن الطلب فيقول: اللهمّ رزقني، فيقول الله تعالِى: ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب...» إلى آخره.
7 - رواية علي بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله (ع): ما فعل عمر بن مسلم؟ قلت: جعلت فداك، أقبل على العبادة و ترك التجارة، فقال: ويحه، أما علم أنّ تارك الطلب لا يستجاب له، إنّ قوماً من أصحاب رسول الله (ص) لمّا نزلت: وَ مَنْ يَتَّقِ اَللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَحْتَسِبُ (1) أغلقوا الأبواب، و أقبلوا على العبادة، و قالوا: قد كفينا، فبلغ ذلك رسول الله (ص)، فأرسل إليهم فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا: يا رسول الله، تكفّل الله لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة! فقال: إنّه من فعل ذلك لم يستجب له، عليكم بالطلب.
هكذا في التهذيب، و في الفقيه زاد قوله (ع): «إنّي لأبغض الرجل فاغراً فاه إلى ربه يقول: ارزقني و يترك الطلب».
8 - ما في رواية عمر بن يزيد من قول الصادق (ع): «أرأيت لو أنّ رجلاً دخل بيتاً و طيّن عليه بابه، و قال: رزقي ينزل عليّ كأن يكون هذا، أما إنّه أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعوة...» إلى آخره.
أقول: و الروايات كثيرة اكتفينا بهذا مخافة التطويل. ثم أعلم أنّ الحق عدم التعارض بين هذه الأخبار و ما تقدم.
بيا ن ذلك: أنّ السعي لا يكون سبباً تاماً لجلب الرزق، بل قد يتخلّف عنه، كما نشاهده خارجاً، و إنّما هو شرط له، و السبب هو تقدير الله و إرادته تعالى، فما قدّره الله للشخص يعطيه على سعيه، فليس كلّ ما أراده يناله، فما ورد من «أنّ الرزق يصل إليه لا محالة» ناظر إلى هذه
ص: 320
الجهة، و لا دلالة على عدم مدخلية السعي و بطلان تأثيره فيه، بل الطائفة الأخيرة من الأخبار بين ما هو صريح في مدخليته فيه، و بين ما هو ظاهر فيها.
و على الجملة: معنى قسمته تعالى الرزق للحيوان و ضمانه إيّاه له: أنّه يخلق و يوجد ما ينتفع هو به و يهيّؤه له حتى تصاحبه بالسعي و الكسب، لا أنّه يوصله إليه و إن لم يسع نحوه، كما يدلّ على ذلك: قوله (ع) فيما مرّ: «لو كان العبد في حجر لأتاه الله برزقه، فأجملوا في الطلب»، فجمع (ع) بين وجوب الرزق عليه تعالى، و الطلب الجميل.
و يدلّ عليه أيضاً: قول رسول الله (ص) في حجة الوداعٍ كما في صحيحة الثمالي عن الباقر (ع)، و هو مروي في جملة من الأخبار المختلفة سنداً و متناً: «ألا إنّ الروح الأمين نفث في روعي أنّه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتّقوا الله و أجملوا في الطلب و لا يحملنّكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنّ الله تبارك و تعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً، و لم يقسّمها حراماً، فمن اتّقى الله و صبر أتاه الله برزقه من حلّه، و من هتك حجاب الستر و عجّل فأخذه من غير حلّه قصّ به من رزقه الحلال و حوسب عليه يوم القيامة».
فقد ذكر (ص) لا بدّية استكمال الرزق مع الأمر بالطلب، و جعلها مغنية عن طلب الحرام، و الروايات الدالة على هذا المضمون - و هو عدم احتياج العبد إلى الحرام بما قدّره الله له من الحلال - كثيرة، فاتقن ذلك حتى تعرف أنّ الطائفة الأولى من الأخبار ناظرة إلى نفي حرص العبد في تحصيل رزقه و لو من المحرّمات، و تسديده من الوقوع في الهلكات، و راحة باله من قلّه الزاد و لا نظارة لها إلى سقوط السعي عن التأثير بتاتاً، ألا ترى أنّ القرآن ينادي: وَ مٰا مِنْ دَابَّةٍ فِي اَلْأَرْضِ إِلاّٰ عَلَى اَللّٰهِ رِزْقُهٰا(1)، وَ مَنْ يَتَّقِ اَللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَحْتَسِبُ (2)، وَ كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لاٰ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللّٰهُ يَرْزُقُهٰا وَ إِيّٰاكُمْ (3)، نَحْنُ قَسَمْنٰا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ (4)، وَ فِي اَلسَّمٰاءِ رِزْقُكُمْ وَ مٰا تُوعَدُونَ (5)، فَوَ رَبِّ اَلسَّمٰاءِ وَ اَلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مٰا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (6).
ص: 321
و مع ذلك يأمر الناس بالطلب و السعي بقوله: فَامْشُوا فِي مَنٰاكِبِهٰا(1)، و قوله: وَ اِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اَللّٰهِ (2).
و سرّ ذلك: أنّ الله أبي إلاّ أن يجري الأمور بأسبابها.
و أمّا ما تقدم عن أمير المؤمنين و الصادق من تقسيم الرزق إلى الطالب و المطلوب فيمكن حمل الطالب منهما على بعض الشقوق التي ذكرنا سابقاً خروجها عن محلّ البحث، أو على بعض الموارد تفضّلاً، و نحو ذلك.
و بالجملة: الرواية دليل لنا، لا له، كما لا يخفى.
و أمّا ما ذكره بعضهم من نفي اشتراط السعي متمسّكاً بقوله تعالى: وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (3) فهو خطأ، فإنّ التوكّل لا ينافي الأسباب.
قال الصادق (ع) كما في رواية عمر بن سيف(4): «لا تدع طلب الرزق من حلّه فإنّه عون لك على دينك، و أعقل راحلتك و توكّل».
أقول: و منه أخذ من قال: (با توكّل زانوي أشتر ببند). هذا كلّه بالنظر إلى الروايات، و أمّا بلحاظ حال العقلاء و سيرتهم فلا شك في تأثير السعي المذكور في حصول الرزق، و إنّما طوّلنا المقام لأنّه ليس من المسائل العلمية الاعتقادية فقط، بل له ارتباط مستقيم بالمجتمع الإسلامي و ثقافتهم و اقتصادهم.
هل السعي يوجب زيادة الرزق بعد مدخليته في أصل حصوله، أو لا؟
قال صاحب لآلي الأخبار (رحمه الله) بعد كلامه السابق: و لو تنزّلنا عن ذلك و قلنا بوجوب السعي و طلب الرزق فلا ريب في أنّ المستفاد منها (أي من الأخبار) استفادة قطعية أنّه لا يتفاوت بتفاوت السعي له، بل يكفى فيه مسمّاه في كلّ باب... إلى آخره.
أقول: الأمر بعكس ما ذكره يظهر لمن لاحظ بعض ما تقدم هنا و ما لم ننقله من الروايات:
فعن الصادق (ع): «إنّ الله قسّم الأرزاق بين عباده، و أفضل فضلاً كبيراً لم يقسّمه بين أحد،
ص: 322
قال الله: وَ سْئَلُوا اَللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ (1). و السؤال قد يتحقّق باللفظ و قد يتحقّق بالسعي و العمل.
فلئن وجد في بعض الروايات ما ينافيه فلا بدّ من حمله على محمل آخر.
نعم، السعي لا يلزم الزيادة دائماً كما هو محسوس خارجاً، و لذا قال أمير المؤمنين (ع) - على ما نقل -: «و كم رأيت من طالب متعب نفسه مقترٍ عليه رزقه».
ثم إنّ لزيادة الرزق أسباب أخرى دلّت عليها الروايات، و لا مجال لذكرها، و في أحد الوجهين في قوله تعالى: وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اَللّٰهُ (2)، أنّ الإنفاق يزيد الرزق، نعم، في جملة من الروايات: «إنّ الله قسّم الرزق حلالاً و لم يقسّمه حراماً، فمن ارتكب حراماً نقص من رزقه الحلال، و حوسب عليه يوم القيامة».
أقول: عدم تقسيم الرزق من الحرام ظاهر الوجه، فإنّ الله منع من التصرف فيه، فكيف يجعله رزقاً لعباده؟!
و إن شئت فقل: إنّ الله أمر بطلب الرزق، و الحرام فاحشة، و الله لا يأمر بالفحشاء و أمّا إذ اختار الشخص الحرام بسوء اختياره فيمسك الله عنه ما قدّره له من الحلال، فليتدبّر العاقل أنّ ارتكاب المحرّم لا يزيد في الرزق، فما الموجب للميل إليه؟ حيث إنّه عمل لانفع فيه عاجلاً، وعليه العقاب آجلاً.
اللائح ممّا كتبناه في الفائدة الرابعة و غيرها: أنّ الرازق هو الله فقط فإنّ خلق ما ينتفع به الحيّ و إيصاله إليه، أو جعله على نحوٍ إن سعى نحوه لوصله، لا يمكن إلا من الله تعالى، فالعباد و إن كان بعضهم واسطة في إيصال الرزق إلى بعضهم لكنّهم ليسوا برازقين، و الارتكاز الديني أيضاً لا يسوّغ إطلاق لفظ «الرازق» على غيره تعالى مطلقاً، و يمكن استفادة ذلك من قوله تعالى: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ قُلِ اَللّٰهُ (3)، و أمّا قوله تعالى: خَيْرُ اَلرّٰازِقِينَ في غير مورداً(4) فلعلّه بلحاظ إيصال الرزق أو بلحاظ اعتقادهم أو غير ذلك، فتأمل.
ص: 323
حسن الإحسان و التفضّل لا بتقيّد بشرط أصلاً، فهو حسن دائماً، إلا أن يمنع عنه مانع، كالتحفّظ على نظام الاجتماع و غيره. و من هذا الباب قبح العفو عن الجناة و المفسدين و القاتلين و السارقين.
و قال عزّ من قائل: وَ لَكُمْ فِي اَلْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ يٰا أُولِي اَلْأَلْبٰابِ (1). و في غير صورة المانع فلا حدّ لحسن التفضّل و الإثابة، كما لا يخفى. و أمّا العقاب و التعذيب فهو لا يصح الابتداء به من دون سابقة استحقاق للشخص بارتكاب جريمة و معصية، فإنّه ظلم بحت، و عدوان محض، و نفي هذا الأمر عن الله الحكيم العادل بعد الأصول المتقدمة في هذا المقصد ضروري لا يحتاج إلى تنبيه و توضيح.
لكنّ الذي يصعب في المقام ما يتراءى من جملة الروايات من عدم اطّراد هذا الحكم العقلي القطعي في موارد، فلا بدّ من لفت النظر إليها و تحقيق حالها، فنقول مستمدّاً من الله الغني:
و هي على أقسام:
القسم الأول: ما دلّ على أنّ فيه منقصة ذاتية، أي مع قطع عن عمله السيّىء: مثل رواية زرارة(2)، قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: «لا خير في ولد الزنا و لا في بشره، و لا في شعره، و لا في لحمه، و لا في دمه، و لا في شيء منه» يعنى ولد الزنا.
و رواية أبي بصير(3)، عن الصادق (ع) قال: «إنّ نوحاً حمل في السفينة الكلب و الخنزير و لم يحمل فيها ولد الزنا، و إنّ الناصب شرّ من ولد الزنا».
ص: 324
و رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (ع) قال(1): «لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا، و هو لا يطهر إلى سبعة آباء...» إلى آخره(2).
و مرسلة الوشّاء، عمّن ذكره، عن الصادق (ع)(3): أنّه كره سؤر ولد الزنا و اليهودي و النصراني، و كلّ من خالف الإسلام... إلى آخره.
و رواية ابن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن(4)، و فيها: «لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنّه يغتسل فيه من الزنا، و يغتسل فيه ولد الزنا.
و الناصب لنا أهل البيت، و هو شرّهم».
و قريب منها: رواية حمزة بن أحمد، عن الكاظم(5) (ع)، و حسنة ابن مسلم، عن الباقر (ع) قال: «لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحب إليّ من ولد الزنا».
أقول: جميع هذه الأخبار ضعيفة الإسناد، سوى أخيرها، و مع ذلك الالتزام بمفادها غير بعيد، فيقال لولد الزنا: منقصه و حطّة، كما يستفاد ذلك من أخبار أخر أيضاً، و هذا ممّا لا ينافي عدله تعالى أبداً، فإنه من تأثير الأسباب في المسببّات، كما مرّ بحثه في مباحث الآلام.
القسم الثاني: ما دلّ على أنّه لا يدخل الجنة، كرواية سعد بن عمر الجلاّب(6) قال: قال لي أبو عبد الله (ع): «إنّ الله خلق الجنة طاهرة مطهّرة، فلا يدخلها إلا من طابت ولادته».
و قال أبو عبد الله (ع): «طوبى لمن كانت» أمّه عفيفة».
و رواية محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه(7)، رفع الحديث إلى الصادق (ع)، قال: «يقول ولد الزنا: يا ربّ، ما ذنبي؟ فما كان لي في أمري صنع؟ قال: فينادي منادٍ فيقول: أنت شرّ الثلاثة، أذنب و الداك فتبت عليهما، و أنت رجس، و لن يدخل الجنة إلاّ طاهر».
أقول: لعلّ المراد بالثلاثة هم: اليهود و المجوس و النصارى، كما يستفاد من بعض أخبار الباب، و يحتمل أن يراد بهم: الزانية و الزاني و ولد الزنا.
و في طهارة الشيخ و مصباح الفقيه: و نشأت عليهما بدل «فتب عليهما»، و في الحدائق:
ص: 325
«فنبت عليهما»، و في الأنوار النعمانية: «فثبت عليهما».
و رواية أبي خالد الكابلي(1): أنّه سمع عليّ بن الحسين (ع) يقول: «لا يدخل الجنة إلا من خلص من آدم».
و رواية سدير الضعيفة سنداً(2)، قال: قال أبو جعفر (ع): «من طهرت ولادته دخل الجنة».
أقول: و الظاهر أن مساق الرواية مانعية خبث الولادة عن دخول الجنة.
و رواية عبد الله بن سنان(3)، عن أبي عبد الله (ع) قال: «خلق الله الجنة طاهرة مطهّرة، لا يدخلها إلا من طابت ولادته».
فهذه الروايات الخمس تنطق بأنّ ولد الزنا لا يدخل الجنة، سواء كان مؤمناً عادلاً، أم كافراً فاسقاً، على ما هو مقتضى إطلاقها، و قد مال إليه العلامة المجلسي (رحمه الله)(4) و قال: إنّه مع فعل الطاعة و عدم ما يحبطه يثاب في النار.
و اختاره المحدّث البحراني (رحمه الله)(5)، لعلّه المستفاد من كلام شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) أيضاً، حيث قال في كتاب الطهارة(6): ثم إنّ الأخبار في مجازاة ولد الزنا مختلفة، و الذي يحصل من الجمع بين مجموعها أنّه لا يدخل الجنة و لا يعذّب في النار إذا لم يعمل عملاً موجباً له. انتهى كلامه.
فقوله: «لا يعذّب في النار» يشعر بأنّه يدخل النار و لا يعذّب، فيكون موافقاً لما مال إليه المجلسي (رحمه الله). نعم، لم يقل: إنّه مختاره، و إنّما ذكره بعنوان الحاصل من الروايات، و لعلّه لا يرى لمجموع الروايات حجية.
أقول: البحث هنا في جهات:
الأولى: في حال الروايات في أنفسها، و هي ضعيفة الإسناد، سوى رواية أبي خالد فإنّها معتبرة بناءً على وثاقة أبي خالد المذكور، و لكنّها لم تثبت، لكنّ دلالتها غير واضح في المراد، و لا يمكن إثبات مثل هذا المطلب بمثل هذا المضمون المجمل.
الثانية: في قياسها بالنسبة إلى القواعد العقلية، و الصحيح: أنّ الروايات إن تمّت في أنفسها
ص: 326
لا مانع عنها عقلاً، فإنّ الثواب غير واجب على الله تعالى، و على فرض وجوبه فلا دليل على تعيينه في الجنة، بل يجوز إيصاله في الأعراف و غيرها أيضاً، فإذا مات ولد الزنا مؤمناً صالحاً يثيبه الله تعالى في غير الجنة.
الثالثة: في جمعها مع الأدلة النقلية، و الانصاف أنّه لا يمكن الأخذ بها في قبال العمومات القرآنية الدالة على دخول من آمن و عمل صالحاً الجنة، إذ هي على سياق خاصّ لا يقبل التخصيص حتى يقال - كما قال بعضهم - بأنّ الروايات المذكورة مخصّصة لها غير ولد الزنا، و ليس كلّ عامّ يقبل التخصيص، بل بعض العمومات يابى عنه لخصوصية فيه كما قرر في اصول الفقه و المقام كذلك كما لا يخفى على الخبير الماهر.
و إن شئت فقل: الروايات تدلّ على أن ولد الزنا لا يدخل الجنة، سواء كان مؤمناً عادلاً، أو كافراً فاسقاً، و الآيات القرآنية تدلّ على أن المؤمن الصالح يدخل الجنة، سواء ولد من الزنا، أم لا، و النسبة بينهما عموم من وجه، و مورد الاجتماع هو المؤمن الصالح المتولّد من الزنا، فتعارض فيه الآيات و الروايات، فتسقط الروايات المذكورة عن الحجية في المورد المذكور؛ لما دلّ على طرح ما خالف كتاب الله، خرج منه صورة المخالفة بنحو العموم المطلق بالدليل القطعي، و بقي الباقي تحته و هو المخالفة بالعموم من وجه أو بالتباين، و مع فرض إلحاق الثاني بالأول و اختصاص الطرح بالثالث أيضاً تقدّم الآيات؛ فإنّ دلالتها على المورد بالعموم، و دلالة الروايات عليه بالإطلاق(1)، و قد حقق في محلّه تقديم العموم على الإطلاق في مورد التعارض.
لا يقال: بناءً على ذلك لم يبق تحت الروايات إلا ولد الزنا الكافر فيلغو عنوان ولد الزنا؛ إذ الكافر مستحق للنار، و لا يدخل الجنة و إن كان ولد الحال.
فإنّه يقال: لا بأس به بناءً على أنّ ذكر العنوان المذكور لأجل كونه سبباً غالبياً لاختيار صاحبه الكفر و العصيان و لو بسوء اختياره، فافهم و تأمّل.
فتحصّل: أنّ مقتضى الجمع بين الأدلة: أن ولد الزنا إذا عمل يدخل الجنة كغيره من المكلفين، و هذا هو المناسب للاعتبار العقلي أيضاً، كما يوضّح ذلك بضرب مثل، و هو: أنّا نفرض رجلاً و امرأة مؤمنين فاسقين، فزنى الرجل بالمرأة طيلة حياتهما و ولد لهما ولد صار مؤمناً عادلاً بعد بلوغه، و عمل صالحاً حتى انتضى عمره، و أمّا والداه فتابا في آخر عمرهما و ماتا، نقول: لا شك أنّهما يدخلان الجنة و لو بعد مكث في النار؛ لأنّهما مؤمنان على الفرض،
ص: 327
فهل يعقل أن الجواد المطلق يمنع الولد التقي من الجنة مع دخول أبويه فيها؟!
و لنأخذ مثالاً آخر: نفرض رجلاً و امرأة كافرين فاسقين، فجمع الرجل بالمرأة وزنى بها، فتولّد ولد صار مؤمناً من أول تمييزه، و نصح أبويه في آخر عمرهما و أرشدهما إلى الاسلام فآمنا و ماتا، و الولد استمر في أعماله الصالحة حتى مات، فهل يصحّ أن نقول: إنّ الله بكرمه يدخلهما الجنة و لا يدخله؟
القسم الثالث: ما دلّ على كفره و دخوله النار، و عدم قبول عمله، كرواية سليمان الديلمي المتقدمة الدالة على أنّه شر الثلاثة بناءً على أنّ المراد بالثلاثة: الملل الكافرة، كما احتملنا، لا أبواه و نفسه.
و رواية أبي بكر(1)، قال: كنّا عنده - قيل: الضمير راجع إلى الصادق (ع) - و معنا عبد الله بن عجلان، فقال عبد الله بن عجلان: معنا رجل يعرف ما نعرف، و يقال له: أنّه ولد زنا، فقال: ما تقول: فقلت: إن ذلك ليقال له، فقال: إن كان ذلك كذلك بني له بيت في النار من صدر(2) يردّ عنه و هج جهنّم و يؤتى برزقه.
و صحيحة أبي خديجة(3)، عن أبي عبد الله (ع) قال: «لو كان أحد من أولاد الزنا نجا، نجا سائح بني إسرائيل، فقيل له: و ما سائح بني إسرائيل؟ قال: كان عابدا فقيل له: إنّ ولد الزنا لا يطيب أبداً، و لا يقبل الله منه عملاً، قال: فخرج يسيح بين الجبال و يقول: ما ذنبي؟!
و رواية إبراهيم بن عبد الحميد، و مرسلة جعفر بن بشير، و مرسلة عبد الرحمن بن عبد الحميد(4) الدالة على أن ديته كدية اليهودي ثمانمئة درهم.
بل في خبر ابن سنان، عن الصادق (ع): كم دية ولد الزنا؟ قال: «يعطي الذي أنفق عليه ما أنفق». (نقله في الحدائق).
و قد نقل عن السيد المرتضى(5) و ابن إدريس القول بكفره و نجاسته، و إن لم يظهر الكفر،
ص: 328
كما في البحار و غيرها.
و في الحدائق: و نقل جملة منهم عن الصدوق أيضاً القول بالنجاسة و الكفر... إلى آخره.
و في الجواهر: بل ربّما قيل: إنّه ظاهر الكليني، حيث روى ما يدل عليه.
أقول: عبارة الصدوق المحكية في الحدائق غير دالة على كفره، بل على نجاسته، و مجرد رواية الكليني شيئاً لا يدلّ على أنّه اختاره، فلا قائل معلوم بذلك من أصحابنا، سوى العلمين المذكورين، فما ادّعاه ابن إدريس في سرائره من عدم الخلاف في ثبوت كفر ولد الزنا، بل قد يظهر منه أنّه من المسلّمات كما في الجواهر شيء عجيب.
و لنعم ما قال شيخنا الأنصاري في طهارته: فلم يبق مع الحلّي رواية تدلّ على كفره (أي كفر ولد الزنا)، و لا فتوى يوافقه إلا علم الهدى - السيد المرتضى - فكيف ينفى الخلاف؟
أقول: أمّا الرواية الأولى فإن سلّمنا تمامية دلالتها فهي ضعيفه سنداً، كما أشرنا إليه سالفاً، و كذا الرواية الثانية، بل لم تثبت كونها رواية؛ لأنّ مرجع الضمير في قول الراوي: «كنّا عنده» غير معلوم، و إرجاعه إلى الصادق (ع) كما قيل بلا دليل، و أما صحيحة أبي خديجة فهي تضمنّت أمرين: أحدهما: أنّه لا يطيب، ثانيهما: أنّه لا يقبل عمله.
أمّا الأمر الأول فقبوله غير ضائر بإيمانه، بعل بعدالته.
و أمّا الأمر الثاني فهو مقطوع البطلان، ضرورة دلالة العمومات القرآنية عمل الصالحين و المتّقين، و لا يمكن تخصيصها بغير ولد الزنا بهذه الروايات، فإنّها آبية عن التخصيص، كيف؟ و لا يسع لأحد أن يقول بتخصيص قوله تعالى: إِنّٰا لاٰ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً(1) و أّنه يضيع أجر بعض المحسنين!!
و أمّا الروايات الدالة على أنّ ديته كدية اليهودي، فهي أيضاً ضعيفة الإسناد جداً، و في الجواهر: أنّه لم ينقل القول به عن أحد من الأصحاب غير القائلين بكفره، فهذه الروايات لم تصلح لاستناد ثبوت كفر ولد الزنا إليها على هدي ما ذكر، فيصبح قول علم الهدى و ابن إدريس ضعيفاً باطلاً؛ لعدم الدليل عليه.
أضف إلى ذلك و أقول: إنّ الدليل القطعي قائم على بطلان هذا القول، فإنّ ولد الزنا إذا كان كافراً نجساً مستحقاً للنار، سواء أطاع أو عصى! فإمّا أن يكون مكلفاً كغيره، أو لا يكون مكلفاً بشيء؟
و الثاني باطل قطعاً، بل ضرورة، و الأول يستلزم صحة عمله إذا أتى على وفق ما كلف به،
ص: 329
و إلاّ لغي التكليف المذكور.
و على الجملة: هذا القول مصادم للقواعد المتأصّلة الثابتة عند العدلية، و يناسب مذهب الأشاعرة، فإذن لا نشكّ في سقوطه و ضعفه، و إن كان قائله من المشاهير، لكنّ العبرة بالقول دون القائل.
القسم الرابع: ما دلّ أنّه يجزى بعمله مثل رواية ابن أبي يعفور(1) قال: قال أبو عبد الله (ع): «إن ولد الزنا يستعمل، إن عمل خيراً جزي به، و إن عمل شرّاً جزى به.
قال العلاّمة المجلسي (رحمه الله): هذا الخبر موافق لما هو المشهور بين الإمامية من أن ولد الزنا كسائر الناس مكلّف بأصول الدين و فروعه، و يجري عليه أحكام المسلمين مع إظهار الإسلام، و يثاب على الطاعات و يعاقب على المعاصي. انتهى كلامه، و هذا هو الحقّ الصحيح.
و قال بعضهم(2): و أكثر أصحابنا: على إسلامه و طهارته، و إمكان تديّنه و عدالته و صحة دخوله الجنة.
أقول: الإنصاف أنّ دخوله الجنة و إن كان هو الأنسب بالأدلة النقلية و الاعتبارات العقلية كما حرّرناها، لكنّه ليس بقطعي، و قال الفقيه الأعظم صاحب الجواهر (قدس سره) في كتاب الشهادات في الوصف السادس للشاهد: نعم، ذلك (أي منع شهادته) لا يقتضي عدم إجراء حكم الإسلام، بل و الإيمان، بل و العدالة عليه في غير مورد النصّ و الفتوى، بل قد تحمل صحة الاطلاق مع حضوره و حضور عدل واحد. أقول: ما أفاده متين جداً.
جاء في رواية وهب بن وهب(3)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام) قال: «قال عليّ (ع): أولاد المشركين مع آبائهم في النار، و أولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة، و في حديث عن الكافى(4):
أمّا أطفال المؤمنين فإنّهم يلحقون بآبائهم، و أولاد المشركين يلحقون بآبائهم، و هو قول الله عز و جل: بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (5).
ص: 330
و صحيحة عبد الله بن سنان(1) قال: سالت أبا عبد الله (ع) عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث؟ قال: كفار، و الله أعلم بما كانوا عاملين، يدخلون مداخل آبائهم. و قال (ع): «يؤجّج لهم ناراً فيقال لهم: ادخلوها، فإن دخلوها كانت عليهم برداً و سلاماً، و إن أبوا قال لهم الله عزّ و جلّ: هو ذا قد آمرتكم فعصيتموني، فيأمر الله عزّ و جلّ بهم إلى النار».
أقول: و من الواضح أنّ عذاب من لم يكن مكلّفاً و لم تتمّ عليه الحجة ظلم ينافي عدله تعالى، و لذا حمل الشيخ الصدوق (قدس سره) الروايات المذكورة على البرزخ، حيث قال(2): و أطفال المشركين و الكفّار مع أبائهم في النار؛ لا يصيبهم من حرّها، لتكون الحجة أوكد عليهم، متى أمروا يوم القيامة بدخول نارٍ تؤجّج لهم، مع ضمان السلامة متى لم يثقوا به، و لم يصدقوا وعده تعالى بشيء قد شاهدوا مثله.
لكنّه حمل بعيد بلا شاهد، بل الرواية الأولى كالنصّ على خلافه، فلا عبرة به.
و قال العلاّمة المجلسي (قدس سره)(3): و الأظهر حملها على التقية؛ لموافقتها لروايات المخالفين و أقوال أكثرهم.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: اختلف العلماء في من مات من أطفال المشركين، فمنهم من يقول: هم تبع لأبائهم في النار، و منهم من يتوقف فيهم، و الثالث - و هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون - أنّهم من أهل الجنة. انتهى كلامه.
أقول: قد تقدم في الجزء الأول(4) أنّ أكثرهم حكموا بخلود أطفال الكفار في النار! لكنّ الحمل على التقية موقوف على صحة إسنادها، و إلا فطرحها متعيّن. و الرواية الأولى مرسلة، و وهب أكذب البرية، كما قال بعض الرجاليين. و الرواية الثانية أيضاً مرسلة، فالعمدة هي الثالثة، إلاّ أنّ ذيلها يفسّر صدرها، فلا تنافي عدله تعالى، كما لا يخفى.
لكنّ الظاهر من الفقيه و الحدائق أنّ قوله (ع): «يؤجج لهم ناراً...» إلى آخره، رواية مرسلة مستقلّة، لا أنّه من تتمة الصحيحة، كما يظهر من البحار (الطبعة الحديثة).
فالصحيح أن يقال: إنّ الروايات الدالة على تكليف الأطفال في القيامة و دخولهم في النار بعد مخالفتهم للأمر المتوجه إليهم، تقيّد إطلاق هذه الصحيحة بصورة مخالفتم للتكليف الموجّه إليهم و عصيانه، فالمستفاد من مجموع الروايات لا يكون منافياً للقواعد القطعية العقلية،
ص: 331
و لا أعلم أحداً من الإمامية قال بدخول الأطفال المذكورين في النار تبعاً لآبائهم. و أمّا الروايات الدالة على تكليفهم فقد مرّ ذكرها، و نعيد هنا اثنين منها، و هما: صحيحة هشام(1)، عن أبي عبد الله الصادق (ع): «ثلاثة يحتجّ عليهم: الأبكم، و الطفل، و من مات في الفترة، فيرفع لهم نار، فيقال لهم: ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه برداً و سلاماً، و من أبي قال تبارك و تعالى: هذا قد أمرتكم فعصيتموني».
و صحيحة زرارة(2)، قال: سألت أبا جعفر (ع): هل سئل رسول الله (ص) عن الأطفال؟ فقال: «قد سئل فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين»، ثم قال: «يا زرارة، هل تدري قوله: الله أعلم... إلى آخره»، قلت: لا، قال: «لله عزّ و جلّ فيهم المشيئة، أنّه إذا كان يوم القيامة أتي بالأطفال و الشيخ الكبير الذي قد أدرك السنّ و لع يعقل من الكبر و الخرف، و الذي مات في الفترة بين النبيين، و المجنون و الأبله لا يعقل، فكل واحد يحتجّ على الله عزّ و جلّ، فيبعث الله تعالى إليهم ملكاً من الملائكة و يؤجّج ناراً، فيقول: إنّ ربّكم يأمركم أن تثبوا فيها، فمن وثب فيها كانت عليه برداً و سلاماً، و من عصاه سيق إلى النار».
فذلكة:
يعارض هاتين الصحيحتين و غيرهما من الروايات الصحيحة و غير الصحيحة ما دلّ على أنّ أطفال المشركين خدم أهل الجنة على صورة الولدان، لكنّ سنده ضعيف للإرسال، و يعارضها أيضاً إجماع الإمامية (قدس سره) على دخول الأطفال المؤمنين في الجنة.
قال المجلسي(3): ثم اعلم أنّه لا خلاف بين أصحابنا في أن أطفال المؤمنين يدخلون الجنة(4)، و ذهب المتكلمون منّا إلى أنّ أطفال الكفّار لا يدخلون النار، فهم: إمّا يدخلون الجنة،
ص: 332
أو يسكنون الأعراف. و ذهب أكثر المحدثين منّا ما دلّت عليه الأخبار الصحيحة من تكليفهم في القيامة بدخول النار المؤجّجة لهم... إلى آخره.
أقول: قد تقدم أن المتعيّن هو قول المحدّثين، و لا وجه لإنكار المتكلّمين التكليف المذكور بعد ورود صحاح الأخبار، و عدم ما ينافيها، و هذا ظاهر، و العمدة في المقام: دخول أطفال المؤمنين الجنة مطلقاً، أي بلا تكليف، فإنّه منافٍ للصحاح المذكورة الدالة بإطلاقها على أنّهم يكلّفون في القيامة و يدخل المطيع منهم الجنة و العاصي النار.
و لعلّ مستند الإجماع على دخولهم الجنة: ما دلّ على أنّ أطفال المؤمنين يلحقون بآبائهم، و أنّهم يستغفرون تحت عرش الرحمن لآبائهم يحضنهم إبراهيم و تربيهم سارة (عليهاالسلام) في جبل من مسك و عنبر و زعفران، و ما دلّ على أنّ طفل المؤمن إذا مات دفع إلى بعض أهل بيته إن كان، و إلاّ دفع إلى فاطمة (عليهاالسلام) تغذوه حتى يقدم أبواه أو أحدهما أو بعض أهل بيته، فتدفعه إليه. و ما دلّ على أنّ إبراهيم وسارة (عليهاالسلام) يغذوانهم بشجرة في الجنة لها أخلاف، فإذا كان يوم القيامة ألبسوا و أطيبوا و أهدوا إلى آبائهم، فهم ملوك في الجنة مع آبائهم(1).
فإن هذه كلّها بين ما هو ظاهر و ما هو مشعر بدخول أطفال المؤمنين الجنة بلا تكليف.
و يمكن أن يستدلّ عليه أيضاً بقوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اِتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مٰا أَلَتْنٰاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ (2).
قال في مجمع البيان: يعني بالذرّية أولادهم الصغار و الكبار؛ لأنّ الكبار يتبعون الآباء بإيمان منهم، و الصغار يتبعون الآباء بإيمان من الآباء، لكنّه غير واضح، فإنّ ظاهر الآية الكريمة إلحاق الذرّية المؤمنة بالآباء، لا مطلق الذرّية.
و في بعض الروايات: «قصرت الأبناء عن عمل الآباء(3) فألحقوا الأبناء بالآباء لتقر بذلك أعينهم.
و عليه فلا ربط للآية بمحلّ البحث؛ إذ لا تشمل الذرّية الصغار.
و على الجملة: الإجماع المذكور و هذه الروايات تنافيان تلك الصحاح الدالة على تكليف الأطفال يوم القيامة، و دخول مطيعهم الجنة و عاصيهم النار.
نعم، حمل المحدّث الكاشاني - كما في الحدائق - الطائفة الأولى على البرزخ، و الثانية على القيامة، لكنّه حمل فاسد تبطله الروايات نفسها، فلاحظ.
ص: 333
و لذا على المحدّث البحراني عنه، و ذكر وجهين آخرين لدفع التنافي المذكور، لكنّهما أيضاً ممّا لا دليل عليهما، بل هما من الجمع التبرّعي الذي لا يغني و لا يسمن(1).
و الأحسن هو القول بتخصيص الصحاح المذكورة بغير أطفال المؤمنين، جمعاً بين الأدلة، فإنّ الصحاح المذكورة و غيرها تدلّ على تكليف أطفال المؤمنين يوم القيامة و بالإطلاق، و الإجماع و الأخبار المتقدمة يصلحان لتقييدها، فهذا الجمع جمع صناعي متين، غير أنّ الالتزام به مشكل، و المقام ذو صعوبة.
وَ اِتَّقُوا فِتْنَةً لاٰ تُصِيبَنَّ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (2)
ففي بادئ النظر يتوهّم أنّ إصابة الفتنة إلى غير الظالمين لا يلائم عدله تعالى.
و جوابه: أنّ الفتنة في حقّ الظالمين عقاب و انتقام، و في حقّ غير الظالمين إيلام يعوّضهم الله في الآخرة لأجله، و هذا لا خفاء فيه.
جاء في مرفوعة الأشعري إلى الصادق (ع) قال: «خمسة خلقوا ناريّين: الطويل الذاهب، و القصير القميء (الذليل الصغير)، و الأزرق بخضرة، و الزائدة و الناقص.
و في رواية محمد بن الحسين بإسناد له يرفعه، قال: قال رسول الله (ص): «لا يدخل الجنّة مدمن خمر... و لا شديد السواد...» إلى آخره.
و عن الصدوق: يعني شديد السواد: الذي لا يبيضّ شيء من شعر رأسه، و لا من شعر لحيته مع كبر السنّ، و يسمّى الغربيب.
و في رواية سعيد، يرفعه إلى الصادق (ع) قال: «ستة لا ينجبون: السندي، و الزنجي، و التركي، والكردي، و الخوزي، و نبك الري.
و في رواية مطرف، عنه (ع) قال: «لا يدخل حلاوة الإيمان في قلب سندي، و لا زنجي، و لا خوزي، و لا كردي، و لا بربري، و لا نبك الري، و لا من حملته أمّه من الزنا.
و في رواية داود بن فرقد، عن الصادقين: «ثلاثة لا ينجبون: أعور يمين، و أرزق
ص: 334
كالفصّ، و مولد السند، و غير ذلك من الروايات(1).
أقول: هذه الروايات كلّها ضعيفة الإسناد، فلا مجال للاعتناء بها فضلاً عن الاعتماد عليها، و كانت الرحى تدور - و لا تزال الحدّ الآن - على غير مدارها، فقد أتيح لبني أمية الفجرة و بني العبّاس الفسقة كلّ شيء، حتى جعل الروايات من النبي الأعظم و أولاده الطاهرين، و لو لحطّ مقامهم و تنفير القلوب عنهم، و بجانب هؤلاء كان إناس لا شرف و لا دين لهم سوى البطن و الفرج، و لا صفة لهم سوى الشهوة و الغضب، فاخترعوا أموراً نسبوها إلى الأئمة من آل محمدٍ (ص)، بل و إلى الرسول الأعظم (ص)، أيضاً، و قد ساعدهم جمود الجماهير فأصبحت جعلياتهم روايات مأثورة ببركة تسامح المحدّثين من نقل كلّ شيء مع الغض عن أسانيدها في كتبهم.
و من هنا اضطرّ رجال من أهل الديانة و الفضيلة و الدقّة إلى تنقيح الروايات و تمييز الباطل من الصحيح، و على أثر هذا القيام وضع على الرجال، فنحن نردّ هذه المجعولات إلى جاعليها.
و نوصي القراء المدقّقين و المحقّقين بمراجعة كتابنا (بحوث في علم الرجال الذي ألفناه بعد هذا الكتاب بسنين كثيرة و بمراجعة مشرعة بحار الأنوار، بعد هذا الكتاب بمراجعة تعليقتنا على جامع الأحاديث المميزة لمعتبرات أحاديثها من غير المعتبرة و الله التوفيق.
و نختم كلامنا في هذا القصد، حامدين شاكرين لله ربّ العالمين، و مصلّين و مسلّمين على خاتم المرسلين و أفضل العالمين، و على عترته المعصومين الأنجبين الأفضلين.
و نسأل الله تعالى أن يوفّقنا لطبع بقية الأجزاء، كما وفّقنا لطبع هذا الجزء و الجزء الأول، و أن يتقبّل هذا العمل منّا بفضله و كرمه إنّه رحيم كريم، اللهمّ ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت نستغفرك و نتوب إليك.
ص: 335
الصورة
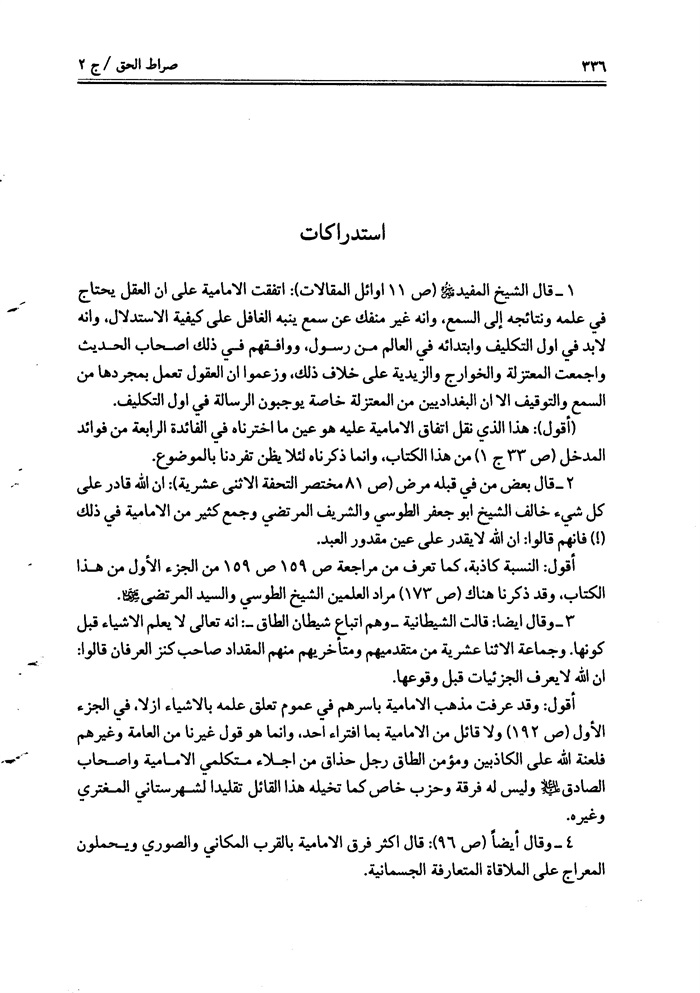
ص: 336
الصورة
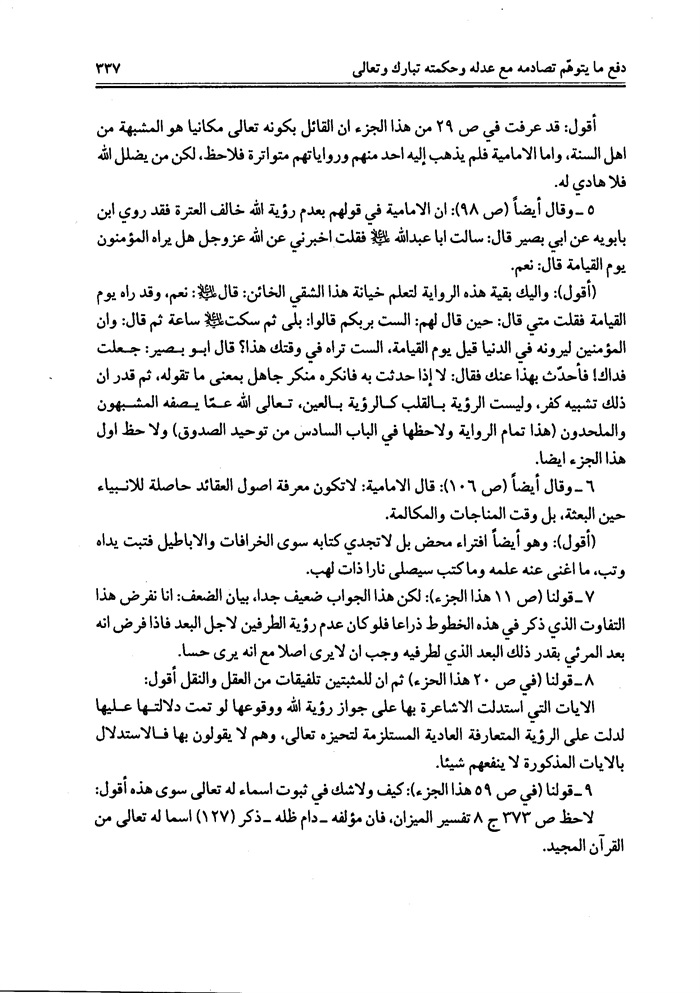
ص: 337
ص: 338
الصورة

ص: 339
الصورة
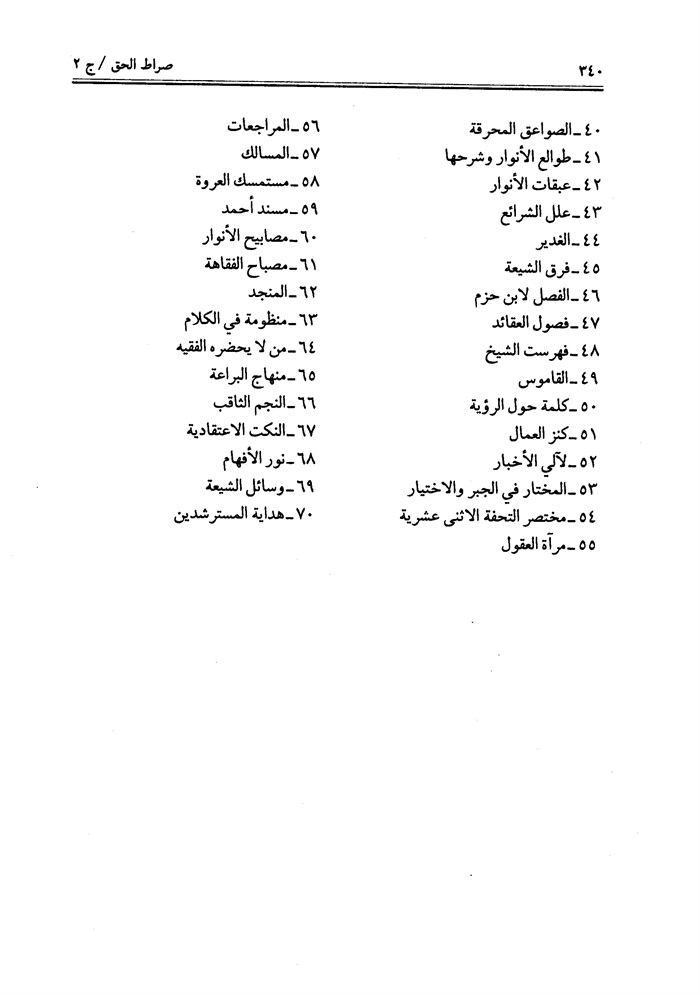
ص: 340
الصورة
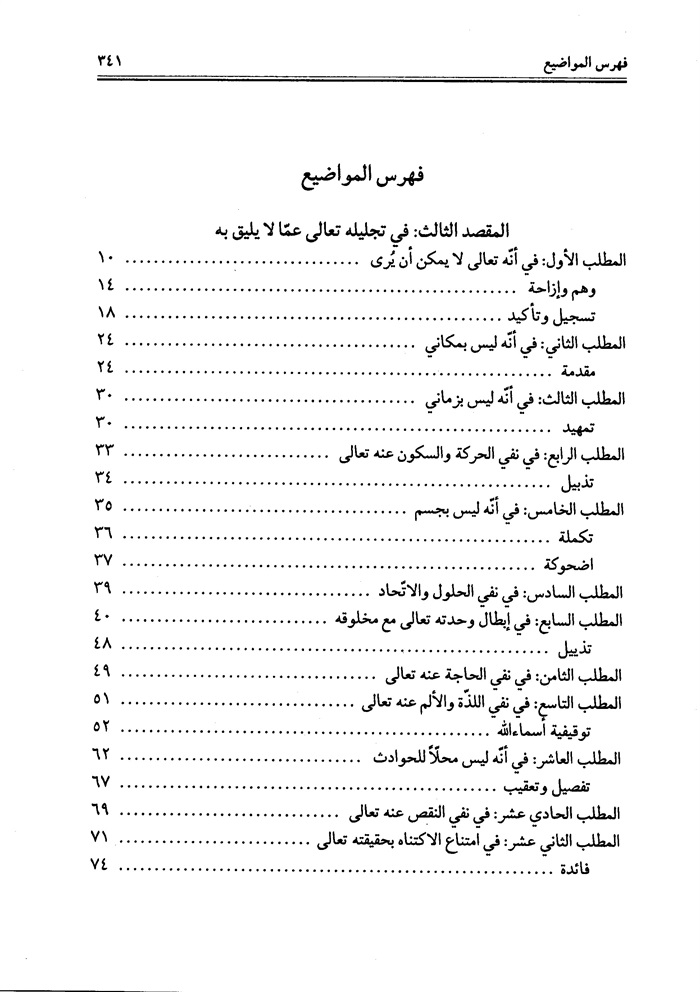
ص: 341
الصورة
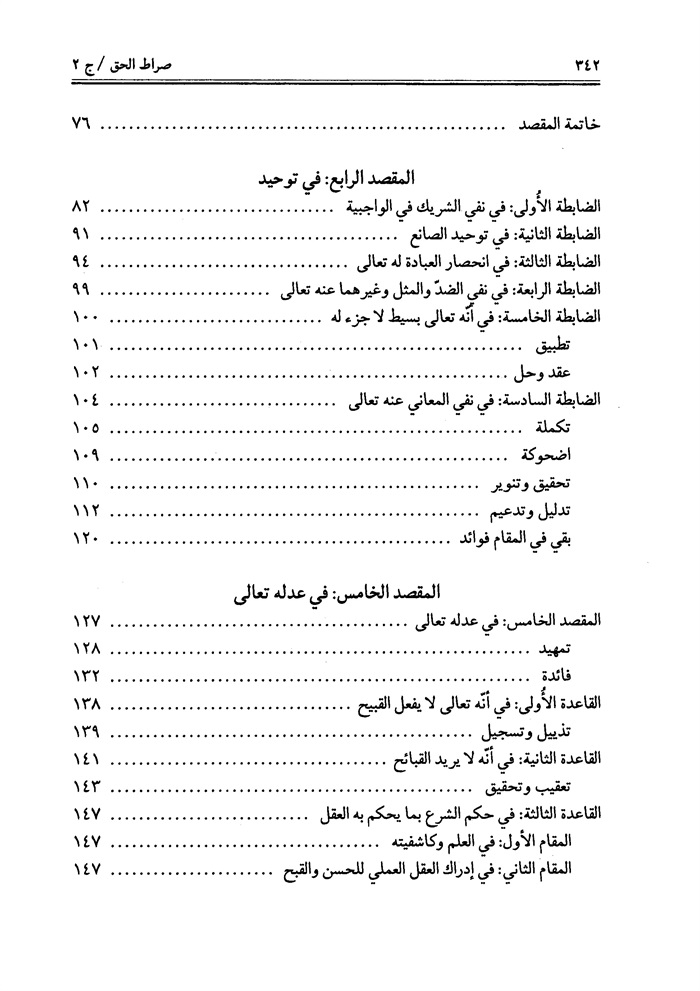
ص: 342
الصورة
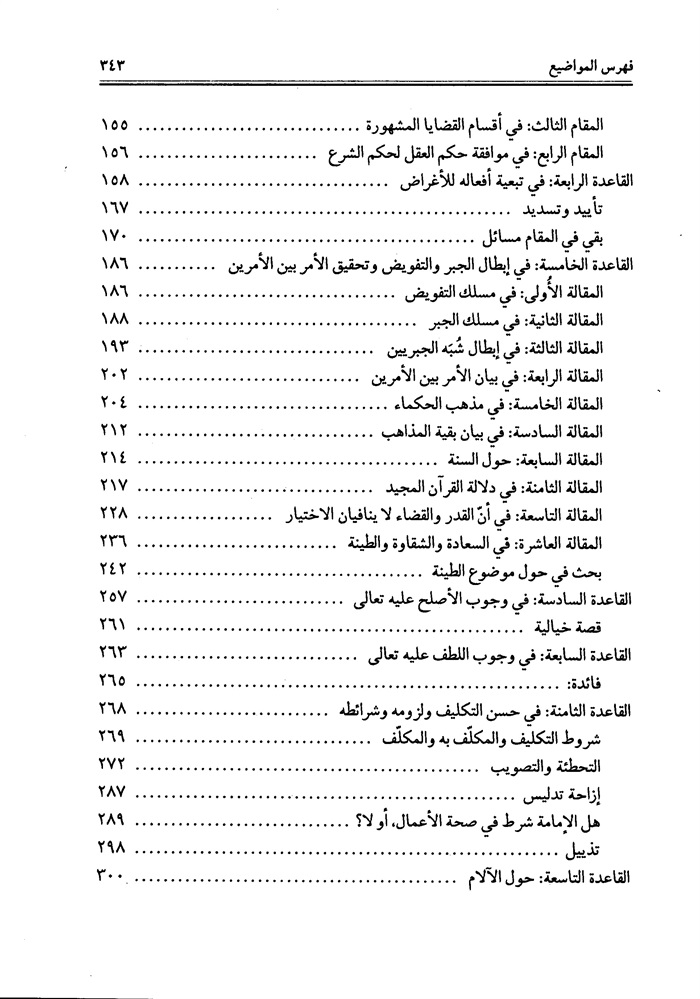
ص: 343
الصورة
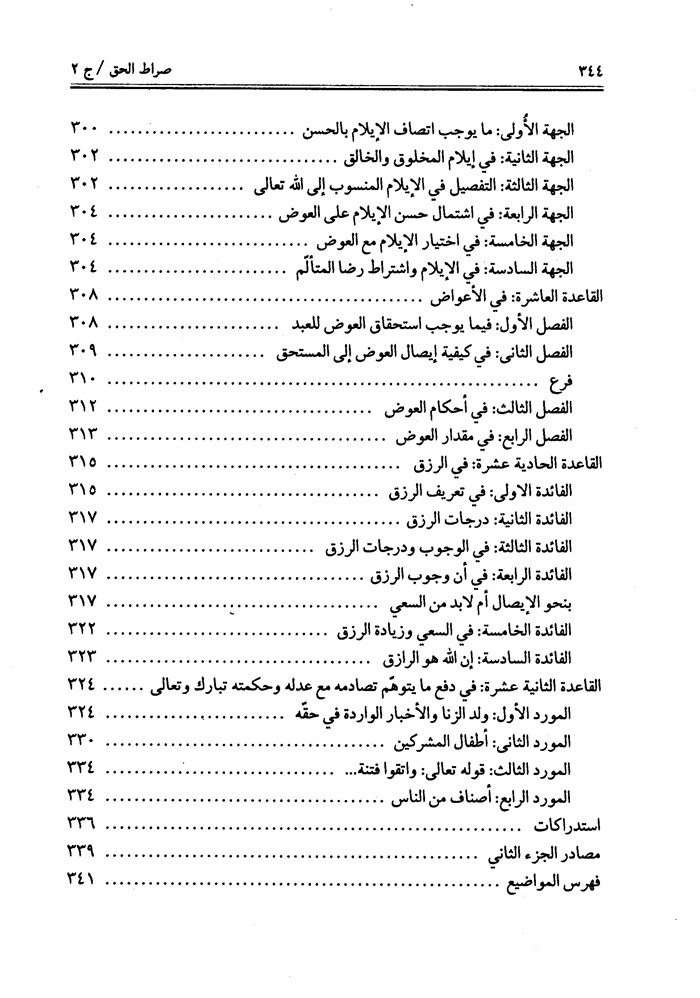
ص: 344